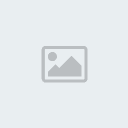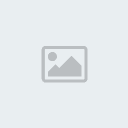
في كتابه الصادر حديثاً عن “دار التنوير في بيروت” بعنوان “الحداثة والقرآن”، يخوض الكاتب المغربي سعيد ناشيد مغامرة تفكيك قضايا إشكالية في القرآن، كانت وما تزال موضع خلاف وجدال، سلمياً أحياناً، وعنفياً أحياناً أخرى. لعل ما يشهده العالم العربي والإسلامي اليوم من صراعات تعطي لنفسها عنوان الدفاع عن الدين، خير مبرر للدخول في عالم القرآن بجرأة ومن دون تحفظ لنزع الشرعية الدينية عن مستخدمي النص القرآني في صراعات سياسية ومذهبية، وهو ما أراد الكاتب في قوله بأنه يهدف إلى تقديم “أطروحة متكاملة قد تساعدنا في إعادة بناء العلاقة مع النص القرآني على أساس تعبدي قد يساهم في طمأنينة النفس، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تحريضي أو أيديولوجي قد ينتج البغضاء والطغيان والتطرف”.
يفتتح ناشيد كتابه بسؤال عن ماهية القرآن وما إذا كان حقاً كلام الله ونصاً أملته السماء؟ لا ينفي الجواب أن يكون الله هو منتج الوحي الذي حوّله الرسول إلى جمل وعبارات وقام بتأويل هذا الوحي وفق رغبته وثقافته ولغته وشخصيته وبيئته وعصره، مما يجعل من القرآن نصاً بشرياً بامتياز. لاحقاً، وفي امتداد انتشار الدعوة الإسلامية، جرى تحويل “الرسول إلى أقنوم ثان يجاور الذات الإلهية بل يتجاوزها أحياناً”، كما أصبح النص القرآني نصاً مغلقاً ثابتاً مستندًا إلى المصحف الذي جمعه الخليفة الثالث عثمان بن عفان، بحيث بات يعرف ب“المصحف العثماني” الذي توافقت عليه المذاهب الإسلامية، بعد أن جرى إتلاف سائر المصاحف بالقوة.
أثار النص القرآني وكيفية التعاطي معه وتأويل سوره وآياته معضلات ومشاكل دينية وثقافية وسياسية لم تتوقف حتى اليوم. كسائر النصوص الدينية السابقة على الإسلام ومعه، جرى إطلاق القداسة عليها باعتبارها كلام الله الذي لا يأتيه الباطل، وجرى التعاطي معها بوصفها المرشد للبشر في حياتهم وعملهم، وكل اجتهاد وتأويل يخرج بالنص عن حرفيته يدمغ صاحبه بالكفر والهرطقة. مشكلة الأديان مع نصوصها المقدسة أنها لا تأخذ في الاعتبار صدورها أو كتابتها في مراحل تاريخية كان ال“المجتمع فيها بلا مؤسسات، والسلطة بلا قوانين، والمعرفة بلا مناهج، واللغة بلا قواعد”، أي باختصار يجري التعاطي مع النصوص على أنها ثابتة ولا تخضع لمتغيرات الزمان والمكان والتطور الاجتماعي والثقافي والبشري.. وهو ما يجعل اتهامها بالجمود والدوغمائية اتهاماً في محله. يؤكد ذلك ما تشهده مجتمعاتنا العربية والإسلامية من انبعاث لحركات أصولية وسلفية تريد العودة بنا إلى قرون سابقة، وتفرض قراءة للنصوص الدينية تجعل من الدين الإسلامي دينا يبرر الإرهاب والعنف، استنادًا إلى آيات نزلت في مرحلة من الزمن خلال صراع المسلمين لنشر الدعوة، وهي آيات تقادمها الزمن ولا علاقة لها، لا بالزمن الراهن، ولا بالجوهر الحقيقي للدعوة الإسلامية من حيث هي دعوة إلى الإيمان بالتوحيد ونشر الأخلاق والمحبة والتسامح.. يطرق ناشيد الصواب عندما يقول :“إنّ انتقال فكرة الله في الإسلام من مستوى الخطاب الوحياني والآيات البينات ذات الطابع الشفوي، إلى مستوى نص كتابي ثابت ومقدس ومحكم الإغلاق، قد جمّد الألوهية عند مستوى النمو العقلي والأخلاقي للحظة تدوين النص القرآني”.
يحتل الوحي موقعاً مركزياً في الأديان ونصوصها الدينية. ينسب إلى جميع الأنبياء أنّ الله كان يوحي إليهم، وأنّ هذا الوحي المترجم على لسان النبي هو كلام الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل. سيترتب على هذا الاقتناع نتائج سلبية على النص وكيفية قراءته والتعاطي معه. صحيح أنّ “القرآن وحي إلهي فعلاً ورباني فعلاً وسماوي فعلاً، لكنه ليس كلام الله أبدًا. إنه وحي نابع من وجدان الرسول” على ما يشير الكاتب. لكنّ الوحي خضع لتفسيرات متعددة كان جزءا من هذه التفسيرات يهدف إلى نزع “الأسطرة” عن الوحي ويعطيه تفسيره الفعلي. فالوحي عند النبي محمد كان تعبيرًا عن قوة تخييلية تمتع بها الرسول كما تمتع بها أنبياء من قبله. كان محمد قوي الخيال، لكن عقليته لم تكن لتتجاوز في تفوقها سوى العقلية العربية في زمانه ومكانه وبيئته. جميع الرسل تميزوا بقوة ملكة الخيال، وكل اختلاف في الشرائع يعود إلى اختلاف خصال الأنبياء، لأن كل شريعة متناسبة مع خراج وطبيعة النبي المبعوث بها على ما يشير جلال الدين الرومي. بعض ما يتميز به الوحي عند الرسول أنه كان يأتيه ليلاً، وهو ما يشير إليه نولدكه في كتابه “تاريخ القرآن” حيث يقول :“لا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلاً كما يبدو، حين تكون النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح النهار”.
ما الذي يجعل القرآن، نصا وتأويلاً، غير متوافق مع ما قدمته الحداثة خصوصاً خلال القرنين الماضيين؟ ليست الحداثة احتكارًا غربياً على رغم إنجازات الغرب في ميادينها المتعددة، لكن الحداثة هي مجمل التقدم البشري والتطور الإنساني الذي يطال مختلف جوانب الحياة ومنها مسألة النظر إلى الدين والظاهرة الدينية. تبدو نقاط الاختلاف انطلاقاً من تقديس النص الديني وتأليهه، بما منع إخضاعه لمنطق العقل الذي يعتبر أهم مكون وإنجاز من إنجازات الحداثة. هذا الإغلاق على العقل أدى إلى خلط رهيب بين الجوهر الديني الأخلاقي منه والإنساني، وبين مفاهيم وأحكام وروايات يغلب عليها الخرافات والأساطير. إنّ إضفاء صفة الدستور الإلهي على القرآن ورفض الاجتهاد والتأويل بما يتناسب وتطورات المجتمع، يجعل من الكثير من أحكامه تقع خارج الزمان والمكان ومجمل التطور البشري. “فحين نظن أن القرآن المحمدي كلام صدر أو فاض مباشرة عن الذات الإلهية، ونزل بالتمام والكمال وبالمعنى الحرفي، فإننا ننتهي إلى تقديس كل أفعال الأمر الواردة فيه، باعتبارها أوامر الله إلى الإنسان.. يتحول الخطاب القرآني من رسالة تعبدية إلى وصاية أبدية تعطل الإبداع وتشل الإرادة: بهذا النحو يصير القرآن عائقاً من عوائق التحديث” على ما يقول سعيد ناشيد.
يعاني النص القرآني من معضلتين أساسيتين تؤثران على مهمته الأصلية. الأولى تتصل بقراءة النص وتفسيره أو تأويله، والثانية بتحميله قضايا لا صلة لها بالدين من قريب أو بعيد. من المعروف أنّ القرآن أتى في الأصل داعية إلى الهداية والإيمان بالله الأحد، ومشددًا على المحبة والإخاء والإحسان وحسن التعامل بين البشر، أي باختصار أتى دعوة إلهية تحض على الأخلاق الحميدة. هذه المبادئ ينطبق عليها حقاً أنها متجاوزة للزمان والمكان وتصلح لكل الشعوب في العالم بصفتها تقوم على علاقات إنسانية بين البشر، وروحية مع الله. هذا هو جوهر الرسالة المحمدية. لكن الرسول، وفي سياق الدعوة، كان عليه أن يواجه مع قومه تشريعات وعادات وتقاليد موروثة من مرحلة ما قبل الإسلام، وكان عليه أن يجيب عن مسائل كثيرة تتعلق بتدبير أمور المسلمين. كانت أجوبة الرسول في هذه المسائل، إما تكرّس ما كان موروثاً، أو تعدل من السائد فيها، مع العلم أنّ الرسول كان يؤكد دوماً على أتباعه “أنكم أدرى بشؤون دنياكم”. كانت تلك “التشريعات” ذات صلة وثيقة بالمرحلة الزمنية التي كانت الدعوة الإسلامية تمر بها، وكانت أيضاً متصلة اتصالاً وثيقاً بالبئية العربية وعاداتها، مما ينفي عنها صلاحيتها لكل زمان ومكان. عمد الفقهاء والمؤسسسات الدينية إلى الخلط بين جوهر العقيدة وبين التشريعات الضرورية التي فرضتها مسيرة الحياة اليومية للمسلمين في العلاقة بين بعضهم البعض أو بين غير المسلمين المقيمين في ديار الإسلام. أصرّ الفقه الإسلامي على اعتبار كل ما ورد في النص القرآني هو كلام الله الأزلي والصالح لكل زمان ومكان، واتهموا كل مخالف بالهرطقة والكفر وأهدروا دمه. لا تزال هذه المعضلة تشكل القضية المركزية في قراءة النص وفهمه، ولا تزال المؤسسات الدينية ترفض التعاطي بأن هذا النص له تاريخ وزمان وبيئة معينة، وهي عناصر تحدد موقعه ومكانته.
من القضايا الهامة جدا التي تواجه المسلمين اليوم الآيات القرآنية المتصلة بالجهاد. واجهت الدعوة الإسلامية قوى تصدت لها بالقوة، وأدى ذلك إلى نشوب حروب خاض معظمها النبي، ونزلت آيات تتصل بقتال غير المسلمين، بحيث نرى في القرآن حضاً على القتل والقتال لغير المسلمين أو للكفار. على رغم مرور أكثر من أربعة عشر قرناً على نزول هذه الآيات، فإن المؤسسات الدينية ترفض حتى الآن الاعتراف بتقادم زمانها وعدم صلاحيتها لعصرنا. فاقم هذه المشكلة انبعاث الحركات الأصولية الإسلامية التي وضعت في رأس أولوياتها اعتماد العنف وسيلة لتحقيق أهدافها في الوصول إلى السلطة وإعادة الخلافة الراشدية. من أجل ذلك، أحيت آيات العنف والقتل الواردة في النص القرآني، وبنت خطابها انطلاقاً من هذه الآيات، وبررت أعمالها بأنها تنفيذ لإرادة الله في الجهاد لإحياء الإسلام الحق. صحيح أن ردود الفقهاء تركز اليوم على أن الإسلام ضد العنف وهو دين المحبة والرحمة، إلا أنهم يرتبكون عندما يتصل الأمر بالإعلان عن أن هذه الآيات لا صلة لها بالكتاب المقدس للمسلمين وأن زمانها قد ولى. هذا الارتباك، ومعه ممارسات الحركات الإسلامية المتطرفة، أدى إلى وسم الإسلام بالإرهاب وأنه دين العنف والقتل. وقد وفرت ممارسات الحركات المتطرفة الحجة اللازمة لوسم الإسلام بهذا الإرهاب. يشير ناشيد إلى هذه المسألة بالقول :“إن التحريض القرآني على القتل والقتال، أيا كانت مسوغاته ومبرراته، لا يعكس”وجهة نظر الله“، وإنما يعكس أثر شخصية الرسول في تأويل الوحي الإلهي.. المفاهيم القتالية الواردة في النص القرآني هي مجرد تدابير فرعية تخص بيئة الرسول وتناسب عنف ما قبل الدولة.. إنّ آيات الدعوة إلى القتل والقتال في القرآن لا تمثل أي قانون مقدس أو تشريع إلهي، بل هي مجرد توصيات فرعية تناسب ثقافة الرسول”.
ترفع المؤسسات الدينية ومعها الحركات الأصولية شعارًا مفاده أن القرآن هو دستور المسلمين والأساس الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية. تطبيقاً لهذا الشعار أخضعت معظم قوانين الأحوال الشخصية في أكثر البلدان العربية والإسلامية إلى ما تضمنه القرآن من آراء في شؤون دنيوية كان على الرسول التطرق إليها وإعطاء أجوبة في شأنها. تنصيب القرآن دستورًا يخضع له المسلمون تسبّب على مدار التاريخ بفتن وحروب بين المذاهب والطوائف الإسلامية، بالنظر إلى تعدد التفسيرات والتأويلات للنصوص المتصلة بالحياة الدنيوية، وهو صراع لم يتوقف حتى اليوم. الدستور وفق المنطق الذي قدمته الحداثة لم يكن يوماً مفهوماً قرآنياً، ويستحيل أن يكون. الدستور يخضع إلى الواقع الإجتماعي ودرجة تطور المجتمع بحيث تأتي التشريعات الوضعية متناسبة مع الواقع الذي يمر به بلد محدد. فيما يؤدي إصرار المؤسسات الدينية على اعتبار القرآن دستورًا إلى تجميد التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي لأنه “كلما اتسع الفارق الزمني بين النص الديني والواقع العيني، اتسعت مساحة الفراغ التشريعي، ومن ثم استعصى القياس.. إن الإصرار على ترسيم القرآن كدستور إلهي هو محصلة مسار طويل من الانتقال من إسلام الفطرة إلى إسلام الحبر والورق”.
يصرّ الخطاب الإسلامي الذي تنطق به قوى ومؤسسات إسلامية على تصنيف القرآن كتاباً يحوي نظريات علمية، منها ما هو صريح في النص، ومنها ما هو مضمر في الآيات، ويصل المنظرون إلى اعتبار معظم الاكتشافات العلمية الحديثة إنما تعود بذورها وجذورها إلى النص القرآني. ليس هناك ما يسيء إلى القرآن أكثر من اعتباره كتاباً علمياً، فالنظر إلى النص القرآني بمنظار النظريات العلمية الحديثة هو ظلم للقرآن وللعلم في الآن نفسه. صحيح أنّ القرآن كانت له نظرات حول الأرض والشمس تعكس النظرة العلمية السائدة في العصور القديمة ومنها مجتمع الجزيرة العربية، مما يعني أن القرآن وثقافة الرسول كانت محكومة بدرجة تطور العلم آنذاك. وقد أظهر العلم لاحقاً خطأ النظريات العلمية القديمة حول الأرض والشمس، هو أمر ينطبق على ما أتى به القرآن، لأنّ “الخطاب القرآني يعكس منذ البدء المستوى العلمي للعصر الذي عاش فيه الرسول، وهو عصرسبق العلم، وسبق الفيزياء، وسبق الثورة الكوبرنيكية بمئات السنين”.
ساد اعتقاد منذ القدم، ولا يزال سائدًا، باعتبار القرآن المرجع الأعلى للنص العربي الفصيح والمطابق لقواعد اللغة العربية كتابة ونحوًا. وخرجت مجلدات تؤكد على إعجاز القرآن وعدم قدرة أي إنسان أن يأتي بمثل آياته. تكرست هذه النظريات بالتطابق مع تصنيف القرآن كتاباً إلهياً لا يأتيه الباطل، لا في الشكل ولا في المضمون. اصطدم كثير من علماء النحو بوجود هفوات نحوية في المصحف العثماني عزوها إلى كون المصحف كتب بلغة عربية لم تكن تحوي بعد قواعد، كما أن التقاليد الكتابية لم تكن قد ترسخت، لذا رأى هولاء العلماء أن وجود أخطاء وهفوات أمر لا يجافي الطبيعة. ورأوا أن الهنات اللغوية تنتمي إلى غلبة الأسلوب التداولي الشفهي في زمن الرسول. المشكلة القديمة الراهنة والمستمرة تكمن في تقديس النص القرآني واعتباره “كلام الله” بالتمام والكمال، وهو ما أدى إلى إبقاء الأخطاء والهنات في النص طالما أن الله لا يخطئ. يعدد سعيد ناشيد بعضاً من هذه الأخطاء النحوية المتضمنة في القرآن من قبيل :“1 ــ رفع المعطوف على المنصوب. 2 ــ نصب الفاعل. 3 ــ تذكير خبر الإسم المؤنث. 4 ــ تأنيث العدد وجمع المعدود. 5 ــ جمع الضمير العائد على المثنى. 6 ــ جاء باسم الموصول العائد على الجمع مفردًا. 7 ــ جزم الفعل المعطوف على المنصوب. 8 ــ جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً. 9 ــ نصب المعطوف على المرفوع. 10 ــ نصب المضاف إليه. 11 ــ أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة. 12 ــ جمع إسم علم حيث يجب إفراده. 13 ــ وضع الفعل المضارع بدل الماضي. 14 ــ لم يأت بجواب لمّا. 15 ــ نوّن الممنوع من الصرف. 16 ــ وقوع المفعول موقع الفاعل. 17 ــ أتى باسم جمع بدل المثنّى”.
لا يكف رجال الدين والفقهاء عن اعتبار القرآن قانوناً جنائياً ينص على عقوبات يجب تطبيقها على المرتكبين لأخطاء أو جرائم. في هذه المسألة تبدو المسافة شاسعة جدًا بين نصوص القرآن العقابية ومنجزات الحداثة على صعيد حقوق الإنسان وإخضاع العقوبات لقوانين ومؤسسات بعيدًا عن منطق الغرائز والثأر. فالتصورات العقابية للنص القرآني تقول بالقصاص العين بالعين، وتشرّع الجلد والرجم والقطع والحرق.. وهي عقوبات تستعيدها اليوم التنظيمات الأصولية المتطرفة في وصفها عقوبات سنها الله في كتابه، ويجب الالتزام بتطبيقها. لعل نظام العقوبات “الإسلامي” هذا من العناصر التي تشوّه صورة الإسلام وتؤكد على دور النص الديني في صناعة العنف والإرهاب. إنّ نظام العقوبات هذا يعود إلى الزمن القديم الذي تجاوزته التطورات والتقدم البشري في عصرنا الراهن، وهو من الأمور التي يجب على المؤسسات الدينية والفقهاء اعتبارها متقادمة مع الزمن، مما يعني انعدام صلاحيتها لصالح القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان وتمنع العسف عنه.
يكمن التناقض الأكبر بين منطق الحداثة ومنطق القرآن في المسائل المتعلقة بموقع الإنسان الفرد وحقوقه الخاصة. “في عالم الحداثة يدرك كل فرد أنّ وجوده بلا غاية محددة سلفاً، بلا طريق مرسوم مسبقاً، بلا صراط موضوع لعبور الجميع. إنسان الحداثة سيد نفسه، وتكون علاقته بالجماعة علاقة شراكة لا علاقة إذعان. القدرة على امتلاك الوعي بالذات كفاعلية مستقلة هي الفيصل بين العالمين القديم والجديد، وهي الشرط الوجودي والوجداني للوعي بالحرية والكرامة. تاريخ الحداثة هو تاريخ مفهوم الحرية. في العالم القديم، كانت حرية الفرد تأتي في أدنى سلم القيم، لم يكن الفرد موجودًا في الأساس ، كان الفرد مجرد تابع وخاضع للجماعة والعشيرة والطائفة. إنّ الفرد هو ابن الحداثة” على ما يشير سعيد ناشيد. في مقابل هذا الفهم الحداثي للفرد وموقعه، يأتي النص القرآني على نقيض هذه المفاهيم بحيث يؤدي إلى إعاقة وعي الإنسان بذاته كإنسان فرد وكينونة مستقلة. يركز النص القرآني على الطاعة بوصفها فضيلة أخلاقية، توجب على الفرد طاعة الحاكم والولي على أمره. فالطاعة تؤدي إلى ذوبان الفرد داخل الجماعة، وامحاء الذات أمام مشيئة ولي الأمر. وهناك “مفهوم الاتباع” في القرآن الذي يؤدي إلى “تلاشي فردانية الإنسان أمام النموذج السلوكي الوحيد والذي يتوجب على كل فرد اتباعه”. وينص القرآن على “مفهوم ملك اليمين” والذي يطال المرأة بحيث يؤكد على عبوديتها وإلحاقها بالرجل. إضافة إلى ذلك، يتضمن القرآن آيات تبيح أو تتسامح مع الرق والإسترقاق، وهي مفاهيم كانت سائدة زمن الدعوة الإسلامية وقبلها في المجتمعات القائمة في الجزيرة العربية. المشكلة أن المذاهب الإسلامية ما تزال تغض النظر عن هذه العادة، فلا تدعو إلى تحريم أو تجريم الإسترقاق، الذي ناضلت الشعوب والمجتمعات لإلغائه بوصفه انتهاكاً لحرية الإنسان وحقه في الوجود.
تشكل الحرية الدينية وحق الإنسان في اعتناق الدين الذي يشاء أو عدم الإعتناق أهم منجزات الحداثة، وقد توصلت إليها المجتمعات الحديثة بعد أن عانت من التعصب الديني والمذهبي والذي دفعت ثمنه حروباً أبادت مئات الآلاف من البشر. إنّ إصرار القرآن على اعتبار “أن الدين عند الله الإسلام” وأن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وأن من لا يعتنق الإسلام هو كافر... هذه المفاهيم وغيرها تشكل النقيض الحاد في وجه مفاهيم الحداثة التي باتت تقدس الحرية الدينية بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات حرية الفرد. يشير الكاتب في هذا المجال إلى “أن الإجماع الفقهي على تجريم الحرية الدينية، قد حول الإسلام من ديانة فطرية إلى ديانة جبرية وقهرية وتسلطية وإنتاج طوائف مغلقة.. وإذا كانت البوابة الرئيسية للحداثة هي انعتاق العقل ورفع الحجر عن وعي الإنسان بلا وصاية من أحد على أحد، فإن معضلة دول العالم الإسلامي أنها لا تعترف بحق الإنسان في التحول الديني”
في عالم عربي وإسلامي منفجر تنخرط طوائفه ومذاهبه في حروب عبثية، وفي زمن يشهد أبشع أنواع التوظيف للإسلام في الصراعات السياسية والمذهبية، يحتل كتاب سعيد ناشيد موقعه في قلب هذه المعمعة. إنه كتاب في صلب الإصلاح الديني الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم أكثر منه في أي زمن مضى