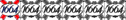ثمة ملاحظتان لا بد من إيرادهما في بداية حديثنا هذا, أولاهما أن ما نقصده بالوعي السياسي العربي هنا, هو الوعي الجمعي سواء على صعيد النخب الثقافية والحركات السياسية أم على صعيد الرأي الشعبي العام. ذلك لا ينفي استثناء وجود بعض الأفراد أو النويات التي أتيحت لها الدراسة والعيش في ديار الغرب أو تلك المجموعات التي عايشت داخل أوطانها عملية الصراع المجتمعي التحرري المستمرة بين إرادة التطور والحداثة من جهة, وبين قيود وأغلال التخلف والقدامة من جهة ثانية, والتي بقيت تأثيراتها بحكم ظروف موضوعية غلابة ,محدودة الفعل مجهضة النتائج .
أما الملاحظة الثانية فهي أننا بتسليط الضوء على هذه المسألة التأسيسية التي من المفترض أن تلعب دور البوصلة في المشروع النهضوي العربي المأمول لا نهدف البقاء أوالاستغراق في فضاء نظري بعيدا عن معطيات ومشاكل واقعنا المعاش وماتعانيه مجتمعاتنا العربية من عوامل وأعطاب الخلل والقصور والإعاقة في تطلعها إلى المستقبل الأفضل أسوة بشعوب العالم المتحضرة, كما لا يمكن إطلاقا أن نضع أنفسنا في موقع متميز في الادعاء بأهمية ما يتوفرلدينا أو لغيرنا من مستوى وعي سياسي, أو أننا بالتالي نمتلك المشروعية الفكرية والخلقية والوطنية لإصدار أحكام تقييمية في هذا المجال. إن ما نطمح إليه هنا هو أن نستجيب لنداءالواجب الذي يحتم علينا نحن النخب الفكرية والسياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وتباين مرجعياتها, أن نقوم بعملية مراجعة عميقة وشاملة لواقع الفكر السياسي العربي والعناصر المكونة له, أي أن نمارس عملية تقويم ونقد ذاتي للمتاع النظري وللبنية الاجتماعية اللذين مايزالان يتحكمان في بناء وعينا السياسي ونحن اليوم في القرن الواحد والعشرين . إنه تقويم ونقد الذات للذات ووعي أبعاد صراع المجتمع مع عوامل الإعاقة والانشداد للماضي وتصوير أن استعادته هو المستقبل المنشود, للخلاص من ذلك بالرؤية الصحيحة التي تعين الطرق الصائبة لمعالجة هذا الواقع وتوحيد المواقف والجهود المخلصة لتحقيق طموحات الشعوب العربية في تجاوز تخلفها والانتقال إلى حياة العصر.
لقد كان في مقدمة المعطيات التي كشفت عنها انتفاضات الربيع العربي التي شملت العديد من الأقطار العربية على امتداد السنوات الأربع الماضية نوعية بنية هذه المجتمعات ومدى قابليتها للانتقال إلى الحياة الديمقراطية في زمن محدد. كما كشفت في الوقت نفسه عن مدى أهلية الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لقيادة هذه العملية والنجاح في بلوغ غاياتها دون انتكاسات وصراعات داخلية تهدد مصائر تلك الأقطار. ولعل ما كان قد اشار إليه عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل فوكو من أن أنظمة الاستبداد إذا طال أمدها لعقود في البلاد التي تحكمها فإنها تهيئ المناخ الملائم لظهور معارضات على شاكلتها, معارضات تعمل على أساس ردود الفعل, لأنها تركز كل اهتماماتها على إنهاء الأنظمة القائمة والحلول محلها, دون امتلاك الوعي المطلوب ولا الرؤية الصائبة لبناء المستقبل الذي يجسد الأهداف التي قامت من أجلها تلك الانتفاضات. وأوضح مثال لصحة ما نقول مواقف المعارضات السورية خارج الوطن خلال السنوات الماضية وما اتسمت به ممارساتها وبرامجها من قصور وعجز وتشرذم والتي أدت في محصلتها إلى إطالة وتفاقم المأساة التي يعيشها وطنهم . ونحن هنا لا نتحدث عن تلك المجموعات والتشكيلات السياسية التي ارتهنت لارادة وأجندات القوى الإقليمية والدولية وباعت قرارها الوطني المستقل, وإنما نتحدث عن القوى الوطنية الديمقراطية الصادقة في دوافعها ومواقفها والقاصرة في ممارساتها العملية على أرض الواقع. نعم لقد ظل الوعي السياسي العربي في مساره العام حتى اليوم قاصرا عن امتلاك القيم العقلانية وعن استخدام المنهج النقدي العلمي في وعي وإدراك طبيعة الواقع القائم واستشراف آفاق المستقبل. ظل العقل السياسي العربي عقلا انفعاليا عاطفيا يتعامل مع الأحداث بردود الفعل لا يراكم عبر دروس الماضي في بنيته المعرفية وكانما يبدأ من جديد في مواجهة الأحداث والتطورات التي هي استمرار لما سبقها من وقائع مماثلة. وإلا كيف يمكن تفسير انجرار مجموعات عديدة من المعارضات السورية وتسابقهاعلى ركوب موجة التسليح والعسكرة, وكيف يمكن تبرير مواقف تلك الجماعات السياسية التي راحت تخطب ود االمجوعات المسلحة الارهابية والأصولية مثل داعش والقاعدة وتفرعاتهما, محاولة تبرير مواقفها بأن هدف الثورة السورية هو القضاء على النظام القائم وبعد ذلك يتدبر السوريون أمرههم في طبيعة الدولة التي تحكم وطنهم, هذا إذا بقي لديهم وطن موحد يرومون له غدا أفضل.
في شهر أيلول – سبتمرعام 1970 ذهبنا كوفد رسمي يمثل بلدنا سورية في جنازة القائد الفيتنامي هوشي منه, وصلنا هانوي متأخرين ثلاثة أيام عن موعد الجنازة حيث بقينا هذه الأيام الثلاثة في بنوم بنه عاصمة كمبوديا لعدم توفر رحلات جوية تنقلنا الى الفيتنام, كان هذا التأخير فرصة مناسبة لنا بعد أن غادرت كل الوفود تقريبا كي نطلب برنامجا لمقابلة المسؤولين الأساسيين في الحزب والدولة خلال إقامتنا هناك التي استمرت عشرة أيام. أوردت هذه الواقعة هنا لقناعتي بأن ما أرغب الاستشهاد به هنا له علاقة وثيقة بموضوع حديثنا, أثناء لقائنا المطول مع السيد لي دوان السكرتير العام للحزب الشيوعي الفيتنامي سألته على ضوء تجربتهم الثورية التي كانت تشكل في القرن الماضي مثالا ملهما لكل شعوب العالم الطامحة نحو الحرية والاستقلال,عن رأيه في حاضر ومستقبل مختلف فصائل حركة التحرر العربية وبخاصة مستقبل الثورة الفلسطينية. كانت إجابة الرجل وافية بحيث غطت مختلف التساؤلات التي تجول في خاطرنا ولكن ما يهمنا هنا أن أورد الخلاصة التي انتهى اليها بقوله: لقد علمنا التاريخ أن كل ثورة لا يمكن أن تنجح لمجرد كونها تتبنى قضية عادلة وتطرح اهدافا مشروعة, بل لا بد لها من صياغة استراتجية صحيحة تبنى على أساس وعي الواقع ورسم صورة المستقبل البديل الذي تسعى لتحقيقه, وهذا الوضع بدوره لا يكفي بل يتطلب البرامج العملية المرحلية التي تعين المهمات الانتقالية وأسلوب تحقيقها بحيث توفر الظروف المطلوبة لمواصلة الطريق نحو تحقيق المهمات والأهداف المستقبلية,
ولكن وبصدد موضوعنا هذا, هل يجوز أن نقصر استشهاداتنا على التجارب الثورية العالمية ونغفل ما لدينا في هذا الصدد من صفحات مضيئة في تراثنا النهضوي القريب, فهذا ما يؤكد عليه شيخ التنويرين العرب في مطالع القرن الماضي عبد الرحمن الكواكبي في باب :الاستبداد والتخلص منه في كتابه المعروف:طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد:
( يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما ذا يستبدل به الاستبداد. إن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل, كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئا إذا جهل الطريق الموصل اليها, والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقا, بل لا بد من تعيين المطلب والخطة تعيينا واضحا موافقا لرأي الكل أو لرأي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عددا أو قوة بأس وإلا فلا يتم الأمر. حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعا يكون الإقدام ناقصا نوعا. وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم فهؤلاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء, وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط, تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقا ).