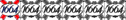ربيعة
" ثـــــــــــــــــــــــــائــــــــــر "
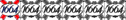

عدد الرسائل : 204
تاريخ التسجيل : 26/10/2010
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 2
 | |  خمس أطروحات في السياسة النبوية قراءة في كتاب د. عبد الإله بلقزيز الأخير: «تكوين المجال السياسي: النبوة والسياسة» خمس أطروحات في السياسة النبوية قراءة في كتاب د. عبد الإله بلقزيز الأخير: «تكوين المجال السياسي: النبوة والسياسة» | |
إن لمن أعقد القضايا قضايا
البدايات. بهذا قضى أهل المناهج في شتى المجالات: من الباحثين في "بدايات
الكون" إلى الناظرين في "بدايات الاجتماع البشري"، ومن المدققين في شأن
"بدايات الفن" إلى المحققين في أمر "بدايات الاجتماع السياسي" ... لا فرق
في هذا بين العلوم المدعاة "مادية" وتلك المسماة "إنسانية".
غير أن الأستاذ عبد الإله
بلقزيز ـ بوسمه باحثا في الفكر السياسي العربي، وبعد أن هو جرب النظر في
شأن الفكر السياسي العربي الحديث، ورام هذه المرة العودة إلى أصول هذا
الفكر مفتشا منقبا ـ ما خشي أن يطرق مسألة "البدايات" هذه ـ بدايات السياسة
عند العرب. وما تردد القلم ولا تمنع الورق. فكان أن طلع علينا بنتائج
أنظاره هذه التي أجالها في قديم الفكر السياسي العربي الإسلامي بكتاب جديد
اختار له من العناوين عنوان: "تكوين المجال السياسي الإسلامي: النبوة
والسياسة"1. وهو جزء من مشروع أوقف الباحث مستفتحه على النظر في شأن
السياسة في "الحقبة النبوية" ـ أو ما سماه "اللحظة النبوية التأسيسية" (ص.
203) ـ ووعدنا ـ في مستهل الكتاب ومختتمه ـ بأن يعطف عليه بضميمة أخرى تخص
الحقبة المتأخرة عن الحقبة النبوية ـ أو كما سماها في مقدمة الكتاب "الحقبة
ما بعد النبوية" (ص. 9)، وأطلق عليها في خاتمة الكتاب "حقبة الخلافة
الراشدة" (ص. 203). وبالعبارة الواحدة، من "سياسة النبي" إلى "سياسة
الصحابة": ذاك وعده قطعه المؤلف على نفسه (ص. 203)، وإنا له لمنتظرون.
وما كان هذا الكتاب بدعا من
كتب الأستاذ عبد الإله بلقزيز. لا ولا كان صاحبه على الموضوع دخيلا. وإنما
أنت واجد أنه في كل كتبه التي ألفها قارب هو الموضوع ودانى ـ إن من قريب أو
بعيد. هذا وإن هي اختلفت الحقب بين حديثها وقديمها ووسيطها.
بيد أن جديد هذا المؤلَّف ـ
بالنسبة والإضافة إلى مشروع صاحبه ـ أنه لأول مرة، ههنا، أفرد الباحث
للحقبة النبوية عملا مخصوصا. ولعل من بين أزيد من عشرين كتابا ألفها
الأستاذ عبد الإله بلقزيز، يبقى كتاب: "دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال
السياسي"2، من بين كتبه، الأقرب إلى ما رامه المؤلف في الكتاب الذي بين
أيدينا. ولا أدل على ذلك من أنه المؤلَّف، من بين مؤلفاته الكثيرة، الذي
يحيل إليه، داخل المتن، أكثر من سواه. وكأني بصاحبه قد أحس بأنه لئن كان
معنى أن يكون جذريا هو أن يأخذ الأمور من جذورها، وأنه لما اتفق أن جذور
السياسة عند العرب تعود إلى اللحظة النبوية التأسيسية، فقد عاد المؤلف إلى
هذه الحقبة يستطلع أمرها.
تأسيسا عليه، تحدد موضوع هذا
الكتاب الجديد، من البدء إلى الختم، بتناوله «[الشأن] السياسي في النبوة،
أو المشروع السياسي للنبي» (ص. 30)، أو قل: «التجربة المحمدية في تأسيس
دولة وإدارتها» (ص. 199). فكان هذا الكتاب بذلك: «قراءة في السيرة السياسية
المحمدية، أو في الوجه السياسي من المشروع النبوي» (ص. 202).
والحال أنه ما كان القصد من
هذا الكتاب قصدا سجاليا. فهو وإن عرض إلى أطروحات سائدة حول صلة الدين
بالسياسة في الإسلام، وانتقد بعضها، فإن ذلك كان بإلماعة وإيماضة، وما أوغل
هو أو تلبث. ذلك أن هذه الأطروحات ـ لا سيما منها الاستشراقية ـ إنما
شأنها، في نظر المؤلف، أن يوقَف عليها كتاب مخصوص وتُفرد بدراسة مستقلة (ص.
10 و14). ولنا أن نحمل كلامه عن المستشرقين، بالمجمل، على محمل العرفان.
فالمؤلف وإن هو ما قاسم المستشرقين كل رؤاهم، فإنه اعترف لهم، على الأقل،
بفضل على الفكر العربي المعاصر ليس له أن يجحد. إذ لئن هي كانت لبحوثهم من
مزية ـ ومزاياها لا ريب كثيرة، كما أن عيوبها لا تغضي منها ـ فهي استنهاض
همم الباحثين العرب إلى إعادة دراسة السيرة بأجد دراسة وأرصنها وأحكمها،
واستحثاثهم لهم على الأخذ بعُدة المناهج التاريخية والتأويلية الحديثة في
إعادة الدراسة تلك (ص. 10).
ولئن هو ثبت أنه ما كانت
البغية من الكتاب بغية سجال، فإنه ثبت أيضا أنه ما كانت النية منه نية
تفكيكية هدمية. إذ أقر الباحث أنه ما عاد ثمة إمكان لإعمال منهج "مسح
الطاولة" بالكلية، وذلك بأن يعمد إلى إبداء الريب وبث الحيرة في كل ما كتب
عن السيرة النبوية، أو يلجأ إلى تفكيك بعض "مواضع إجماع" كتاب السيرة
والمؤرخين حول أحداثها ومروياتها3. ذلك عمل شأنه أن يكون عدمي الهوى،
والعدمية ضيف غير محبوب عند باحثنا. إذ ثمة إقرار بالحاجة إلى ما في كتب
السيرة ـ على تفاوت مراتبها، وتفضيل بعضها على بعض (ابن هشام، الطبري، ابن
الأثير) ـ من «أخبار ومواد يستحيل كتابة تاريخ من دون البناء على معطياتها»
(ص. 31)، على شريطة حفظ يقظة العقل، وذلك بتحاشي «التعامل مع ما ينفر منه
العقل وما يعارض النص الديني من أخبار تبدو منحولة أو مدسوسة» (ص. 31)؛
وذلك من مثل أن نسقط بين خيارين كلاهما مرفوض: خيار المؤرخ الذي يكتب عن
الأسطورة، وخيار الأسطوري الذي يكتب عن التاريخ.
على أن القصد من الكتاب يبقى
بنائيا وتركيبيا. نعني أن صاحبه رام إعادة بناء الممارسة النبوية للسياسية
كما تحققت لا كما تخيلت، وبوفق صلتها بالدين لا بوفق خلطها به. فإن هو تبين
لنا ذلك الأمر، ألفينا أن الكتاب قام على أطاريح خمس نفصل فيها القول على
النحو التالي:
الأطروحة الأولى: في أن أول
دول العرب على الحقيقة دولة يثرب
ما كانت أمة العرب في
الاهتمام بالسياسة بدعا بين الأمم، وإنما شأنها كان كشأنها. وليس الشأن في
أن تكون السياسة موجودة عند العرب ـ فلا شأن هنا ـ إنما الشأن في كيفية
نشأتها عندهم: فمتى ما أمكن الحديث عن "السياسة" عند العرب؟
ليس يسمي الباحث صراعات
القبائل العربية، في الحقبة المسماة "جاهلية"، وتحالفاتها وتخالفاتها
"سياسة". فلا سياسة في القبيلة بالقبيلة ومع القبيلة. ولا سياسة ثمة لأن لا
دولة هناك: تلك معادلة تخترق الكتاب بأكمله اختراقا. فليست تكون سياسة ولا
دولة حيثما تكون القبيلة هي البنية الاجتماعية الأساسية التي تشكل ضربا من
"الأنا الجمعية" (ص.139). إنما تنشأ السياسة بنشأة الجماعة ويكون الاجتماع
سياسيا متى قامت جماعة مركزية. إذ علينا ألا ننسى أن العرب، في المعظم
منهم، «بدو لا عهد لهم بالدولة» (ص.192). وبالتالي:«لم تكن الدولة من
تقاليد المجتمع العربي الجزيري [نسبة إلى الجزيرة العربية] إلا في ما ندر
وفي حدود ضيقة لم تتجاوز نطاق مراكزه الحضرية في بعض الحجاز واليمن. وحين
يحدث أن يقوم فيها سلطان سياسي بالقوة، تنصاع إليه القبائل مكرهة دون أن
تعترف بشرعيته. وأكثر تلك الحالات لدى بدو الجزيرة العربية الذين لم يألفوا
الاستقرار: وهو قاعدة أية سلطة، فكانوا مصدرا دائما لم ينضب لكل تمرد»
(ص.189). وإذ يقر الباحث: أجل «قامت "دول" عربية عديدة في الحقبة
"الجاهلية"، وتحديدا في جنوب الجزيرة العربية (اليمن وحضرموت): ممالك معين
وسبأ وقتبان وحضرموت»، فإنه سرعان ما يعقب: «لكن نظيرا لها [للدولة] في
الحجاز لم يقم قبل "دولة المدينة"» (ص.137-138). وبالجملة، إن العرب «لم
يألفوا معنى الدولة أو الانقياد لسلطة مركزية في تاريخهم: في الحجاز أساسا
وفي الأعم الأغلب من الجزيرة العربية تاليا» (ص.139). ولهذه الحيثية، يكاد
الباحث ألا يطرح مسألة "إعادة كتابة" تاريخ الحقبة الموسومة بوسم "الحقبة
الجاهلية". وذاك تخم من تخوم البحث.
وتلقاء هذا، لا يتردد
الأستاذ عبد الإله بلقزيز في الإعلان عن أن أول "اجتماع سياسي" في تاريخ
العرب هو ذلك الذي أنشأه نبيهم (ص.88). إنما أول اجتمع سياسي تخلق من رحم
قبائل العرب هو ذاك الذي كان بيثرب (ص.93). أكثر من هذا، أول "دولة" أنشأها
العرب هي "الدولة المدينية" التي أقامها النبي محمد. فهي «أول "دولة" فعلية
نشأت في تاريخ الحجاز في حدود ما لدينا من مصادر» (ص.137). وبالفعل: «لقد
كانت "الدولة" التي أقامها النبي في المدينة، ومدت سلطانها إلى مجموع
الجزيرة العربية، أول "دولة مركزية" تعرفها القبائل العربية وتفرض عليها
أحكامها» (ص.192). وما عاشه العرب معها إن هو حقق أمره وجد أنه ما كان إلا:
«قيام أول مظهر من مظاهر الدولة التي ما عرفوا لها "نظيرا" إلا عند
الساسانيين والبيزنطيين» (ص.59).
لكن بأي معنى يمكن الحديث عن
"بداية السياسة" في الحقبة النبوية؟
ما كان الحديث عن "السياسة
في الحقبة النبوية" ليعني، بالأولى، الحديث عن "ميلاد فكر سياسي إسلامي".
فهذا ما نشأ إلا بعد مضي هذه الحقبة وبالذات أوان ظهور فرق الإسلام السياسي
الأولى ـ من شيعة ومحكمة وأموية ـ واستشكالها لمفهومي "الإمامة" و"الخلافة"
(ص.73). لا ولا كان هو الحديث، بالأحق، عن "الكلاميات السياسية"، كما كان
عليه الشأن لدى المرجئة والقدرية والمعتزلة (ص.74). ولا هو كان ليعني،
بالأحرى، الحديث عن "علم السياسة" العربي الذي هو، على التحقيق، ضرب من
"الفقه السياسي"ـ أو "فقه الدولة" ـ على نحو ما نجده في كتابات "السياسة
الشرعية" (الماوردي، أبو يعلى، الجويني)، حيث تم إخراج الكلام عن السياسة
من علم الكلام إلى مسائل "الخلافة" و"الإمامة" و"الشرعية" (ص.75). فهذه
كلها مباحث إن هو حقق أمرها وجد أنها لواحق وتوابع من شأنها أنها كانت
تفترض، برمتها، قيام ممارسة سياسية. هذا فضلا عن أن يكون الحديث عن
"السياسة في عهد النبوة"، بالتبع، حديثا عن مبحث "النظرية السياسية"
(ص.75)، أو "الآداب السلطانية" و"الفلسفة السياسية" ـ التي هي «مما لا يدخل
في موضوعنا هذا» (ص.76).
وهكذا، فإنه من حسنات بحث
الأستاذ بلقزيز التدقيق في مفاهيم دائرة كلها على "السياسة" ولكن ليس بنفس
المدار: "الفكر السياسي"، "الفقه السياسي"، "النظرية السياسية"، "علم
السياسة" ... إذ تعمد أغلب البحوث ـ التي مدارها على السياسة في الإسلام ـ
على النظر إلى هذه الأمور نظرة سديمية تخلط الشيء بالشيء، إلا أن إفادة
الباحث من تقسيمات العلوم السياسية الحديثة أكسبت عرضه وضوحا وجلاء وقدرة
على التمييز قد لا تضاهى.
فقد تحقق، على جهة السلب،
أنه ليست تعني "نشأة السياسة في العهد النبوي" نشأة الفكر السياسي أو الفقه
السياسي أو النظرية السياسية. فماذ تعني إذن على جهة الإيجاب هذه المرة؟
إنما هي تفيد نشأة "الاجتماع السياسي" الذي هو المقدمة الضرورية لكل فعل
سياسي، وبالتبع، لكل نظر. وما "الاجتماع السياسي" هذا سوى نشأة "الجماعة
السياسية" وميلاد "المجال السياسي"، وذلك بتحول "القبيلة" الجاهلية إلى
"جماعة إيمانية" أو "جماعة عقدية" إسلامية ـ مما لم تتحصل عنه السياسة بعد،
وهو ما حدث في حقبة الرسول المكية ـ فإلى "جماعة سياسية" ـ وهو ما تحقق في
الحقبة اليثربية حيث كان الوجه السياسي للدعوة المحمدية أجلى وأظهر وأوضح
... تلك الحقبة التي يخصها الباحث بعناية كبيرة، ويعتبرها الشاهدة على وجوه
بدو السياسة في عهد النبوة.
ولا يتوانى الأستاذ بلقزيز
عن حشد الدلائل على تبدي "وجوه السياسة في عهد النبوة": من أخذ النبي
بأساليب السياسة (المساومة، المفاوضة، المحاربة)، وكلها "أفعال سياسية" ما
بقيت هي معلقة بإطار القبيلة القديم، وإنما تجاوزته لتتم باسم "الجماعة
السياسة" حديثة النشأة.
الأطروحة الثانية:في أن
النبي أنشأ دولة
يحتاط الباحث عبد الإله
بلقزيز في تنزيل مفاهيم السياسة على الحقبة النبوية بأشد احتياط يكون
وأوجبه وأكبره. وهو يتجنب كل أشكال الإسقاط وتنزيل المفاهيم السياسية
الحديثة على الكيانات الجمعية القديمة. ومن فضائل بحثه كثرة لجوئه في
إعماله المفاهيم إلى التحوط والتحفظ والتحرس. فهو يعي بأتم وعي وأقومه
مخاطر "الإسقاط"، ولا يتقدم إلا متحفظا يقظا محتاطا وكأنه يخترق حقل ألغام.
ومن علائم التحري المنهجي الدقيق الذي يشكل خلفية هذا البحث النبيهة وضع
المفاهيم الإجرائية بين قوسين: "المؤسسة الحربية"، "الجماعة المواطنة"،
"الدستور"،"الطبقة السياسية"... واللائحة تكاد من فرط طولها ألا تنضبط
بضابط أو تنحصر بعدد. أكثر من هذا، لا يلجأ الباحث إلى إبداء تحفظه بتسييج
المفاهيم بالأقواس فحسب، وإنما هو يلجأ إلى العبارات الدالة على التيقظ من
مثل: «إن شئنا استعارة مفردات اليوم»، «إن جاز القول»، «بلغة اليوم» ...
ومع ذلك، فإن الباحث لا
يتردد في أن يسم "الكيان" الذي أنشأه النبي بميسم "الدولة". دولة يقف على
أهم تجلياتها وتبدياتها بالتوصيف والتحقيب (ص. 145-148). فليس من شأن
التحفظ على تسمية الكيان أن يعني نكرانه، لا ولا عدم مقارنته بما كان في
عصره. ولمن قد يتهمه بأنه "أسقط" مفردات "الدولة الحديثة" على "الكيان"
الذي أنشأه الرسول، يجيب الباحث بأن هذا "الكيان" وشى بظواهر «لا يمكن
تجاهل معناها السياسي أو دلالتها على قيام مجال سياسي في الإسلام المبكر»،
وأن هذا المجال لهو مجال الدولة عينها (ص. 143).
على أنه يبدي ملاحظتين بهذا
الصدد:
أولهما؛ أن ممعن النظر في
أمر هذه الدولة التي أنشأها رسول الإسلام في الحقبة اليثربية يقف بنظره على
أنها: «لم تأخذ شخصيتها الكاملة بسبب التباس الصلة بين الدعوة والدولة في
بواكير الإسلام» ؛ مما ترتبت عنه «صعوبة التمييز بين السياسي والديني في
شخصيته [=شخصية الرسول]» (ص. 137). هذا فضلا عن أن قصر مدة حكم الرسول زادت
مسألة تبين ملامح الدولة هذه تعقيدا.
ثانيهما؛ أن من المبالغة في
الكلام القول: إن دولة المدينة استكملت كل مستلزمات البناء القانوني
للدولة. ومن ثمة لزم تجنب تعسف إسقاط مثال الدولة الحديثة على دولة النبي.
وبالجملة، فلا النبي أنشأ دولة بمعناها المكتمل، لا ولا هو ما أنشأ دولة
بالمرة. إنما هو أنشأ دولة بمعنى "الدولة" كما تعوهدت في العصر الوسيط. ومن
ثمة، لا مساغ لمقاربتها بأدوات الفقه القانوني والدستوري الحديث (ص. 140).
نعم، كانت لهذه الدولة
مقومات. وهي في عداد الثلاثة: أرض، وأمة، ونظام. فأما الأرض، فقد شهدت
التحول من يثرب ـ نواة الدولة ـ إلى أرض عرب الحجاز جمعاء. وأما الأمة،
فبادية من خلال جهود النبي في الانتقال بالعرب من "أمة اعتقادية" إلى "أمة
سياسية". وأما النظام السياسي، فهو متجل من خلال ممارسة النبي لدور القيادة
السياسية والحربية: إصدار قرارات، تعيين ولاة وقضاة، توقيع معاهدات ... أي
من خلال وظائف أمنية وقانونية ومدنية وسياسية (ص. 143). وقد بسط الباحث
القول في هذه المقومات بسطا ضافيا.
الأطروحة الثالثة:في أن دولة
النبي ما كانت دولة نبوة
لا يكف الأستاذ عبد الإله
بلقزيز عن إبداء الإعجاب بالوجه الآخر لنبي الإسلام ـ الوجه السياسي هذه
المرة وليس الوجه الديني المعروف المعهود. فهو عنده نبي وقائد سياسي وعسكري
ورئيس دولة في الآن نفسه. وكم هو أطرى الباحث على "سياسة النبي" و"قيادة
النبي"، وكم هو وقف مادحا النبي القائد السيوس المهاب. فهو عنده رجل «ذو حس
سياسي عالي» (ص. 159). أكثر من هذا، هو «قائد عظيم» (ص. 33) و«رجل سياسة
كبير» (ص. 106). بل إن «محمد بن عبد الله كان رجلا سياسيا
ودبلوماسيا ـ بلغة اليوم ـ من طراز نادر» (ص. 111). بل إنه «في السياسة
أثبت النبي اقتدارا استراتيجيا وتكتيكيا (...)» (ص. 107)، وكان: «(...) رجل
دولة وصاحب شخصية سياسية ثاقبة، يتقن ممارسة السياسة بأبعادها المبدئية
والتكتيكية (...)» (ص. 128. هامش 26).
من هنا ضرورة التنبيه على
«البعد السياسي الحاد في المشروع النبوي» (ص. 123). وهو مشروع يقف عبد
الإله بلقزيز على تفانينه وتلاوينه بأدق وقوف وأكمله: لقد أتى النبي من
الأفعال السياسية الشيء الكثير. فاوض هو وساوم وقاتل وحالف وخالف ... هي ذي
الأفعال التي برزت فيها شخصية النبي كقائد ورجل دولة (ص. 116)، وذلك من حيث
أنه التجأ إلى أدوات السياسة المتاحة في عصره ـ المفاوضة والمساومة
والمحاربة ـ وذلك بغاية «إنشاء دولة أو كيان سياسي للجماعة الإسلامية
الوليدة» (ص. 116).
لكن، من أين استملى النبي
فضائله السياسية تلك؟
منذ البداية، يؤكد بلقزيز
على أن سياسة النبي ما كانت من الإلهام الإلهي في شيء. فلا سياسة لله بالله
مع الله. إنما السياسة للناس بالناس مع الناس. فهي شأن بشري صرف. لا سياسة
لله عند بلقزيز، وما كانت السياسة أمرا إلهيا، فضلا عن أن تكون أمرا من
الله (ص. 115). إنما هي أمر إنساني بحت.
فقد تحصل، أن مظان سياسة
النبي ما كانت لتوجد، بالأولى، في القرآن، وإنما في التجربة البشرية هي
كامنة ثاوية. فلا توجد سياسة النبي في القرآن بقدر ما توجد في السيرة. ولا
توجد في الحديث قدر ما توجد في الفعل النبوي. وما كل فعل نبوي بفعل سياسي.
إنما الفعل السياسي ما شهدت عليه مراسلات النبي ومواقعاتة ومخاطباته، وهو
كثير بديع.
منذ الوهلة الأولى، يلاحظ
الأستاذ عبد الإله بلقزيز «غياب تشريع قرآني للمسألة السياسية» (ص. 46و51)،
كما يسجل «الفراغ التشريعي القرآني [في مجال السياسة]» (ص. 51)، بل يذهب
إلى حد القول بفكرة: «امتناع النص القرآني عن التصريح بقواعد تشرع للاجتماع
السياسي» (ص. 63). مما استلزم عنه أن: «نصوص الإسلام لم تصنع دولة لأنها لم
تشرع لاجتماع سياسي إسلامي» (ص. 58). ولعل هذا هو ما يفسر أن "سؤال
السياسة" ظل في وعي المسلمين، بعد وفاة الرسول، "سؤالا إشكاليا" على
الدوام. وذلك لأنه، كما أسلفنا، فإن: «نصوصهم الدينية لم تسعفهم في العثور
على أجوبة قطعية عليه [=على سؤال السياسة الإشكالي]؛ الأمر الذي دفع بهم
إلى سلوك دروب متعرجة ـ لم تكن لتخلو من مجابهة مريرة ـ سعيا في تحصيل مثل
ذلك الجواب الذي سكت عنه النص» (ص. 45). وهي خلافات أنذرت ـ إذ أبرقت ـ
فأرعدت، وكان ما كان من أحداث شهد عليها السلف واكتوى بنارها الخلف.
والمتأتى عن هذا، أن الباحث
يرفض "لاهوت التاريخ" جملة وتفصيلا؛ أي أنه يرفض أن تكون السياسة مستملاة
من الكتاب المقدس. إنما السياسة شأن دنيوي، ما كانت السياسة شأنا دينونيا.
فلا توجد ثمة سياسة في النص وبالنص. وما كان اللاهوت السياسي من شأن
الإسلام، وذلك حتى وإن هو حاول بعضهم إعماله بوفق الشعار القديم «لا حكم
إلا لله»، وبوفق الشعار الحديث «الإسلام هو الحل» ـ ذاك شأن أولئك لا شأن
الإسلام، وإن الإسلام لمن دعاويهم اللاهوتية السياسية لبراء.
ومثلما هو رفض الباحث
اللاهوت السياسي، فكذلك هو رفض "لاهوت التاريخ"؛ إذ امتنع عن كل تفسير
"ميتا تاريخي" ـ أي غيبي ـ لوقائع التاريخ؛ عنينا ذاك التفسير الذي دأبه
وديدنه أن يجعل من "الغيب" فاعلا في التاريخ، بل موجها، بل محركا (أنظر
مثلا ص. 101. هامش 11).
لكن بقدر ما لاحظ الباحث هذا
الغياب والفراغ أضاف: «لكنه غياب لم يمنع ـ على عظمته ـ من تغطية فراغه
النصي في إطار التجربة» (ص. 46)، مسجلا سعي المسلمين إلى: «البحث عما يملأ
هذا الفراغ (...) في التجربة النبوية وما أعقبها من خلافة الراشدين» (ص.
51)، وملاحظا أن: «المسلمين صنعوا تلك الدولة [الغائبة تشريعاتها في النص
القرآني] بما اجتهدوا في البحث فيه عن حلول وقواعد ومبادئ وما أتوه من
إجراءات في باب إقامة دولة وسلطان و ـ الأهم من ذلك ـ على مقتضى مصالحهم
كجماعة يصنع الإسلام لحمتها وتحتاج إلى تمتين تلك اللحمة بالسياسة» (ص.
58). وحين استعرض هو مظاهر دولة الرسول السياسية لاحظ أن أغلب هذه المظاهر:
«لم يؤخذ به على مقتضى نص قرآني، وإنما بتقدير من النبي واجتهاد» (ص. 137)،
تاركا بذلك للمستنتج أن يستنتج أن دولة النبي ما كانت دولة نبوة، إنما
الدولة المدينية كانت أشبه ما تكون بالدولة المدنية.
ويعترف عبد الإله بلقزيز، في
غير ما مرة، بصعوبة التمييز بين الشأنين الديني [الدعوة] والسياسي [الدولة]
في الحقبة النبوية (أنظر مثلا ص. 115 وفي ما سواها كثير). مما لزمت عنه
«التباسات لا حصر لها في وعي المسلمين» (ص. 59). وتأسيسا عليه، يقر بأن
«النبوة لم تنفصل عن السياسة في التجربة المحمدية، بل استوعبتها» (ص. 101)،
وأنه حدث بينهما "تلازم" شديد (ص. 59). ويحاول هو البحث في مسوغات هذا
"التلازم" الذي حدث في تاريخ الإسلام. ومنها أن: «ميلاد [الشأن] السياسي
إنما جرى في حاضنة دينية هي الإسلام» (ص. 200). ومنها أن: «أية جماعة
سياسية لا تقبل الوجود والقيام دون ذلك النظام [=نظام القيم المشترك الذي
يعد الدين أهم أسسه] الذي يلحمها ويصنع لها الشخصية والماهية. وبعبارة
أخرى، ليس في وسع الجماعة السياسية أن تقوم وتتماسك على مبدأ اجتماعي مشترك
إلا متى كانت جماعة اعتقادية؛ أي أن اجتماعها السياسي ممتنع دون اجتماعها
الديني» (ص. 151). بيد أن هذا لم يمنع الباحث من القول بإمكان الفصل ـ فصلا
منهجيا هذه المرة ـ بين الأمر الديني والشأن السياسي، ومن القول باستقلال
الثاني عن الأول باستقلال نسبي هو ـ عمليا ـ "تضافر" (ص. 43) وهو ـ منهجيا
ـ "تفارق" (ص. 200).
وبعد، فإن عقد النبي
التحالفات وإبرامه العقود مع غير المسلمين وإقامته نظام المدينة على مقتضى
الأمة لا الملة: تلك بعض من علائم كثيرة على الوجه السياسي المستقل الذي لا
يقبل أن يستتبع إلى الدين استتباعا كاملا (ص. 201). ولعل هذا الاستقلال
النسبي هو ما نجد له الشاهد في الحقبة اللاحقة لعهد النبوة التي أنبأت عن
«الانفصال المتزايد رتقا [لعله سبق قلم، ولعل مقصود الباحث هنا: فتقا] بين
الديني والزمني في تجربة السلطة منذ الخلافة إلى الملك: قياما واستواء
وامتدادا» (ص. 62. هامش 5). وذلك بحيث كانت "خلافة النبي"، بعد وفاته،
"خلافة سياسية" وما كانت هي "خلافة دينية" (ص. 62)، وشكل الصحابة بذلك نواة
"طبقة سياسية" (ص. 143-145) و"أول نخبة سياسية في الإسلام" (ص. 144)، وما
كانوا هم "طبقة فقهاء".
والمتأمل في حيثيات هذا
الموقف يجد أن الباحث يرد، ههنا، على موقفين اثنين:
أولهما؛ موقف علي عبد الرازق
الذي مفاده أن النبي ما أسس للسياسة قط، وأن الإسلام من السياسة براء. وهو
الموقف الذي نسج على منواله دعاة العلمانية في العالم العربي.
وثانيهما؛ موقف شيخ الإخوان
المسلمين حسن البنا الذي دمج بين الدين والسياسة في أمزوجة واحدة، بحيث جعل
هو من الإسلام دينا ودولة، بل دينا يملك دولة ودولة تملك دينا.
ومهما تصرفت الأحوال، فإن
مؤدى الموقفين هو: إما جعل السياسة في التجربة النبوية مستنكرة [علي عبد
الرازق وأتباعه]، أو بالضد من ذلك جعلها مستتبعة بوسمها «من أملاك الدين لا
تقوم إلا به، ولا تقاد إلا بتعاليمه» (ص.199) [حسن البنا وأنصاره]. كلاهما
ينتهي، من حيث لا يدري، إلى الموقف نفسه: إضاعة استقلال السياسة، إما بجعل
التجربة النبوية تجربة بلا سياسة، أو باستتباع السياسة للدين استتباعا.
والحال أنه منذ أن استحدث مرشد جماعة الإخوان المسلمين العبارة: «الإسلام
دين ودولة» صار يصعب التفريق بين الإسلام والسياسة. ولقد زاد الأمر حدة حين
تم التعبير عن هذه الفكرة بالشعار: «الإسلام مصحف وسيف». مما تولدت عنه
التباسات كثيرة: الإسلام قرآن وسلطان، دعوة ودولة، ديانة وسياسة ... بحيث
هو أضحى الدمج بين الشأنين القاعدة والتمانع الاستثناء (ص.60).
وإذ يعرض عبد الإله بلقزيز
لهذا الإشكال، المرار العديدة داخل الكتاب، فإنه يلخص موقفه منه في الفكرة
الجدلية التالية: «نعم، وقع تلازم بين الديني والسياسي في التجربة النبوية
خلافا لما ذهب إليه عبد الرازق، ولكن ليس بالمعنى الذي فهمه حسن البنا
ودافع عنه. لم تكن السياسة منفصلة عن الدين في المشروع النبوي، لكنها ـ في
الوقت نفسه ـ لم تكن محكومة به أو مجرد فرع من فروعه»(ص.200). ذاك هو قوله
الفصل.
فقد تحقق، أنه بالرغم من
التلازم بين النظامين، فإنه لا بد من حفظ المسافة بينهما. وفيما يتعلق
بالسياسة على وجه الخصوص، فإنه لا مناص من التأكيد على أن: «مجال السياسة
في الإسلام نشأ بعيدا عن أية قداسة دينية مفترضة، من نوع تلك التي يراد
إلباسها به اليوم، لأنه بني على اجتهاد؛ وما بني على اجتهاد لا يمكن
مناقشته إلا باجتهاد» (ص.58). وعلى الجملة، ليس الشأن في سياسة النبي أنها
كانت سياسة نبوية، إنما الشأن في سياسة النبي أنها كانت شأنا عن الأمر
النبوي بمعزل ومنأى ومبعد؛ أي أنها كانت شأنا دنيويا، وما كانت هي بالشأن
الدينوني.
وبعد وقبل، قامت سياسة
المسلمين الأولى على مبدأ "المصلحة" وبوفق منطق السياسة، وما قامت هي على
مبدأ "الواجب" وبوفق منطق الديانة، كما نهضت هي على مقتضى الجماعة السياسية
وما نهضت على مقتضى الجماعة الإيمانية (ص.182).
الأطروحة الرابعة: في النظر
في أمر سياسة النبي عن الخير والشر بمعزل
لئن هو حق أن النبي زاول
السياسة، فإنه يحق أيضا أنه زاولها بأدواتها المخصوصة، وما زاولها هو بوحي
ولا بإلهام ولا بنبوة. مفاوض هو النبي كان في كل الأحوال: في حال المرقى
(القوة)، وفي حال المهوى (الضعف)، وفي حال المسوى (تكافؤ القوى). ما جنح هو
للحرب وحدها وإنما جنح إلى الأخذ بأسباب السياسة وأدواتها متى كانت هي تفي
بما تعود به الحرب عليه من غير ما أن يعمد إلى خوضها (ص.106). فما مارس هو
الحرب للحرب وإنما مارسها للسياسة وبالسياسة. وما لجأ إلى المحاربة إلا متى
فشلت المسايسة، بل ما كانت المحاربة عنده إلا إكمالا للسياسة على وجه آخر.
وبالجملة، جرب النبي كل أساليب المسايسة: المحاربة والمفاوضة والمساومة.
وما سلك النبي في السياسة
ضديدها وسالبها: المواقف الحدية. إنما النبي بالضد مارس السياسة ضد المواقف
الحدية التي كان يدعو إليها بعض الصحابة. كلا، ما سلك هو مسلك "الإطلاقية"
ولا نحا هو منحى "الحسمية"، وإنما "الواقعية" هو اتبع و"النزعة المرحلية"
هو اعتمد (ص.107): الاستقواء والاستليان، الحلف والنقض، المعاهدة والنكث
... (ص.107)، لا صلح دائم في السياسة ولا صداقة مستديمة. إنما الموجه
الأساسي لسياسة النبي ـ شأنها في ذلك شأن أي سياسة دنيوية ـ هو مبدأ
"المصلحة": مصلحة الدعوة والجماعة الإسلامية (ص.107). فما كانت دولة النبي
بدعا من الدول، وما كانت سياسة النبي بدعا من السياسات. ما كان يديرها
ملائكة وإنما بشر. كانت تحكمها مصالح ومنافع. وذلك بحكم أن «منطق الدولة
والسياسة غير منطق الدعوة» (ص.132).
وإن سياسة هذا شأنها لا يمكن
تقويمها بمنطق الخلق الضيق. فهي تتجاوز مبدأي "الخير" و"الشر":
هذه "الجزية" نظام لم يعد
العصر الحاضر يستسيغه، فضلا عن أن يعمل به. لكن، حسب الباحث، فإن منطق ذاك
العصر كان يسوغه: إما بوصفه محض "عقد استئمان" لا شبهة فيه، أو "ضريبة
عادية" (ص.156-157). أكثر من هذا، هي ضريبة عن القيم بمعزل، بل عن الصبغة
الدينية بمنأى. إن هي إلا «ضريبة اقتصادية ـ سياسية وليست دينية»
(ص.182)4!!!
وهذه غزوات النبي ـ لا سيما
منها غزواته ضد يهود يثرب ـ ينأى الباحث بنفسه عن الحكم الأخلاقي عليها،
متبنيا في ذلك مبدأ "الحياد القيمي". فهو ما يفتأ يشير إلى ما يسميه
"تصفية" يهود يثرب و"تنقية" الاجتماع الإسلامي منهم و"تشذيبه". وحين يعرض
له أن يجد نفسه أمام ما يشبه الحكم الأخلاقي على هذه "التصفية" يكتب ـ لا
في المتن ولكن في الهامش ـ قائلا: «لا شأن لنا بأن نبررها [=التصفية]
سياسيا أو لا نبررها سياسيا وأخلاقيا. همنا الأساس أن نفهم لماذا حصلت؟ ما
الحامل عليها ولأية غاية حصلت، وما النتائج التي ترتبت عليها في التاريخ
السياسي الإسلامي على ذلك العهد» (ص. 133. الهامش 41). وبعد هذا وذاك، أَوَ
ليست «تنتمي تلك التصفية إلى حاجة حيوية لدى الجماعة الإسلامية إلى التميز
والتمايز الديني بوصفهما شكلا من إعادة بناء المجال الديني السياسي المديني
(...)» (ص. 133)!؟
كلا، ما كان نبي الإسلام
بمثل ذاك النبي الذي لامه مكيافلي ـ القس الراهب سافونارول ـ "نبيا أعزلا"،
وإنما هو كان "نبيا مسلحا". ولهذا كان من المبرر ـ سياسيا ـ أن يحمل السلاح
ويعمله، أما ـ أخلاقيا ـ فإن الباحث يترك هذا الأمر لمن لا يكتفي بتحليل
آليات السياسة وتسويغها.
غير أن النظر إلى سياسة
النبي بوفق أحكام عصرها لا بوفق أحكام عصرنا وبحسب منطق السياسية لا بحسب
منطق الأخلاق وعن قيمتي الخير والشر بمعزل، ما كان ليمنع الباحث ـ كائنا من
كان ـ بأن يكون قد كتب ما كتب ـ وإن هو تحاشى في أغلب ما كتب، جليله
ودقيقه، اللجوء إلى الإسقاطات ـ أن تجول بذهنه إشكالات الزمن الحاضر
يسترجعها عن غير وعي. فلا يمكن أن ننكر أن شبح الحاضر يخيم على ما نكتبه عن
الماضي، مضى هو ما مضى واحتطنا نحن ما احتطنا.
ولعل من بين هذه الإشكاليات
المسترجعة خفية إشكالية الأقليات العرقية والدينية في العالم العربي. إذ
بقدر ما حاول الباحث "تسويغ" موقف النبي من يهود يثرب، فإنه وجد في موقف
النبي من النصارى ـ وهو الموقف الذي كان أكثر انفتاحا وتسامحا ـ رغبة منه
في بناء «دولة متعددة الملل»! (ص. 179) لا شك أنها تشي بشيء مما يرام ويؤمل
في الحاضر.
من الأمة الاعتقادية الخالصة
[حقبة مكة] إلى الأمة الإسلامية اليهودية [حقبة المدينة المتقدمة] فإلى
"الانقلاب" على اليهود وطلب "النقاء" [حقبة المدينة المتأخرة]، فإحياء
مفهوم الأمة المديني المستوعب للنصارى: تلك تحولات سياسة النبي في أهم
لحظاتها. وهي تحولات وشت بأن: «المصلحة كانت مبدأ مؤسسا لعلاقة المسلمين
بغير المسلمين»، وأن «النبي أقام دولة مدنية ـ لا دولة دينية ـ لا يستند
تشريعها الاقتصادي والسياسي إلى المفاصلة الدينية وإنما إلى المشترك
الاجتماعي السياسي» (ص. 183).
الأطروحة الخامسة: في أن
سلطة النبي السياسية كانت سلطة كاريزمائية
لا يرد ذكر اسم المنظر
السياسي والاجتماعي الألماني ماكس فيبر في كتاب بلقزيز، ومع ذلك يظل ظله
حاضرا في مناسبتين اثنتين على الأقل: أولهما؛ أثناء تحديد الباحث معايير
الحكم على "الكيان" الذي أنشأه النبي بوسمه "دولة"، وذلك من خلال لجوئه إلى
المعيار الفيبري الشهير: التخطيط العقلاني لإدارة شؤون الدولة ميسما (ص.
149). وثانيهما؛ توصيف الباحث لطبيعة سلطة النبي السياسية. فههنا أيضا
يستلهم ضمنا نظرية السلط عند ماكس فيبر، وذلك ليرى أن السلطة النبوية كانت
من ذاك الصنف الذي يدعوه ماكس فيبر صنفا "كاريزمائيا".
وجديد الأستاذ عبد الإله
بلقزيز هنا أنه لا يقرن الكاريزما بالنبوة ـ كما دأبت على ذلك الكتابات
العربية في هذا المجال ـ وإنما هو يربطها بالفضيلة السياسية التي كان يتمتع
بها النبي: «هنا كانت السياسة حاملة الكاريزما وأداة تأسيسها وإعادة
إنتاجها لأنها، ببساطة، هي مجال الكاريزما» (ص. 197). ودليله على ما ذهب
إليه أن النبي لما كان هو نبيا أعزلا ـ إبان العهد المكي ـ ما استجاب
لدعوته النبوية إلا بضع عشرات، فلما كان أن انتقل إلى المدينة و"تسلح" و"تسيس"
ما أسلمت قريش وحدها ولا الحجاز بل سائر عرب الجزيرة. إذ ما كانت الكاريزما
من شأن نبي أعزل، إنما الكاريزما تعلقت بنبي مسلح.
معنى هذا، أنه ما كانت سياسة
النبي لتعود إلى الوهب (الوحي) وإنما نتيجة الكسب (المزايا السياسية
الشخصية) هي كانت. إذ كانت للنبي: «سجايا وسمات قيادية ومعنوية (= بشرية) ـ
لم تجتمع لغيره ممن عاصره أو أتوا بعده ـ رفعت مقامه في عيون قومه وبني
ملته إلى حدود أسطورية» (ص. 185)، فصارت هي «مثالا للقوة والهيبة» تستدعي
«الامتثال والإقتداء» (ص. 192).
فقد تحصل، أن المقصود
بالكاريزما ههنا: «تلك الهيبة المطلقة والتبجيل الذي يقابلها ويرتفع إلى
مرتبة التقديس»، أو قل: إنما الكاريزما «سلطة رمزية غير عادية ترتفع
بصاحبها عن مستوى البشر العاديين» (ص. 197). تلك هي طبيعة السلطة السياسية
التي كانت لنبي الإسلام.
وفي الختم، لعل السؤال الذي
يغيب ـ عن قصد ـ في كتاب الأستاذ عبد الإله بلقزيز ـ والذي يشكل، بالضد من
ذلك، "سؤال الأسئلة" في أدبيات الحركات الإسلامية اليوم ـ هو: كيف لنا بأن
نطبق السياسة النبوية اليوم؟ أو بالأحرى: أنى لنا بأن نعيد تطبيقها في
زماننا هذا؟ والسبب في هذا التغييب المقصود سبب مبدئي من شقين: أولهما؛ أن
الأستاذ الباحث يعلم أن ما "العودة" بمثل "البدأة" ريمت ما ريمت هي، لا ولا
يمكنها أن تكون كما كانت وبما كانت، وذلك لأن ثمة شيء جوهري حدث بين البدأة
والعودة اسمه: التاريخ. وثانيهما؛ أن الباحث يعلم أن ما من سياسة إلا ومن
شأنها أن تتعلق بعهدها بأشد تعلق يكون. ولما هي كانت كذلك، كان من شأنها أن
"تموت" بتبدل عصرها، وذلك لأنها سياسة أناس لأناس كلهم محكومون ـ مثلهم في
ذلك مثل أزمانهم ـ بالموت.
الهوامش:
1- الدكتور عبد الإله
بلقزيز: تكوين المجال السياسي العربي: النبوة والسياسة. مركز دراسات
الوحدة العربية. الطبعة الأولى. بيروت. 2005. نلمع ههنا إلى أننا سنحيل
إلى هذا الكتاب داخل المتن بالتنصيص على رقم الصفحة.
2- الدكتور عبد الإله
بلقزيز: الإسلام والسياسة: دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال
السياسي. المركز الثقافي العربي. بيروت ـ الدار البيضاء. 2001.
3- يقول المؤلف: «(...)
لم نكد نعتمد إلا المادة التاريخية التي كانت محط إجماع لدى كتاب
السيرة والمؤرخين، على علمنا بما يمكن أن يكون عليه ذلك الإجماع نفسه
من وهن إن كان إجماعا على نحل ووضع أو على مادة مظنونة» (ص. 31).
[التشديد من عندنا].
4- لا يتردد المؤلف في
كتابة ما يلي: «الجزية ـ كما الخراج ـ بمنظور تاريخي مقارن، وبمنظور
معياري، أفضل حالا من تصفية الجماعات غير المسلمة التي فرضت عليها هذه
الضرائب: حفظت لها بقاءها وكثيرا من حقوقها داخل جماعة أخرى مختلفة في
الدين، ووفرت لها الحماية منها، ورفعت عنها سيف الإكراه الديني. وهذا ـ
في كل حال ـ ما لم يلقه المسلمون في الأندلس مثلا بعد سقوط حكمهم
وسيطرة الكاثوليكية الإيبيرية عليها: لقد جرى محوهم بالعنف المسلح، ولم
يبق منهم سوى من تنصر وتكثلك مضطرا، ومحنة المورسكيين ماثلة للتمثيل
على ذلك» (ص.175. هامش 45). ولا يستنكف عن أن يضيف في مكان آخر: «ربما
كانت الضرائب على غير المسلمين (الخراج، الجزية) مرهقة وثقيلة، لكنها
لم تكن تمييزية وشاذة في أي حال (...) كانت هذه الضرائب رديفا لتلك
التي يدفعها المسلمون من ضرائب دينية وسياسية مثل الزكاة والعشور أو
الصدقات (...)» (ص. 175) | |
|