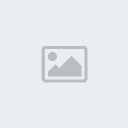 لوسيان جرفانيون مؤرخ وفيلسوف، من كبار المفكّرين الفرنسيين اليوم. كان تلميذا لـفلاديمير جانكيليفتش وأستاذا لميشال أونفري. متخصّص في الفلسفة اليونانية والرومانية وعلى الخصوص فكر القديس أوغسطين. من مؤلفاته الغزيرة : الشرّ والوجود (1955)، ما الشخصية الإنسانية؟ (1961)،
لوسيان جرفانيون مؤرخ وفيلسوف، من كبار المفكّرين الفرنسيين اليوم. كان تلميذا لـفلاديمير جانكيليفتش وأستاذا لميشال أونفري. متخصّص في الفلسفة اليونانية والرومانية وعلى الخصوص فكر القديس أوغسطين. من مؤلفاته الغزيرة : الشرّ والوجود (1955)، ما الشخصية الإنسانية؟ (1961)،
العيش والتفلسف تحت حكم القياصرة (1980)، تاريخ روما القديم (1987)،
القيصر الربّاني، دراسة حول السلطة زمن روما الإمبراطورية(1991)، القديس أوغسطين والحكمة(2006)، إغواء المسيحية (2009) .. وافته المنية ليلة 19الـ من سبتمبر الماضي وهو في التسعين من
عمره وظلّ محتفظا بحيوية فائقة حتى النهاية إذ أصدر مؤخرا كتابا تحت عنوان
مثير "عن الحبّ، الموت، الله وغير ذلك من التفاهات". وهو عبارة عن حوار
شيّق تناول فيه حياته ومسيرته الفكرية بشكل خفيف وعميق في آن. شائع ذلك الرأي الذي يقابل بين الأسطورة والعقل كما يقابل بين الخطأ
والصواب. ومن شدّة تكرار هذا الفصل أصبح يغري بالتصديق. يقول هُكسلي في
كتابه "أحسن العوالم" : "سيشكّل حقيقة كلّ أمر تكرّر 62400 مرّة". وإذا ما
دققنا النظر يمكن أن نجد أنّ الأمر تعبير عن وجهة نظر حول العالم. يقول
سارتر: "الإنسان، هو ذلك الكائن الذي إن ظهر وُجد العالم". وأكاد أضيف:
والآلهة أيضا.
كانت الآلهة حاضرة في أوّل النصوص التي عرفها التاريخ، هوميروس، هزيود،
التوراة..الخ. وكذلك نجدها في مصر وروما حيث نتعرّف عليها منقوشة أو
مرسومة. وهو حضور يشهد أنّ البشر في العصور السحيقة قد أدركوا أنّهم مجرّد
عابرين في هذا العالم. ابتداء من ذاك الذي تنبّه للأمر: "الإنسان، ذلك
الحيوان المفكّر، الذي يعرف أنه سيموت حتما"، كما يقول جون روستان. قطعوا
مع الحاضر الدائم الذي كان يعيش فيه أسلافهم البدائيون والذين لم يكونوا
يتساءلون أكثر من الديناصور المتوسّط العاشب الذي سبقهم، أو البقرة التي
تشاهد مرور القطار السريع في أيامنا هذه. ونتيجة لذلك يعرف الإنسان العارف
أو الهومو سابيان أكثر وأقلّ ممّا ينبغي. ومن هنا تلك الأسئلة وذلك القلق:
من أين يكون قد جاء هذا العالم وما يجري فيه؟ إلى أين نحن سائرون؟ من الذي
يقرّر تعاقب الليل والنهار والصحو وسقوط المطر، الحياة والموت وربّما بعد
الموت؟ ألا ينبغي أن يكون لكلّ ذلك معنى؟ لن يعثر من جديد "آدم الكهوف" على
حدّ تعبير تيلارد دو شاردان، على طمأنينة حديقته الحيوانية الضائعة أبدا؟
ومن حسن حظه، لم يشعر الإنسان أنه وحيد على وجه الأرض إذ حيثما عاش
ومنذ طفولته، كان يعرف الألف طريقة وطريقة التي اعتمدتها الآلهة في صنع كل
شيء. وانطلاقا من لاشيء أحيانا. وكان يعرف كيف كانت تمرّ كلّ صباحات
العالم، فالآلهة كانت تقوم بكلّ شيء، كان لها من أجل ذلك كلّ الوقت : كانت
خالدة لا تموت. والغريب أنها كانت تشبه الفانين، وتعيش فضلا عن ما فوق
طبيعتها، نفس المغامرات. وكانت تلك الآلهة قاسية غير متساهلة وكان من
الأحسن عدم معاداتها. وإن لم يكن العيش أحسن فعلى الأقلّ كان العالم
متناسقا وما بقي من قلق سرعان ما كان يضمحلّ أمام بعض رجاء. ومع امتداد
مفهومي العلّة والمعلول إلى العالم، من المفارقات أنّ الأسطورة هي التي
منحت الإنسان العارف أولى أشكال العقلانية.
أشياء واحدة ونظرة أخرى ولكن ما هو نوع ذلك الإيمان الذي كان يوضع حينذاك في تلك الرسوم
السماوية المتحركة والجهنمية؟ لا يمكن أن نجيب على ذلك بشكل دقيق إلا إذا
أخذنا بعين الاعتبار التغيّرات التي حدثت أثناء القرن السابع قبل عصرنا، أو
على الأقل الاعتماد على العصور اليونانية-الرومانية القديمة في طريقة
النظر إلى العالم. وفعليا كان التفكير يدور حول "طبيعة الأشياء" وليس حول
عللها الأولى المبهمة.
إنّ ملاحظة النجوم والتأمّل في الأشكال المرسومة على الرمل كما كان
يفعل أرخميدس، والنظر إلى الظل المحمول للأهرامات مثل طاليس، وربط الأعداد
بالأشكال مثل فيثاغورس، يجعل الإنسان يرى العالم بشكل مخالف تماما.
وبالتالي ولد علم الفيزياء والهومو سابيان. ولكن هذه المرة بشكل جدّيّ
ونهائيّ. وكانت هدية حقيقية من الآلهة أن يكتشف الإنسان أنه لم يكن في حاجة
إلى العودة إليها ليقف على كل ما وضعته في متناول البشر: الهواء، الأرض،
الماء، النار…أما الآلهة ذاتها فقد بات ينظر إليها على أنها أقل فظاظة. وقد
أصاب كسينوفان حينما قال : "إنّ الأثيوبيين يرون الآلهة سوداء وبأنف أفطس،
أمّا التراقيون* فيرونها ذات عيون خضراء مائلة إلى الزرقة، وبشعر ملتوِ
متوهّج". وراح الفيلسوف كسينوفان يتأمّل : لو كان للثيران أو للخيول أو
للسباع أربابٌ، لكنّا عرفنا جيّدا على أيّ شكل تكون. واختصارا فإنه لم يكن
ينفي أن تكون ألوهية ما مصدرا للعالم إذ "لم تكشف الآلهة للبشر عن كل شيء
منذ البداية، ولكن بالبحث ومع مرور الوقت اكتشفوا الأفضل"حسب رأيه. وهكذا
أدّى علم الفيزياء إلى ظهور الفلسفة.
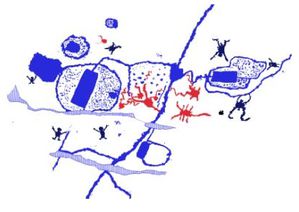 تعايش سلمي
تعايش سلمي تتعاقب نظرات الإنسان للعالم عبر الأزمان بينما تظل الأساطير حاضرة. وقد
تعايش الطبيعي وما فوق-الطبيعي، الأسطوري والعقلاني قرونا طويلة بطريقة
سلمية، ينير أحدهما الآخر. كان ينظر إلى طريقتي البحث عن الحقيقة على أنهما
متوافقتان ولم يكن يخطر على بال أحد البحث عن تناقض بين قواعد الهندسة
وحكايات الميثولوجيا. كان ينبغي وجود علم الرياضيات لتشييد المعابد
والصلوات لتدشينها. وهكذا عاش الناس مدة طويلة وفقا للبعدين،
الأسطوري-الديني والفلسفي معا. ولم يكن بعدٌ من البعدين يزعم أو ينوي إقصاء
الآخر، وذلك بصرف النظر عن ميل كلّ شخص إلى تفضيل هذا البعد أو ذاك. ويمكن
إبداء ثلاث ملاحظات في هذا الشأن :
- لم تكن فكرة الله تحظى في مرحلة تعدّد الآلهة بنفس قيمة التعالي التي عرفتها في الديانات التوحيدية.
- عدم فرض أيّ تنظيم دوغمائي على المؤمنين : كان كلّ شيء مرتكزا على
تقاليد الأسلاف التي تُحترم، وفي غالب الأحيان دون أن تُفهم، وكان المؤمنون
يأخذون ويتركون منها ما شاؤوا.
- لم تكن الأساطير تُفهم بالمعنى الحرفيّ، بل كان معناها
الرمزي يُفكُّ اعتمادا على الطريقة المجازية التي ابتكرها تياجان دو
ريهجيوم في القرن الخامس قبل الميلاد. واستعملها فيلون الأسكندري في الوسط
اليهودي، وكليمون الأسكندري وأوريجان وأمبرواز في الوسط المسيحي.
وفي المحصلة، كان يمكن لـلناس أن يؤمنوا بتعقّل. يميّز فارون (عاش بين
القرنين الثاني والأول قبل الميلاد) في ثلاثيته الثيولوجية الشهيرة بين
ثلاثة مستويات يقابل كلّ منها رغبة من نوع خاص : ثيولوجيا أسطورية للشعراء،
الثيولوجيا المدنية التي تبجّل الإلهة الرسمية في الوقت المرغوب من السنة،
وأخيرا ثيولوجيا الفلاسفة التي تبحث في طبيعة الآلهة. ظواهرية هي قبل
الأوان. وقد استمرت هذه الحال إلى أن هيمنت الديانات التوحيدية التي تعتبر
أن عقيدتها هي وحدها الصحيحة.
زمن الهيمنة وبدأت إذن تستحوذ على السلطات الدينية رغبة إخضاع العقلاني لصالح
الأسطوري، بل وإقصائه تماما. ومن هنا جاء تعسّف محاكم التفتيش، وقضية
غاليليو، ومذهب الخلق المعادي لــ "لامارك" وداروين الخ. وضدّ ديكتاتورية
الإيمان تلك، تحرّكت مقاومة وإن لم تكن علنية تماما فقد كانت كلها تصميما
وعزما. بدأت إبان النهضة الأوروبية مع رابلييه ومونتاني، وبانت معالمها
جيدا في القرن السابع عشر مع "العقلانية العظمى"، كما يقول ميرلوبنتي :
ديكارت، الديكارتيون، وباسكال. وستتجذّر أكثر فأكثر مع الفلاسفة الموسوعيين
في القرن الثامن عشر، فولتير وديدرو وتعيد السقوط في شطط معكوس خلال
الثورة مع الإله "العقل"..اطرد الأسطورة، تعُدْ إليك راكضة. وخلال القرن
التاسع عشر انحدرت الإيديولوجية العقلانية إلى طائفية عصبية مع ما يسمّيه
ميرلوبنتي "العقلانية الصغرى"، وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الأصوليات
الدينية. وكما كانت المشاجرات بين الطرفين مؤسفة فهي كانت مسلّية أيضا.
* التراقيون كانوا شعوبا هندو-أوروبية، تسكن في تراقيا والأراضي
المجاورة (حالياً بلغاريا، رومانيا، جمهورية مولدوفيا، شمال شرق اليونان،
تركيا الأوروبية وشمال غرب تركيا الآسيوية، وشرق صربيا، وأجزاء من جمهورية
مقدونيا، ويتحدثون اللغة التراقية.


