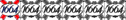نحنُ بإزاءِ ربيعٍ جديدٍ للكتابةِ أكثرَ منه للثَوْرة. إنّه يتخلقُ وسط لهيب بركانِ الاتّصالِ الّذي لن يهدأ قريبًا. ومن بَيْنَ تخوم، ومتون، هذه الكِتَابَة العربية الولودة، والمتوثبة نحوَ مجدِها، يترسمُ أيضا عالمٌ للقراءِ جديدٌ، ومُستنبَطٌ لقيمٍ جديدةٍ، ومحفزٌ، لنشرِ الوعي الثقافي. ولكن مع كُلِّ هذا الوَعدِ، أو الاستِبشارِ، فإنّ هناكَ تحدياتٍ أمامَ الّذين كانوا يكتبونَ عَلَى ضوءِ الشّموعِ، ولمبةِ الكيروسين، ويقرؤون قُبالَة نارِ الحطب. فالكتّابُ التقليديون الّذين عايشوا عصرَ الصحفِ، والمجلاتِ، المُتَوَاضِعة في كميّةِ طِباعتِها، سيُعانون كَثيرا أمامَ منافسةِ الكُتّابِ الجُدد المُعلّقة أسماؤُهم في الفضاءِ، وليس بالضرورةِ أن تهبِط بمنطادِ الذّبول. ولعلّ بعضَها سيصعدُ أكثر إلى صَدارةِ المُجيدينَ لهذه المُمارسةِ الإنسانيّةِ الراقيةِ. وقد نَبذِلُ وقتًا لمعرفةِ تطوراتِ هؤلاءِ الأنبياءِ اليانعينَ من الكتّابِ، وبعضُنا عَدّهم صعاليكَ العصر. ولا نستيأس من محاولةِ الاستِعلامِ حولَ ما إذا كان بعضُ أسمائِهم يَدلّ عَلَى كيمياءٍ لإنسانٍ من لحمٍ، ودمٍ، وعظمٍ، أم أنّهم مُختبِئونَ وراءَ حِجاب.
والكُتّابُ، والكاتِباتُ، المُتحجبونَ، والمُتحجباتُ، كانوا موجودين َباستمرارٍ في تاريخِ الكِتَابَة الصاعدةِ، والهابطةِ، ونشطين عَلَى مدارِ فصولِ هذا المجالِ الحفيّ بكشفِ خواطرِ البشر. بعضُ أولئكَ الكُتّابِ المتحجبينَ، والمحجوبينَ عن أعينِنا، مات، أو قُبر، مع سرّهِ تحتَ رخامِ الصيت. وبعضُهم الآخر حامت الشُبهاتُ حولَ حقيقتِهم العيانية، بل وحقيقةِ وجدانِهم الّذي تَسربَلت أرواحُنا الخضراء به. أمّا بَعضُهم الأخير فما يزالُ يكتبُ بأسماءه المُستعارةِ، ونُخمنُ في نهارِ يومنا من هو يا ترى هذا الكاتِبُ الجميلُ، أو تلك اللئيمة، ومن هي يا تُرى تلك السنونيّة الّتي أغَردت ضدّ تابوهاتِ العَصرِ، وأصولياتهِ، وتنقلُ، بقليلٍ من الانتقامِ النبيلِ، وكثيرٍ من الغبنِ الكامنِ، شكاوى جنسِها إلى سفحِ الشاشةِ الفاضحةِ، والحنينةِ، معا.
قدامى الكُتّاب الّذين أدركوا عصرَ الأنترنات ربّما يتحايلونَ بُغية المنافسةِ الصعبةِ، كما هو شأنُهم سابقًا أمامَ رقابةِ السلطاتِ الاجتماعيةِ، حينما كانوا يَرمُزونَ، ويغَمزونَ، ويُهمهمونَ، دون أن يفقدوا شيئا، خلافَ مواجهةِ الاتّهامِ المرِّ من ممثلي السلطاتِ السياسيّةِ من القُضاةِ. ولكنّ الكلاسيكيينَ حتمًا مواجهونَ بمراوغاتٍ لكتّابٍ جُددّ لا تُكبلهم التقاليدُ، سواءَ تقاليد الكِتَابَة، أو تقاليد العلاقاتِ العامّة، والمواقف الوطنيّة، الّتي انشبك فيها جيلُ كتابِ الرونيو، ثمّ الأوفست، فالماكيناتِ الألمانيةِ الّتي تَطبعُ في الدقيقةِ ألف صحيفة. وفي هذا فميدانُ الأنترنت حنوٌ، ولطفٌ، وثَمّةُ رقةٍّ، للقرّاءِ الّذين كانوا مجبولينَ عَلَى تحسّسِ التقاليدِ الصارمةِ للكتابةِ المحاطةِ بلوازمِ المجتمعِ، الحُرِّ، وغيرِ الحرِّ.
تقريبًا، أربعةُ أشياءٍ كانت تَصرمُ حركة َجيلِ كُتّابِ القرنِ الماضي، وهي ضيقُ فرصِ النّشرِ، وكلياتُ الرّقابةِ المجتمعيّةِ، وقلةُّ التواصلِ مع القارئ، وتكاليفُ الوصولِ إلى المعرفةِ المفتوحة. أمّا كاتبُ اليوم فقد سخرت له سلطةُ الفضاءِ الرحيمةِ كلّ ما لم يكن زملاؤُه السابقون مُقرِنين إليه. بل منحت هذه السّلطةُ بعضَهم صيتَا سريعًا، ومالاً في حالاتٍ، يُعين عَلَى كُلفِ الحياةِ، أو يَجلبُ مكتبةً بألفِ عُنوان. ومع وجودِ الخيرينَ في المشهدِ الثقافي توفّرت هناك جوائزُ سخيةٌ لشبابِ الكُتّاب، والّتي جعلت من الميسورِ أن يُصبحوا بعدها خبراءَ يَفتون في شؤونِ، وانعراجاتِ الحياةِ، ويدلوننا عَلَى كيفيةِ أن يكونَ النّاسُ، كلُّ النّاسِ، بما فيهم الكتّابُ الكلاسيكيون، كتابًا ناجحين.
هذا أمرٌ طيّبٌ في ظاهرهِ فلكلِّ جيلٍ حساسيتُه المفارقةُ، والّتي تُخصبُ طَّمْي القراءة، وتُحافظُ عَلَى تنميةِ دورةِ الكِتَابَة الزارعةِ لثالوثِ الحقِّ، والخيرِ، والجمالِ. فقد كان كولن ويلسون في زمانِه قد هوجِم بأنّه أحدُ الفلاسفةِ المشاغبينَ، حين نشر “اللاّمنتمي” في عمرِ السادسةِ والعشرين. وقد جرّده بعضُ منافسيِه في المجالِ من تجويدِ التّأملِ بوصفِه أداةَ الفيلسوفِ الّتي لا غنى عنها. بل وصفه غُرماؤهُ بالزَّيْفِ، والتنطعِ، والكذبِ، حين أصدرَ في العامِ الّذي تلاه “الدين والتّمرد”. ولكن بقيَ الفيلسوفُ الصّغيرُ، كما سُمي، واحدًا من بُناةِ عصرِه في مجالِ التفكيرِ، وغرةً في جبينِ الفلسفةِ، ووصلَ إلينا بعدَ انسحاقِ كلِّ الانتقاداتِ غيرِ الموضوعيّةِ لتأملاتِه. والأمثلةُ أكثر من أن تُحصى أو تُعدُ.
ولكنّ المهمَ أنّ القضية الأساسية هي أن التمكّن من حِرفيةِ الكِتَابَة لا تتعلقُ بجيلٍ دون آخر، حتّى نزدري الكتّابَ من صغارِ السّنِ كما نصطلحُ كناية على الاستهتارِ بهم، وبما يُعبرون. فالقضيّةُ تتعلّقُ بميلاديّة الكِتَابَةَ، وإمكانيّةِ توفّرِها، إذ أنّ مَوَاوِيلَها الطربُ لصوتِ الكاتِبِ، والرّقصُ على إيقاعِ جملِه الشجيّةِ. ولو توفّرت هذه الشروط فلا بدّ من سقوطِ اعتباراتِ السّنِ، وممحكاتِ حُرّاسِ القبور، ومشاحناتِ بعضِ النّقادِ. ونحنُ قد عرفنا السيّاب وأبو القاسم الشّابي، ومعاوية نور، والبارودي، بوصفِهم عباقرة زمانِهم. ولاحقا عَرِفنا روادَ مدرسةِ أبولو، ومجلّة شعر، والغابة والصحراء، ورواد قصيدة النثر الّذين هم الآن أجدادٌ، وآباءٌ، لجيلِنا الحاضرِ، والّذي ينطلقُ من مضمارِهم عدوٌّ سريع للتحديث. وقد كتب بعضُ هؤلاء المبدعين وهم لما يكمِلُوا مرحلةَ الثانويةِ العليا آنذاك. وهنا مربطُ الفرسِ بالنسبةِ للجيلِ الجديدِ من كُتّابِ الشعرِ، والنقدِ، والروايةِ، والترجمةِ. فقد عُرف ذلك الجيل بتمكنِه البليغِ في اللّغة، والّذي سَهّل لهم الإبداع في هذه السوق الثقافيّة، وقد توفى الله بعضَ رموزِ ثقافتِنا المعاصرة في سنّ مبكرة تُناهز الثلاثين فقط، مُخلفين كلّ هذا الإرث الّذي تقفُ الجرأةُ في الطَرح، والمُعالجة المُمتازة، عناصر أساسية من عناصر تفوقِهم، وفرادِتهم، وريادتِهم.
فرحيقُ الكِتَابَة، أو الإبداعِ عمومًا، إضافةٌ، وموضوعٌ، وموقف.
إضافةُ الكاتِبِ تأتي من قراءةِ مُجملِ تجارب الماضي، وتشربِها، وإعادةِ قراءتِها. فلا يُمكنُ أن تكونَ مسرحيًا دونَ أن تَستذركَ ماذا فعل الّذين سبقوك وجربوا الملحميات، وترجماتِ التُراثِ الإنساني، حتّى وصلوا إلى تيّارِ التجريب المسرحي الّذي ابتدره برتولت بريخت. ولا يُمكن أن تَكونَ ملحنًا يُضيفُ إلى إرثِ الإبداعِ الغنائي دونَ أن تُذاكرَ صفحة جغرافيا النّغمِ الحديثِ الّتي طبعها ملحنون أفذاذ، في أفئدةِ المستمعين. وستتعثر لو أردتَ أن تصبحَ كاتبًا صحافيًّا مُجيدًا، ولك بصمتِك، وفي ذاتِ الوقتِ أنت تَجهل ما فَعله كُتّاب كِبار قَبلك. ويُصعب عليك أن تَكونَ روائيًّا ما لم تقف على التراثِ المحليِ، والإقليمي، والعالميِ، في هذا المجال، وبالتّالي يتعجم عودُك بقراءةِ رواياتِ فرانس كافكا، ودوستويفسكي، ومكسيم غوركي، وماركيز، وتوني موريسون، وول شوينكا، ويوسف حقّي، ونجيب محفوظ، وحنا مينا، والطّيب صالح، والطّاهر وطار، وإبراهيم الكوني، وعبد الرحمن منيف، وغيرهم. ولعلّك ستَرهِقُ نفسكَ مليًّا إن لم تكن قد أدركتَ جيّدًا مُفردةَ البياتي، أو محمود درويش، أو أنسي الحاج، أو الفيتوري، أو سعدي يوسف، أو الماغوط، حتّى تَبني فوقَها. وكذلك تحتاجُ أنت التشكيلي الحروفي أن تقفَ على جمالياتِ لوحةِ شاكر حسن آل سعيد، وعثمان وقيع الله، وسعيد عقل، وكمال بلاطة، ورمزي مصطفى، حتّى تأتي بما لم يستطعه هؤلاءِ الأوائلُ، وهكذا هي شروط الإضافةِ الملهمةِ، أو تحسينُ الجودةِ. ومع ذلك فهناكَ استثناءاتٌ خارقةٌ تَخرجُ من بين الإلهامِ حتّى تكونَ وَمضاتٍ مشرقةٍ في المجالِ بقليلٍ من التمرينِ، والتدريبِ. ولكن الاستثناءَ لا يَشمِلُ كلّ الممارسين للإبداعِ التدويني.
وما خصّ الموضوع بالنسبةِ للكاتبِ فهو فلسفتُه، ورؤيتُه، وحجّتُه، الّتي بها يَزيدُ في وهجِ التنويرِ، أو التنبيهِ للمناطق الجميلةِ، والمعتمةِ، سواء في الذّاكرةِ الجمعيّةِ، أو الإنسانيّةِ، أو في الواقعِ، أو في غورِ النّفسِ. فالكاتِبُ هو مُستنبط لقيمِ ذلك الثالوث المذكور آنفًا. إنّه العقلُ الّذي يسيرُ في الطريقِ ليرى ما لا يراهُ الآخرون، وعندئذ فحُجتُه دامغةٌ على تبيينِ تلك الرؤيةِ، وهو ضميرُ الإنسانيّةِ الّذي يحلم برؤيا تَمنحُ مجتمعَه، أو الإقليمَ الحضاري، أو البشريّة َعمومًا، سبيلا موشى بالورودِ نحو التّقدمِ، أو حُروفًا لمسألةٍ ملحة للتأملِ. ورؤيا الكاتِبِ هي آياتُه البيّنات الّتي تُخلصُ مجتمعَه من سخائم النّفسِ، وسيئاتِ الأعمالِ، وتُشذّبُه بمهتدياتِ الوعي، والسّلامِ، والتّسامحِ.
أمّا موقفُ الكاتِبةِ فهو إلهامها الّذي به تخطُ حروفًا لإعادةِ فحص المعرفةِ المسلّمِ بها، ومثلما أنّ لغة الكاتِبِ هي شكلُ مشروعِه فإنّ في مضمونِه نستشفُ قدراتِه على توظيفِ كلِّ مناهجِ النظرِ المطروحةِ للإتيانِ بمنهجٍ جديدٍ يتقارب، ويتناص، ويتقاطع، مع هذه المَناهجِ ليشكل تراثًا موحيًا للنظرِ العقلاني، ذلك الّذي تتجلى عبره الحيثياتُ المعرفيّةُ الجديدةُ، والّتي من شأنها أن تُحدث الحوارَ الفكري، أو السّجالَ الملحمي، حول القضايا المعنية.
لقد ثورت حركةُ الاتّصالِ العالميّةِ مجالِ الكتابةِ بصورةٍ غيرِ مسبوقةٍ في التّاريخِ البشري، وأفرزت تفجيرًا هائلاً للمعلومةِ الّتي كانت تَغيب عن أذهانِ النّاسِ في زمانٍ كان للمعارفِ كثيرُ سياجٍ. ليس فقط سِياج الدولةِ القطريةِ الّذي “يُسنسر”، ويَصبُّ المعلومات صبًّا في عقولِ النّاسِ بُناءً على نظرياتٍ أيديولوجيةٍ، أو شعوبيةٍ، أو أقواميةٍ، وإنّما كانت السياجُ هذه تتعلقُ بضعفِ تأثيثِ المجتمعِ، باقتصادِه، وتفسيراتِه للدولة، ومنظوماته السّلطوية، وأسسه التعليميّةِ، وصناعتِه، وقدرتِه اللّوجستيةِ على الحصولِ على نفاجٍ نحو بيوتِ الحكمةِ، والمعرفةِ.
الآن، الحمدُ لله، بدا أن شُعوبنا، والّتي هدّ عقلَها حَملُ خزعبلاتِ الأنظمةِ المستبدةِ، وصلت إلى خيارِ الأخذِ بناصيةِ تغذيتِها الثقافيّة، وامتلكت مقدِرتَها على الكتابةِ بعد أن كانت تتلقى معونات معرفيّة سلطويّة.َ لقد خرجنا من إسارِ هذا التنميط المقصود لنكون سوقًا للغث، والثمين، من منتجاتِ المركزِ الإقليميِ، وصار مجتمعُنا كلّه يكتبُ، ويَتمرنُ على الكتابةِ، ناهيك عن تزايدِ الكتّابِ المحترفينَ، وشبه المُحترفينَ. ذلك يعني أنّنا ننتجُ معرفتَنا سواء تمّ نقدهُا بأنّها “نيئةٌ، أو تافهةٌ، أو عنصريّةٌ”. فالمهمُ هو تمديدُ سلطةِ التعبيرِ الشعبي، ويجب ألّا نُحاكمها، كما نُحاكم الكُتّاب المُحترفين، وبالتّالي نتصيد أخطاءَ الكُتّابِ الجُدد النحويّةِ، وإخفاقِهم في الإملاءِ، وضعفِ صياغاتِهم التركيبيّةِ للفقراتِ، وهشاشةِ تقدميةِ النظرةِ في المكتوب، أو انعدامِ هرميّةِ بناءِ الكتابةِ، أو استطالتِها، أو تثلثِها، وغيرِها من المثالبِ الّتي تقعِدُ بالكتابةِ الحرفيةِ. لا، علينا أن نكونَ رحيمينَ بهؤلاءِ الكُتّابِ الجُددِ الّذين كان أجدادُهم، وآباؤُهم، قد أدخلوا قسرًا، وغشًا، في حظيرةِ التزييفِ الديني ـ السياسي حتّى صاروا يحلفون بغيرِ آلهةِ الباطن.
كلُّ ما يحتاجُ إليه كُتّابُ جيلِ الأنترنات أن نُذكرَهم بأدبٍ، ورفق، أن للكِتابةِ إضافة، وموضوع، وموقف، هذا إذا أبدوا استعدادًا للجنحِ إلى الاحترافِ. والحقيقةُ أن كلَّ الكتّابِ الكلاسيكيين لم يُولدوا، وهم قادرون على إجادةِ الكتابةِ الذّهبيةِ. فقد تعثروا عندما كانوا “كتّابا صغارا” في تَجويدِ النحوِ، والإملاءِ، حتّى استووا بالمرانِ، والدربةِ، والتوجيهِ، على الإجادةِ. والمؤسفُ أن بعضًا من الكتّابِ المحترفين الّذين يعنفون الكُتّاب الجُدد يسدرون في الأخطاءِ النحويّةِ، والإملائيّةِ، ولا أعفي نفسي برغمِ طولِ الممارسةِ. فالكاتِبُ ليس أستاذًا للنحو، برغم حاجتِه إلى المعرفةِ بأصولِ النحوِ، والبلاغةِ، والبيانِ والتبيينِ، والإعرابِ. فهو إنّما الكائنُ الّذي يتطورُ دائما نحو المثالِ في المضمونِ فيما يشرئبُ شكلُ كتابتِه إلى أفقِ التّجويدِ دومًا. ومن ذا الّذي يتفضل بأن يشرح أصولَ الكتابةِ مجّانًا من الكتّابِ الّذين أفاض اللهُ عليهم بالصيتِ والتجربةِ؟
إن الكِتَابَةَ َوالقِراءة َصِنْوَانٌ. تخرجُ حيّة من ميتِ الحبرِ الّذي جف، والتَهَمَته الأعينُ، وبقيَ مردودُها يتخمّر في غائلةِ الصدورِ. القراءةُ الجيّدة، فوقًا عن أنّها تزيدُ العمرَ، فإنّ ما يوقر في عقلِ صَاحِبها يسكنُ هناك في البرزخِ. ولعلّها نديمة الروحِ الوحيدةِ عند صعودِها إلى السَّماءِ. فالكاتِبُ قارئٌ مَهَما ذاع اسمُه، وانتشَر. وكلُّ ما يفعله هو أنّه يَملأ حُوَيْصلَتَه المَعرفيّة َمن زادِ الآخرين، ولولا كِتابتهم لما كَتَب. لا توجدُ كِتابةُ خارجَ الكِتَابَةِ. إنّها تخرجُ من بَيْن أدمغةِ الموتى، وبراعةِ الأحياءِ، إنّها نسلُ الأقدمينَ والآخرين. توُلدُ من بَيْن أمخَاخِهم، وتتناصُ بما هَرِفوا، وعَرِفوا، وكَذبوا حتّى. فالتباساتُ الكِتَابَةِ هي التباساتُ روحِ الّذين رَصَفوا طريقَها بمعارفِهم الخُرافيّةِ، أو الأسطوريّة، أو سذاجةِ البصرِ أحيانًا. ومن لم يقرأ لن يحيا، وما الحياةُ إلّا القراءة الّتي تزهر سريرتَك، وتزهيها حتّى تتأنسن علاقتُك بمن حولِك. واليومُ لا عُذرَ لمن فاتهم قطارُ التعليمِ النظاميِ، أو عَطلت وحيَ روحِهم ظروف النّشأةَ، وطبيعة َالأخطاءِ الّتي ارتبكها آخرون حتّى استَطالَ الفاقدُ التربويُ، وتعَشعَشت الأميّةُ. عصرُنا إن كان هناك شيء يُميزه فهو لخلقِ الانفتاح الثّقافي على تراثِ البشريّةِ بغيرِ وسَيط، والتّميزُ الأكبرُ هو أنّه أعطى صوتًا حقيقيًا لمن لا صَوتَ لهم. إلّا من أبى.
كلُ هذه المُعطياتِ الجَزلةِ لا بدّ أن تدعم مسيرة َ الإنسانيّةِ الّتي بدأت تعْبِيرِاتها بالطلاسِمِ، ولا بدّ أنّها تنهضُ سريعًا بالشعوبِ الّتي تَخلّفَت عن رَكبِ التدوينِ، وما تزال مُنجدلة في طينِ الشفَاهةِ. وشكرًا لكلِّ الّذين سَاهموا بفِكرةٍ حتّى ينفجرَ بُركانُ الاتّصالِ ليُقلصَ مساحة َزيفِ الدولةِ الّتي ما قَامت إلّا على أكتافِ المَسَاكِين، وأبناءِ السَبيل، والّذين تناسلوا فيها وملأوها بملايين الأحَفاد الّذين ما يزال بعضُهم عَبدة لمن استأسدوا بخيراتِها. ولقد جَاء مددُ الفَضَاءِ للمساكين، والّذي سوف يُحررهم من الحيفِ السياسيِ، والتنميطِ الثّقافيِ، وغلوِ ضَغطِ الرأسماليةِ الطفيليّة الجاثِمة عَلَى صدُورِهم، والّتي ما هي إلّا وَسِيلَة الأنانيّة الّتي خرجت من تعامُلاتٍ غيرِ شَفَّافة. وسيحرر الفضاء دويلات الفقراء من سلفيةِ الدين الّتي علت من شأنِ بعضٍ من أبناءِ السبيلِ ليبرزوا نقاط ضعفِهم في تسييرِ دُولاب الحياةِ، ولا يَخَدِمون إلّا الطَّبَقَات الّتي تُسيطرُ على تحديدِ المُحَاصَصةِ وفقًا لحِساباتِ العِلاقاتِ العامّة، على أن يحظوا ببيتٍ حُكُومِيٍ، وسائقٍ مُخَصصٍ للأُسْرَة، وآخر يَركُبه المَسؤول أكثر من العَرَبَة، ولا بأسَ من مَحْفَلين تجاريين، وأرضٍ سكنيةٍ، وتعاملاتٍ مع الطبقةِ الجديدة الّتي تغَيَّبُ من ذاكرِة ابنِ السبيلِ ماضيَه الفَقيِر.
ولُغة الكِتَابَة وميضُ لحنِها. فما من كِتابةٍ إلّا وقيست بسلامةِ أسلوبها، عسى أن تَدلّنا عَلى الفِقه اللّغوي لفنانِها. فاللّغة في ذَاتِ نَفَسِها مَعَرِفة، وتطريزٌ في مِعمارِ النَّفسِ الكاتبةِ. تَخرِجُها ملونة، ورقيقة العِباراتِ، وجَزِلةَ في نوعِها. والّذين يَكتِبون فَنانون، بما مَلَكت أُذنَهم من مَعرفةٍ لجِرسِ الكلمةِ، ووقع العبارة. وكثيرون يَرَونها فقط أداة للتعبيرِ بغير تفنين. ولَكِن الكِتَابَةَ َفنٌّ يَمتلِكَ إيقاعَه، ومُوالاته، ولزَماتِه. يُقضي الكاتبُ وقتًا مقدرًا ليُعيد تركيبَ بِناءِ مادتِه، ويُراجع دِقتَها في التبيين، والسلاسة، ويوشيها بما جَادت به قريحتُه من ذوق. وهكذا يتخلّقُ التمايزُ بين فنانِ في الكِتابةِ، وبين آخر، حتّى يَعيشَ الكاتِبُ في ذِهنِ القرّاء فنانًا في الحروف. وبما أنّ للقِطعةِ المُوسيقية ألقٌ عِندَ السامعين فإنّ للكِتابةِ لحنُها الّذي يفرز تأثيره، وشده لذِهنِ القارئ. والكُتّابُ المُجيدون هم الّذين يوازنون بين الشكلِ، والمَضمونِ، وهذا هو سرُّ النِسبةِ العالية من القراءةِ الّتي يَحصِدها كتّابٌ دون آخرين. وإذ يُقاس حَجم إبداعِ المُوسيقارُ بقدرته على الاستماع إلى أكبر عددٍ من المؤلفات المُوسيقيّة الّتي تكسب أذنه المعرفة بمناطقِ مقامات الآلةِ الشجيةِ، فإنّ الكاتبَ بقراءاته الجَّادةَ، والصَبورةِ، والمُثابرةِ، لإنتاجِ الآخرين يَستطيعُ أن يُخرجَ بأسلوبِه الّذي ينَطبع في ذهن قارئِه. والّذين يَستسهلون الكِتَابَةَ من المحترفين الجدد بأنّها مُجرّدُ حروفٍ لتُحقق لهم النجوميّة، من غيرِ عناءٍ، أو صبرٍ، أو تجويدٍ، ضلّوا الطريقَ إلى هذا الفنِّ الرّاقي. فلا مناص للكاتبِ من أن يهتمَّ بأسلوبِه قَدرَ اهتمامِه بتوصيلِ الفكرةِ، وكلّما تَعمقت لغةَ الكاتبِ سهُلت قدرته على تشذيب كِتابتُه، وتبيين مَوضوعَه. وكلّما قلّت ذاكرتُه اللُغويةِ تَعثرت إمكانيتُه في لفت النظر إلى ما يُريد قوله. ولا تعني قراءةَ الكاتبِ بالعربيةِ إلّا الاقتباسِ من لغةِ القرآنِ الكريم، والشعرِ القديمِ، وقواميس اللّغةِ، ومجملِ التراثِ الإنساني الّذي خَلّده المبدعون في كلِّ مجالاتِ الحياة. وفي حالِ تَمكنِ الكاتبُ من حذق لغةٍ أجنبيةٍ أخرى فإنّه يَكون قد اكتسب الكثيرَ من إمكانيةِ التّجويدِ لكتابتِه، فضلاً عن تَدعيمِها بتلك المعارف الّتي يَحصُل عليها.
إن حظّ الكُتّابِ الجُدد اليوم أكبرُ من حظِّ الّذين سَبقوهم. فلو أنّ الظُروفَ لم تتوفّر لهم لاقتناءِ أُمّهاتِ الكُتبِ، لأسبابٍ شَتّى، فإنّ في الفضاءِ اليوم متّسعٌ لِلحُصولِ مجانا على معظمِ هذه الكُتب الّتي تُثقف. وقد مرّ زمانٌ على الكُتّابِ الكلاسيكيين كان يصعب عليهم فيه الحُصولِ على الصحيفةِ ناهيكَ عن المجلّاتِ المُحكمةِ، والمُجلّدات الضخمةِ. ولكن أُتيحت لهذه الأجيال الناشئة فرصٌ َلقِراءةِ حتّى الصُحف والمَجلّاتِ العالميّةِ في لحَظتِها، وأحيانًا مُترجمة. بل إنّ الكُتّابَ الجُدد الحريصين على اكتسابِ لغةٍ جديدةٍ تَزيد معارفَهم أصبحوا يَحصُلون على الكُتبِ، والرواياتِ العالميةِ بِلُغتها. وأحيانًا يترجمونها بعد أن عاشوا في الخارجِ واكتسبوا مُهاراتٍ في الترجمة من اللّغةِ الجديدةِ إلى لغتِهم. والأكثرُ من ذلك أنّ هذا الانفتاح الّذي وجده الكُتّابُ المُهاجرون سيساعدهم كثيرًا في تنويعِ معرفتِهم عبرَ الفنونِ السمعيّةِ، والبصريّةِ، والّتي تَجعلُ تجاربَهم في تملكِ الوعي أكبر من تجاربِ أساتِذتِهم. ولكنّ المُهمَّ هو كيفيةُ توظيفِ هذه المعارف، والمناهج، عبر كتابةِ تَستبطنُ موضوعات ٍجديدةٍ تُعالجُ قضايا حَيوية، بدلًا من أن تكونَ مجالًا لاستعراضِ المعرفةِ بأسماءِ الكُتّابِ العالميين، والمصطلحاتِ، أمامَ القارئ، وتعقيد الأسلوب. وعلى كلّ حالٍ، سيصل كلُّ كاتبٍ جديدٍ إلى آخر السباقِ متى ما نضِجت كتابتِه على نارٍ هادئةٍ، وارتبطت بجذورٍ إنسانيّةٍ، واستهمت بمقاومةِ شرّ الشموليّةِ المستطير في بلادِه، وخِدمةِ مجتمعِه الّذي هو بحاجةٍ إليه لنشرِ تثاقفِه المعَرِفي، والحَضاري.