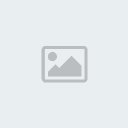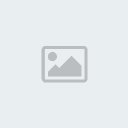
"إذا كان الحكم الليبرالي
والحكم الاشتراكي قد فشلا فخلّينا نجرّب الحكم الإسلامي"؛ مقولة يردّدها
الإسلاميون الفائزون بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية المصرية
الأخيرة..وهي مقولة تثير الكثير من علامات الاستفهام لا في طبيعة نموذج
الحكم الإسلامي الذي سوف يطبقه الإسلاميون فحسب، وإنّما هل طبقنا فعلا في
مجتمعاتنا العربية الجمهورية منها أو الملكية نماذج ليبرالية أو
اشتراكية؟…فاستفهام الإسلاميين يتضمّن إسقاطا بالتشويه لتجربة الحكم لا في
المسمّى الذي تحمله وإنما في جوهر التطبيق الذي أثبت نجاحه في المجتمعات
الغربية والكثير من دول العالم الثالث، والمتمثل في أنظمة الحكم
الديمقراطية.. وهنا نطرح التساؤل : أيّ نظم حكم كانت تسود المجتمعات
العربية خلال العقود الستّة الماضية؟؟ وهل مسمّى النموذج يغنى عن جوهر
الحكم؟
بالنسبة لشكل النظم فقد كان هناك نوعان من نظم الحكم في المجتمعات
العربية؛ الملكية وهي نظم ممتدّة، الحكم فيها لأسر حاكمة ترجع لقرون الى
الوراء(الأسر الحاكمة في الخليج) والشكل الثاني نظم جمهورية ظهرت في النصف
الثاني من القرن العشرين عقب الاستقلال، وهي بطبيعتها إمّا كانت محتلّة
إضافة الى كونها كانت تحت نظم ملكية مثل العراق ومصر، أو أنها خرجت من تحت
عباءة تقسيم الاستعمار.. وبالنظر الى مدى ارتباط هذه النظم بالنماذج
الغربية؛ نجد أنّ بعضها أخذ بالنموذج الاشتراكي والآخر أخذ بالنموذج
الرأسمالي، أو ما يجمع بينهما من حيث الشكل فقط، أمّا من حيث الجوهر ومضمون
الحكم فإنّ ما هو سائد هو حكم الديكتاتور، وبالتالى نموذج الحكم الليبرالي
أو الاشتراكي ما كان إلا واجهة لحكم الحزب المتسلط الذي على رأسه
ديكتاتور؛ مثل ظاهرة حزب البعث في كلّ من العراق وسوريا تحت صدام حسين
وحافظ الأسد.. ومن هنا فالذي اختبر لم يكن الحكم الاشتراكي أو الحكم
الليبرالي وإنما هو حكم الفرد الديكتاتور الذي كان تجسيدا للحزب وللقانون
وللدستور ولكلّ المؤسسات السياسية التى تُسَبح باسمه في البلاد..وهو ما خلق
حالة ازدواجية ما بين القيم الغربية للحكم والقيم التقليدية وهيمنة حكم
الفرد في هذه المجتمعات… فقد كانت هناك الانتخابات التى تُجْرى بأشكالها
المختلفة الرئاسية والبرلمانية ولكن نتيجتها كانت تأتي وفقا لرغبة الرئيس
الديكتاتور، وكان هناك رئيس الوزراء ووزراؤه ولكنهم لم يكونوا في يوم من
الأيام وزراء سياسيين او مسئولين وإنما هم تابعون لتوجيهات السيد
الرئيس..فقد تمّ تشويه كل قيم مرتبطة بجوهر مؤسسات الحكم التى تم أخذها من
النماذج الغربية في هذه المجتمعات بتسطيحها في صالح تعظيم صلاحيات هذا
الديكتاتور..ومن ثم قد يكون هناك حقّ وتبرير وتقبّل لمقولة الإسلاميين في
النموذجين الاشتراكي والليبرالي بفشل تطبيقهما في مجتمعاتنا، ومن ثم يجب
إتاحة الفرصة لتطبيق النموذج الإسلامي.. ولكن هذه ليست كل الحقيقة..فهذه
النماذج لم تطبّق وإنما اتخذت شمّاعة لتدشين واستقرار حكم الفرد
الديكتاتور، كما أنّ حركة تطوّر المجتمعات ليست بهذا الانفصال بين نموذج
وآخر في التطبيق. فكلّ النماذج الناجحة في الحكم مع اختلاف أشكالها يرتبط
نجاحها بالأساس بحكم القانون وليس بحكم الفرد.. فالقضية ليست بهذا الشكل
الإقصائي الذي يحمله الإسلاميون في مقولاتهم، فالتمييز هنا ضروري ما بين
كونهم قوى سياسية تسعى الى تطبيق الشريعة الإسلامية وبين وسائل الحكم التى
لا يمكن في يوم وليلة أن تُبتدع حتى لو استعيدت من الماضي بظروفه المختلفة
عن الحاضر.
فالإسلاميون أنفسهم ما كان وجودهم في السّاحة وحصدهم الأغلبية إلا نتيجة
لاتباع النهج الليبرالي الديمقراطي في الحكم، نتيجة ثورة قامت بالمطالبة
بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية..وعلى ضوء نتائجها كوّنوا
أحزابا سياسية وتنافسوا بها في الانتخابات التى أجريت في كل من مصر وتونس
والمغرب - وفقا للنموذج الليبرالي- وظهر منهم في السياسة في هذه الانتخابات
من كان مجهولا ومتواريا في االمساجد مثل حالة السلفيين في مصر.. وبالتالى
فالقيم الليبرالية كانت سببا في وجودهم في الساحة، وسببا لأن يظهر وزنهم
الحقيقى عبر وسيلة نزيهة تحمل الحدّ الادنى من تحقيق العدالة، بصرف النظر
عن المثالب الأخرى، إلا أنها في النهاية حققت قدرا من العدالة إذ عكست رغبة
الناخبين الذين أعطوهم أصواتهم…
فتسليم الإسلاميين بقواعد الانتخابات، ودخولها بشكل فيه منافسة وحصولهم
على الأغلبية في انتخابات نزيهة بهذا الشكل وبهذه الأداة المحسوبة على
النموذج الليبرالي، يناقض مقولاتهم ويبرهن على نجاحه عندما يطبق بشكل يحمل
النزاهة بعيدا عن تزوير الحاكم الديكتاتور الفرد..
وربما تكون تجربة الانتخابات الأخيرة فرصة للإسلاميين بأن يغيّروا قدرا
من الاعتقاد الذي كانوا عليه من قبل باقترابهم من الواقع ومشكلاته
والاحتكاك مع أفكار الآخرين، وذلك سيعتمد على مدى قدرة اقتناعهم بقيمة
الديمقراطية والتداول على السلطة، فليس من المستبعد أن تحدث الكثير من
المراجعات لهم على خلفية وجودهم في المسئولية في المواقع النيابية أو
التنفيذية، والتى يجب ألا ينسوا أن وصولهم إليها تم عن طريق هذه المبادئ
الليبرالية، وبالتالى فإنّ احترامهم لمبادئها كفيل بأن يجعلهم أحرارا في
تبنّي توجّهاتهم الدينية، وكفيل بالآخرين أن يتخيروا السير معهم أو العمل
ضمن قوى سياسية أخرى في إطار وجود مؤسّسيّ حاضن لهذا التنوع والاختلاف في
الرؤية للقوى السياسية. فالقضية ليست في تفضيل نموذج عن آخر بقدر ما هي
عملية احترام لمجموعة من المبادئ تعكس حكم القانون وتحقيق قيمة العدالة
التى تغتالها السلطوية والطائفية والايدولوجية وكل من يحمل معتقدا يظنّ به
أنه فوق الجميع.