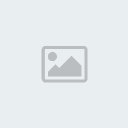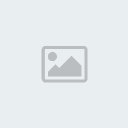
أثير الكثير من الجدل حول ما
يحدث في العالم العربي على مدار عام 2011: أهي ثورة أم انتفاضة أم غير ذلك
من المسمّيات. وأخذ هذا الجدل حيزا كبيرا لدى الباحثين العرب وغيرهم من
المعلقين. وما لفت النظر أنّ المنظّرين في العلوم الاجتماعية اهتموا عند
تناولهم لهذه الظاهرة بالمناهج القديمة في تفسيرهم لها دون أن تكون لديهم
أدوات جديدة تتناسب مع ما حدث بشكل مفاجئ وفقا للمعطيات الجديدة.. ومن
هنا يجوز أن نطلق على هذا الواقع كلّا من التوصيفات السابقة سواء كانت
انتفاضات أو هبّات أو ثورات.. فلكلّ من هذه التعريفات مدلولاتها مع هذه
التغيرات.
وفي محاضرة لأستاذ العلوم السياسة
ديفيد اتاواى في الجامعة الامريكية بالقاهرة يوم 23 اكتوبر الماضي تطرّق
إلى هذه الجزئية عند تعرّضه لما يحدث في المجتمعات العربية؛ أهي ثورة أم
انتفاضة؟ وانطلق في تعريفه لهذا الواقع من خبرة هذه المجتمعات في السابق،
فاستشهد بما حدث في مصر عام 52 في كونها كانت ثورة لارتباطها بالتغيّرات
الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وبالمثل ما حدث في إيران في عام 79 لكونها
أدت أيضا الى تغيير المنظومة السياسية والثقافية للمجتمع، ومن خلال هذين
المثالين من وجهة نظره يرى أنّ ما يحدث في العالم العربي الآن ليس بثورة
ولا يقارن بما حدث في هاتين الحالتين..
وإذا انطلقنا
من تحليل ديفيد اتاوى الذي نقل ما يحدث في العالم العربي من كونه ليس
بثورات يمكننا بنفس المنهجية التى استخدمها أن نؤكّد أنّ ما يحدث هو بالفعل
ثورة لأسباب أبرزها أنّه أغفل عامل الزمن، فهو حكم على الظاهرة من خلال
مرور بضعة شهور عليها عكس ما حدث في ثورة 52 في مصر التى استشهد بها، لأنّ
جوهر التغيرات الاجتماعية والسياسية في المجتمع احتاجت الى عشر سنوات سواء
بقوانين التأمين للممتلكات الخاصة، أو بقوانين إلغاء الأحزاب وقوانين توزيع
الاراضي وغيرها.. وبالمثل التطورات التى ارتبطت فيما بعد بالثورة
الإيرانية في عام 1979.
وبناء على هذا المتغيّر
فمرور بضعة أشهر غير كاف للحكم على ما يحدث بأنّه ليس بثورات لعدم حدوث
تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، لأنّ الواقع نفسه يثبت أنّه مع مرور
الوقت، كل الخيارات والفرص باتت متاحة، ففى حالة صعود الإسلاميين -وهو ما
بدأ يتحقّق على أرض الواقع بفوزهم بأغلبية المجالس النيابية- فإنّ تساؤلات
كثيرة تطرح عليهم، حول قضايا عدة من بينها قضية الدستور -ووفق تفاعلاتهم في
السنة الأولى للثورة فهم لا يرون دستورا غير القرآن والشريعة … وبالتالي،
فهل نحن بصدد عملية قطع حضاري وثقافي في مسيرة المجتمع وتفضيل قيم ترتبط
برؤيتهم للدين؟ هذا احتمال، وهو يشكّل بعدا من أبعاد تعريف الثورة.. وهناك
احتمال آخر وهو أنّه في حالة حدوث توافقات بين القوى السياسية والنموّ
تدريجيا نحو الديمقراطية، حتى لو كانت هذه التحالفات إسلامية ويسارية
وليبرالية مثلما حدث في تونس والمغرب، فإنّ هذا مؤشر أيضا على أنّ هذه
المجتمعات داخلة في ثورة بتغيير منظومة القيم والأفكار بانتقالها من
الاستبداد إلى الحرية والتسامح، وغيرها من القيم التى تعكس التطور الحديث
في منظومة الحقوق، والتى في جوهرها لا تتعارض مع القيم الدينية …الخ.
ومن
هنا فمفهوم الثورة إذا اتفقنا على كونه تغييرا للواقع وإحلال واقع جديد به
فليس بالضرورة أنّ ما تاتى به يكون نافعا، وإنّما قد يكون ضارا ويعود
بالمجتمعات الى الوراء، مثال التجربة الناصرية في مصر وتجربة الإسلاميين في
ايران ..
ويلاحظ أنّ التطوّر الدستوري المصري على مدار المائتي
سنة الماضية كان مصحوبا بتطوّر في بنية المجتمع ، فعلى قدر ما كان هناك
حراك ثوريّ كان هناك تطوّر دستوريّ موازٍ له، سواء بشكل إيجابيّ أو بشكل
سلبيّ، فتجربة مصر ماقبل 52 كانت حافلة بثراء دستوريّ ارتبط بانتفاضتين أو
ثورتين مهمّتين في التاريخ المصري، الأولى هي ثورة عرابي 1881 وثورة 1919،
فالأولى جاءت بدستور 1882 والثانية جاءت بدستور23. وكان هذان الدستوران
بمثابة مرآة فكرية لحركة التنوير داخل المجتمع وقدرته على الوعي بحقوقه
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مواجهة الحاكم.. هذا ما يتعلق بالجانب
الإيجابي بعلاقة الدساتير بالثورة، أمّا الجانب السلبيّ فارتبط بشكل كبير
بثورة 52 والتى كانت ثورة بالفعل لأنها أحدثت قطيعة مع الخبرة السابقة سواء
الدستورية ؛ إلغاء دستور 23، أو السياسية بإلغاء الأحزاب والتعددية
السياسية او الاقتصادية بقوانين الإصلاح الاقتصادي وعمليات التأميم.. ومن
هنا فالتجربة الناصرية أثبتت عكس ما تثبته عجلة حركة التاريخ والتطور من
كون ان الثورة على القديم تؤدّي إلى التقدم والتطور بكونها في ثورتها على
القديم قادت إلى التخلف لعدم احترامها قاعدة مهمّة في التطور الحضاري
للمجتمعات وهي المتمثلة في التراكم والبناء، فهي هدمت الكثير من الأطر
المؤسساتية الثقافية والسياسية والاقتصادية داخل المجتمع واستبدلتها بأطر
جديدة أقل فاعلية ترتب على ذلك نتائج سلبية عديدة داخل المجتمع على مدار
العقود الماضية .
وهذه التداعيات السلبية
طالت التجربة الدستورية بدورها، فبدلا من وجود دستور ليبراليّ ووجود تعددية
سياسية تحوّل المجتمع المصري إلى مجتمع يهيمن عليه تنظيم
واحد برئيس ديكتاتوريّ في يده كل السلطات، مما أفقد المضمون للمؤسسات
السياسية وبالأخصّ السلطتين التشريعية ممثلة في البرلمان، والتنفيذية
الممثلة في الوزراء والذين كانوا بمثابة الديكور، فكانت البرلمانات تزوّر
انتخاباتها لتأتي تركيبتها بالشكل الذي يريح الديكتاتور والوزراء يصبحون
بمثابة الدمية التى يحركها في الوقت الذي يريده…
ومن خلال هذا
يمكن قراءة ما حدث وسوف يحدث في مصر وبالأخص فيما يتعلق بالنواحي السياسية
والاجتماعية بكونه يعكس مفهوم الثورة..فنحن الآن بالفعل نمرّ بمرحلة مشابهة
تماما لمرحلة ثورة 52 سواء في المسألة الدستورية أو السياسية أو
الاجتماعية.