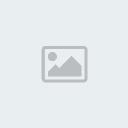
الآن وقد مضى على الهبّات العربية ما يزيد على ثلاثة أشهر جيّاشة بالحركة
والأمل وتلمس ما هو ممكن وما هو ليس بممكن، صارت لدينا فرصة استعادة ما
يحصل في ضوء ما حصل بما يتجاوز متطلبات الانفعال والهوى، ودون إطلاق
الشعارات. علينا الإشارة أوّلاً إلى أمر أراه بالغ الأهمية لما ينطوي عليه
من دلالات تاريخية عريضة. هذا الأمر هو مزاج الكثير من معلّقينا، مزاج
مأخوذ بما ترتّب على استفحال الخطاب العبثيّ والبدائيّ حول الهوية
والممانعة، ومرتّب على هذا الخطاب القول بأننا معشر العرب مفطورون على
الخيال وممانعة التاريخ والتغني بالذات وأمجادها السالفة والركون إلى غرائز
استبدادية وطائفية تجعل منا - عدا في مصر وتونس- وهْم أمّة أو أمّة وهمية،
وإنّ الكلام حول أمّة عربية لا عماد له إلّا الاستخدام الذرائعي للعبارات
القومية من قبل دول وأحزاب هي أبعد ما تكون عنها. تستثمر مزاجاً وتتلطى
بالإيهام بالممانعة- وكثر ما يثار في هذا السياق أن سورية قد ضمنت أكثر
حدود إسرائيل أماناً لمدة تقارب العقود الأربعة.
علينا القول إنّ كل ما يقال في هذا السياق ليس ختلاً، وأنّ بيننا من هو
أصوليّ نكوصيّ ومن يرى في التغنّي بالأمجاد المتقادمة ليس فقط تعويضاً عن
قصور الحاضر بل بديلا عنه. والراهن أنّ أعراض التأزم التاريخي هذه التي
تخال نفسها حلاً للأزمة قد تمدّدت في العقود الأخيرة، وأنها نتاج لأزمة
آيلة عن ممانعة عدد من الأنظمة لتمكين المجتمعات العربية من إعادة بناء
ذواتها على صورة تتوخى الرشاد، لها مقدمات الديمومة، بعد أن مرّ العالم
بتحوّلات بالغة الأهمية في العقود الماضية تركت آثاراً مدمرة وإمكانيات
وظروف جديدة هي، إن أهملت أو قمعت، لا بدّ أن تؤدّي إلى تفجير الاحتقانات
التي شاهدناها في الأشهر الأخيرة ومازلنا نشاهدها.
ولئن دلّ تفجر الاحتقانات هذه على أننا ابتدأنا بالعودة إلى التاريخ بعد
استقالتنا منه، إلا أن الأهم هو أننا نفعل ذلك مجتمعين. ولذلك فإنّ على
معلقينا المتشائمين مراجعة القدر الكبير من تشاؤمٍ كنا لا نلام عليه في
السنين الأخيرة. إن التشاؤم عبارة عن انسداد الأفق، وفي انسداد الأفق ما
يحثّ على استحباب الاستقالة من التاريخ وحركته بدعوى عدم المقدرة أو بدعوى
تشوّهٍ خلقيٍّ عامٍّ للمجتمع. وإن في ما حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما
يدعونا إلى إعادة الاعتبار للعروبة : ليس باعتبارها قدراً سبق وأن تحقق في
الماضي، وإنّ ما علينا إلا استعادته بمزاج غنائيّ مرتفع النبرة، بل
باعتبارها واقعاً سياسياً جامعاً دلّ عليه ترابط الأحداث الأخيرة الذي
اشتمل على مسارات متقاطعة مترابطة، مؤثرة في بعضها البعض ومتأثرة ببعضها
البعض رغم اختلاف الأوضاع والمسارات في الأقطار العربية المختلفة، مكملة
لبعضها البعض في جامعها الجيو- سياسي، آيلة أيضا عن ناظمٍ خارجيٍّ أكيد،
ناظمٍ بنيويٍّ مؤثّر في كلّ قطر وبقع، متفاعلة معه استناداً إلى مفاهيم
وثقافات سياسية داخلية هي، على اختلافها وتعقيدها بل وتباينها، مترابطة
ترابط الرزمة التاريخية الواحدة. خلاصة القول إننا - مجتمعين- بإزاء ردود
فعل متأخرة تجاه النظام النيو- ليبرالي العالمي، معطوفةً على آلياتٍ
وكوابحٍ مجيّرةً لاستئثار فاجر بالسلطة والثروة في كل قطرٍ على حدة، وأننا
بصدد ردٍّ عربيٍّ جامعٍ عليها مجتمعةً.
***
في هذا السياق الجامع، هل تشير اللحظة السورية إلى أن الأنظمة العربية
العاتية بصدد استعادة الروح أو محاولة استعادتها على نحو جدّيًّ، وأننا
بصدد مشاهدة تبدّد الربيع العربيّ وتحوّله إلى خريف ينذر بالبوار
وبالاستمرار في الانصراف عن التاريخ؟ من المفيد أن ننظر لهذا الأمر بإمعان،
دون الانخراط في مزاج حماسيّ كاد أن يكون طاغيا لدى هذه الفئة أو تلك،
ودون تملّق هذا المزاج أو ذاك، مهما بدا طاغيا في هذه اللحظة أو تلك.
قد يدلّ تأخّر الحركات الاحتجاجية السورية عن غيرها في أقطار عربية أخرى
على رهبة كانت للدولة قبل سقوط هذا الحاجز منذ أسابيع قليلة، وعلى تخوف من
سيناريو عراقي أو لبناني في سورية، وقد يدلّ على جوّ من الانعزال والتقوقع
على الذات تأتّى عن مسار التخلف والانحسار التاريخي الخلقي والعقلي لسورية
الذي قام برعاية الدولة والحزب الحاكم في العقود الأخيرة. وإنّ ردود فعل
الدول التي لم تستقرّ فيها الأوضاع بعد على وتائر ومسارات واضحة - اليمن و
ليبيا والبحرين وسورية- تشي، ليس باستعادة الروح على نحو مرض لأصحابه، بل
بمنازعات قد تطول وقد تستفحل : في ليبيا على شاكلة معدّلة لنموذج إفريقي
(ساحل العاج، إن توفرت الظروف الخارجية لذلك) أو على نموذج عراق صدام حسين
ما بعد ١٩٩١؛ في اليمن على نحو قد تكون نتائجه كارثية وقد يتخذ في بعض
المناطق صورة صومالية؛ في البحرين على صورة مفتوحة على احتمالات لا ضوابط
لها إلا الرهان على حكمة أو صفاقة الدولة من جهة، وحكمة أو تهور الحركات
ذات الطابع الطائفي.
أما في سورية، فإن الخطاب الثاني لرئيس الدولة أمام حكومته الجديدة،
والسلوك المعدل نسبياً لأجهزة الأمن تجاه مظاهرات يوم الجمعة ١٥/٤ قد يدل
على أنه قد ابتدأ باستيعاب ما هو حاصل على نحو لم يش به خطابه الأوّل أمام
ما يسمّى بمجلس الشعب. لسنا على بيّنة مما هو حاصل من خلافات أو توافقات
داخل السلطة وأجهزتها، إلا أن الأكيد والمقلق أن النظام السياسي يبدو عاجزا
بنيوياً عن تجديد نفسه وعن الإتيان بإصلاحات جديَّة.
لهذا مؤشرات بالغة الوضوح مما شهدناه في الأسبوعين الأخيرين تشي ليس فقط
بتلكؤ في فهم ما يجري، بل باستصعاب فهم عالم - سوري وعربي وعالمي- تَشَكَّل
على صورة لا يمكن استيعابها في إطار عادات خطابية مُتخشِّبة وأساليب
سلطوية تعود إلى عقود قد انطوت. تشكَّل الزمان العربي الراهن وانفتح ليس
فقط على الأزمات، بل على المستقبل، وابتدأ بالانصراف عن الدوائر المغلقة
التي حادت بنا عن مسارات التاريخ وحنطتنا في الستينات والثمانينات. إنّ
سياق العجز هذا هو ما يبلور طبيعة فهم السلطة وممارستها في سورية البعث،
وفي لبّ هذا السياق تغليب منطق السلطة على منطق الدولة. ولا يبدو أن هناك
حلا يرتجى، أو إنقاذاً لسورية من الخراب، ولا خطوات تحدّ من رفع سقف
المطالب التي تزداد راديكالية، دون قرارات جريئة على حساب الأجهزة والحزب
الحاكم.
إذا كان منطق الدولة قد تغلب على منطق السلطة في تونس وفي مصر، فإن ذلك
يعود إلى درجة أرفع من التطور الاجتماعي والسياسي (خصوصاً في تونس) الذي
سمحت به الدولتان الأكثر انفتاحا من سورية على سياق التطورات العالمية؛
والتي أُثبِتَت فيها تمايزات بين المؤسسات بما يشي بطور أرقى من التطور
الاجتماعي والسياسي. الترجمة العملية لذلك التمايز الوظيفي بين السلطة
والجيش : ذلك عماد النظام في مصر التي اسْتَنْقَذ النظام فيها نفسه عبر
التضحية بطاقم جهازه المعلن، وجعل نفسه منفتحاً على تطوراتٍ ليست حدودها
واضحة حتى الآن وذلك عماد تآلف الجيش وطاقم العهد البورقيبي في تونس في
تحالفٍ ناظمٍ لمسارات التحوّل التي ما زالت تبدو عليها البلبلة، ولا سيّما
اصطياد الجماعات الإسلامية المختلفة في المياه العكرة. أما في سوريا البعث،
فقد شهدنا في العقود الأخيرة نكوصاً تنظيمياً على صورة سلطة تتخذ موقعا
محوريا من السياسة والمجتمع، سلطة مجردة تتخذ لنفسها نظاما استتباعياً
شكَّل شبكة من المصالح السلطوية والاقتصادية، ثم اتَّخذ من الدولة ومن
الحزب الحاكم أداتين لها ولنظامها معاً.
يترتب على ذلك قيام الدولة على خدمة جهاز سلطة متشكل على شاكلة الدولة
المملوكية، مع بيوتاتها وأوجاقات عساكرها، مع اعتبار هذه البيوتات
والأوجاقات أسياد الشعب ومالكي البلد بدلا من كونهم ممثلين له. يترتب على
ذلك أن جُماع المواطنين ما هو إلا طحين اجتماعي وموضوع للرصّ والاستهلاك
والابتزاز. وعلى ذلك، فليس غريبا أن نرى السلطة السورية رافضة اعتبار
الأزمة الحالية على أنها أزمة سياسية بل قضية احتجاجات مطلبية ومصالح جزئية
خاصة بالمناطق والفئات المختلفة، وقضية أمنية تحتاج إلى معالجة تطاول
المواطنين على رؤسائهم وكبرائهم. وهي تبدو عاجزة عن استيعاب أن المطالبة
بالحرية والخبز والكرامة وسيادة القانون وكفاءة الإدارة ولجم إرهاب
المواطنين وابتزازهم من قبل الأجهزة الأمنية بل ومن أصغر موظف في الدولة
إلى أكبرهم، إلا تآمرا على السلطة ومشروع انفراط لإمكانية الاستمرار في
سياسة استباحة المواطن والوطن معاً؛ وإلّا استعادة لفترة الثمانينات التي
تجاوزها البلد ولكنها مازالت حابسة لمنطق السلطة. بعبارات أخرى- نرى السلطة
السورية عاجزة عن فهم الآتي : تشكّلت في سوريا سبل جديدة وفتحت فيها
مبادرات جديدة لمعالجة الشأن العامّ على نحو يعيد للبلد شأن السياسة، بعد
أن كانت قطاعات واسعة من الشعب قد اضطرت إلى الانصراف عن الشأن العام إلى
الانشغال بتفاصيل الحياة اليومية، وإلى العياذ العاجز بالله مما هو قائم
والانشغال بأحكام الطهارة والنفاس.
أما السلطة في الأسبوعين الأخيرين، فهي قد التفتت مجدّدا إلى أفيون أحكام
النفاس والطهارة، وهي تباشر البلد وكأنها قوة أجنبية محتلة، متخذة من نهج
الانتداب الفرنسي سبيلاً، مستدرّةً القوى الدينية ووجهاء الأحياء والمناطق
في محاولتها ضبط الأوضاع وممارسة الضبط الاجتماعي. ليس غريباً أن نجد أن
السلطة قد وجدت من المناسب أن تتملق المشايخ، وتلغي منع النقاب للمدرسات،
وتُيَسِّر إقامة محطة فضائية دينية بالغة الرجعية: ليس استرضاء أرباب الدين
أمراً قريب العهد، بل له سوابق في تسهيل إقامة المعاهد الدينية المرخصة
وغير المرخص لها، وإغراق السوق بكتب الخرافات، والسماح للمشايخ بالتدخل في
منع الكتب والنشاطات الثقافية العلمانية وهي - أي الأجهزة الأمنية- ترفض
طلباتٍ لإقامة جمعياتٍ مدافعةٍ عن العلمانية، وتنظيم مظاهرات غوغائية
وتخريبية تالياً لحادثة الكاريكاتورات الدانمركية، وغير ذلك مما هو معلوم
للجميع. وإن من المعلوم للجميع أيضاً أن هذه سياسات اجتماعية- سياسية،
نكوصيّة، قد برهنت عن كونها انتحارية، وما علينا في هذا المضمار إلا اعتبار
سياسات أنور السادات، والسعودية، وباكستان، والولايات المتحدة (وبريطانيا)
في تمكينها للقوى السياسية الإسلامية على امتداد عقود، تمكيناً ارتد عليها
جميعاً في نهاية المطاف عل صورة بالغة الدموية. على ذلك، فإن السلطة
السورية، في سياسة تمكين الدينيين على تمديد النكوص الاجتماعي والعقلي
والمعرفي في مفاصل المجتمع، إنما تعمل على خلق الجني والقمقم معاً، في نهج
عبثي على نحو بالغ الوضوح والتخبط.
لهذا النهج مكملات هي الأخرى ذات تداعيات مع سياسات فرنسا الانتدابية.
فإذا كانت السلطة السورية على الشاكلة التي وصفناها أعلاه، وإذا كان النظام
الشبكة الاستتباعية السياسية والاقتصادية للسلطة التي تتخذ من الدولة
والحزب أداتين لها (وعلى صورة شبيهة بما حصل في ليبيا القذافي)، فإن من
المكملات لنهج محاولة إفراغ الأزمة من طابعها السياسي الأكيد، أي محاولة
جعلها غير ذات أثر على التركيبة الحالية للسلطة ولنظامها، هو محاولة
استمالة من يعرفون بوجهاء القرى والمدن، مع أن الدولة والمواطنين قد جروا
في العقود الأخيرة على اعتبارهم مؤسسة سياسية قد تقادمت. وإن ما يؤكد نزع
الصفة السياسية عن هذه العملية هو أن هؤلاء الوجهاء ليسوا مدعوّين للإقبال
على عملية سياسية بين قوى سياسية - إذ هم لا يمثلون أحداً تمثيلاً سياسياً
في مجال سياسي عام- بل هم مدعوّون لتقديم التماسات إلى سلطة يمثلها رأسها،
رئيس الجمهورية، وعناصرها من ضباط الأمن، في التفاف واضح عن مجال السياسة
إلى مجال الاستتباع والصلح العشائري. وإن ما يكمل هذا النهج هو الالتفاف
على الرأي العام المسيس والحداثي، المنظم في بعض مجالاته، مما يمعن في
محاولة نزع الصفة السياسية - وهو نفي سياسي بامتياز- من قبل اللاعب السياسي
الأوحد الذي هو السلطة التي ترى الجمهور هلاماً أو أفراداً، والتي لا ترى
من عناصر تماسكه، ولا تريد أن ترى من عناصر تماسكه، إلا أولياءه : كبار
العشائر والأسر. رأينا ذلك في اللقاءات مع أعيان دوما ودرعا وغيرهما،
ورأيناه من الاجتماعات مع أعيان السوريين ذوي الأصول الكردية في الجزيرة
(برعاية، عشائرية هي الأخرى، وبتدبير من جلال الطالباني الذي مازال يترأس
حزباً هو، كالبعث، كانت له في سابق الدهر والأوان تطلعات تقدمية). وإن
السلطة لا شك ترى في الآغا خان ضامناً للإسماعيليين، وأن المسيحيين بخير
(على الرغم من محاولاتها تقديم الجنرال ميشيل عون على أنه زعيم المسيحيين
في المشرق)، وقد يكون ما هي فاعلة مشجعاً على بوادر ما نراه من بيانات
لفئات كالتنظيم الآرامي الديمقراطي الذي يتكلم عن الشعب الآرامي باعتباره
شعبا مسيحيا والذي يشدد على التعددية القومية والثقافية والدينية في سورية -
ولعل في الكلام عن شعب آرامي مسيحي أو فينيقي مسيحي شيئا من استلهام
مزاوجة العروبة بالإسلام. شدد على ذلك أيضا بيان موقّع منذ أسبوعين من قبل
بعض المثقفين السوريين الذين كنا نتمنى عليهم إيثار قدر أكبر من الحكمة
السياسية بإزاء وضع مفتوح على احتمالات غير محمودة، احتمالات يشي بها أيضا
ما تقوله فئات من الأكراد السوريين الذين شكلوا منذ زمن طويل جزءاً من
النسيج الاجتماعي والسياسي لسورية، والذين جنح البعض منهم في السنين
الأخيرة إلى إيثار النسب على الحسب، وأرومة الدم على الواقع المعاش،
والاعتبار الكردي على الاعتبار السوري.
ومادمنا في سياق الكلام حول الأعراق والعشائر والطوائف والتخندق فيها
واستتباعها، ينبغي عليّ القول بأنني ما ذهبت أبداً إلى الرأي القائل بأن
سورية دولة علوية – كما لم اذهب في الماضي إلى الرأي القائل أن عراق صدام
حسين كان دولةً سنيةً. إن سورية دولة وطنية اختزلت إلى سلطة تستتبع شبكة من
البيوتات والمصالح، وفي هذه التركيبة أولوية لسوريين ذوي أصول علوية.
ولكنه ليس باستطاعتنا القول إن الطائفة العلوية كطائفة هي الحاكمة. تمصّر
علويّو سوريا كغيرهم في العقود الأخيرة، واندمجوا في النسيج المديني إلى
حدّ كبير، وتزاوجوا مع الدمشقيين والحلبيين والحماصنة وأنتجوا مثقفين مثل
سعد الله ونوس ولؤي حسين. وإن رأينا أفرادا علويين منتفعين من بنية السلطة
بنسب أعلى من غيرهم في بعض المجالات، فإن هذا لا ينسحب على العلويين
كعلويين، فإن أفراد الطائفة متباينون اجتماعياً، منهم النمرود ومنهم
المسكين، وإن من استصفي منهم داخل شبكة الاستتباع قد استثنى آخرين خصوصا
بعد تصفية نظام ٢۳ شباط، وبعد تصفية شبكات رفعت الأسد.
إن القول أن طائفة تحكم يستند إلى مفاهيم عامية لا سند لها قي علم
الاجتماع السياسي- ثم إنه لأمر مشهود أن الشبكة الاستتباعية للسلطة لا
تقتصر على العلويين بل هي مشتملة أيضاً على سنّة ومسيحيين وغيرهم. ولكن على
الرغم من ذلك، فإن الوضع السوري يشكو من تنامي الشعور الطائفي لدى كل
الفئات، وهذا شأن يعود إلى الاختناق وإلى الاستئثار وانسداد الأفق والتفجر
الذي نراه - وكل ذلك من صنع السلطة - وهو عائد أيضا لأسباب تتعلق بتحول
الجغرافية البشرية لحواضر سوريةً كثيرةً لعل أهمها مدن الساحل وبعض أرياف
حمص.
وعلى ذلك، فإذا كان للسلطة السورية استباق ما قد يستفحل، عليها أن تستوعب
الطابع السياسي للوضع بدلا من استسهال الاعتبار الأهلي. إن الانفجارات التي
نشهد - على الفقر والتحوّط النسبيين لمحتواها المعلن - لا تدل على أن
النعرات الطائفية تشكل إطارها الناظم، بل هي مشددة على وحدة الجسم السياسي
المرجو. ولقد سبقالسوريون الموجودون في الشوارع السلطة إلى إعادة الاتصال
بالزمنين العربي والعالمي، ولا أعتقد أنه سيسمح للسلطة بالاستمرار في
الاعتقاد أنها خارج هذا الجوّ وخارج الزمن. ولكن الإمعان في التخندق وفي
استدرار الحلول المستسهلة القائمة على سبل الاستتباع الاجتماعي والنفعي
بدلاً من سبيل السياسة فما من أمرها إلا أن تحوّل الوسطيين إلى مناوئين،
وتحوّل الاختناق إلى تفجّر وإلى مزاج عامي انتقامي متهوّر يرى أن السياسة
تُصْنَع من الشارع وليس في مجال السياسة. وفي هذا ما يبعث على القلق
البالغ. ليس إلغاء حالة الطوارئ في ذاته شأنا كافيا للإصلاح، إن لم يقترن
أوّلاً وبسرعة بإعادة الاعتبار للجهاز القضائي الذي اهترأ، وجعله قوام
المرحلة المقبلة.
إذا كان الوضع السوري على هذا التعقيد، ينبغي التنبّه إلى أمرين أساسيين.
يتناول الأمر الأول التفاؤل الساذج : التفاؤل الرومانسي الغنائي الذي يجد
في هدير الجماهير علامة على حتمية خلاص له التمام. أو يجد في هبّات
وانتفاضات متعددة ومتباينة المكونات والأهداف والظروف "ثورةً عربيةً"، أو
يجد في الديمقراطية نظاما خلاصياً وطلسماً شافياً ومهرجاناً وبهجةً
مستديمةً. ولا يخفى أن هذا المزاج ينظر لبهجة الديمقراطية وجنّتها على أنها
أيضاً تعدّد مُرسل للأفراد والثقافات والأعراق والطوائف على نحو رسمته
بكثافة المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية ومدارس إدارة الأعمال
وعضلاتية حروب جورج بوش ويوتوبيا الإنترنت وغنائية العنصر الشبابي. ولكنه
مزاج هو - بدوره- نافٍ للسياسة ومنطوٍ على قدر كبير من النظرة العدمية تجاه
الدولة : الدولة التي - على علّاتها وترهلها واستتباعها للسلطة- تبقى
الجامع الأساسي للمواطنة والمواطنين بغض النظر عن الأصول والدم، وإنجازاً
تاريخياً غير قابل للمفاوضة.
أما الأمر الثاني، فهو الإسلام السياسي. ليس خافياً على أحد أن السيناريو
المثالي لحلّ الأزمات العربية لدى الولايات المتحدة وغيرها هو تحالف عسكري-
إسلامي ضابط للأمن والمجتمع معاً، مع اضطراب بيّنٍ تالٍ للهجوم على برجي
نيويورك، اضطراب أذكاه الإسلام السياسي بوصفه فزّاعة حملتها الأنظمة
العربية. والحال أن التخوف ليس مقتصراً على القوى الأجنبية، بل هو متوطن
لدينا دولاً وأفراداً. إن تمدد الإسلام السياسي والتدين اليومي لدى قطاعات
واسعة من الشعوب العربية - وهو أمر غير مقتصر على المسلمين - شأنٌ آيلٌ عن
انسداد السبل وتقطع أسباب حماية النفس والمال والكرامة، وإزالة السياسة من
المجال العام، وإضعاف وسائل الحماية الفردية والاجتماعية في مواجهة سلطات
عاتية، جائعة العين على الدوام، تلك السبل التي وفّرتها فيما مضى الأحزاب
والنقابات والمنظمات الأهلية. وإن عودة الإسلام السياسي إلى البروز، وفي
مصر على سبيل المثال (وفي تونس إلى درجة أقل، رغم أن المجتمع التونسي،
بجهازه السياسي القديم الذي كان بن علي دخيلاً عليه، وبحراكه المدني المنظم
والأقل تنظيماً، يشي بتطور اجتماعي غير قابل للردّ وفّرته الهندسة
الاجتماعية البورقيبية)، ركوباً على موجات الانتفاضات التي تمت، هو المقابل
السياسي لانسداد الآفاق السياسية الذي ترتجي السلطة الاستناد إليه.
أما في سوريا، فإن تأسلم قطاعات كبيرة من الشعب بسبب انسداد الآفاق الذي
سبق الكلام عليه، وإفقار الثقافة، يشي بمسار معقّد، ولو أننا على الاعتقاد
الجازم بخطأ النظرة العامية المحببة إلى كثير من المثقفين، والذاهبة إلى
أنّ كل مسلمٍ، بالسليقة، إسلاميّ الهوى في السياسة. فالمسلم مسلم، أما
الإسلامي فهو ملتزم إما بالإسلام السياسي أو بمكملاته المجتمعية من أسلمة
المجال العام والأخلاق والسلوكيات الفردية والنظام القضائي بل والدولة.
يؤثر الكثير منّا، باسم بهجة الديمقراطية، عدم التنبه إلى هذا الأمر،
وتأجيل الحديث فيه باسم الكتلة التاريخية الجامعة وما يضارعها من العبارات -
ومن هذا عدم مساءلة الناس توقيت التظاهر بمواقيت الصلاة، رغم أن أيام
الجمعة مناسبة للتظاهر في أي وقت ولسنا على قناعة بأن التدين الاستعراضي
ناظم مناسب للحراك السياسي. علينا النظر بشيء من الحصافة والإحكام إلى ما
هو قد بدأ بالتفتح من إمكانيات، ليست كلها بهيجةً. إن محاولة الاستئثار
بنتائج تفتح المزاج الديمقراطي من قبل قوى معادية للديمقراطية إيديولوجياً
وثقافياً واجتماعياً، متعددة الألسن، مطبوعة على المراوغة - وهي محاولة لا
بدّ أنها آتية، وذلك حكم على النوايا، إذ ما من موقف سياسي عاقل لا ينطوي
على حكمٍ على النوايا- أمر ينبغي التنبه إليه الآن في سياق التركيبات
المتنامية البالغة التعقيد، وذلك درءاً لتبدد ما ابتدأ بالحصول، ودرءاً لما
ينطوي عليه طموح الإسلام السياسي من محاولة لمعاودة إغلاق التاريخ علينا.
ليس مستبعداً أن تكون منظمات أصولية مسلّحة ناشطة في تضاعيف التظاهرات
القائمة في سورية، ولكن هذه المنظمات ليست تلك التي يُخشى منها بنيوياً.
وإن صح هذا، فإنه ليس مؤشراً إيجابياً على كفاءة المقدرة الأمنية لدولة
الأمن.
وأخيراً، علينا التنبه إلى أن الحرية ليست قيمة مجردة وليست هي فوضى
وتَنَادي الأصوات المتعددة البهيجة التعدّد، ولا قيمة تاريخية لها في هذا
الظرف بالذات إلا تطلعها نحو التقدم والترقي. أما إذا فهمت على أنها الفرصة
لاستصلاح مهملات التاريخ، وهي هكذا تفهم من قبل الإسلام السياسي الذي ما
فتئ يحاول إغراقنا في "الأصالة" إنقاذاً لنا من مفاتن التقدم وموبقاته،
فإنها لا تعدو أن تصبح إلا المكمل للخروج عن التاريخ الذي رعته السلطات،
والذي ترعاه كما يبدو، السلطة في سورية في توسلها الأعيان والعشائر، والذي -
أخيراً- قد لا تتنبه إليه بعض فئات الخارجين على السلطة والقائمين ضدها
باسم حرية مرسلة لا رابط لها مع ما هو ممكن، وما هو متاح، وما قد يقوم
باسمها ويراوغها على السيادة ويراودها على سيادته. إذا كان للوضع في سوريا
أن يستقر على بدايات عملية سياسية جديّة، تعيد الاعتبار للجسم السياسي
للسوريين، بدلاً من أن يفضي إلى تفجّرٍ أو إلى هدوءٍ طاغٍ يمهد لخرابٍ
مؤجلٍ، فإن ذلك سيكون وضعاً يسمح ببروز سيّدات ورجال دولةٍ وقادةٍ من عيارٍ
محترم للاجتياز بالبلد إلى السلامة استناداً إلى تبصر المصلحة الوطنية
العامة بدلاً من الانغلاق على اللحظة الراهنة بمكونيها الأساسيين،
الاعتبارات الآنية للسلطة من جهة، والتغني بالهدير وكأنه هديل من جهة
ثانية. وفي جميع الأحوال، فإن القيادة من هذا العيار ستكون قيادة من
الأمام: أما القيادة من الخلف أي الارتهان لما هو راهن من مزاج السلطة أو
مزاج الجمهور، فإنه لن يؤدي إلّا إلى طريقٍ مسدودٍ ينتج عناصرَ متفجرةً
متعاظمة المدى والصدى.


