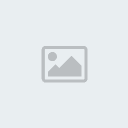
صدر مؤخرا عن دار بترا بدمشق، ورابطة العقلانيين العرب، كتاب " ضد التوفيقية " للكاتب والباحث محمد كامل الخطيب. يقع الكتاب في | 122 | صفحة من القطع المتوسط. وبذلك بتابع الكاتب إصدار كتبه بطريقة لا تخلو من دلالة حيث يستمر منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين إصدار العديد من الكتب الصغيرة بحجمها لكن الغنية بمواضيعها وأفكارها وموادها التوثيقية، تحت عنوان " دراسات فكرية ". هذا عدا عن إشرافه لسنوات سابقة 2005 – 2007 على إصدار كتاب شهري بذات الطريقة بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة السورية، وصحيفة البعث السورية، حيث كان يختار كتبا متنوعة في الفكر والأدب والتاريخ لكتاب كبار، عالميين وعرب بالإضافة إلى سلسلة الكتاب الشهري " آفاق ثقافية " الصادرة عن وزارة الثقافة التي بدأها وكان يشرف عليها ويختار كتبها منذ عام 2003 وحتى 2008. وكأنّ هاجسه الرئيس في ذلك، على طريقة الموسوعيين الفرنسيين في القرن الثامن عشر، تعميم الثقافة الجادة، لاسيما العقلانية والتنويرية منها، على أوسع نطاق بين الناس، حيث يمكن اقتناء هذه الكتب بيسر وسهولة وقراءتها حتى في وسائط النقل العام أثناء السفر الطويل. بل يمكن دعم فكرتنا تلك بالإشارة إلى جهده الطويل عندما كان يشرف على إعداد وتحرير وتقديم مشروع سلسلة قضايا وحوارات النهضة العربية، التي صدر أغلبها عن وزارة الثقافة السورية، بين عامي 1992 - 2005. وأهمية ذلك تكمن في إعادة تبويب وتقديم شخصيات وأفكار عصر النهضة العربي تحت عناوين رئيسة وأساسية وحسب تسلسلها الزمني، في مختلف قضايا الفكر والثقافة والفنون والمجتمع كمرجعية جديدة جامعة للدارس والباحث والقارئ في فكر وأحوال عصر النهضة العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العقود الأولى من القرن العشرين عندما كان الحوار الفكري والخلاف على أشده ضمن جماعة الإصلاح والنهضة بين تيارين أساسيين، حول الموقف من القديم والحديث، التقليد والحداثة، وبالتالي في الموقف من الغرب المتقدم الذي كانت تصلنا منه إشعاعات الحداثة الأولى منذ منتصف القرن الثامن عشر. وهذان التياران هما: تيار الفكر الوسطي التوفيقي. وتيار الفكر العقلاني ( الراديكالي )، أو ما يسميه الكاتب نقلا عن ( يوسف أسعد داغر ) في موسوعته " مصادر الدراسة الأدبية " بـ" مدرسة التحرر الكامل ". من هنا نفهم اهتمام الكاتب بموضوعه هذا، كثمرة بحث طويل في فكر عصر النهضة العربي. ورغبته ليس فقط، في تسليط الضوء من جديد، على إشكالية نهضوية قد يبدو للبعض أنها انتهت، بل في محاولة إحيائها من جديد عبر تبني موقف واضح وهو " ضد التوفيقية ". فالتوفيقية هي رأي ذلك التيار الذي يرى بضرورة الأخذ من الحداثة الغربية ما يناسبنا ويفيدنا ولا يؤثر سلبا على هويتنا وثقافتنا المتمثلة بمعتقداتنا الدينية ومجمل تراثنا التاريخي، ونبذ ما عدا ذلك ، وذلك يعني الاستفادة من التكنولوجيا الغربية مع نبذ الفكر ومجمل السياق التاريخي اللذين أنتجاها. أي أنه تيار تسووي توفيقي يحاول الجمع بين القديم والجديد بين التقليد والحداثة، لكنه في النهاية يكرس العقم المجتمعي عبر محاولته الجمع بين كل أسباب التأخر، مع بعض نتائج ومظاهر وسلع الحداثة والتقدم دون الأخذ بأسبابها الحقيقية. أما التيار الراديكالي فيرى أنه لا إصلاح حقيقي ولا نهضة أو تقدم إلا عبر الأخذ بكل أسباب ومقدمات عصور النهضة الأوروبية الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فتسمية " الحداثة الغربية " جاءت نسبة للمكان الجغرافي الذي نشأت وظهرت فيه إلا أنّها في عمقها الحقيقي هي شكل من أشكال الحضارة الإنسانية في أعلى مراحلها تقدما حتى اليوم. وقد شاركت جميع الحضارات الإنسانية السابقة عبر التاريخ في الوصول إلى مقدماتها المباشرة التي بدأت منذ القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. ومن بينها كما هو معروف تاريخيا الحضارة العربية الإسلامية في القرون الوسطى.
الجذر الفلسفي لإشكالية الفكر الوسطي التوفيقي:
يؤسس الكاتب لموضوعه وفكرته بخصوص ( التوفيقية ) بإضاءة هامة ومكثفة عن الجذر الفلسفي للفكر الوسطي التوفيقي الذي بدأ مع الفيلسوف اليهودي " فيلون الإسكندري " ( 25 ق . م – 50 ب . م ) ( الذي حاول التوفيق بين الديانة اليهودية والفلسفة اليونانية الوافدة مع سيطرة الاسكندر المقدوني الحامل الأول للثقافة ( الهلينية ) وفلسفتها ) مما أدى إلى نشوء مرحلة الثقافة الهلنستية الناتجة عن لقاء فلسفة اليونان مع ثقافة شعوب الشرق الأوسط آنذاك، فنشأت على إثر ذلك ( مدرسة الاسكندرية ) كأهم مدرسة فلسفية في المرحلة الهلنستية تلك، والتي أنجبت بدورها الفيلسوف المصري الثاني وهو " أفلوطين " ( 205 – 270 ) كأهم أعلامها، حيث تابع طريقة " فيلون " في التوفيق بين الدين والفلسفة، لكن على أرضية جديدة وهي ظهور المسيحية كديانة بشرية جديدة آنذاك. فكانت محاولة أفلوطين تلك هي المحاولة الثانية في التوفيق بين ( الفلسفة اليونانية ومنطقها الصارم وعقلانيتها وبين أديان الشرق واعتقاداته الصوفية والغيبية ). فظهرت إثر ذلك " الافلاطونية المحدثة " كتيار فلسفي كبير أسر التفكير الفلسفي طويلا، حتى أواخر العصور الوسطى، في إشكالية التوفيق بين الدين والفلسفة في أوروبا بعد انتشار المسيحية فيها، كما في ثقافات ومعتقدات شعوب المنطقة الهلنستية. ومن الطبيعي أن تنتقل العدوى إلى المنطقة العربية الإسلامية بعد انتشار الإسلام واللغة العربية وتمكنهما، ومن ثم نقل " علوم الأوائل " أي الفلسفة اليونانية وترجمتها إلى اللغة العربية، في البداية، عبر مصدر رئيس هو " مدرسة الإسكندرية " وكتب فلاسفة الافلاطونية المحدثة وتلامذتهم. فدخل التفكير الفلسفي العربي الإسلامي منذ بداياته تلك، ضمن دائرة الأسر لإشكالية التوفيق بين الدين والفلسفة لكن على أرضية الدين الإسلامي، الذي ظهر فيه فقهاء حاربوا الفلسفة محاربة شديدة وكفروا أصحابها ومريديها. وكان ذلك أحد الأسباب التي أعاقت تطور الفلسفة العربية الإسلامية ووصولها إلى مرحلة تستطيع من خلالها تجاوز إشكالية التوفيق بين الدين والفلسفة. فتوقف التفكير الفلسفي العربي لدى ابن رشد كأخر فيلسوف عربي حتى اليوم، وأكبر ممثل للمنطق الأرسطي في العصر الوسيط العربي عند مسألة ( فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من " اتصال " ). بالرغم من ظهور حالة فردية خاصة مثلها ( أبو سليمان المنطقي – القرن الرابع الهجري )، حيث يقول كما يروي عنه تلميذه ( أبو حيان التوحيدي ) قي " الإمتاع والمؤانسة ": " إن الفلسفة حق، لكنها ليست في الشريعة من شيء، والشريعة حق لكنها ليست في الفلسفة من شيء ". وبالتالي لا جدوى من محاولة الجمع أو التوفيق بينهما.
التوفيقية في عصر النهضة العربي : المشكلة الحقيقية بالنسبة للتفكير الفلسفي العربي تتلخص بأنه في الوقت الذي بدأ فيه الفكر الفلسفي الأوروبي يكسر جدران هذا الأسر بتجاوزه لهذه الإشكالية، باعتماده طريقة جديدة في التفكير تعتمد مبدأ ( العقل والملاحظة والتجريب )، وتنقل مركز التفكير الفلسفي: من ماوراء الطبيعة إلى الطبيعة، من السماء إلى الأرض، من الله إلى الإنسان. وكانت بذلك تؤسس لتطور كل العلوم اللاحقة وتقدمها المبهر حتى اليوم فإن التفكير الفلسفي العربي بقي أسير هذه الإشكالية، ليس هذا فحسب بل إنه منذ القرن السادس الهجري | الثاني عش الميلادي، تجمد هذا التفكير وخفت صداه، حيث أخفقت المحاولة الأولى لتبيئة الفلسفة وتفكيرها في المناخ الثقافي والاجتماعي العربيين لأسباب عديدة أهمها بدء تحلل الإمبراطورية العربية الإسلامية مع تزايد الأطماع الخارجية الأمر الذي ساعد أيضا على ترجيح كفة فتاوى الفقهاء المتشددين ضد الفلسفة وطغيان دورهم في توجيه الناس والمجتمع قرونا عديدة، حتى مطالع عصر النهضة العربية التي ولدت بتأثير صدمة اللقاء بحداثة الغرب المتقدم. تقدّم في مستويين، مستوى الاحتلال العسكري المباشر" الحملة الفرنسية " وما تبعها من احتلالات متلاحقة، ومستوى الطالب الموفد للدراسة في الغرب، ( الشيخ رفاعة الطهطاوي )، وما تبعه من طلبة العلم حتى اليوم. وهذا ما أسس للحظة مزدوجة في العلاقة مع الغرب، انبهار شديد يتضمن الإعجاب، وحساسية عداوة مستمرة حتى اليوم. فإذا كان لا يمكن قبول الغرب كليا ، كذلك لا يجوز رفضه بالمطلق. وهنا يكمن جذر النظرة الوسطية وتيار الفكر التوفيقي في بدايات عصر النهضة العربي.
لكن إذا كان لهذه النظرة ما يبررها في لحظة تأسيسية مزدوجة كانت تتضمن موقفا متقدما ( اكتشاف الآخر المغاير )، كما تبدت في كتاب الشيخ رفاعة الطهطاوي " تخليص الإبريز في تلخيص باريس " الذي يدعو فيه إلى أخذ " العلوم الاستعمالية البرانية من الغرب "أي التكنولوجيا، مع الإبقاء على " العلوم الجوانية للشرق " أي المعتقد. فإنها كانت بحاجة إلى تطوير وتجاوز نحو الأمام وليس إلى ( تكرار أو تجميد أو تأبيد أو تنظير ). وهذا ماحدث لها فعلا، وأدى إلى استفحال الفكر الوسطي التوفيقي لاحقا حتى عند أهم أقطاب وممثلي الثقافة العربية، ليس فقط في الجانب الليبرالي فقط، بل أيضا عند العديد من مثقفي اليسار. ففي ثلاثينات القرن العشرين ( توجه المثقفون العرب بسؤالهم إلى الماضي فظهرت كتابات محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد وأحمد أمين وجميل صليبا وغيرهم حول التراث وموضوعاته وشخصياته ). وتكرر الأمر خلال عقد السبعينات من القرن العشرين الذي شهد ( طوفان الكتب التراثية )، عند الجميع، ليبراليين وماركسيين وسلفيين ( طيب تيزيني، أدونيس، زكي نجيب محمود، حسن حنفي، حسن مروة، محمد عابد الجابري، محمد أركون، محمد شحرور وغيرهم ). لكن في الحالين لم يكن سؤال الماضي بعيدا عن سؤال الحاضر. ( فالإنسان لا يطرح على نفسه إلا الأسئلة التي يحتاج إلى أجوبتها في حياته وراهنه ) ففي ثلاثينات القرن العشرين كان سؤال الماضي يعني تصفية حساب فكرية لطبقة برجوازية تتكون بتأثير الغرب ومساعدته، منطلقة من رحم طبقة ملاكي أراضي ريفية ساكنين في المدن، ( وتعبر عنها ليبرالية فكرية وسياسية في طور التشكل. وكانت بحاجة لتملك واقعها عبر تملك تاريخها معرفيا – وربما من هنا نفهم تلك النزعة العقلانية المعتزلية لدى أحمد أمين وطه حسين ومحمد حسين هيكل في أبحاثهم التراثية ). أما في فترة السبعينات فإن الإخفاق الذي أصاب الجميع على خلفية هزيمة حزيران 1967، يسار ويمين، طبقات برجوازية ووسطى، وأنظمة سياسية ( ثورية وتقدمية ) لكنها في حقيقتها وسطية تلفيقية. هو ما أسس للعودة من جديد إلى التراث والتوفيقية ( وكأنها لحظة استعادية وتمجيدية للحظة الأولى الثلاثينات، مما أسس وفتح الباب واسعا أمام الأفكار السلفية من جديد، وفي جانبها العنفي والإرهابي منذ ثمانينات القرن العشرين وإلى الآن ). وهكذا نجح السلفيون في جذب الطرف الأخر إلى ميدانهم وبحثهم المفضل، وبمساعدة الدور الذي لعبته أموال الفورة النفطية آنذاك. هكذا تبدو التوفيقية في الفكر العربي الحديث تعبيرا عن إشكالية أو أزمة راهنة في المجتمع لا يمكن القطع مع أسبابها البنيوية والتاريخية وبالتالي تجاوزها نحو آفاق مستقبلية صحيحة وواعدة. فتنشأ الحاجة للوسطية والتوفيق فالتلفيق الذي يوصل في النهاية على أرضية السلفية، إلى مصالحة قوية مع الماضي ليس التراثي فحسب بل الإثني والطائفي فالارهاب والحروب الأهلية. وإذا كان للتوفيقية ما يبررها فلسفيا في التاريخ القديم والوسيط وحتى في بدايات عصر النهضة العربي بحكم ظهور متضادات مجتمعية جديدة تستدعي الحكمة العقلية النظر العقلي فيها والتوفيق فيما بينها حتى يتم تجاوزها مجتمعيا ومعرفيا. إلا أنه من الخطأ الكبير تأبيد لحظتها المجتمعية وبالتالي رفعها إلى مستوى النظرية الدائمة والخالدة. كما حدث ويحدث في الفكر العربي الحديث والمعاصر.
لكن إلى جانب ذلك بقي تيار " مدرسة التحرر الكامل " في الفكر العربي الحديث موجودا ومستمرا بدأ من فرانسيس مراش في القرن التاسع عشر مرورا بشبلي شميل وفرح أنطون وسلامة موسى وإسماعيل أدهم وسليم خياطة، فصادق جلال العظم وفؤاد زكريا وعبدالله العروي وجورج طرابيشي، ومجموعة ( رابطة العقلانيين العرب )، وكأنه استمرار لمن اعتبروا في الفكر العربي القديم ( ملاحدة الإسلام ) كالمعري وابن الراوندي والرازي وأبي حيان التوحيدي. لذلك فقد حوربت هذه المدرسة وما زالت تحارب، لدرجة بقيت فيها ( والحق يقال – طائفة من المثقفين صغيرة شبه منسية، أقلية قليلة العدد وضعيفة التاُثير في المجتمع والثقافة العربيين ) الذي تتحكم فيهما تيار السلفية والوسطية بطبعاته القديمة والجديدة.
من جهتنا نختم بالقول أن الفلسفة تبقى حاجة بشرية دائمة في كل المجتمعات والأزمان، بحكم كونها طريقة في التفكير العقلاني، يمارس من خلالها الذهن البشري تمرينا مستمرا في البحث عن أجوبة مستمرة لأسئلة دائمة، فحياة الإنسان على هذا الكوكب، بحد ذاتها سؤال دائم. وعبر التفكير الفلسفي هذا وفي سياق البحث عن أجوبة، يستطيع الإنسان تكوين " رؤية للعالم " يستطيع من خلالها التبصر وبناء وجهات نظر متعددة في الحياة والموت والعلاقات البشرية، حتى في أدق تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي في استشراف أفق مستقبل جديد. وفي حال غيابها تخسر هذه المجتمعات والإنسان فيها إمكانية التفكير في المستقبل ويضيعان في مسالك التفكير الماورائي والظلامي كما حدث ويحدث في مجتمعاتنا العربية بسبب ضعف وتهميش دور الفلسفة وتكفير روادها منذ القرن الثالث العشر الميلادي وحتى اليوم رغم أن الفكر العربي الحديث أنتج أساتذة وشراحا كبارا في الفلسفة لكنهم لم يستطيعوا تبيئة الفلسفة عربيا، فظلّ دورها غائبا.


