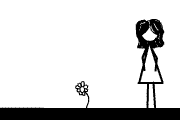قدّم المفكّر المصري ناصر حامد أبو زيد قراءة تأويليّة نقديّة للطّريقة الّتي أسّس بها الإمام الشافعي نظريته في الدَّلالة في أصول الفقه. وقد رمى هذا الأخير من ذلك إبراز الطّابع النسبيّ لهذا التّأسيس، وذلك بالكشف عن الجوانب الإيديولوجيّة، وكذا الاعتبارات التاريخيّة والثقافيّة الثاوية خلف تأسيس هذا المنظّر الكلاسيكيّ لأصول الفقه. وإذ نقدّم بعض خصائص القراءة التأويليّة لنصر حامد أبو زيد، بخصوص مسألة تأسيس الأيديولوجيا الوسطيّة في أصول فقه الإمام الشافعي، فإنّنا نبتغي في المقام الأوّل إبراز الطّابع النسبيّ لمحورة الدّلالة الأصوليّة على المسألة اللغويّة، وإلاّ كان ذلك نوعا من تحوير الطّابع النّقدي لهذه المحاولة التأويليّة الفريدة من نوعها.
استثمر أبو زيد المنهجيّة التأويليّة الحديثة، المُتوسّلة بالآليات الدلاليّة والهرمنوطقيّة في قراءة النّصوص التراثيّة، لإبراز دور الشافعي في تأسيس الأيديولوجيا الوَسَطِيّة من خلال مفهومه للدّلالة الأصوليّة. وقد ركّز على المنهجيّة النقديّة في قراءة نموذج الشافعي في تأسيس الدّلالة في كتابه الموسوم: “الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطيّة”، الصّادر عن مكتبة مدبولي في نسخة ثانية مزيدة ومنقّحة. وهي النّشرة الّتي اعتمدنها في هذه القراءة نظرا لكونها مصدّرة بمقدّمة طويلة يردّ فيها المؤلّّف على بعض المنتقدين لطريقته في التّعاطي مع المسألة الدينيّة عموما والأصوليّة خصوصا.[1] ينطلق أبو زيد، في معرض تحليله لطريقة الشافعي في محورة النّص على الدّلالة اللّغويّة، من دعوى عامّة ملخّصها كالآتي:
يَعُدُّ نموذج الشافعي في أصول الفقه تأسيسا أيديولوجيا لحصر دلالة النّصوص الدينيّة على ما يسمح به لغويا من دلالات لها ما يقابلها من معاني وتفسيرات في الأحاديث والآثار السنيّة. وهكذا، مصداقا لذلك، يصعب على من يريد أن يتحرّر من عقال هذا الرّبط (بين دلالة النّص والتّفسير اللّغويّ وحجيّة الحديث) أن يتجنّب المسألة اللسانيّة والإشكالات المرتبطة بها المستثمرة في القول بأنّ العلم هو فقط علم بالنّص وفقا لقواعد اللّغة العربيّة والحديث دون إمكان فتح الدّلالة على آفاق أخرى اجتماعيّة وتاريخيّة.[2] ولفضح تقنّع هذا التصوّر الأصولي، اعتمد أبو زيد على ما أطلقنا عليه الحجّة التأويليّة. فما فحوى هذه الحجّة؟ وكيف استعملها لنقد تصوّر الشافعي للدّلالة؟
لئن عرف ناصر حامد أبو زيد بتقديمه للمنهجيّة التأويليّة على باقي المقاربات التّقليديّة في التّعاطي مع النّصوص الدينيّة والتراثيّة، فذلك يرجع إلى إيمانه بأهميّة الهرمنوطيقا في الفهم والنّقد، اعتبارا من كونها نظريّة تهتمّ بعمليات الفهم والشّرح التّأويل الديني والتّفسير.[3] ساهم هذا الاعتقاد لدى هذا الأخير على اعتماد المقاربة التأويليّة للّتعاطي مع النّصوص الدينيّة، نعتبر هذه العمليّة نوعا الحجج النقديّة الّتي يترافع بها هذا الأخير بخصوص إمكان توسيع أفق فهم النّصوص. أطلقنا على ذلك “حجّة التّأويل” القائمة على خلفيّة إبستيمولوجيّة ترى أنّ التّفسير مجرّد آلية محدودة في التّعاطي مع المعارف الدينيّة قد تفيد في قراءة النّصوص اللّغويّة، لكنّها محدودة عندما نريد توسيع دائرة فهمنا للنّصوص الدينيّة وغير الدينيّة. لذلك، فالتّأويل أعمّ من التّفسير في رأي أبو زيد لأنّه يصلح لفهم التّاريخ والتراث والنّصوص بشكل أرحب، ولا يقتصر على مجرّد النّصوص اللّغويّة المكتوبة.[4] استثمر هذا الأخير حجّة التّأويل للقول بإمكان الوصول إلى اكتشاف تلك الوحدة الّتي تشكّل بنية العلاقات الموجودة في مختلف مجالات التراث الدينيّ المعرفيّة والثّقافيّة والتاريخيّة للإسلام (الفقه، الأصول، الحديث، النّحو…).[5] لكن لماذا يشدّد هذا الإمام على البيان العربي في الفهم والعلم بالأصول؟ ولماذا يعتبر اللّغة العربيّة أكثر اتّساعا ممّا يظّن بها، حيث يستوجب اعتبارها منبع طرق الدّلالة في النّصوص الدينيّة الإسلاميّة كلّها؟ ثمّ كيف ساعد هذا التّصور أصحاب الحديث وبعض الأصوليين على رفض الطّرق الأخرى للدّلالة، كالدّلالة العقليّة والكلاميّة، مقتصرين على الدّلالة النّصيّة واللّفظيَّة؟ يبدأ فهم تأسيس علم الأصول عند الشافعي بالكيفيّة الّتي يوازي بها هذا الأخير العلم بالقرآن، والسنة باللّسان العربيّ؛ بالتّالي معرفة النّص الدينيّ لا تتأتّى إلاّ لمن له معرفة وإلمام بالبيان العربيّ مادام هو مبنى هذا النّص. إنّ من يبلغ المعنى الحقيقي للنّصوص الدينيّة، هو دوما من يمتلك القدرة على الجمع بين الدَّلالة النّصيّة والدلالة الشرعيّة، أي الفقيه بالمعنى الكلاسيكي. وإذا كانت اللّغة بهذا الاتّساع الدَّلاليّ، فإنّه يترتّب عن ذلك، أنّه لا يمكن للإنسان المجتهد للنّصوص الدينيَّة.
ترتّب عن هذه القناعة لدى الشافعي أنّ لغة القرآن هي أوسع الألسن على الإطلاق، وهذا ما يجعل القرآن، بما هو تجسيد لإعجاز البياني، صعب الدّلالة معجز اللّفظ، الشَّيء الّذي حذا بالشافعي ليعتبر السنّة دالّة على القرآن ومبيّنة له، ولها مشروعيّة كبرى في فكّ رموزه الدلاليّة، فهي تجعل المستحيل بيانيا يمكن تأويله وتفسيره بالسنّة.
وفقا لهذا الرّبط الدّلاليّ القائم بين نصّ القرآن ونصّ الحديث، تكتسب السنّة مشروعيتها ليس فقط في كشف دلالة القرآن، بل في تشكيل الدّلالة الأصوليّة أيضا. وقد كان غرض الرّسالة عند الشافعي وضع منهج أصولي يمكن اعتباره أساس علم يختصّ بدراسة أصول الدّلالة الشرعيّة، كما تصوّرها الشافعي، انطلاقا من نظريته في البيان، قصد إظهار معاني النّصوص الدينيّة. فكيف يتصوّر الشافعي البيان؟
البيان عند الشافعي اسم جامع لمعاني مجتمع الأصول، أو إجمالا في بعضه وتفصيلا في بعضه الآخر، وقد يكون بيان من القرآن للقرآن، أو بيان من السنّة للقرآن. فهو يعتبر جميع معاني البيان مدركة ومتقاربة الاستقراء عند من يفهم لغة القرآن ويخاطب بها، أمّا متى جهلها بالمرّة، فإنّه سيجهل أنواع البيان ومن ثمّ يجهل معاني النّصوص. إذاً لا بدّ لمن يريد إدراك دلالة النّص القرآنيّ أن يمرّ بطرق العرب في البيان، فهي الطّرق عينها المستعملة في القرآن، وإذا كان بيان القرآن في نظره أحيانا من إعجاز، وهو ما لا سبيل إلى إدراكه إلاّ للرَّسول.[6] تكتسب هذه الطرق البيانيّة قوّتها ومشروعيتها، حسب الشافعي، من القول بالتّلازم بين اللّفظ والمعنى؛ لهذا، فالبيان العربي جزء جوهري في بنيّة النّص الدينيّ. ويقسّمه هذا الأخير، حسب مقتضيات تصوّره، إلى: أ ـــ ما أبانه الله لخلقه بصورة لا تقبل الاحتمال أو الظّن، وهذا ما يسمّى بالنّص، كفرض الصّلاة والزّكاة وتحريم الزنا والخمر، ونحو ذلك من الفرائض والمحرّمات. ب ــ ثمّ منها ما قرّر الله فرضه في القرآن، وترك بيانه كيفيته للنّبي، كتعدّد الصّلوات ومقادير الزّكاة ونحو ذلك. ج ـــ ومنه ما فرضه رسول الله ابتداء وليس في القرآن له نظير، وذلك مثل فرض القرآن تماما، لأنّ الله تعالى فرض في كتابه طاعة نبيّه، وذلك كتحريم لحم الحمير. ذ ـــ كذلك منها ما فرض الله تعالى على العباد معرفته بالاجتهاد والنّظر وابتلاهم بذلك، كالاجتهاد في معرفة القبلة عند البعد عنها، لأنّ التوجّه إليها في الصَّلاة فرض.
يظهر من هذا التّقسيم، حرص الشافعي على إبراز أنّ للنّص الديني أوجها عدّة في الإبلاغ؛ فهو يدلّ بطرق مختلفة على حلول لكلّ المشاكل والنّوازل الّتي وقعت في الماضي أو يمكن أن تقع في الحاضر أو في المستقبل. ولقد نوقشت طرق البيان هذه تحت مسمّى العموم والخصوص، وهو مبدأ أصولي لغوي طرح في سياق النّقاش الدَّائر بين مدرسة الحديث والرّأي، حول طرق الدّلالة الشرعيّة. أمّا مدرسة الحديث، فهي تقول بأنّ الحلول الدنيويّة والأخرويّة موجودة في النّص ويكفي فقط اكتشافها بالبيان، بينما ترى المدرسة الثّانية أنّ هناك ضرورة لاستعمال الرّأي في بحث الدّلالة (أبو حنيفة).[7] يدافع الشافعي في هذا السّياق عن مبدأ وجود الحلول لكلّ المشكلات في النّص، مدافعا بذلك عن مدرسة الحديث. وهكذا انصرف للدّفاع عن مدرسة النّص، فكان أن أقرّ بكثير من الجهد العقليّ، أنّ طرق الدّلالة في النّص متعدّدة، وأنّ معنى النّص مرتبط بالكيفيّة الّتي تؤدّي بها اللّغة العربيّة الدّلالة. فمعاني الكتاب (النّص) إنّما هي مكتسبة بطرق العرب في الدّلالة، لهذا نجده يقرّر أنواع الدّلالة حسب هذا المنظور إلى:
أ- العام من الألفاظ الّذي يبقى في إطار دلالته على العام داخل التّركيب أو السّياق، مثل قوله تعالى: (الله خالق كلّ شيء)، وفيها خلاف من حيث دلالة الكل للعموم. وإنّها نموذج للعام الباقي على عمومه.
ب- والعام الظّاهر الذّي يدخله تخصيص جزئي لا يلغي عمومه، مثل الآية 12 من سورة التوبة: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخفّوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه..).
ت- ثمّ العام الظّاهر، لكن دلالته هي الخصوص على غير ظاهر، مثل الآية 173 من سورة آل عمران: (الّذين قال لهمُ النّاس إنّ الناسَ قد جمعوا لكمْ فاخشوهمْ، فزادهمْ إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلُ). يلاحظ هنا أنّ الدّلالة تراوح بين الوضوح والغموض، فالغموض والوضوح في دلالة العموم على الخصوص لا يرتبط بطبيعة التّركيب أو السّياق، بل هو مرتبط أساسا بطبيعة الملتقي حسب الشافعي.
ث- الظّاهر الّذي يعرف من سياقه أنّه يراد به غير ظاهره، وقد فهم هذا النّوع بظاهرة الحذف أو مجاز الحذف كما درسه اللّغويون كالفراء وغيره.
ولقد تكلّم العرب بالشّيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللّفظ، كما تعرفه بالإشارة، ثمّ يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به، دون أهل جهالتها. ويتجلّى هذا النّوع من الدّلالة من أعلى الأنماط لأنّ العلم به مقصور على أهل العلم دون الجهلة. أمّا ما يتعلّق بدلالة الألفاظ المفردة بواسطة التّرادف، فالشّيء الواحد بالأسماء الكثيرة. ما يتعلّق بدلالة الألفاظ المفردة بواسطة الاشتراك، لأنّ للاسم الواحد أكثر من معنى.[8] يستشفّ من تأسيس دلالة العموم والخصوص باعتباره ظاهرة لغويّة وأصوليّة أنّ له فائدة كبيرة بالنسبة للشافعي، وذلك ما يتجلّى في ربطه لتأويل معنى النّص المؤسّس باللّسان العربيّ، بالتَّالي حاجته الدَّائمة إلى النّص الشّارح (الحديث). ويعدّ هذا الرّبط الأصولي بين النّص واللّسان ربطا تأسيسيًّا بين القرآن والحديث واللّسان. غير أنّ ما يعيبه أبو زيد على نموذج الشافعي ذاك، هو اعتماده في هذا التّصنيف لأشكال الدّلالة على تصنيف المتلقين وليس على رصد آليات إنتاج الدّلالة في بنية النّص في حدّ ذاته، ثمّ اكتفاءه بشروح اللّغويين والنّحات والبلاغيين.[9] تكمن الحقيقة المتوارية وراء هذا المنزع الأصوليّ في استبعاد دور العقل في تأسيس الدّلالة الأصوليّة، في مقابل تأسيس إمكان تفسير النّص من منطلق اللّغة والحديث فقط، وذلك بالمعنى الّذي يفيد أنّه لا يوجد مدخل غير اللّسان (البيان) لفهم حقيقة النّص الدينيّ، مكرّسا بذلك ثنائيّة النّقل والعقل. [10] يعتبر هذا الأمر في حدّ ذاته عملا يتنافى ومقصد كونيّة الدّين الإسلاميّ، بالتّالي سقوط إمكانيّة أن يتلوّن النّص القرآني بثقافات أخرى غير الثّقافة العربيّة. ولعلّ ما يزكي هذا التوجّه لدى الشافعي، نفوره من الشعوبيّة وتعصّبه للّغة والثّقافة العربيّة القريشيّة تحديدا حسب ما يبرزه الباحث نصر حامد أبو زيد. يستشفّ ممّا سلف أنّ كتاب “الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطيَّة” يعدّ بحقّ عملا تأويليا جادّا في نقد المنهجيّة الأصوليّة للشافعي. ولقد حرص فيه صاحبه على إبراز كيف عمل الشافعي على تسيّيج النّص الدينيّ بسياج اللّغة. يظهر ذلك من خلال تمسّك هذا الفقيه بحرفيّة النّص والنّقل في مجال دلالة الحديث على القرآن، وقد أدّى به ذلك إلى نفي أهليّة العقل في تأسيس الدَّلالة، ممّا كرّس لديه مبدأ تباعد العقل والنّقل، بل وتعارضهما في مجال التّأويل الدَّلالي للنّصوص؛ ضاربا بعرض الحائط مبدأ الدَّلالة العقليّة الّتي أسّس لها بعض المتكلمة والنظّار مثل المعتزلة، وكذا القول بالرّأي لدى أبي حنيفة وغيرهم.
لقد أسّس الشافعي، عبر اجتهاداته وعقلانيته الأصوليّة، لمفارقة نفي العقل؛ ومن ثمّ أسّس لسلطة النّصوص من خلال تسييج النّص الدينيّ بسياج اللّغة. لذلك بقي هذا النّموذج الأصولي يراوح حدود اللّسان وبقيت الدّلالة مقتصرة على ما تسمح به التّفسيرات اللّغويّة دون السّماح بإمكان تأويليات أخرى غير اللّغويّة والأصوليّة الفقهيّة.[11] لقد أسقط هذا النّموذج العقلانيّة المنطقيّة في التّأويل، ثمّ ألغى التّفسير الثّقافي والتّاريخي والسّياسي في مجال تأويل النّصوص الدينيّة، فاسحا بذلك المجال لذمّ إدراك المعاني الدينيّة إدراكا عقليا بل وتقبيحه في أحيان كثيرة. يستشف من هذا التّأويل أنّه لا مجال للتحرّر من تلك السّلطة الثقافيّة والهيمنة الدلاليّة النّصيّة الّتي أسّس لها النّموذج الأصولي للشافعي، وذلك إلاّ بنقده وردّه إلى سياقه الثّقافيّ التّاريخيّ الّذي أنتج فيه المعرفة الأصوليّة وفق تصوّر لغوي محدود للدَّلالة. وإذا كانت المعارف الدينيّة في السّياق الإسلاميّ لا تخرج في مجملها عن هذه السّياقات التاريخيّة والثّقافيّة الّتي أنتجت فيها؛ فإنّها تبقى مجرّد معارف نسبيّة تاريخيّا وثقافيّا، وهي بذلك محكومة بالظّروف الّتي أفرزتها، وساهمت في أنتجتها وإبداعها من طرف الفقهاء، فلا تتعالى على الزّمان والمكان.
***************
[1] نصر حامد أبو زيد: الإمام الشافعي وتأسيس الأديولوجيا الوسطية، نشرة مكتبة مدبولي، ط الثانية، القاهرة، 1996، ص 53. [2] المعروف جدا أن علم الفقه مرتبط بعلم الأصول، باعتبار هذا الأخير البناء المنطقي للأول. فقد تم التركيز دائما على أهمية أصول الفقه بالنسبة للتشريع في المعرفة الدينية الإسلامية، فجرى العرف عند جل النظار المسلمين أن يعتبروا مصادر التشريع هي الأصول التي ينبغي التقيد بها في إصدار الأحكام الفقهية حول وقائع معينة. ومن المعلوم أيضا أن كتاب الرسالة للشافعي هو أول محاولة منظمة في تقعيد هذه الأصول الفقهية. فلم يكن هناك قبل كتاب الرسالة نظام جامع، ولا قواعد كلية يرجع إليها الناس، بل إنهم يتكلمون في المسائل الأصولية حسبما اتفق؛ ولهذا فإن نسبة أصول الفقه للشافعي كنسبة المنطق إلى أرسطو.