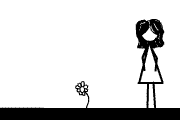أبحر علي زيعور في كتاباته التحليلية النفسية في بحور واسعة لم تترك ميداناً إلا وطرقته. يذهب بعيدًا في قراءاته للموضوع الذي يعالجه، بما يجعل المرء تائهاً أحياناً حول أي الأمور يصدق، ترى هل هي الوقائع الماثلة أمامه، أم تلك الحقائق التي يستخرجها الكاتب من وراء المكتوب والمنثور، والتي قد تشكل صدمة عبر كشف حقائق في اللاوعي، تفضح الإنسان وتصوراته وأفكاره وحتى مبادئه؟. لم ينج الشعر من اقتحامات زيعور، فأعمل مبضعه التحليلي في جوانب متعددة تتصل بالقصيدة، مبنى ومعنى، وكشف مستورات ما وراء القصيدة وعرّى أحيانا كثيرة الشاعر نفسه.
يقدم منهجه الدراسي لهذا القطاع بالقول :“الشعر والعلم كفلسفة بنية كلية، ولكل خطابه. إنه سديد، إنه نافع أن يكون الشعر لا يعادي العلم أو يبعده. ومن السوي أيضاً أن تكون مشكلات الشعر قريبة مقتربة، أو منفتحة متفاعلة، مع مشكلات الفلسفة، مع الماورائيات، وحتى- في حالات أو خيالات – مع الغيبيات، ومع الأخرويات من نعيميات وجحيميات وما إلى ذلك. المذاهب في الشعر مشغلة مؤسسة بتكافوء وتغاذ مع نمو وتطور المعرفة، مع اكتشافات وثورات أو منعطفات في العلم. لكن الأجدر والنافع جدًا التأكيد على أن (الشعران)، أي الشعر الفلسفي أي الأرقى إنسانوية وحداثانية بل ورشدانية، معناه فلسفة في التعبير عن الإنسان ومن أجله، وعن دوره وأسئلته، وما يكون، وما يحب ويستطيع أن يكون. وبكلمات أدمث، الشاعران، الشاعر الفيلسوف، أي الأقرب إلى المطلق والألوهي في الشعر، يكون هو عينه الحرية. إنه يكون رفضاً للحتمانية، وللفكر التبريري السوّاغ، للدوغمائية والإنسجان في غضون الرؤية التلفيقانية كما التوفيقانية في التأمل المكرس للشعر وإنتاج الشعر ومحاكمته، وفي غضون التصور العلموي والآلوي للعالم. ويكون الشاعر الفيلسوف رمزًا للتحرر أيضاً كما الانعتاق والإعتاق من النكوص إلى أحضان الشعر المعهود، إلى الأصول، إلى التجارب التأسيسية، إلى الفردوس المفقود، إلى عدن الأب الذي قتلته أحاديته وتسلطه، ذكوريته وساديته علائقيته الهيمينية السيدية أي اللاتضافرية والشاقولية” (علي زيعور، حقول التحليل النفسي والصحة العقلية كما الروحية والحضارية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2016، ص218 – 219 ).
كانت لزيعور تجربة شعرية، زمن الشباب خصوصاً، لم يخرج بها في دواوين إلى العلن. قد يكون الكامن وراء هذا الانكفاء الشعري ما ساد في العالم العربي من وضع الشعر على الهامش لصالح العلم والصناعة والفلسفة والمنطق الرياضي وغيرها من أنواع العلوم الوضعية. يعيد هذا التراجع، عند العربي عموماً، إلى الانهزام الحضاري، وفشل العقل الاستراتيجي، “والمرض أو التخلخل الذي أحدثه الرئيس العصابي والسلطة الفصامية كما القهرية والبارانويائية. غيّبنا، أخفينا تقديرنا العالي للشعر، فترات متفاوتة وفي لحظات ذبولية حضارية، وحين تقهقر المعنويات والنرجسية، لأن الذات العربية فقدت الشعور بتقبل الذات، وبصورة إيجابية بناءة عن الوجود والعقل والحاضر. لقد كنا خسرنا، فعلاً وقولاً وأملاً، بالاطمئنان والانتماء، وبالقدرة على انتزاع حقنا بالاختلاف، وباعتراف الآخر بنا” (المصدر نفسه، ص219).
بالنسبة إلى زيعور، يتغذى الشعر العربي بمنتوجات العلوم الإنسانية والتاريخية، كما يتأثر بشعراء المتصوفة الذين تركوا آثارًا فلسفية وإنسانية في الشعر، على غرار ابن عربي وابن الفارض والحلاج والشيرازي وغيرهم.. وهم الذين أعطوا أبعادًا عالمية للشعر، وهم “الذين أبدعوا أجنحة التحليق للبشري في رحلته إلى المطلق، في هجرته إلى التحقق، إلى التفريد الكوني، إلى الخلود بواسطة الفن واللغة، الاستعاريات والرمازة كما الحلميات والخيليات” (المصدر نفسه، ص222).
يطلق على الشعر علم الحالات النفسية، بما يشكله من دراسة عيادية للذات وما تحمله من أفكار وعواطف ومشاعر ورغبات وميول، ومن خيبات واضطرابات. ولأن الشعر واحد من أعمدة الأدب والرواية خصوصاً، فإنه يتزاوج مع القصة في تحليل الذات البشرية وصراعاتها وتناقضاتها، بحيث يمكن القول أن أهم ميدان لعلم النفس والتحليل النفسي إنما هو الرواية. وكم من روايات عالمية تغني كثيرًا عن دراسات نظرية في علم النفس، بحيث تقدم للقاريء بانوراما الشخصية الإنسانية في وعيها ولاوعيها. ألا تعتبر روايات الكاتب الروسي دوستويوفسكي مختبرًا نفسياً للبشرية أهم بكثير من مجلدات نظرية في هذا المجال؟ لا يبتعد زيعور عن هذه الوجهة في النظر، فهو يقول :“إن الشعر هو حقل من نباتاته ومزروعاته حالات النفس أو انفعالاتها وحدسياتها، مشاعرها وعواطفها، أي أن الحقل هذا هو حقل الوجدانيات، والمتخيل، بل والعالم الذاتاني، الداخلي، الوعيوي أو الشعوري. تتكافا هذه التشخيصات، أو القراءة الاستبطانية الاستبصارية للشعر، مع القراءة للتصوف أو العرفانيات. فكلاهما محوره وغرضه يطل على”علم أحوال النفس“. أما المناهج في الشعر، فهي أيضاً تتكافأ مع المناهج في التصوف، وطرائق الشاعر والمتصوف هي انقداحية أو انبجاسية، اندلاعية وتدفقية” (المصدر نفسه، ص 225).
كثيرًا ما يقدم الشعراء أنفسهم كأنبياء، وقديماً كانت القبائل العربية تقيم الأفراح إذا ما ولد لها شاعر، لأن الشاعر هو العارف والأذكى في القبيلة والمرشد أحياناً كثيرة. والشاعر في قرارة نفسه ولاوعيه الباطني يرى نفسه من طينة غير طينة البشر، وأنه يحمل مهمات “مهدوية” وخلاصية. لعل بعض المظاهر السلوكية لكثير من الشعراء، والتي تبدو غير سوية قياسا للسلوك البشري، إنما تنبع من هذا الشعور الفوقي، الرباني المعطى للشاعر تمييزًا له عن سائر البشر. لا يعجز التحليل لنفسي عن تفكيك شخصية الشاعر وصحته الروحية والنفسية والحضارية. يمكن للتحليل النفسي القبض على هذه الشخصية منذ طفولتها، وعلى امتداد تطورها الذاتي أو في علاقتها بالبيئة التي يعيش فيها، الصغيرة منها والكبيرة، واستخراج ما هو كامن في اللاوعي، وصولاً إلى كشف العقد النفسية التي تكون قد تراكمت خلال مسار حياة الشاعر، بما يجعل علم التحليل النفسي قادرًا على تفسير هذه القصصيدة أو تلك وما تتضمنه من إيحاءات لا يرغب الشاعر الاعتراف بها عملياً.
يسود في ميدان الشعر تعبير “شيطان الشاعر”، بما هو ربة الشعر أو الموحي بالشعر والملهم للشاعر. يقدم زيعور وصفاً من منظور علم النفس لهذا التعبير – الظاهرة الذي يصر عليه معظم الشعراء، أيضاً تمييزًا لهم عن سائر البشر. يقول زيعور في هذا المجال :“شيطان الشعر رمزية وخيلة لتفجر اللاوعي والدفين والاختباري. فذلك الشيطان إيجابي، إسهامي، وكما ملاك. إنه الوحي الخاص بالشاعر، إنه القسم المخبوء، الهاجع، وقطاع غير متمايز. إنه القصيدة الآخذة بالتكون، والتطور الذي يختمر، والمعرفة الاختمارية السائرة نحو الخروج ببطء وعفوية، بغير إرادة أومنهج. يكون شيطان الشاعر أمل الشاعر بالانعتاق من مرحلة الإعداد والتعلم، وبتفجر الطاقة الكامنة، والشجاعة النائمة في أدغال الغوريات والاختلاجات. يضاف أيضاً أن ذلك الشيطان هو ، في اللاوعي، مستقبل الشاعر أي الطموح إلى التحقق أو التفرد، وهو رغبة، وإرادة في التعزز والتوكيد الذاتي استنادًا إلى السحري، وتغذياً بالحلمي والمجهول، والجني الذي يقر الجميع بوجوده”.
يستند التحليل النفسي إلى القصيدة في دراسة الشاعر وشعره، ويعتمد على جملة مباديء ترشد المحلل في القراءة واستكشاف الشخصية. فللشعر بعدان : نفسي وطبيعي، فما هو نفسي داخل الشعر يكون ذاتياً، وتعبيرًا عن حالات عواطفية وانفعالية. فيما يمكن إعادة البعد الطبيعي داخل الشعر إلى “الطبيعة الحية، والطبيعة الفيزيائية غير الإحيائية”. والشاعر، بحسب معايير علم البطولة، هو بطل. فالشاعر، بعد أن تكون شخصيته قد اكتملت، يصبح في مقام الشخصيات التاريخية. “يحضر البطل – الشاعر على صعيد الشخصية الفردية، أو الأنا، والأنا الأعلى، والذات، والذات المثالية، وضمن فلسفات كالوعيانية، الغيرانية، الآخرانية، التأويلانية، الوجدانية العربية، التطورانية، النقدانية الاستيعابية الحضارية... يعيش البطل أيضاً أو يحضر ويفعّل في حقول أخرى، في العلم والمنطق والصناعة والتكنولوجيا والإعلام والصورة وعالم الاتصالات..” (المصدر نفسه، ص248).
يربط فضاء مشترك بين الصوفي والحكيم اليوناني والغورو الهندوسي وشاعر الربابة المتجول والشاعر صاحب الإلياذة والشعر الجاهلي. كأن الشاعر يضع نفسه في موقع الإنسان المتأله، الذائب في الله وفي أهل الله. هو الذي يضحي بنفسه في سبيل الله وخدمة مجانية لأهل الله. يخال الشاعر نفسه هائما في كل واد، والمتصعلك وغير المهتم بثيابه. في السياق نفسه، يعتبر التحليل النفسي أن الشعر والحب أهم ادوات كشف شخصية الشاعر. في مثال على الدراسة النفسية للشاعر، يتطرق زيعور إلى الشاعر السوري نزار قباني الذي تركز شعره على المرأة والحب، فيخضعه للمعاينة النفسية ويخرج بخلاصة هي “أن الرجل قد يكون زير نساء أو مريضاً جنسياً، سوياً أو متقشفاً جنسياً، شهريارًا أو شبقاً سادياً، بريئاً طاهرًا ومحتشماً أو ماجناً، محباً على غرار الصوفي في عشقه الإلهي، على غرار رابعة أو ابن الفارض وابن عربي والآخرين، أو مجرد مؤلف يتخيل ثم يروي، يلاحظ ثم يعبر عن عواطف وانفعالات أو ظواهر وحوادث تحصل داخل العلائقية الأنثوية – الذكورية. تلك متكافئة حكمت القول والفعل عند شاهد تاريخي قديم، عند عمر بن أبي ربيعة. فهل كان يقول ما لا يفعل، أو كان يفعل ما لا يقول؟ هل نصه هو تجربته، هل شخصيته ولّدت وخلقت شعره؟ الأهم هو شعره الماثل بين أيدينا، وأمام الوعي والتاريخ، والموصول بالمستقبل والبقائية. لكن، ولمرة أخرى، لا نستطيع السكوت عن المسكوت عنه، عن اللاواعي أو المطمور وشتى المكونات الدفينة داخل شخصية الشاعر أو داخل المعنى المعلن والقول الفصيح المفصوح..” (المصدر نفسه، ص251-252).
يحتل الشاعر الأصولي (بالمعنى الشعري الذي يعود إلى الأصول وليس الديني)، موقعه في الدراسة النفسية. يتفق الاختصاصيون النفسيون على معظم سمات ومضمون الشاعر الأصولي، فشعره يكشف عن سلوكه، ووعيه وفكره، بل وأيديولوجيته. يشير زيعور الى التوافق مع المتفحصين للحالة النفسية الاجتماعية عند الشاعر المحافظ أو الشعر العمودي من “حيث الأسلوب في فهم الوجود والجنس والقيم، ومن حيث الاتصاف والتمتع بالصحة النفسية الروحية، والنفسية الحضارية، والنفسية الجنسية الجسدية. لكن ذلك الاتفاق يتقهقر حين النظر في أساليب التغيير، في إعادة التعلم الحضاري، في إعادة التكيف مع الدار العالمية للقصيدة المعاصرة وللمعاصرة، التنويرانية والحداثانية في الشعر والقصيدة كما في المجتمع والفلسفة والسياسة، وفي الشخصية العقلية والسلوك الحضاري. العقلية الأصولية واحدة في كل الحقول، وفي كل سلوك أصولي. فالأصولي في الشعر، وتماما كما هو الأصولي في التدين والتفسير والفعل السياسي، قد يوصف بأنه حرفاني، أحادي المستوى في النظر والتحليل والمقاضاة، وبأنه استبدادي، يتمسك بفهمه المقفل المجمد الثابت والفقير، وبعلائقية السيطرية الاجتماعية والخضوعية أي غير الأفقية والتضافرية.. كما قد نقول، بغير أدنى شعور بالذنب أو الأسف، أن المتشدد المتعنت في”أسطرته“للقصيدة العمودية أو للشعر المنبري قد يوصف أيضا بأنه سادي ومتصلب، وبأن القصيدة العمودية”امرأة قضيبية“عنيفة متعصبة. وفي اقتضاب توضيحي، الأصولي سواء كان في الشعر أو في السياسة والدين والفكر، أصولي هو أيضاً في تصوره للمرأة والجنس والحب. من هنا إمكان تشخيص مايعانيه من إحباط جنسي، عجز أو هوامات جنسية ومكبوتات، وذكريات صدمية جنسية. ومن التشخيصات ما يتلخص بأن هذا القاسي الظالم في الدفاع عن الشعر التراثي (التقليدي، الخطابي، البطريركي) متعلق بالأم، مصاب بالحنينية المرضية الاختلالية إلى عدنيات السلفي، والرحم الثقافي. ومن السوي أن يقال فيه، في شخصية من ذلك النمط المذكور، أنه عبارة عن حالة شلل ذاتي، ونكوصية، وقساوة عل الذات مع رفض للحرية والانفتاحية، للتطور والحداثة” (المصدر نفسه، ص 253- 254 ).
يحتل الشعر الغزلي موقعاً رئيسياً في النتاج الشعري العربي، وكما العالمي أيضاً، قديمه وحديثه. والمعنى الظاهري للشعر الغزلي هو الحديث عن المرأة كحبيبة، وكغرض حب، بل وعبادة. لكن المعنى المضمر والأصلي هو الجنس والعلائقية الذكورية – الأنثوية. فالشعر الغزلي يركز على التعاطي مع غرائز الجنس، ما يجعل الغزل المكون الأكبر للحياة والنشاط، والمحدد لتكوين الوعي، والمنشيء للكلام واللغة. يصف زيعور الغزل بالقول :“شعر الغزل، في الشخصية واللغة والسلوك، أعقد من أن يكون قصائد تشبيبية أو ماجنة، أو روايات غرامية وأشعارًا في الهوى والشبق.. إن المدرسة العربية الراهنة في التحليل النفسي، وعلوم النفس والمجتمع والصحة العقلية، تعطي للجنس أو للمرأة والتكاثر والتناسل قيمة أولى فعالة ومسيطرة في الحركة والفعل والقول، في تطور الإنسان والمجتمع والحضارة، في البقائية والتكيف الخلاق والحافظ للاستمرار والتواصلية، ولقوانين تفرضها الأوضاع والشروط البشرية. والذين يرون في الغزليات عند العربي تسلية أو رطانة لا يعرفون أن الشعر هو الحياة، والمعبر عن الإنسان بما هو مشاعر وفعل، واللغة التي تخلق الفعل والتواصل والفكر. يضاف هنا أن الشعر الغزلي، عند العربي، أكثر وأعقد من أن يكون عينه الرغبة. ليس هو التعبير عن شهوة جسدية، أو عن أمنية، وعن لذة أومتعة. فهو قد انتهى بأن تحول وارتفع إلى العشق الإلهي، إلى الحب المحض” (المصدر نفسه، ص 258).
عرف الشعر العربي قطاعات متعددة إضافة الى الشعر الغزلي. هناك شعر الرثاء الذي يراه علم النفس بمثابة رد على الخوف من الموت، وعلى رغبة لا واعية بالخلود، “وحنين إلى العدنيات وما قبل اللغة”. وللرثاء وظيفة يقوم بها المجتمع أو الجماعة من أجل تخفيف المصاب، وحماية المتألم والخائف أمام الفقدان. “فالشعر الرثائي مسحة دمعة، وغسل غصة أو مرارة. إنه الفلسفة التي تدفع عنا المأساوي والأحزان، الخسارة والمخاوف، والفلسفة التي تخلّد. إنه الفن في وظيفة له هي، كوظيفة الموسيقى، نقل إلى عالم الخلود والمتخيل أو اللاعقل واللاواقع” (المصدر نفسه، ص259).
عرف الشعر العربي المديح في تاريخه القديم والحديث. يوصف قطاع المديح بالاستجدائي والتسول، وهدفاً لمنفعة مادية. لكن علم النفس يذهب إلى تفسيرات أخرى للمديح يرى فيه مكافأة لنجاح أو لأفعال إيجابية، وقد تكون له صفة تربوية من خلال التركيز على الصفات الحميدة في الشخص موضوع المديح وتكون أمثولة في السلوك. يقول زيعور في هذا الصدد، “إن القراءة الراهنوية لشعر المديح، تعطي اسماً جديدًا، ومعنى جديدًا للشعر في اللاوعي والوعي عند العربي، وللمديح المقدم هو نفسه على أنه الأبرز والممثل الأكبر للعقل والخيال والروحية، للحدس والتفكير والوجدان..المديح الشعري حمد وشكر : حمد على ما أوتي، وشكر على ما سوف يأتي للشاعر، من نعيم وصلات على يد الممدوح. المديح مختلف عن الاستجداء، ولا يجوز أن يقال فيه أنه إذلال للنفس، وانمحاء لها أمام القوي المعطي أو المانح. الاستجلاب لا يكون دائماً وأبدًا مقصود الشاعر المادح. والتسول لا يكون غاية، أو اسما آخر كما القناع، لذلك الفاعل المداح. وشعر المديح ليس مجرد أوالية دفاعية كالتعويض والندم، والشعور بضآلة الذات أو بانفتاحها” (المصدر نفسه ص 260).
عرف الشعر العربي وبقوة الفخر الذي هو في حقيقته تعبير عن النرجسية في الشخصية العربية. يكشف الفخر الدونية البشرية، كما يمثل تعويضاً ونكوصاً وهروباً من الواقع. لكن زيعور يرى في الفخر “بحثاً عن حقائق، وخفضاً للتوتر، ورصاً للصفوف، وتعلمات سلوكية وحضارية، وترتيباً للقيم، وتدقيقاً في المعايير، وترددًا قلقاً في لفظ حكم أو في ضبط الفعل والقول” (المصدر نفسه، ص261).
أما شعر الهجاء، فهو أغنى وأوسع من قراءته كردة فعل أو استجابة آلية على تحديات أو مثيرات أو مخاطر وتهديدات. فهو “اللغة التي تطهر، وتنقل إلى الإيجابي والانفتاح، إلى المرونة الضرامية واحترام الغير أو المختلف السلبي.. الإنسان بحاجة إلى عدو وعقبات، وإلى إخراج العداوة المكبوتة، والأحزان المكظومة، والمشاعر المؤلمة كما الضاغطة والمرعبة” على ما يشير إليه زيعور.
وأخيرًا هناك قطاع الشعر الخمري الذي عرف ازدهارًا واسعاً في الشعر العربي خصوصاً في العصور الأموية والعباسية، وكانت له رموزه على رأسهم الشاعران ابو نواس وعمر الخيام. يقول زيعور عن هذا الشعر “إن الخمريات متجذرة في تجربة الإنسان أمام مآسي الحياة، وفي إمكانات الابتهاج والانشراح. وهكذا فقد نكتشف في ثنايا الخمريات خوف الإنسان، كفرد ونوع، من الظلم والجوع والمرض، ومن الاعتباطي والتعسفي أو الكارثي في الطبيعة والمجتمع والسلطة... والخمريات الإلهية، عند الشعراء العرفانيين، تستحق الاهتمام الأكبر بسبب أنها، باعتماد أوالية التسامي اعتمادًا متعمدًا ثم عن غير تعمد، نقلت الخمريات من المستوى الجسدي والواقع المادي إلى فضاءات روحية وفلسفية مثالية” (المصدر نفسه ص 264).
لعل الدكتور علي زيعور من المحللين النفسيين القلائل في العالم العربي الذي أعطى للتراث العربي عموما وللأدب والشعر منه خصوصا، موقعاً مهما في دراساته النفسية، انطلاقاً من قراءة عينية لهذا التراث الغني، وتناوله من جوانب متعددة بعيدًا عن النظرة الأحادية الجانب في التحليل التي وقع فيها كثير من الدارسين النفسيين ، وتسببت في قراءات خاطئة أحيانا كثيرة لما يهدف إليه هذا النص أو هذه القصيدة.