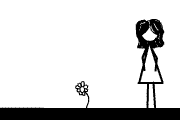14 أكتوبر 2014 بقلم
حمّادي ذويب قسم:
الدراسات الدينية حجم الخط
-18
+ للنشر:كتاب "القرآن والدولة" لمحمد أحمد خلف الله، نشر للمرة الأولى عام 1973. ويعدّ هذا الكتاب بحثا جديرًا بالدراسة لعدّة عوامل:
- إنّه صدر في طبعته الأولى سنة 1973 (ط2، 1981)، وقد شهدت السبعينيات مدًّا سلفيًّا برزت معه خطابات توفيقيّة، انطلقت في الغالب من مثقّفين وأكاديميين لا ارتباط لهم بالمؤسسات الدّينيّة. وهذه الحالة يمكن أن تشمل عدّة مفكّرين منهم محمد أحمد خلف الله وعبد الحميد متولّي صاحب كتابي "أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث" (ط 2، 1975) و"مبادئ نظام الحكم في الإسلام" (1978).
- إنّ صاحبه متخصص في الدراسات القرآنية، وقد أثارت بعض كتاباته جدلاً حادًا وهذا ما يتجلى من خلال ترجمته التالية، فهو باحث مصري، تخرّج من كليّة الآداب جامعة القاهرة وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه. شغل وظائف عدّة مثل التدريس بكلية الآداب ومعهد الدراسات العربيّة التابع لجامعة الدول العربيّة، عميد كليّة الآداب بجامعة الاسكندريّة، وكيل وزارة الثقافة المصريّة. متخصص في الدراسات القرآنيّة وله مؤلّفات عديدة منها: محمد والقوى المضادّة، وهي رسالته الأولى لنيل درجة الماجستير وعنوانها الأصلي "جدل القرآن"، الفن القصص في القرآن الكريم (ط1، 1953) وهي رسالته الثانية لنيل درجة الدكتوراه. وقد تقدّم بها فرفضتها لجنة المناقشة وأحدثت زوبعة سنتي 1947 و1948 ولكنّها في سنة 1965 أصبحت تدرس في كليّة الآداب بجامعة بغداد، وله أيضا "القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة" (1967). كما له عديد المؤلّفات الأخرى الأدبيّة وكتب التراجم والمقالات بمجلّتي العربي والمستقبل العربي على سبيل المثال، والبحوث في الندوات الفكريّة الخاصّة بالقضايا الإسلاميّة، وقد كان المشرف العام على مجلّة "الوحدة" الصادرة عن المجلس القومي للثقافة العربيّة.
- إنّ خلف الله يمثّل رؤية متميّزة لقضيّة الحكم في الإسلام، باعتبار تكوينه المخالف لكل من التكوين القانوني والتكوين الفقهي لبعض الباحثين المسلمين. فخلف الله ذو ثقافة أدبيّة لغويّة بالأساس، وهو يعترف بتأثّره بأستاذه أمين الخولي الذي درّسه بقسم اللغة العربيّة بجامعة القاهرة مادّة الدراسات القرآنيّة حسب منهج جديد يناسب كلية الآداب، وأساسه دراسة القرآن دراسةً أدبيّةً اعتبارًا أنّه معجزة أدبيّة في المقام الأوّل. وهذا المذهب تواصل لفكرة محمد عبده الذي ذهب إلى أنّ القرآن يجب أن يفهم على الأساس الذي كانت تفهمه عليه العرب وقت نزوله من حيث فهم الألفاظ اللغويّة والعبارات الأدبيّة.
[sup][1][/sup]- إنّ هذا التميّز هو الذي حدا بأحد الباحثين المحدثين إلى اعتبار خلف الله مع محمد عمارة ممثلين للتيار الإنساني في موقفهما من الدولة.
[sup][2][/sup]- كما لا يمكن أن نغفل ما لصاحب "القرآن والدّولة" من ميول قوميّة عربيّة تجلّت منذ التمهيد، بل منذ الجملة الأولى في الكتاب، حيث أعلن أنّه يعالج قضيّة من أهمّ قضايا القوميّة العربيّة في العصر الحديث، كما أنّه عنون الفصل الثاني بـ "أمّة عربيّة جديدة".
ويتدعّم هذا الرّأي من خلال نقد كمال زعموت لمقال كتبه خلف الله موسوم بـ "القرآن وهموم المجتمع العربي" ونشر بمجلّة العربي عدد 291 سنة 1983، حيث يرى هذا النّاقد تركيز خلف الله على عبارتي المجتمع العربي والنبيّ العربي. ويتساءل إن كان خلف الله يميل إلى ما يدّعيه المستشرقون من أنّ محمّدًا نبيّ للعرب فحسب.
وقد اشتمل كتاب القرآن والدولة في طبعته الثانية الصادرة سنة 1981 على 163 صفحة واحتوى على تمهيد وتقديم مطوّل وثمانية فصول وخاتمة.
ونلمس من خلال عناوين الكتاب تركيزًا على أجهزة الدّولة السياسيّة التي اعتبرها خلف الله مؤسسات بديلة استحدثها الإسلام لتعويض المؤسسات التي كانت تحتكر السلطة قبيل البعثة المحمّديّة.
لقد ألّف خلف الله كتابه هذا للدّافع نفسه الذي جعل بعض حكّام العرب يلجؤون إلى السلفيّة فيعتمدون على مبادئ الشريعة الإسلاميّة في إصدار النظم الحديثة في مجال السياسة والإدارة والاقتصاد والاجتماع. إنّ هذا الدّافع هو الحيرة العربيّة أمام الإيديولوجيّتين المسيطرتين على العالم زمن تأليف الكتاب: الرّأسماليّة في الغرب الأوروبي وأمريكا والشيوعية في الشرق الروسي والصيني. إنّ هذه الحيرة قد دفعت خلف الله للعودة إلى النص التأسيسي المقدّس، ليستلهم منه الصيغة القرآنيّة الخاصّة بالدولة، وقد أوضح أنّ هذه الصّيغة القرآنيّة تستخلص منها نتيجتان:
أوّلا: إنّ القرآن الكريم لم يضع إلاّ الخطوط الرئيسة الكبرى التي توجّه الإنسان إلى الحق والعدل.
ثانيا: إنّ القرآن قد ترك للإنسان التفصيلات وكلّ ما يتأثّر بالزّمان والمكان.
وهاتان الحقيقتان اللتان خلص إليهما خلف الله بعد بحثه جعل من توضحيهما وإبراز آثارهما مقصده الرئيس في الكتاب.
إنّ ما سلف من اعتبار أحد الباحثين أنّ خلف الله يمثّل التيّار الإنساني في بحثه في قضيّة الدولة قد يعود إلى ما لم ينفكّ خلف الله يكرّره في كتاباته من أنّ البحث في قضيّة الدولة من اختصاص الإنسان وأنّ هذا البحث متطوّر ومتغيّر وخاضع للتاريخ على عكس من يعتبر أنّ البحث قد انتهى على ما قرّره القدامى من صيغ وشروط.
وهكذا عمد خلف الله إلى إعادة النظر في عدّة مفاهيم وألفاظ فنفى أن تكون سلطة الحاكم إلهيّةً، وسمح للإنسان بحق التشريع في غير المسائل الدينيّة التي وقع النصّ عليها بوضوح، وبذلك فصل بين سلطة إلهية لها حقّ التشريع الديني وسلطة بشريّة لها حقّ التشريع المدني لمسائل السياسة والحرب والاقتصاد والإدارة.
كما قدّم خلف الله مقترحًا إجرائيًّا عمليًّا لحلّ إشكاليّة اختيار أعضاء الهيئة التشريعيّة غايته الجمع بين قاعدة اختيار أولي الأمر القديمة وقاعدة الانتخابات العامّة الحديثة.
إنّ هذا الحلّ التوفيقي سيتقهقر في أحيان كثيرة أمام حلول حديثة ومواقف جريئة يتخذها خلف الله، مثل تجويزه تعطيل النصّ في سبيل الصالح العام، واعتباره المواصفات الخاصة بدعاة التنظيم السياسي (الحزب) وشروط المرشّح لرئاسة الدولة ملائمةً لعصر الذين اجتهدوا فيها وأنّ من حقّنا أن نجتهد كما اجتهدوا. وهو بذلك يفتح أبواب الاجتهاد الموصدة على المكتسبات التي دعا عبد الرازق إلى بناء حياتنا على أساسها: إنّها النظم والأفكار الحديثة.
ومن نتائج تحليلات خلف الله في كتابه هذا أنّ القرآن الكريم لم يستخدم ولو مرّة واحدة أيّ مفهوم سياسي مماثل لما نعرفه اليوم في استخدامنا لكلمات الحكم والحكومة والحاكم. لقد ثبت القرآن عند استخدامه للكلمات المشتقّة من الجذر اللغوي (حـ كـ م) على معنى واحد لا غير، هو القضاء بمعنى الفصل في المنازعات والخصومات وكلّ ما يقع من خلاف بين الناس.
أمّا ثاني النتائج التي يستخلصها خلف الله، فهي أنّ شعار الحاكميّة لله حين يكون مصدره أمثال الآيات القرآنيّة "ومن لم يحكم بما أنزل الله" فليس يصحّ أبدًا أن تكون هذه الحاكميّة مقصودًا منها السلطة التي تحكم وتدير شؤون المجتمع ما دامت كلمة الحكم في مثل هذه الآيات لم يقصد منها معنى السلطة هذه لا من قريب ولا من بعيد.
ويشدّد خلف الله على وجوب أن يكون معنى الحاكميّة لله مستمدًّا من المفهوم القرآني لمادّة حكم ومشتقاتها حسب الاستخدامات القرآنيّة لهذا المفهوم أي القضاء والفصل في الخلافات والخصومات والمنازعات.
وتتمثل النتيجة الثالثة في أنّ القرآن الكريم عند حديثه عن الحكم بمعنى الفصل في الخصومات لم يجعل السلطة للحاكم بمعنى القاضي، وإنّما جعلها للتشريع الذي يحكم به القاضي، وهو في الحقيقة صادر عن الله. وما يمكن أن يبنى على هذا فيما يخصّ الإسلام أنّه دين وتشريع أو عقيدة وشريعة. ومن هذا المنطلق لا يصحّ أن يقال: الإسلام دين ودولة.
ورابع نتيجة هي أنّ الحاكم بمعنى القاضي أو الحكم لم يكن وقفًا على رسول الله (ص)، وإنّما كان يمتدّ إلى غيره من كلّ من يتحاكم الناس إليهم؛ وهذا إنّما يعني أنّ محمّدًا عليه السلام كان أحد الحكّام ولم يكن رئيسًا لهم، أي أنّه لم يكن رئيس دولة أو حكومة لا بالمعنى القديم ولا بالمعنى الحديث. (هذه النتيجة وصل إليها عبد الرازق قبله).
أمّا النتيجة الأخيرة، فهي تتمثّل في أنّ النبي لم يحكم الناس بمعنى قهرهم إلى حيث يريد وتوجيههم في الحياة حسب ما يريدون على الرغم منهم. لقد بعث الله محمدًا رسولاً ولم يبعثه حاكمًا أو رئيس دولة، ولو اقتضت حكمة الله أن يكون محمد رئيس دولة لكانت الصيغة القرآنيّة فاحكمهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم. وفي لهجة تقريريّة يقول: "يجب أن نفرّق دائمًا بين صيغة محمد يحكم الناس وصيغة محمد يحكم بين الناس. الصيغة الأولى هي التي تصلح لرئيس الدولة. أمّا الصيغة الثانية، فهي التي تصلح للقاضي والحكم وكلّ عبارات القرآن الكريم وردت في الصيغة الثانية الحكم بين الناس ولم تكن أبدا حكم الناس".
[sup][3][/sup]وبعد، على الرغم من مشروعيّة مراجعة تراثنا وإعادة تأويله، فإنّنا ينبغي أن نتجاوز الحلقة المفرغة التي قد يؤدّي إليها قصر البحث في مفهوم الحكم على الجانب السياسي أو القضائي.
فلم يعد هناك بدّ في القرن الواحد والعشرين من أن نركّز مجهودنا الفكري على تعميق النظر في الحكم، باعتباره موضوعًا لعلم السياسة. إنّ من مقتضيات الحداثة أن نضيف إلى التراث الفكري السياسي الحديث انطلاقًا من اقتناعنا بأنّ كلمة الحكم في كلّ جماعة من الجماعات تعني السلطة المنظّمة ومؤسسات القيادة والإكراه.
إنّ تقوقعنا في دائرة ما أنتجه التراث أو ما يخيّل إلينا أنّه أنتجه يفوّت علينا فرصة إثبات طاقة الفكر الإسلامي الحديث على التكيّف مع آخر المستجدّات في علوم الإنسان عامّةً وفي العلوم السياسة خاصّةً.