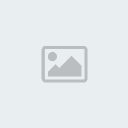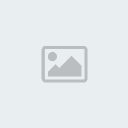
“إن الكلمات غير المضبوطة هي أحسن الكلمات لتعيين شيء ما بطريقة مضبوطة. لنبدع كلمات غير عادية شريطة استعمالها استعمالا عاديا جدا، وإعطاء الوجود للكيان الذي تشير إليه في المستوى ذاته الذي يتمتع به الشيء الأكثر تداولا”.
“دولوز”
“بأي وجه يكون القلق وجدانا متميزا”؟
“هيدغر”
“درتي لي أقلوق في رأسي”
“ريم”
التساؤل عن الأقلوق
الأقلوق ليس من القلق في شيء، بل هو ما ينحو ضد القلق بوصفه تحقيقا لإمكانية الوجود الأصيل، أي أنه يحول أحيانا بين الإنسان وبين إمكانية القلق، فيغدو تعبيرا عن عجز الكائن عن تحقيق القلق بما هو انفتاح للكينونة. فلا يصير وجدانا متميزا.
إذن ما هو هذا “الشيء” المسمى “أقلوقا”؟ ولماذا يتعقبنا الأقلوق، فيفصلنا عن القلق باعتباره إمكانيتنا الخاصة في انفتاح كينونتنا على الوجود؟ أي لماذا يستهدف الأقلوق مضجع القلق من حيث هو تجربتنا الأصيلة بما هي نمط يكشف كيفية التقائنا بذواتنا، من خلال القلق الذي يصير تجربتنا الوجدانية ممكنة. ذلك لأن القلق هو شرط انكشافها كنمط وجود أصيل ومن ثمة فما نسميه “أقلوقا” ليس هو في الحقيقة سوى حجاب يبقينا منفصلين عن تجربتنا الوجدانية فيحول دون تحقق ذواتنا. كذوات مستقلة ما دام أنه يلقي بنا عالم التفاهة والانحطاط والعدميَة فيجعلنا لا نحيا على نحو وجودنا الخاص، وإنما خاضعين لنمط حياة مزيفة فنغدو مجرد تابعين، أي مجرد كائنات لا شخصية. فنحن نعيش في عالم هو بالأحرى مزعج، حيث تكون السلطات القائمة، وليس الناس فحسب، في حاجة إلى أن تمرر لنا عواطف حزينة. فالحزن والعواطف الحزينة هي التي تقلص كل قدراتنا على الفعل. تحتاج السلط القائمة إلى حزننا كي تجعل منا عبيدا. يحتاج المستبد والكاهن وسالبوا الأرواح إلى إقناعنا بأن الحياة صعبة وثقيلة. إن حاجة السلطات في قمعنا هي أقل من حاجتها في ترعيبنا، أو كما يقول فرليو Virilio، لتدبير وتنظيم رعبنا الصغير والحميمي“. (1)
إن الأمر يتعلق بما يجعلنا عاجزين عن الحياة، أي بتقليص اقتدارنا، أي يتعلق ببؤس يصير علاقتنا بجسدنا مستحيلة، فيتقمصنا التبخيس ودم الحياة. ومن ثمة تحقير هذا الجسد المدهش”نتشه“الذي لا نعرف بعد ما يستطيعه كما يقول”سبينوزا“. معنى ذلك أننا لا نصير سوى خاضعين لانفعالات النفس أي أننا لم نتخط بعد عتبة العبودية. بمعنى أننا لا نعيش وفق نمط الاقتدار بل وفق نمط العجز. فنحن في نهاية التحليل لسنا سوى أنماط للعيش، هناك منا من يلتحم بإرادة الاقتدار وهناك منا من ينفصل عنها ويجد ملاذه في”الشكوى الطويلة والكونية بصدد الحياة: النقص اللازم للفعل الذي تشكله الحياة- فرغم ترديدنا “لنرقص” فإننا مع ذلك لسنا مرحين، ورغم ترديدنا “أي تعاسة هي الموت” فإنه من اللازم أن نعرف الحياة كي نحصل على شيء يمكن فقدانه. لن يتركنا مرضى النفس ومرضى الجسد، أي الهامات، قبل أن يوصلوا إلينا عصابهم وكربهم، وخصيهم المعشوق، وحقدهم ضد الحياة. أي العدوى القذرة. ليس من الهين أن يكون المرء إنسانا حرا حيث ينبغي الهروب من الطاعون، وتنظيم الالتقاءات، والرفع من قوة الفعل، والتأثر الذاتي بالفرح، وتكثير العواطف التي تعبر عن أكبر قدر من الإثبات أو تحتوي عليه“. (2)
إذن نحن لا نوجد لأننا كائنات، بل نوجد لأننا نتشكل كأنماط للكينونة، فتتحقق كينونتنا بقدر ما تتمرن على الحرية وتعلي من قوة الفعل والإثبات أي بقدر ما تتعلم الحياة. وبقدر ما تتعلم القلق ليس بما هو غم وحزن ولكن بقدر ما هو انفتاح مخصوص للكينونة على الوجود، وبما هو وجدان متميز، أي بما هو اقتدار على تخطي العجز الذي ينشره الانحطاط ونمط العيش البئيس.
بقدر ما أكشف قدرتي على القلق بقدر ما ينكشف طريقي نحو كينونتي. ما يستطيعه جسدي، وبقدر ما ينكشف خط هروبي عن البداءة والانحطاط، وبقدر ما أكون على أتم الاستعداد على أن يشكلني نمط الوجود، فألتقي بكينونتي الخاصة، ذلك لأن لقاء الكينونة الخاصة هو من قبيل النمط الإثباتي، وليس من قبيل التنميط الارتكاسي ،فأنا ما أكونه ككيان تؤسسه روابط الحركة والسكون التي تنشأ بين الأجزاء”دولوز“، لست أنا وجودا بل كيفية وجود، فما أكونه في صيرورتي هو نمط الكينونة الخاصة، أي النمط الذي تتوسع فيه القوة بما هي إرادة الكينونة ويما هي اقتدار على الحياة، أما ما أوجد عليه فليس سوى معطى الموجودية أي معطى ما نوجد عليه داخل نسق التنميط، وفي نسق التنميط نصير نمطا ارتكاسيا للحياة، نمطا تتقلص فيه القوة إلى حدودها الدنيا، وتغيب فيه إرادة الاقتدار.
لكن ما الذي يجعل قوانا تتقلص، أي ما الذي يضمر فينا إرادة الاقتدار ويصيرنا نمطا للعجز؟ ينكشف عجزنا بقدر ما نخطئ السبيل نحو القلق بما هو لقاء بأنفسنا. إذن ثمة ما يحول بيننا وبين قدرتنا على الخصوصية ليس سوى هذا الذي نسميه”الأقلوق“.
ندعو”أقلوقا“، هذا الذي ينبعث في صلب حياتنا المعيشة كممنتج للغم، أي هومنبع الحياة المكدرة التي يملؤها الغم. فالأقلوق ليس إلا مضادا للقلق، إنه كيفية من كيفيات تشتيت القلق بما هو وجدان أصيل ومتميز، بتعبير آخر إنه إقلاق أو نمط لإزعاج القلق في وجداننا، فإذا كنا من خلال القلق نلتمس الطريق نحو فكر كينونتنا، فيكون القلق بمثابة مضاد حيوي للعجز الذي يشل قدرتنا على التفكير، فإننا نكون من خلال الأقلوق عاجزين عن القلق، وبالتالي نكون عاجزين عما يستطيعه جسدنا وفكرنا، أي عاجزين بتاتا أن نحيا حياة هي حياتنا الخاصة، فالتبئيس ينبعث من هذا الذي ندعوه أقلوقا. ولا أخفيكم سرا فقد عثرت على هذه التسمية صدفة، إذ بينما كنت أحاور ابنتي ريم ذات صباح، لكن بمجرد ما أحست بأني أفرض عليها القيام بخطوة ما لا تتناسب وما عزمت عليه، عندئذ صرخت في وجهي”درتي لي “أقلوق” في رأسي“.
لم أسمع قط بهذا اللفظ، غير أنه دفعني إلى التوقف مليا، متأملا صيغة هذا”الدال“الذي تلقته أذني لأول مرة.
الفحص الدقيق لأقلوق لا يعني قط القلق الذي يعرض للكائن لحظة لقائه بذاته، أي ليس هو القلق الوجودي الذي يقودنا إلى التساؤل عن ذواتنا وعن مصير كينونتنا. بل هو ما ينبعث من قوى خارجية تحد من قوانا الذاتية على التأمل وعلى الفعل. يفرض علينا الأقلوق نوعا من الخضوع ضد رغباتنا من أجل إرضاء الآخر. بمجرد ما نلبي من غير مقاومة رغبة الآخر ونخضع لانفعالاته بمجرد ما نسقط فجأة في تجربة معيشة نسميها هنا”تجربة الأقلوق“التي تسقطنا في حضن الغم الذي يشل قوانا على أن نحيا بكيفية جدلى نشيطة ،مرحة ،منتعشة بإمكانياتها الخاصة.
في تجربة”الأقلوق“لسنا نحن من نختار نمط حياتنا، بل ثمة من يختار لنا وفق انفعالاته ما هو أنسب لرغباته. فنعيش على إيقاع التنميط. والتنميط دوما هو جواب عن”الأقلوق“.
لا يدعنا”الأقلوق“نستكين إلى وجداننا، ولا حتى أن نعترف إلى أنفسنا أو أن نفهم العالم الذي متقاسم العيش فيه، وتلك هي أبلغ صيغة للعيش وفق الغم، بانزعاج وفي انزعاج. لا يحيل الانزعاج على القلق بما هو قلق الكائن الذي يتأمل ذاته ككائن من تأمل المصير أو من أجل الفعل، وإنما يحيل إلى ما يسميه هيدغر”الوجود الزائف“أي ذلك الوجود الذي يطمس الجوانب الشخصية الحقيقية، ويفرض على الناس التجانس بحيث يختفي أي نوع من الاختلاف أو أي شيء يحقق التميز عن التنميط السائد. فالكائن من حيث هو كينونة بالمعية –صحبة- الآخرين،”إنما يقع تحت سيطرة الآخرين، إنه ليس هو ذاته الذي يكون، فالآخرون قد انتزعوا منه الكينونة. إن مشيئة الآخرين تتصرف في إمكانات الكينونة اليومية للدازين“. (3) ومعنى ذلك بحسب”هيدغر“أن هذه الكينونة –معا- الواحد- صحبة الآخر تديب”الدازاين“الخاص بالكلية في صلب نمط كينونة الآخرين، بحيث إن الآخرين سوف يضمحلون أكثر فأكثر من حيث قدرتهم على الاختلاف ونمط تعبيرهم. هنا حيث لا شيء يلفت النظر ولا شيء يثبت، يَبْسط الهُمْ ديكتاتوريته الحقيقية. (4)
معنى ذلك أننا نوجد، لكننا لا نكون، فما يطبع علاقة الكائن بالهم هو سلب الكينونة، فالواحد منا ينشغل عن كينونته في خضم الوجود بالمعية، فلا يغدو الكائن سوى مجرد امرء. المرء من حيث هو تعبير عن الكل، عن الهم، فطبيعة هذه العلاقة تقوم على السلب، سلب الكينونة من حيث هي اقتدار على الاختلاف. كما تقوم على سلب المسؤولية مادام أن الكينونة ترتكن إلى الغير، وتخضع لقرارات الهُمْ وأحكامه. وهذا الارتكان يظهر في الالتزامات المشتركة للحياة اليومية، ويمتد ليشمل الأفكار، وتصبح بذلك ىنية الحياة اليومية كائنا محايدا لا شخصيا يعمل دوما على إلغاء المسؤولية الخاصة لحساب مسؤولية مشتركة ليست مسؤولية أحد بالذات،”فكل هو الآخر وما من واحد هو ذاته“(5)، وتصير الآنية (الدازاين) أقل قدرة على تأكيد مالها من إمكانيات خاصة، وتكتب رغبتها في الفهم والوجود الحقيقي. (6)
لا ينشأ الأقلوق في الذات المستقلة التي ترتكن إلى كينونها، فما ينشأ في الذات المستقلة هو القلق بما هو انفتاح على الوجدان الخاص، ولكنه ينبعث في العلاقة بين الذات والذوات الأخرى، أي في صلب الوجود”الناسي“الذي ليس هو الذاتية المشتركة لأن ما يميز هذه الأخيرة هو كونها ذاتية مسؤولة تقوم على أساس الوعي اليقظ، ذلك لأن الذاتية المشتركة بالرغم من كونها هي أيضا تواجد، أو كينونة معا صحبة الآخرين إلا أنها كيفية أساسية لتفتح كل ذات على ما يخصها وعلى العالم حولها، فالذاتية المشتركة هي نمط العيش المشترك الذي هو نمط الوجود الحر في أفق الفضاء المشترك للإنسانية. في هذا النمط ثمة ما يميز فردا عن الآخرين، وما يميز مجموعة من الأفراد أو الهيئات عن المجموعات أو الهيئات الأخرى، غير أن الكل في الذاتية المشتركة يحرص بكيفية مسؤولة على ضمان قاعدة العيش مع الآخرين، ومن ثمة ينشأ ضرب من التضامن الناتج عن القلق تجاه المصير، والقلق بهذا المعنى قلق مؤسس لوحدة الشعب حيث تتجلى إرادة القوة البانية لأفق وجودها، ويتجلى القرار التاريخي الذي يصير شعبا متحكما بمصيره.
أما الوجود النَاسي”نسبة إلى الناس“، فهو وجود من غير ذات، هو وجود وفق الآخرين، يمكن أن نسمي هذا الوجود بلغة”المسكيني“وجودا هوويا حيث أن هوية المرء لا ترتكن إلى ذاتها، وإنما تستند إلى الناس، فالكل كما يؤكد”هيدغر“يغدو هو الآخر وما من واحد هو ذاته. في هذا الوجود تستمر الرداءة من خلال التقاليد والعادات البالية في إحكام سيطرتها على الأفراد الذين لا يحققون ذواتهم بقدر ما يسعون جاهدين إلى الذوبان في نسق جمعي يكبح إرادتهم في تشكيل وجودهم وفق نمط الذاتية المشتركة.
ينتعش”الأقلوق“في نمط الوجود الناسي، لأنه يستفرد بالأفراد من غير مقاومة، فعلى الرغم من شعورهم بالانزعاج من وجودهم الزائف إلا أنهم ينساقون إلى الرأي الواحد، والسلوك النمطي، والاستسلام لقيم يرونها ثوابت للهوية الجمعية، ذلك لأن الأقلوق يستهدف إضمار الذاتيات، وتقليص الرغبات أي يستهدف إفراغ الحياة المشتركة من الإبداع.
ليس معنى ذلك أن حياة”الذاتية المشتركة“تعيش نمط حياتها من غير”أقلوق“، لكنها بما هي قادرة على القلق في صلب وجودها الحقيقي، فإنها تتمتع بالقدرة على مقاومة الأقلوق، فالفرق بين النمط الناسي أو نمط الحياة العامية أو الزائفة، وبين نمط”الذاتية المشتركة“يكمن في انقياد النمط الأول إلى الأقلوق، فالمهم ليس هو أن يكون المرء نفسه كما في النمط الثاني، بل هو أن يكون مطابقا للغير المبني للمجهول، للناس ، إنه امرؤ وليس كائنا فرديا أي ذاتا متعينة. فالقيمة العليا في الوجود الناسي تقاس على نفي القدرة على الكينونة، إلى حد الاستعاذة بالأنا، فالأنا في هذا النمط ليست مقوما للكينونة الذاتية وإنما هي تعبير شيطاني. ينشر الأقلوق وسواسا بالإثم، لأن هدفه الأساس هو إضمار الأنا فلا يحق للمرء أن يعبرعن أناه، فهذا التعبير يذكِّر بالخطيئة التي يحملها المرء في كيانه، وهو ما يحمل المتكلم عادة في الحياة العامة إلى اللجوء مباشرة إلى التعوذ من لفظ”الأنا“حالما تنفلت في لسانه من خلال اللاوعي. ذلك لأن معاداة الأنا كتعبير عن الخصوصية الذاتية هي ما يطبع نمط الوجود الناسي، فهذا النمط ما يفتأ يطالبنا بأن لا نكون أنفسنا، وهذا لا يعني أنه نمط للغيرية بل هو على العكس من ذلك نفي للغيرية بما هي مقوم”للذاتية المشتركة“التي تظهر فيها كل ذات كانفتاح على الآخر وتكون مسكونة بالاختلاف وقوى الخارج وتكون بالتالي قادرة على المسؤولية، أي على اتخاذ القرار فيما يخصها، فهي تتعرف على نفسها بتفاعلها مع الغير، باعتبارها آخرية غير أنها تظل دوما هي الأنا الآخر الذي بدونه تستحيل الغيرية. إن نمط وجود”الأنا الآخر“يستمد كينونته من مقاومة”الأقلوق“الذي يطالبه بالانسلاخ عن أناه، ومن ثمة ما يفتأ الأنا الآخر مستجيبا لنداء أناه بما هو نداء مسؤولية شخصي، ومن ثمة يتمرن الأنا على المسؤولية، فقوله أنا معناه أنه هو الأنا الآخر المتصالح مع ذاته ومع الغير، ولكنه هو أيضا من يتحمل مسؤولية أفعاله. وبالتالي فهو يعيش تجربته الإيطيقية، فهو بحد أناه نمط خاص لأنويته، هو لا يعيش وفق نمط أخلاقي، فمقومُ كائنيته هو المبدأ الإيطيقي المحايث، أي أنه لا يعيش وفق مبادئ أخلاقية تفصله عن قواه. فمبدأه الإيطيقي المحايث يحفزه على الالتحام بقواه أي بما يستطيع جسده أن يبتكره، فاقتداره هو البرهان العلمي على الاحتفاء بما هو ابتهاج.
يحفز المبدأ الإيطيقي”الأنا“على تجريب القوة، فيوسع قدرة الكائن على مقاومة”الأقلوق“بما هو خضوع لإرادة البؤس التي تنشر العجز والاستسلام لنمطية المجاراة والتقليد والتشابه، إنه بمعنى أعمق توسيع لقدرة تحمل الحياة كما هي. ففي القدرة على تحمل الحياة تنكشف تجربته لا كمسؤولية وحسب، وإنما كفعل إبداعي يحتفي باللحظة، ويمنح الحاضر قيمة عليا، أي أنه يمنح لوجوده الخاص معنى الفرح بما هو خير. فالفرح كما يقول سبينوزا في القضية 41 من الباب الرابع من الإيطيقا”ليس شرا بصورة مباشرة أبدًا، بل هو خير، أما الحزن فهو شر بصورة مباشرة“. (7)
وبرهان هذه القضية هو”أن الفرح انفعال تزداد به قدرة الجسم على الفعل أو تساعد، أما الحزن فهو انفعال تضعف به قدرة الجسم على الفعل أو تعاق، وبناء وبناء على ذلك فإن الفرح خير بصورة مباشرة..الخ“. (8)
إن الأمر يتعلق بمسألة جوهرية ترتبط بنمط الكينونة بما هو اقتدار على تفعيل القوة، يقول سبينوزا في القضية 11 من الباب الثالث:”كل ما يزيد في قدرة الجسم (الجسد) على الفعل أو ينقص منها، ويساعدها أو يعوقها، إنما فكرته تزيد في قدرة النفس على التفكير أو تنقص منها، وتساعدها أو تعوقها.“(9)
وبالتالي فالفرح هو انفعال تنتقل به النفس إلى كمال أعظم، أما الحزن فهو انفعال تنتقل به إلى كمل أقل، انفعال الفرح دغدغة أو بهجة، وانفعال الحزن ألم أو كآبة، وبما أن الأمر كذلك فإنه”لا يمكن أن يوجد في البهجة إفراط، بل هي دائما حسنة، أما الكآبة فهي دائما سيئة“. (10)
وبرهان ذلك هو أن”البهجة هي الفرح المتمثل من حيث علاقته بالجسم، في تأثر جميع أجزاء الجسم سوية، أي أن قدرة الجسم على الفعل تزداد أو تساعد، بحيث تحافظ جميع أجزائه فيما بينها على نفس النسبة من الحركة والسكون. أما الكآبة فهي الحزن المتمثل، من حيث علاقته بالجسم، في أن قدرة الجسم على الفعل تكون متناقضة أو معاقة تماما، ولذلك فهي دائما سيئة“. (11)
إن الانتصار للحياة ينكشف باعتباره إثباتا للجسد باعتبار ما يقدر عليه، فما يؤلف ماهية النفس هو فكرة الجسد الموجود بالفعل، ومن ثمة تسعى النفس إلى إثبات وجود هذا الجسم، وبالتالي فهي تسعى إلى ما ينمي قدرة الجسم على الفعل أو يساعدها. ذلك لأن”كل ما يزيد في قدرة الجسم على الفعل، أو ينقص منها، ويساعدها أو يعوقها إنما فكرته تزيد في قدرة النفس على التفكير أو تنقص منها، وتساعدها أو تعوقها“. (12)
تصبح القوة اقتدارا حينما تملأ بالإنفعالات، ففي كل لحظة تملأ الانفعالات قوتي، ذلك لأن قوتي كما يقول دولوز هي”قدرة capacité لا توجد مستقلة عن الانفعالات. ففي كل لحظة تكون القوة مُفعلّة effectuée. فدائما تكون القوة مفعلة يعني ممتلئة بانفعالات متنوعة، ومن ثمة هناك محوران للوجود: الحزن la tristesse، والفرح la joie وهما انفعالان قاعديان de base، وكل الانفعالات مشتقة عنهما. فالحزن يملأ القوة لكنه يملؤها بكيفية تقلص من قدراتها، أي أن القوة مفعلة بكيفية تناقصية، كما أن الفرح يملأ القوة فيصيرها أكثر اقتدارا، أي يفعلها بكيفية تصاعدية. فقوتي هي كل ما يمكن أن تكونه، وهي دائما منفعلة بانفعالات إما تقلص منها أو تزيد من قدرتها. فالقوة ليست كما، ولكنها رابط بين كميات القدرة، إنها انتقال من كم لآخر، أو أنها كمية متنقلة quantité transitive، أو عابرة نحو قوة عظيمة أو نحو قوة ضعيفة. (14) إنها تفصح عن كيفيتين أسايتين للكينونة: كيفية تتعاظم فيها القوة بفعل الفرح الذي يملأها وكيفية تتناقص فيها القوة بفعل الحزن الذي يؤثر عليها ويعوقها.
ما يمكن استخلاصه من هذه الأنطولوجيا الخالصة كما يسميها دولوز، والتي يسميها سبينوزا بالإيطيقا هو إعادة بنائها للكائنات باعتبارها أنماط وجود، وليس باعتبارها ماهيات، فنحن ككائنات لسنا كائنات وإنما أنماط للكينونة. فالأنطولوجيا الخالصة تقدم نفسها كجوهر وحيد لا متناه على الإطلاق، وهذا الجوهر هو الوجود بما هو وجود، أما الكائنات فهي أنماط للجوهر اللامتناهي إطلاقا. (15)
وبناء على ذلك فإن الأنا ليس ماهية أو وجودا بل مجرد كيفية وجود “manière d’être” أي تركيبا وفق نظام ما في صفة، نظام من الأطراف، وجملة من الأجزاء المتناهية في الصغر والتي تتعالق وفق نموذج من الحركة والسكون، وليس أبدا جنسا أو جوهرا أو صورة، إنه قوة تسعى نحو حدها الأقصى (كوناتوس)، فما يميزني عن الآخرين هو قوتي، لأن وجودي ليس أكثر من جهدي وقوتي الجزئية التي هي جزء من قوة الإله، فلا تحقق لي إلا من حيث أنا جزء من هذه الكينونة العامة المطلقة الشاملة المحايثة لذاتها وصفاتها وأحوالها. والتي نسميها الجوهر“. (16)
إذن فالقوة هي ما يميز الكائن الإنساني باعتبار ما تستطيعه قدرته، وليس باعتبار ما تحدده ماهيته، وليس من هدف لهذه القوة المميزة سوى أن تعبر عن نمط الكينونة بالفرح والغبطة والابتهاج أي بكل ما يمكن أن يجلب كمالا أعظم.
وهذه القوة هي المضاد الحيوي لكل ما يجلب الحزن أو البؤس أو الكآبة، أي لكل ما ينكشف من خلال”الأقلوق“. فليس الأقلوق إلا تعبيرا عن نقص في القوة. إنه نمط لا يستهدف فصل الكائن عن قدرته على الفرح فحسب بل فصله أيضا عن قَلقه، باعتباره تعبيرا عن إمكانيات وجوده، فالوجود لا يقترن بالماهية وإنما بالاستطاعة، بحيث يمكن القول”: (أنا موجود، إذن فأنا أستطيع). ولأن الكينونة تعرف بالاستطاعة، فهي تحصل على الممكنات، بمعنى الفرص والوسائل اللازمة لتحقيقها، وتضع ذلك كله موضع اهتمام، فالآنية (الدازين) في حد ذاتها وجود ممكن“. (17)
إن الأمر يتعلق هنا لدى هيدغر”بكينونة – الهناك بما هي فهم أي بما هي استطاعة، أو قدرة على الفعل،“إن ما يستطاع في الفهم من حيث هو وجوداني، ليس ماذا ما، بل الكينونة من حيث هي فعل وجود. إذ ينطوي الفهم، من ناحية وجودانية، على نمط كينونة الدازين بوصفه مستطاع –كينونة. ليس الدازين قائما في الأعيان، يمتاز بكونه شيئا ما نافلة، بل هو بَديا ممكن –كينونة. إن الدازين هو في كل مرة ما يمكن أن يكون وَكيفما يكون إمكانه.” (18)
معنى ذلك أن الفهم يقود الكينونة بوصفها وجودا في العالم إلى إمكانات وجودها، مما يعني أنها توجد في عالم الممكنات والبدائل التي تختار من بينها ما يؤكد نمط وجودها، أي أن الفهم، من حيث هو استشراف، هو نمط كينونة الدازين الذي ضمنه هو يكون إمكاناته بوصفها إمكانات“. (19)
الاستشراف هو طريقة الدازين في أن يكون إمكانات وجوده، وهو ما يشكل البنية الوجودانية للفهم التي تجعله قابلا للنفاد دوما في كل الأبعاد الجوهرية القابلة للانفتاح إلى إمكانات.
يقترن الفهم بالوجدان من حيث كونهما يشكلان نمط الكينونة الذي من شأن الانفتاح، ومن حيث أن القلق وجدان، أي من حيث هو إمكانية كينونة في الدازين على صعيد واحد مع الدازين ذاته المنفتح فيها، فهو ما يهب أرضية الظواهر اللازمة للإمساك الصريح بالكلية الأصلية لكينونة الدازين. كينونته التي تكشف النقاب عن نفسها باعتبارها ضربا من العناية. (20)
لكن بأي وجه يكون القلق وجدانا متميزا؟ (21)
يؤكد هيدغر أن”القلق من حيث هو ضرب من الوجدان، إنما يفتح رأسا العالم بما هو عالم“. (22) ومعنى ذلك أن من خلال القلق تنفتح الكينونة على العالم، وتوضع أمام إمكانات وجودها. أي أنه أداة لكشف التركيب الوجودي الأساسي للآنية (الدازين)، وهو حقيقي بحيث يسمح لنا برؤية الاختلاف بين العالم والذات، ويمكنه ان يكشف عما لا تكشف عنه خبرات عديدة، وسرعان ما يضعنا إدراكنا لوجودنا- في- العالم بوصفنا موجودات حرة وجها لوجه بإزاء تلك المسؤولية الخطيرة التي لا بد لنا من أن نفصل فيها لحسابنا الخاص، فالقلق يفصلنا عن عالم الأشياء والأدوات لكي يردنا إلى عالم الوعي أو الذات، وهو يعين الآنية على فهم ذاتها بطريقة صحيحة ويرد الكائن الحر إلى إمكانيات وجوده.” (23)
يقول هيدغر “إن شأن القلق أن يجلوَ في الدازين عن الكينونة نحو أخص مستطاع-كينونته، نعني الكينونة الحرة إزاء حرية اختيار أنفسنا وإدراك أنفسنا. فالقلق يحمل الدازين أم كينونته الحرة إزاء... أصالة كينونته من حيث هي إمكان هو يكونه بعد دوما.”(24)
يميز القلق وفق هذا التأويل تحقيقا للقدرة، باعتباره شرط إمكانها القبلي، فهو الذي يضع الكينونة في مواجهة قدرتها الخاصة على الوجود، ويكشف عنها كمشروع للحرية. وقوة القلق الكاشفة “إنما تكمن في مواجهة الآنية بحريتها المتناهية لوجودها- في العالم”. (25)
إذن فالقلق “يفتح الدازين بوصفه” كينونة ممكنة، بل حتى بوصفه مالا يستطيع أن يكون إلا انطلاقا من ذات نفسه، من حيث هو معزول في عزلته“. (26)
يمكننا تأويل الكينونة الممكنة بوصفها القوة التي تجعلنا نعيش وفق ما نستطيعه من إمكانات، إنها كيفية اقتدار، فأنا أكون بقدر ما أنا قادر على الكينونة، ولن أكون كذلك إلا بقدر ما أكون أنا هو ذات نفسي. لست مجرد ماهية، بل أنا حال أو نمط خاص لكينونتي الحرة. ليست الكينونة الممكنة التي تصير بقدرتها حرة أو نمطا خاصا، سوى كيفية من كيفيات الوُجود الأصيل. وبذلك يغدو القلق مضادا حيويا للعجز والابتئاس، فهو الذي ينتزعني عن الوجود الزائف، وينقدني من الانحطاط ومن العدمية، ويردني إلى إمكانية وجودي.
أي أنه يحررني من السقوط في عالم الناس، وينزع عني سيطرة الآخر، أي أنني في كل مرة أرتبط في كل مرة في كينونتي مع غمكانيات نفسي. فالدازين يكون”حرا“بالنسبة إلى مستطاع كينونته الأخص له ومن ثمة بالنسبة إلى إمكان الأصالة وعدم الأصالة ينكشف ضمن تجسيد أصلي في عنصر القلق. لكن الكينونة نحو مستطاع الكينونة الأخص إنما تعني على صعيد أنطولوجي: أن الدازين هو بعد أبدا في كينونته متقدم على نفسه،.. فهو دائما بعدُ”فيما هو أبعد من ذاته“، ليس من حيث هو سلوك إزاء كائن آخر، هو ليس هو، بل هو من حيث كينونته نحو مستطاع الكينونَة الذي يكونه هو ذاته...” (27) أي يتعلق الأمر بقدرته على الكينونة –في العالم وضمن ذلك بالانشغال الكاشف بتبصر عن الكائن الذي داخل العالم. إنه ضمن هيئة الكينونة من حيث هو عناية، ضمن الكينونة- المتقدمة- على ذاتها، إنما يكمن الافتراض الأرسخ أصلا. لأن كينونة الدازين قد خصت بكونها تفترض نفسها على هذا النحو“. (28) إذن ينكشف بعد القلق كقدرة خاصة على الكينونة، بمثابة الأساس المتين للكينونة الحقة، مادام أنه بوسعها أن تفترض ذاتها الحقيقية بما تحققه إمكاناتها من إمكانات تضعها على الطريق نحو الحقيقة بما هي قوام أساسي للدازين.
بعبارة”سبينو-هيدغرية“يمكن اعتبار القلق باعتباره وجدانا متميزا كيفية من كيفيات الاقتدار بما هو قوة الانفتاح المتصاعدة، أي قوة قادرة على الكينونة الأصيلة. تغدو الكينونة لدى هيدغر كما لدى سبينوزا الدولوزي كيفية كينونة وليست ماهية، بل هو من يحتمل ماهيته على نمط مخصوص وحدها الأشياء قائمة، أما الإنسان فهو لا يمكنه إلا أن”يوجد“أي أن يحتمل ممكن كينونته نحو مستطاعه الأخص له بوصفه ضربا من العناية بالكينونة في العالم فهما ووجدانا وتزامنا وجديا... ومن ثمة فإن”وجود“Existenz لم تعد”أن الشيء كائن“بل طريقة كينونتهِ. فالدازين هو”كيف –يكون“وليس”أنه-يكون“(29) وتحقيق الكيفية مشروط بالاستطاعة بما هي تفعيل للقوة.
أن أكون معناه أنني أستطيع أن أوجد على نحو الكينونة الخاص بي، إذ أغدو مقتدرا على خلق إمكانية تحمل ذاتي في العالم، وإذا كان سبينوزا قد أكد على الفرح باعتباره تفعيلا للقوة بكيفية متصاعدة، أي من خلال إيصالها إلى كمالٍ أعظم، على النقيض من الحزن الذي يجعل القوة منفعلة، فيقودها إلى كمالٍ أضعف أو أقل، فإن هيدغر يجعل من القلق وجدانا متميزا بما أنه يفعل الاقتدار ويقود الكائن نحو كينونته الأخص، فينقد قوته من التلاشي في الهُمْ، ويحرره من سلطة”الأقلوق“، فيستعيد الكائن ذاته بما هي انفتاح على الوجود الأصيل.
وهذا يساعدنا على أن نضع مقابل”حزن“سبينوزا، مفهوم”الأقلوق“وهو مفهوم على النقيض من”قلق“هيدغر بالطبع، ليست هناك أية إشارة إلى هذا المفهوم لدى هيدغر، لكن بما أن مقام محايثته هو الوجود الزائف، فبإمكاننا أن نمسك بكينونته هناك، ذلك لأن”الأقلوق“هو المقوم الأساسي لهذا الوجود الزائف، وهو يكشف عن نمط كينونة لا مقتدرة، كينونة لا تقدر أن تكون وفق ما يخصها، بل هي نتاج لقوة غفلية تسيطر على الكائن، وتحدد معايير ذوقه وأخلاقه، فيصير منمطا، وكائنا من غير ذات حقيقية، إذ أنه غارق في وجود زائف من غير قرار ما دام منقادا لما تمليه سلطة”الأقلوق“. ذلك لأن ما من أجله يكون الأقلوق هو حَيَاة مبنية للمجهول، لا أحد فيها يكون مبنيا للمعلوم. أو ذاتا متعينة قادرة على اختيار إمكاناتها الخاصة، فالحياة المبنية للمجهول هي حياة في اشتراك مع الناس من غير ذوات مشتركة، أي من غير اقتدار على الكينونة. ومن ثمة فالأقلوق ليس من القلق في شيء، بما أنه يفصلنا عما نستطيع، ويلقي بقوانا إلى عالم الناس فنغدو ككرات تتقاذفها حركة الأقلوق في مقام الوجود الزائف المفعم بالغم،أي بما هو انحطاط وبما هو بؤس، وبما هو عجز شامل.
أن تكون عاجزا معناه، أن تكون مسكونا بالأقلوق، الذي ما يفتأ يذكرك بأنك لا تستطيع أن تكون ذاتك، أنت مجرد شبيه بالهم، وهو يذكرك بأن الحياة اللامتميزة، أي التي تجري وفق مشيئة الناس هي الحياة الحقة، ومن ثمة يخلق الأقلوق جزعا للكائن فيرتكس منقلبا على عزيمته، ومن ثمة تتقلص قوته إلى أدنى مستوياتها، فيهرب بالتالي عَمَّا بدا له نوعا من المخاطرة، أو المغامرة الخطرة، فيضحي بذاته فداء لصالح وجود يرى أنه يرضيه ،وهكذا يقتنع بأن لا شيء يستحق التجربة، إن نمط وجوده كما يتجلى في حياة”الهم“لا تجريبي، وإنما هو تكرار دائم للتطابق مع مشيئة الهم التي هي مشيئة الأقلوق، حيث ثمة جزع دائم من التجريب بما هو إمكان الكينونة. ليس على الكائن إذن أن يفعل ما يقدر عليه، بل عليه أن ينفعل بالمعطى الموجود سلفا.
تغدو هنا التبعية هي النمط الذي يفرضه”الأقلوق“على الكائن، فينتزعه من قله الخاص، ويلقي به في خضم جزع ينآى به عن تجريب إمكانياته. ومن ثمة يعلي من قيم تمجد الخضوع والاستسلام، ويبخس الابتكار أو الإبداع باعتبارهما انفصاما عن حياة”الهم“. وانزياحا عن الثوابت.
إذن يقوض الأقلوق الإمكانيات التي يكشفها القلق، بما هو مشروع كينونة متزمنة، وبذلك يختلف الأقلوق عن القلق، في كونه يفصل الكائن عن تزمنه بوصفه استشرافا لمستطاع كينونته مستقبلا، أي لأجل أن يكون هو ذاته المتعينة في قدرتها على كشف وجودها كاختلافٍ يميز وجودها الحر الذي يتعين كلحظة من لحظات الاقتدار. فالاقتدار هوإعراض عن الأقلوق، خط انفلات هروبي عن الغم الذي ينشره الأقلوق،وانفتاح على القلق بما هوإمكانيتنا على تحمل مسؤولية كينونتنا في العالم،القلق لا يكدر حياتنا بالغم ولكنه يوجهنا الى مستقبل نصنعه بذواتنا،وما نصنعه بذواتنا يصير هو ذاته طريقنا نحو ما يبهجنا، فبقدر ما نقلق إزاء مستطاع كينونتنا بقدر ما نغدو مستقبلا في زمانيتنا الخاصة مفعمين بالفرح.
أن نقلق معناه أن نتحرر من هذا”الأقلوق“الذي يحولنا إلى كائنات حزينة، لأنه يخلق فينا جزعا دائما من إمكانية اكتشاف قدرتنا على ابتكار ما يميز وجودنا ،ويجعله موسوما بالاختلاف.
إن الأقلوق إذن هو الذي يجعلنا في خصام دائم مع رَغبات جسدنا، ومع ذواتنا الحرة، ويقوض أسلوب تعاملنا الحر مع الغير، فلا يسمح إلا بنوع من المجاراة الدائمة لنمط حياة غفلي. فأنا لست أنا إلا بقدر ما أنا هُمْ، وبالتالي فبقدر ما لا يسمح لي الوجود الغفلي بأن أكون ذاتا، فإني أكون بدوري حريصا على التصدي لكل اختيار، ولكل ذات تشرع في اختبار إمكانات وجودها الحر.
معنى ذلك في نهاية التحليل أن”الأقلوق“هو إتلاف للكينونة بما هي ”عِلَّة تأسيسية“ تنكشف كقوة للاقتدار تصنع مصيرها الخاص، وتستمتع بما يمكن أن تنعم به في ديمومتها. فالتأسيس لإمكانية الوجود هو فعل الغبطة التي تحول ما ينفتح في أفق استطاعة الكينونة إلى ما يبهج. والحال أن”الأقلوق“يحول دون تحقيق ما ينفتح فيلقي بالإنسان في عالم النكد والغم والحسرة والندم، ومن ثمة ينكشف ككائن حاقد، يلجأ إلى الضغينة من أجل تسميم الحياة، وجعلها كريهة ليس معنى ذلك بالضرورة أن الكائن يغدو زاهدا في حياته، بل يصير في ديمومته أكثر تسلطا وأكثر عداء لكل ما ينفتح مختلفا. إن المتسلط هو أداة”الأقلوق“التي ينشر بها المشاعر الحزينة، والنكدية، والتي لا غاية لها سوى قمع لحظات فرح الإنسان وغبطته.
أن نفهم الأقلوق معناه أن نتفلسف، بحيث نفعل قوَانا من خلال ما نستطيعه بالنظر إلى قدراتنا، فنصير محدوديتنا وتناهينا إلى إمكانيات للاستطاعة، ونلقي بأقلوقنا إلى عدم، ونحول عدمنا إلى قلق، وقلقنا إلى فرح. فالفلسفة كما يقول”جانكلفتش“هي مبدأ الفرح. بل هي الفرح ذاته.
هذا لا يعني بالطبع أننا لن نعيش من غير”أقلوق“بل يعني أن نكون أقدَرَ على مواجهته، أي أن نمتلك قدرة التحويل التي تمكننا من أن نكون بفعل استطاعتنا كينونة أنفسنا.