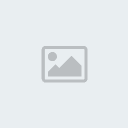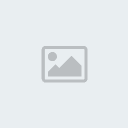
تنتصب معضلة كبرى لدى الأديان التوحيدية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، عمادها الخلط بين الدين والتدين، بين الدين والفكر الديني، بين الدين والشريعة. يتسبب هذا الخلط في إلغاء الفوارق بين ما هو إلهي ومقدس وبين ما هو بشري خاضع لمنطق الزمان والمكان والبيئة التي انطلق منها أو امتد اليها. على امتداد التاريخ، ولاختلاط الديني بالاجتماعي والسياسي، وترافقاً مع مأسسة الدين، ألغى رجال المؤسسة الدينية ذلك الفارق، ودمجوا بين اللاهوت وبين النص المقدس، ونصّبوا أنفسهم حراس هذا النص، بل وجعلوا من كل اعتراض أو نقد لما يقولون به كأنه هجوم على النص المقدس نفسه، بل وحولوا أنفسهم إلى قديسين وأولياء يحميهم الإنتماء إلى الكهنوت الخاص بكل دين. دفعت الشعوب في العالم، ولا تزال، أثماناً باهظة لهذا الدمج بين الدين والفكر الديني، وأنتج هذا الدمج خلافات وصراعات بين المذاهب والفرق، وفقهاً مجبولاً بالكراهية للآخر ومقروناً بتهم التخوين والهرطقة. لعل ما يشهده العالم الإسلامي اليوم من انبعاث للتطرف ووسم الإسلام بالعنف بشكل مطلق، بل واتهامه بأن الأصل في قيامه هو السيف، ليس إلاّ واحداً من نتائج هذه القراءة المغلوطة للنص المقدس. ما يعيشه اليوم الإسلام والمسلمون سبق للمسيحية أن عانت منه وبأشكال أشد عنفاً ودموية، وهو ما جعل نقد المسيحية وفكرها الديني عنصرًا مركزياً في الإصلاح الديني الذي انتهى إلى إعادة الدين إلى موقعه الروحي والإنساني، وفصله عن السياسة، وهو أمر شكل أحد عناصر الحداثة والتحديث والتقدم والتطور في المجتمعات الغربية. من الكتب التي ناقشت في هذا الموضوع، وخصوصاً بما يطال الدين الإسلامي، كتاب :“الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع” لعبد الجواد ياسين. صدر الكتاب عن “دار التنوير في بيروت”.
الدين والتشريع
تمثل مسألة التشريع جوهر النقاش الملتبس والملغوم السائد منذ العصور الإسلامية الأولى، وحجر الزاوية في الفقه ومعه الفكر الديني. خلافاً للخلط المقصود بين الدين والتدين، فإن التشريع يقع داخل التدين وليس الدين. أي أن التشريع يقوم في دائرة المتغير والمتبدل والقابل للتطور، وليس في دائرة الثابت الممتنع على التغيير، أي ما يتعلق بالجوهري في الدين من قيم روحية وأخلاقية وإنسانية. لا شك أن كتب الفقه، في الصياغات التي لجأت إليها، اختزلت الدين إلى جملة تشريعات، مما طرح دائماً إشكالية مدى التوافق بين هذه الأحكام التشريعية وبين الحاجات البشرية المتبدلة على مر الزمان ووفقاً للبيئة المختلفة بين منطقة وأخرى أو بلد وآخر. لا يخفى أن الأحكام التشريعية كانت تصدر دوما جوابا عن حاجات بيئة محددة، وهو أمر يعود إلى زمن نزول النص في عهد النبي، حيث كان مضطرًا لإعطاء أجوبة وأحكام على واقع جديد في توجهاته الدينية، ولم تكن هذه الأحكام من جوهر الدين بمقدار ما كانت تفرضها متطلبات الوضع المستجد. ومن المعروف أن النبي كان يتحاشى قدر الإمكان الدخول في الأمور الحياتية الناجمة عن حاجات التطور الاجتماعي، ويعتبر أن دوره المركزي متعلق بالدين بما هو عقيدة وتقوى وروحانيات وأخلاقيات.. وهو القائل لجماعته :“أ نتم أدرى بشؤون دنياكم..إذا كان شيئاً في أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان شيئاً في أمر دينكم، فلي”. تتخذ هذه المسألة أهمية اليوم من كون المؤسسات الدينية ومعها تيارات الإسلام السياسي تصر على استحضار الأحكام التشريعية القديمة وإسقاطها على الزمن الراهن غير عابئة بما طال المجتمعات العربية والإسلامية من تطور واختلاف، بما يجعل هذه الأحكام غير ذات صلة بواقعنا الراهن. ما يزيد من استحالة اعتماد هذه الأحكام أن بعضها متصل بزمان الجاهلية نفسها، حيث لم يستطع الرسول نفسه تجاوز كل العادات والتقاليد السائدة في ذلك الزمن، فكان عليه أن يتكيف مع بعضها ويأخذ ببعضها الآخر. لذا “نحن حيال تفرقة واجبة بين الدين وأدوات الاتصال بينه وبين البشر، وهي عملية ضرورية لفهم التفرقة الواجبة الأخرى داخل النص بين ما هو مطلق ينتمي إلى الدين في ذاته، وما هو نسبي قانوني ينتمي إلى الإجتماع”.
لا ينفرد الإسلام بهذا التمييز بين الدين والشريعة الناجمة عنه، فقد سبق لليهودية أن مرت بذات الإشكالية، حيث اعتبرت الشريعة جزءًا “من صفقة التدين التي عقدها موسى – ممثلاً للشعب – مع الله”. وفي الأصل، أعلن موسى عن لوحة القوانين التشريعية جنباً إلى جنب مع الوصايا العشر التي تمثل مباديء الدين اليهودي بجوانبها الإيمانية والأخلاقية. وفي المسيحية، نرى أن النصوص المبكرة التي وردت في الأناجيل على لسان المسيح ربطت بين الله وأخلاق المحبة وطهارة القلب. بعد وفاة المسيح، وعلي يد تلامذته خصوصاً منهم بولس، كانت نقطة البداية التي انطلق منها هي إعلانه أن الشريعة ليست من صلب الدين، وأن “الانسان يتبرر بالإيمان، بدون أعمال الناموس”. في الإسلام، كانت الأحكام التكليفية ترد متفرقة وتباعاً جواباً عن تطورات الواقع وحاجاته، ولم تسقط دفعة واحدة بخلاف ما يتصل بالعقيدة التي كانت واضحة أحكامها منذ بداية الدعوة. ما يجمع بين اليهودية والمسيحية والإسلام أن الأصل في تشريعاتها هو الواقع الاجتماعي الذي تعمل من داخله. وفي العودة إلى الإسلام، من المعروف وفق الروايات التاريخية، أنه في بعض الحالات كان الحكم التكليفي ينطق به الرسول عند الحاجة المباشرة إليه، ثم يأتي عليه لاحقاً نص في القرآن. “إن أحكام القرآن التي تنتمي عموماً إلى النص المدني، وصلت إلينا من خلال معالجة النص للوقائع والأحداث، ولم تصل إلينا في شكل مقولات كلية أو منحوتة نظرياً”. لكن العقل التدويني في الإسلام ظل بعيدًا عن التقاط المعنى الاجتماعي والبعد النسبي لهذه الأحكام التشريعية ومدى ارتباطها بظروفها الجغرافية، بل على العكس، عمل على إلحاق هذه الأحكام بالمطلق الديني، واعتبارها جزءًا من بيئة النص التي صارت مقدسة. كما لم يستطع هذا العقل إدراك أن النص التشريعي كان جزءًا من محيط تشريعي أوسع يتضمن العرف السائد الذي يمثل الأصل، وكان النص التشريعي يستهدف أساساً معالجة الحالات الواقعية على نحو آني، ولذلك كان يعتمد في صياغته على الواقع ويبني عليه“. لعل في هذه النقطة بالذات يكمن الأصل الدوغمائي في الإسلام والعجز عن مواكبة التطور والتحول الاجتماعي في الجغرافيا التي يقيم فيها. فالتحدي الذي يواجهه الإسلام، سابقاً وراهناً ومستقبلاً، هو المتصل بالتطور، أي الشق الاجتماعي المتغير بطبيعته، وهو الشق الذي صنعه تاريخ التدين، فيما لا يعود التحدي إلى الشق الإيماني الأخلاقي الذي يمثل جوهر الدين.
في قراءة النص وتفسيره
كيف نقرأ النص الديني وكيف نرى إلى موقعه في الاجتماع، مسألة من أصعب القضايا التي تواجه الدين والفكر الديني. تعرضت المسيحية إلى نقد قاس لنصوصها الدينية الواردة في الأناجيل، وكان أهم ما واجهته هو إخضاعها للقراءة التاريخية ونزع القدسية المطلقة عن محتوياتها والتعاطي معها في وصفها نصوصاً بشرية خاضعة لمنطق الزمان والمكان والجغرافيا. تبدو المعضلة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الإسلام، فالنص المقدس الأساسي أي القرآن، جرى التعاطي معه بأنه في مجمله يتجاوز الزمان والمكان ولا يخضع لتعديل أو اجتهاد. أدت مقولة”اللوح المحفوظ“إلى قطع الطريق أمام أي نقاش يريد أن يظهر التفاعل الطبيعي بين النص والاجتماع، وتعيين أسباب النزول بكونها مظهرًا لهذا التفاعل. في الصراع على كيفية قراءة النص الديني، قراءة حرفية أم قراءة عقلانية تاريخية مفتوحة، يقوم حيز أساسي على مدى انفتاح الإسلام على التطور ومواكبة العصر. وهذه القراءة، السلبية أم الايجابية، تتدخل اليوم في صوغ أيديولوجيا تيارات الإسلام السياسي وممارساته في أكثر من مكان في العالم الإسلامي.
يقوم تساؤل مشروع حول أين تكمن العبرة، هل بمجرد ورود الحكم في النص وكل شكلياته، أم بمضمون هذا النص وما يهدف إلى التعبير عنه؟”فالعبرة بمجرد النصية تعني أن مجرد ورود الحكم في نص معين يعني أنه صار مطلقاً في الزمان، بغض النظر عن المحيط الاجتماعي الذي استدعى وروده، والذي تم تفصيل النص على مقاييسه وحاجاته، وما إذا كان هذا المحيط الاجتماعي لا يزال قائماً بهياكله وأبنيته الاقتصادية والثقافية أم لا“. أما العبرة بمضمون النص فتقوم على”وجوب النظر في هذا المضمون كي نفرق بين المطلق الذي ينتمي لأصل الدين (الإيمان بالله والأخلاق الكلية)، فهو ثابت في الزمان، وبين النسبي الذي يتعلق بالاجتماع المباشر (كالتشريع)، فهو متغير بضرورة الاجتماع، حتى لو تضمنه نص“. وفي تدقيق ببعض النصوص القرآنية نعثر على أحكام تشريعية تبدو واضحة في صلتها بأطر اجتماعية وثقافية إقليمية مخصوصة، من قبيل أحكام الرقيق والزواج والعقوبات والقتال وتوزيع الغنائم وغيرها...هكذا يمكن القول أن القاعدة التي تحكم سريان التشريع أوعدمه تصدر من صميم الواقع التاريخي، أي من داخل الاجتماع تحديدًا.
لم تنزل الأحكام ذات الصفة التشريعية في القرآن دفعة واحدة، فهي كانت محكومة بطبيعة الواقع التاريخي، حيث كانت الآيات تنزل لمعالجة حالات آنية تظهر يوماً بعد يوم، وقد حدث ان كثيرًا من الآيات التكليفية كانت تتغير خلال فترة الوحي، والدليل عليها أن النص القرآني كما تكوّن في صيغته الأخيرة المجمعة، يحوي أحكاماً متغايرة بل ومتناقضة أحياناً، وهي تعبير عن المسار الاجتماعي المتحرك الذي كانت الدعوة تعمل من خلاله. وفي مرحلة التدين اللاحقة، وانتشار الفقه بشكل غير مسبوق بدا أن”المشكل يقع في ثقافة التدين التي أفرزت رؤية مفهومية للنص تفصل بينه وبين الواقع الذي التبس به في مرحلة التنزيل.. وهو مشكل لا ينفرد به التدين الإسلامي، بل ورثه من التاريخ الديني العام“.
تتمظهر مشكلة قراءة النص الديني مع انتشار التفسير لهذا النص. فالتفسير، وبحكم مادته، يبدو الأشد قرباً بل والتصاقاً بجسم النص. لكن معضلة التفسير كما تبلور في معظمه خلال الفترة الزمنية التي تلت وفاة الرسول، أنه لم يناقش تغيّر الأحكام القرآنية مع تغير الظروف الاجتماعية، بل”وجد ذاته تحت ضغط الواقع الاجتماعي مضطرًا إلى إعادة تأويل النصوص بغرض التكييف بينها وبين تحولات الواقع الاجتماعي التي يفرضها الزمن“. وتزداد معضلة التفسير أنه تبلور واتسع مع تكريس الصراعات المذهبية والطائفية التي شقت المسلمين إلى فرق متناحرة، عمدت كل واحدة إلى التماس تفسيرات للنص القرآني بما يخدم أهدافها ومصالحها ويعطي مشروعية لصراعها مع الفرق الأخرى سواء أكان الأمر متصلاً بالصراع على السلطة والموارد، أم لنشر كل فرقة لمذهبها وتكريس ثقافتها الخاصة عن الدين. وقد عزز الفقه الرؤية النقلية للنص، رغم ان الفقه يشتغل على المنطقة الاجتماعية من النص، وهي المنطقة الأكثر والأسرع تعرضاً لعوامل التطور والتغيير بفعل الاجتماع. لذلك اشترك الفقه والتفسير في العجز عن إدراك البعد الزمني للنص الديني، ورفضا الاعتراف بالطبيعة التاريخية لهذا النص. وفي هذه النقطة نرى تجليات التصنيم والدوغمائية التي صبغت النص الديني وعجزت عن المساهمة في نقل المجتمعات العربية والإسلامية إلى الدخول في التاريخ والعصر.
لم يجر تصنيم النص من دون معركة اضطر لها الفقه النقلي ومعه التفسير التقليدي مع”علم الكلام“وبعض الفرق التي قاربت القراءة العقلانية للنصوص الدينية. لعل أبرز المعارك كانت مع فرقة المعتزلة التي قاربت البعد التاريخي للنص التشريعي، وإن تكن عجزت عن الوصول إلى بلورة متكاملة لمفاهيمها، وهو أمر يتعلق بدرجة التطور الفكري والثقافي لأصحاب هذا العلم. شكلت ثلاث قضايا قارب فيها علم الكلام المعتزلي البعد التاريخي للنص القرآني، أولها الجدل الذي دار حول خلق القرآن، وما إذا كان قديماً أزليا، أم كان مخلوقاً في زمن محدد. وثانيها تتصل بالجدل حول الإرادة الإلهية،”وما إذا كان تعلقها بالحوادث المتغيرة في الزمن، ينطوي على قول بالتعدد والحدوث، أي يتنافى مع وحدانية وأزلية الله؟“، وثالثها يتعلق بالجدل الذي تمحور حول الإرادة الإنسانية، والذي دار تحت عنوان القدر ثم تحت عنوان الجبر والاختيار، وكل ما يتصل بمسؤلية الإنسان عن أفعاله وبالحرية في خياراته. هكذا، شكلت”الرؤية النصية التقليدية، التي تضفي مرجعية نهائية على النص، من دون تفرقة بين الثابت الكلي المطلق، وبين المتغير التفصيلي اللصيق بالواقع الاجتماعي، وقفت حاجزًا بين علم الكلام بأدواته العقلية وبين النظر في فاعلية الواقع الاجتماعي حيال النص، سواء في مرحلة تشكله الأولى، أو في المراحل الزمنية اللاحقة التي يراد تطبيقه من خلالها“.
آيات الجهاد
تشهد المجتمعات العربية منذ عقود ازدهار الإرهاب والتطرف الديني، تشكل آيات الجهاد الواردة في القرآن الأساس الأيدولوجي الذي يلهم الإسلام السياسي وممارساته العنفية. يستحضر هذا الإسلام آيات نزلت في زمن الدعوة وانتشارها والصراعات التي واجهتها، ويسعى إلى إسقاطها على الزمن الراهن. ولأن النص الديني لم يخضع إلى مراجعة تاريخية، ولأن المؤسسات الدينية ومعها الفقه يصران على الدمج بين الدين والتشريع مغيبين التمييز بين ما يتصل بجوهر الدين وما يتصل بالاجتماع، كان طبيعيا أن تستلهم تيارات الإسلام السياسي آيات وردت في القرآن وتعمل على تطبيقها على الأرض، وهو تطبيق يجد ترجمته في أعمال القتل والجلد والرجم والتهجير لكل من لا يقول قول هذه التيارات. هكذا تختزل معظم تيارات الإسلام السياسي الدين الإسلامي عبر آيات تكليفية تقادم الزمن عليها، وتصر على انها تحقق مقاصد القرآن ورسول الله.
”تقدم لنا آية السيف مثالاً نموذجياً لأداء الفقه السلفي في موضوع النسخ الذي تحول بين يديه من “واقعة” تشريعية يلزم ثبوت اتجاه قصد المشرع إليها بالدليل الحسي، وتتعلق بعدد محدود من الآيات، إلى آلية تأويل أصولية يجري إعمالها بالاستنباط الاجتهادي، عبر الجسد الكلي للنص القرآني“. فالنص القرآني، أراد معالجة الحالات الظرفية التي فرضها الوضع القائم زمن الدعوة على الجماعات المسلمة الأولى، حيث كانت حالات الحرب بمثابة إفراز اعتيادي لحالة المجتمع القبلي في ذلك الزمن. لم يتعاط الفقه مع هذه المرحلة في كونها لحظة حرب عابرة في تاريخ الدعوة، ف”استخلص منها حكماً “نصياً” في غاية الخطورة من حيث مخالفته لجوهر الأخلاق. فهو يربط صراحة بين الكفر وحل الدم، ويجعل من ذلك القاعدة الأساسية التي تحكم علاقة المسلمين بالأغيار.. لقد وردت آية السيف ضمن الآيات الافتتاحية لسورة التوبة، وهي نموذج واضح من نماذج الحضور الاجتماعي في النص الديني. فهي تحتوي على تسجيل مباشر لوقائع ومعالجات سياسية : الوقائع محلية آنية بامتياز، والمعالجات مؤقتة وذات طابع انتقالي“. هكذا جرى تحويل الغزو”القبلي“تحت اسم الجهاد إلى فريضة دينية أبدية تتجاوز الزمان والمكان ومفروضة عل المسلمين أينما كانو وفي أي زمن عاشوا. وبناء عليه، تم تقسيم العالم إلى قسمين : دار الإسلام ودار الحرب، كما تم الربط بوثاق شديد بين حل الدم وحالة الكفر أو عدم الدخول في الإسلام، مما يعني ضرورة المبادرة إلى القتل والاستمرار في ذلك حتى يدخل جميع الناس في الدين الإسلامي، أو يدفعوا الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب. لا يعود هذا الكلام إلى خمسة عشر قرناً مضت، لكنه يجد تجسيده اليوم بأبشع صوره في الطفرة الإرهابية الصاعدة في المجتمعات العربية والإسلامية، والمصرة على احتكار السماء ودينها الإسلامي والإعلان صراجة أن ما تقوم به إنما هو تطبيق الشريعة كما نص عليها القرآن وما تبعه من فقه وتفسير ما زالت المؤسسات الدينية ترى فيه عين الصواب، حيث أن الفقه، وفق وجهة نظرها، قد توقف منذ ألف عام بعد أن قال الفقهاء في الدين والشريعة كل شيء، ولم يعد هناك مزيد لمستزيد.
”في حقيقة الدين لا يوجد شيء اسمه القتال لنشر الدين، أو القتال للدعوة إلى الدين، لأن الدين في ذاته اعتناق، واعتناق حر بالأساس، ومن هنا لا يمكن للقتال أن يتعلق به". في زمن تنقلب فيه الحقائق الدينية، ألا يعتبر ذلك الفرصة المناسبة لمباشرة إصلاح ديني في الإسلام، يفرز بين ما يتصل بالدين وحقائقه وجوهره الأخلاقي والروحي، وبين ما يتصل بالاجتماع وشرائعه المتبدلة مع تغير الزمان والمكان، بما يستجيب لحقائق التطور والتغيير الدائم في الاجتماع البشري؟