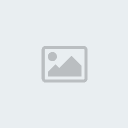
لا مناص لكلّ من يروم الاستفهام
عن أصل الشرّ والتعاسة التي سكنت بقاع الأرض وطالت البشرية، أن يصطدم
بقصّتين غريبتين كلتاهما تحيل على أنّ السبب في ذلك هو امرأة. لكن من تكون
هذه الأخيرة؟ ما اسمها؟ وكيف حصل صكّ الاتهام في حقّها؟ هذا ما سنحاول عبر
هذه المقالة تبيانه، مقتفين في ذلك منهجا جنيالوجيا، سواء بالحفر في أسطورة
الشرّ أو بالتنقيب في جغرافية المعرفة. على هذا الأساس نتساءل عن مكانة
العلم في جنيالوجيا أسطورة الشرّ التي نحن بصدد تفكيك أزرارها؟ لِمَ العلمُ
قاتلٌ في رحاب الجنة؟ ألا يجب علينا أن ننظر إلى الحقد والضغينة التي
تعاني منها النساء في المسيحية واليهودية والإسلام، على أنها النتيجة
المنطقية لكراهية هذه الأديان للعقلانية؟ لنعد إذن إلى القصّتين، اللتين
تحكيان أنّ حواء -في الديانات التوحيدية- وباندور -عند الإغريق- هما علّة
زوال السعادة وسبب انتشار الشرّ. ذلك أنّ ضلع آدم ما أن صار مستقلا بذاته،
حتى أغوته أفعى، دعته إلى أكل الفاكهة المحرّمة، وبالتالي انتهاك حرمة
المقدس وعدم الانصياع لقانونه. لقد وسوست الأفعى (الشيطان في الإسلام)
ونبست في أذن أوّل امرأة، ملحّة عليها، بأن بوسعها التصرف بكل حرية وعلى
نحو مستقلّ دونما اكتراث بالأوامر الإلهية، مؤكّدة لها أنّ آكل الفاكهة لا
يموت، وبأنّ من ابتكر الفاكهة يحوز كلّ المعرفة التي بها تستنير الأبصار.
وعلى هذا الأساس يتبدّى أنّ الفاكهة المحرّمة موضوع النزاع مع الله ليست
في شيء مجرّد تفاحة عادية، بل هي فاكهة المعرفة التي تُثْمرها شجرة بنفس
الاسم(شجرة المعرفة). لكن لنسجّل نقطة نظام هاهنا ونؤكّد أن القرآن يُبْقي
على الشجرة ملتبسة بحيث لا يذكرها بالاسم، فهي ليست بحسبانه، شجرة معرفة
ولا شجرة خلد، وإنما مجرّد شجرة تمثّل الأمر الإلهيّ الذي ينبغي الانصياع
الكلّيّ له، وترمز للحدود الربّانية التي لا يجب تجاوزها؛ ونفس
الإستراتيجية ينهجها حتى مع حوّاء إذ لا يذكرها بالاسم إطلاقا، وهي بنظره
لا ترقى إلى أن يكون لها اسم خاص يميّزها ما دام الوضع المقدّر لها سلفا هو
وضع الزوجة الطيّعة الخنوعة لا غير… وتلكم مرّة أخرى علامة على أن
استراتيجية التسمية ناجعة للقضاء على هذا الكائن. فالغير مسمّى لا اسم له؛
بل قل لا وجود له وفي أحسن الأحوال يُنْسب لغيره، سيّده وحاكمه.
بناء على هذا المنطق نفهم لِمَ خُلِقَتْ حواء فيما بَعد، وعلى نحو
هامشيّ بالنسبة لآدم المَركز. فهي مجرّد ضلع أعوج أُخِذ من الجسد الأصليّ.
لقد حظي الذكر بالخلق أَوَّلا، ثم تَلَتْهُ الأنثى كضلع زائد ومتبقي أخذ
منه. ومن ثمة يبدو واضحا أنّ كلّ شيء يضع حواء في قفص الاتهام بدءا من نظام
الخلق حتى مسؤولية الخطيئة. فمنذئذ وهي تؤدّي الثمن غاليا : جسدها ملعون
وكذلك هي جملة وتفصيلا. هذا عن حواء، أمّا باندور فهي أوّل امرأة خلقها
هيفايستوس Hephaistos من تراب بأمر من زوس. ذلك أن هذا الأخير لما كان يبحث
عن طريقة للانتقام من بروميثيوس والناس الذين ساعدهم، حَبَا هذه المرأة
بأبهى جمال وأرسلها لمصاحبة إبيميتيوس أخ بروميثيوس الذي اتّخذها زوجة، رغم
تحذيرات أخيه. وأنيطت بباندور مهمّة الحرص على جرّة تحوي أشياء هي على
جهل تامّ بها، لكنها بدلا من أن تنصاع للأمر الإلهيّ الموكول إليها، بادرت
بوازع حبّ الاستطلاع والمعرفة إلى نزع غطاء الجرّة، مما أفضى بالشرور كلها
إلى الذيوع والانتشار مابين البشر عدا الأمل.
على هذا النحو نلاحظ ألا فرق بين القصتين اللهم في بعض الحيثيات من قبيل
كون حواء خلقت من ضلع أعوج بينما خلقت باندور من تراب؛ فما يجمع بينهما
أكثر مما يفرق على اعتبار أنهما معا لَقَيتَا نفس المصير ومكثتا على طول
مشوار البشرية تُنعتان كمصدر الشرّ المحض والويلات التي حالت دون سعادة
البشر. شأن حواء إذن شأن باندور، كلتاهما رمز لتمرّد العقل الذي يروم
معادلة العقل الإلهي أو على الأقل انتزاع بعض الأنوار منه. والاثنتان
تحبّذان المعرفة بدل الجهل وترنوان إلى التضحية من أجل العلم بدل الاستسلام
للأمر الطوعي والانصياع للإرادة الإلهية. لكنهما بتمرّدهما وثورتهما،
تُجَرَّدان من عرشهما لِيَعُمَّ الألم والعذاب كلّ البشر مثلما يلحقهم
الموت والمرض، الشيخوخة والترهّل… فهما علّة نهاية السعادة وبداية قصص
الشرّ.
ونكاية فيهما أضحت كلّ امرأة، مسؤولة عمّا يطال الأرض من ويلات، وغدا
هذا الاسم ما أن يذكر، قرينا بالشيطان، موقد الفتن والحروب. لكن ألسنا بهذا
حقيقة، نكيد كيدا ضدّ النساء؟ ألسنا بهذا نمكر هيمنة عليهن واستعبادا لهن؟
ولئن فكرنا على مهل : فلنفترض أن حواء وباندور هما سبب زوال السعادة، لكن
وفي نفس الآن، ألم تفضّلا العقل والمعرفة على الجهل والخضوع؟ فذنبهما إنما
هو رفضهما الكلّي للانصياع، المصحوب برغبة مستميتة في المعرفة والتنوير.
ومعهما ندرك أنّ نهاية السعادة أي نهاية العصر الذهبيّ وقصة الجنة، كلها
أشياء تقوم جنيالوجيا على التمسك بالعقلانية والانتصار لإرادة المعرفة.
وفي سياق هذا الافتراض يغدو وضع المرأتين وضعا استثنائيا في التاريخ
البشري، إذ عوض كرههما كان حريّا بنا تكريمهما وبدل بغضهما وجب علينا
تمجيدهما : فنحن مدينون لهما بميلاد المعرفة وانبثاق العلم أساس كلّ
الإبداعات العبقرية. صحيح أنّ الثمن كان غاليا، لكن من ذا الذي بوسعه أن
يفضّل البراءة على العلم؟ وينحاز إلى الجهل بدل النور؟ فإذا كان الشقاء
(نتاج الخطيئة) كما يرى البعض لصيقا بكفّة العلم، فالسعادة ليست بتاتا إلى
جانب البراءة. وإذا كانت البراءة الحقيقية بحسب هؤلاء لا تكون مؤلمة مادام
البريء مفصولا عن كل وعي يُخَوِّلُه إمكانية إدراك حالته أولا، والمعاناة
جرّاءها ثانيا؛ فما يتناساه زعماء هذا الرأي، إنما هو كون البريء الحقيقيّ
محروما من السعادة، لا لشيء إلا لأنّ غباءه يحول بينه وبينها. لذلك، إذا
كنا مضطرين إلى الاختيار، كان الأجدر بنا، اختيار العقلانية رغم كلفة
السعادة المفقودة، لأنّ العقلانية وحدها تمكننا من استعادة السعادة من
جديد.
بدهي إذن أنّ كلّ مسعى نحو المعرفة هو مجازفة، تماما مثلما هي كل رغبة
في صعود الجبال مغامرة صعبة. لكنّ المتعة، والسعادة هي وحالتنا هاته، حيثما
نبلغ القمم ونستطيع أن نستنشق الهواء النقي. كذلك الشأن بالنسبة لطالب
العلم، إذ لا بد له من مكابدة المعاناة سيما في البداية، لكنه سرعان ما
يسعد بقدر ما يتحصل عليه من معرفة، ويفرح بقدر ما يحوزه من مفاتيح العوالم
المغلقة في وجهه. في ذات السياق نقول على لسان الفيلسوف ديكارت (كما جاء في
رسالة بعث بها لإليزابيث ملكة السويد يوم 6 أكتوبر1645):"أنه من الأفضل
أن نكون أقل سعادة وعلى علم وافر". لكن لنوضح أمرا هاما مفاده، أن العلم
بالشيء ليس يعني غير الوعي به، إلا أن هذا الوعي والإلمام هو ما يبقى دائما
ناقصا لا لشيء إلا لأن الأشياء كلها لا تفتأ تنحو نحوا تراجيديا؛ حتى أننا
عادة ما نحدد التراجيديا باعتبارها ما يتصف بالضرورة، أي أنها من ثمة ما
لا يمكنه الحدوث ويُرْغِمُ كلا منا على الخضوع لقوى تتجاوزه. لذلك فأول
معرفة نتأتاها، تتجلى أكثر ما تتجلى، في إدراكنا لأنفسنا ككائنات زمانية
بامتياز. أقصد أن أول ما نعيه إنما هو كوننا مشمولين بالزمان ومجبرين
بالتالي على مكابدة آثاره : الميلاد، الطفولة، المراهقة، البلوغ، الشيخوخة،
الحزن، الفرح، القبح، الجمال، القوة، الضعف، الصحة، المرض، الحياة،
الموت..
ولا شيء بالتالي يعفينا من الانخراط في هذا المسلسل مادام هو الحياة
عينها؛ الحياة التي ترقص على قدم الزمان منذرة بأن اللحظة هيراقليطسية وغير
قابلة للتكرار. كيف لا والوقت بقدر ما يمضي، وينصرف بقدر ما يترهل الجسد
وتخور قواه منبئة بوشوك الحدث-الموت. وعليه فنحن ملزمون بالتفكير زمانيا
فيما تكونه السعادة والتساؤل عن طريقة تحصيلها قبل فوات الأوان. بدهي إذن
أن يكون السؤال من قبيل : كيف يمكننا أن نحيا سعداء طالما أننا كائنات
مجبرة على الموت والزوال؟ سؤالا زمانيا بامتياز. لذلك أيضا،هي السعادة
زمانية قبل نهاية الزمان(الموت)وليست في شيء مستقبلا(زمنا آتيا)أي مابعد
زمانية. فالسعادة بتعبير آخر هي الحاضر، الراهن واللحظي الذي وحده يستأهل
العناية بلورة للمتعة. أما السعادة الافتراضية، تلك التي تغنّت بها الأديان
والإيديولوجيات الطوباوية، فهي دوما سعادة قادمة، سعادة مستقبلية ومفارقة
للحظة-الحياة، وهي على وجه التحديد ما يكفل تعاسة انتظارها وما يضمن العذاب
باعتباره تكلفة ودينا محتوما تأديته نشدانا لغايات بعينها. القاعدة
المعمول بها، هاهنا هي أن النهاية السعيدة تبرر الوسائل. ويكاد يتساوى هنا
الباحث عن عدن سوسيولوجي مع الساعي وراء إحراز سماوي لجنة مفقودة. فالسعادة
على حد تأويل أونفراي لا تكمن في براءة ما قبل المعرفة ولا في براءة ما
بعد الثورة، أكثر مما تكمن في حسن استثمار الزمان و التعاطي مع اللحظة :
الهنا والآن. وهي ما يقتضي بالتالي نوعا من الاشتغال على الذات بلورة لما
أسميناه في إحدى مقالاتنا بـ"الحيز الأنطولوجي"(1) الذي يستوجب العمل على
نحوين. تفادي كل ما هو سلبي (وهذا علامة صحة) والسعي وراء كل ما هو إيجابي.
الإيجابي هو ما يناقض السلبيّ، إنه السلام والتوازن والتناغم والاستمتاع
والصحة والقوة والثراء وفيض الحياة. الإيجابي هو الإثبات بلغة نيتشه أي ما
يعاكس النفي من حيث هو ارتكاس. إنه إذن فعل وليس ردّ فعل. هو فعل ينشد
التأسيس للمتعة على قاعدة إثباتية ركيزتها على نحو ما أكد Chamfort في
إحدى شذراته : "أن تَستمتِع وأن تُمْتِع، دون أن تؤذي نفسك ولا غيرك ".
لكن هل هذا الرقيّ الأخلاقي -مادام لا بدّ لنا من أخلاق- قابل للتنفيذ
في خضم ثقافات لاهوتية لا تؤمن إلا بالحقد ولا ترمي إلا إلى سفك الدماء؟
ثقافات لا تحبّ العقل ولا الكتب ولا المعرفة ولا العلم. وتكره الواقع
والمادة التي تحيل إليه منتصرة للجهل والعبودية. وهو جهل لا يتجسد مثلما
أسلفنا، في فكرة الخطيئة الأولى التي نسبت لكل النساء في شخصي حواء
وباندور، فحسب بل يتجسّد أيضا، في كراهية المرأة والحقد على كل ما تمثله
بالنسبة للرجل : سواء من حيث هي رمز للرغبة واللذة والحياة، أو من حيث هي
رمز للجرأة، إذا ما اقتفينا أثر قاموس littré (بنت حواء fille d’eve هي
المرأة الجريئة) أي المرأة الفاتنة والتي تجعلك آهلا بالحياة. وراء هاتين
القصتين إذن نلفي مشروعا جهنميا يروم من خلال النيل من النساء، الإطاحة
بالحياة كلها. أعني الحياة من حيث هي هذا الجسد الذي عليه نراهن جميعا. هذا
الجسد الذي هو موضوع الصراع لأنه الرغبة التي لا يمكن الاستلذاذ بها إلا
على نحو متحرر من كل الترسيمات القطيعية التي مافتئت تُنْسَج من حولنا حدّ
عدم الرضى على المرأة إلا إذا غدت زوجة وأما، تضطلع بمهام البيت وتخدم
الرجل مُيَسِّرة له كل شاذة وفاذة، وتطعم الأبناء ساهرة على تربيتهم. وفضلا
عن إقحامهن في الخانات الاجتماعية القاتلة، التي بموجبها يصبحن أمهات
وزوجات ويفقدن أنوثتهن بكاملها، فإن كره النساء يتجلى كذلك في اعتمادهن
رهائن الكوطا السياسية. هكذا تمتزج الأخلاق البرجوازية بالأخلاق اللاهوتية،
عاملة على فبركة طابوهات تضمن استمراريتها، مختزلة الحبّ في أشكال
اجتماعية تفرض على المرأة أن تغدو"امرأة إنجاب لا امرأة متعة". لكن ضد هذا
الأسر الاجتماعي-السياسي، الذي مافتئ يحصر دور الأنثى في الزواج والأمومة،
والتمثيل السياسي، نلتقي كما قال دولوز "صيرورات امرأة تختلف عن النساء وعن
ماضيهن ومستقبلهن، ويلزم على النساء الدخول في هذه الصيرورة كي يخرجن من
ماضيهن ومن مستقبلهن أي من تاريخهن". إنها صيرورات الأنوثة التي ظلت مصونة
مع كل من باندور وحواء واقتضت منهن التجرؤ حتى على الآلهة.


