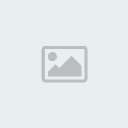
ليس في وارد هذه المقاربة توخي
النظر في الجذور التي أفضت إلى غياب الفلسفة وما لابسها نظرياً وتاريخياً،
على أهمية هذا وخطورته، وليس القصد من وراءها الوقوف على المآلات التي
تناتجت عن هذا الغياب في الفضاء الثقافي العربي العام، من غيابٍ كلّي أو
شبه كلّي لسلطة العقل ومرجعيته لصالح مرجعيات ما قبل معرفية مُعتمة، تناسلت
ولم تزل بما هو أشد ظلاميةً وقتامةً، لدرجة بتنا نلمس فيها التأثيرات
الناتجة عن ذلك ونعاين تجلياته في واقع التخلف السياسي والثقافي والاجتماعي
العربي الذي نشهده بين ظهرانينا.
إن هذه المحاولة تروم البحث في ميكانزمات إهمال الفلسفة وتفاعلاتها، وما
نتج عنها من تراجعٍ لمكانة التفكير الفلسفي في السياق العربي الراهن، والذي
يشهد بمجمله انكساراً وتعثراً في شتى الأصعدة و المستويات، مما حال بيننا
كأمةٍ لم تزل تبحث عن مشروعها النهضوي وبين التطور والتقدم القومي و
الإنساني، وانسحاباً ملحوظاً من ميدان الفكر العلمي بعدما قطع شوطاً طويلاً
من الابتكار والإبداع، من المحتّم أننا نستهلك آثاره وتداعياته هاهنا، في
الجغرافيا العربية الممتدة شرقاً وغرباً، بدءاً من الأقراص المدمجة ذات
الاستخدامات التقنية البسيطة وصولاً إلى الفسفور الأبيض الذي يختص بإذابة
الأجساد البشرية!!.
الإشكالية الأساسية في طرح القضية التي بين أيدينا تتعلق بمدى تأثير
الفلسفة في الجمهور العربي ومدى تفاعل الأخير معها، لكن مهلاً، فإعمال
النظر في هذا لا ينهض إلا على فرضية وجود فلسفة و إنتاج فلسفي ومشروع فلسفي
مستقل وفاعل، وهذا لا يصحّ عربياً، مادامت الفلسفة لم تزل معزولة في جزيرة
صغيرة تقبع عند أطراف المحيط المتشظي، ومادامت حرية التفكير الفلسفي أصلاً
محظورة و محجورٌ عليها من قبل سُـلط سياسية واجتماعية وثقافوية ترى في
الشُغل الفلسفي ممارسة عتيقة ونخبوية انقضى زمنها، إلى جانب نظرةٍ يشوبها
التهكم والسخرية، وقد يكون من الطريف هنا أن نذكر أن بعض المصريين يدعونها
بـ " الفلسحة " تعبيراً عن روح السخرية التي يتمتع بها ضحايا الابتذال
والتسطيح، فضلاً عن أن تلك السُلط غير مكترثة أصلاً بالفكر العلمي ولا
مبالية إزاء حالة الفوات الحضاري و الحطام العمومي بلغة الطيب تيزيني، التي
تستبد بالأمة ومشروعها المنتظر، إذ أن لهذه السُلط في مجموعها مصلحة
متقاطعة في تأبيد ظاهرة الظلام الفلسفي في المجال العام، لأنها منتفعة من
تغييب الفلسفة وعزلها، بمعنىً ما أو بآخر، لكونها لا تفكر إلا بما يضمن لها
المزيد من احتكار الثروة والسلطة.
إلى جانب ما سبق، هناك سلطة ثيوقراطية يتملكها القصور والعطب، سلطة تدّعي
لذاتها العصمة، و ترى في نفسها وكيلاً معتمداً وحصرياً للحقيقة والمعرفة
والغيب، لها الأخرى أيضاً المصلحة في الإبقاء على حالة شيوع المفاهيم
المبتذلة والمسطحة للفلسفة وتكريسها شعبياً، وفي أشد تجلياتها زيفاً
والتباساً، باعتبارها ضرباً من فذلكة تنظيرية هائمة لا جدوى من طرحها أو
بوصفها جنوناً أو زندقةً يحرم ممارستها واقترافها، وقديماً قيل "من تفلسف
فقد تزندق"، إنها سلطة تموضع مرجعيتها في سلطة متعالية مقدسة تمنحها
الحصانة في مواجهة أي نقد أو نقض، لتخلق في إطار هذه الوضعية الإذعان
والتبعية وتجنب أيّ تساؤل!!.
لقد فات كثيراً من المشتغلين في الفلسفة، وهذه معركتهم، أن مواجهة هذا
الابتذال والاختزال والتبسيط المُخل ينطلق بداهةً من التأسيس الملائم
لمفهوم الفلسفة الحقيقي وتعميمه، مرهوناً بالانفتاح على مرجعيات تسهم في
ضبط السؤال الفلسفي وإشكالاته النظرية على قاعدة المبادأة والتجديد لا
المسايرة والتقليد، وهذه معركة لم تحسم بعد، على الرغم من تلك القرون التي
أزهقتها الأمة من حياتها.
إن أكثر ما يميز الفلسفة على الطريقة العربية، وهي بائسة بلا شك، أنها
دائماً محل ريبةٍ وشك، وأنها مصدر قلق وتهديد لتلك السُـلط، لأن الفلسفة
بهذا المعنى لا تعدو كونها طريقة خاصة في التفكير، تنظر إلى العقل بوصفه
السلطة العليا ومرجعية الحقيقة، طبقاً ليورغن هابرماس، علاوةً على كونها
مطارحةً جَسورة للأسئلة القلقة الهاجسة وصوغاً منطقياً لها لا تقديماً
للأجوبة الجاهزة الناجزة، فضلاً عن كونها – زيادةً على ما سبق - هزاً
لليقين السائد ومساءلة متوثبة للبداهات المألوفة وللنماذج المستقرة. وكونها
كذلك فقد حسمت تلك السُـلط أمرها إزاءها، لتصنع من نفسها قوة موحدة، إن صح
التعبير، في مواجهة الشغل الفلسفي، والنتاج الفلسفي بوجه عام.
وإذا كان لأحدٍ أن يعتقد أن التفكير الفلسفي لم تُـتح له المناخات
اللازمة، ولم تتوفر له الشروط والسياقات الضرورية، ليمارس وظيفته في المجال
العام، فلأن السبب يعود في جزء منه إلى ما سبق، ويعود بالموازاة معه إلى
أن الفلسفة في الواقع العربي، الذي يمارس هيمنته بمعنى ما، لم تعد تملك
دفعاً ذاتياً جوّانياّّ ً يؤكد راهنيتها، بالإضافة إلى كون ذلك يحول دون
قدرتها على صوغ التساؤلات الملائمة للواقع الوجودي المعاش، باعتبارها نظراً
عقلياً في الوجود، وصوغاً لأسئلته الحائرة التي تبالي حتى بأدق التفاصيل
عبر إحالتها المستمرة إلى سندها المعرفي، بحثاً عن المعنى والمشروعية،
فضلاً عن كونها بحثاً دائباً في المعرفة ذاتها وشروطها وإمكاناتها، وقدرة
العقل من ثم على إنتاجها، فالفلسفة لا تكفّ عن كونها نقداً ونقض، ثم نقد
النقض ونقضه.
لقد فشلت الفلسفة في رهانها التاريخي على كسب المعركة في مواجهتها مع
الوهم والظلام، فاستبّد التكفير وأُستُبعد التفكير، وغلبت الأسطرة وتراجعت
الحقيقة، والذي حصل فعلاً هو أنه غابت الحرية، حرية التفكير الفلسفي، أو
اغتيلت قسراً و إكراهاً، ولم يعد من معنى لصناعة الإمكان من غير حرية،
فالفلسفة هي نقيض الحَجر والإذعان، وأخلاق الطاعة والامتثال، كما أنها رديف
الخلق والإمكان. ألم يُعرّف هايدغر الكائن البشري بصفته "إمكانيته على أن
يكون حرّاً"، على أن الفلسفة بهذا المعنى أو ذاك لا تعدو كونها نقيضاً
للوهم، الوهم الذي قد يتلبس الإنسان حين يظن أنه يمتلك منتهى الحقيقة
وناصيتها.
تاريخ العلم يكشف لنا أسطع الأمثلة في المعركة التي احتدمت منذ آلاف
السنين، بين سلطتي العقل و اللاعقل، سلطان العقل في مواجهة اللاهوت،
فجاليليو تحدّى هيمنة الكنيسة ومحاكم التفتيش، التي قضت عليه بالموت، ليثبت
بقوانين العلم الصارمة حقيقة دوران الأرض، على الرغم من تمسك رجال الكنيسة
بحرفية النص في الكتاب المقدس، واحتكار تأويله وتفسيره، لقد كان صراعاً
بين منهجين، منهج ينتصر للعقل و يرى أنه يستطيع أن ينقض بالعلم وقوانينه
وأدواته ما يمكن أن يستقر في القاع ويحاكمه بمنهجية محكمة ومضبوطة، في
مقابل منهجٍ يرى في أنه يمتلك إجابات نهائية، قطعية الثبوت، لامناص من
الإقرار والتسليم بها. وهنا يمكن أن تأخذ الفلسفة العربية، والمشتغلين بها،
من هذا المثال وغيره على مر التاريخ، درساً في التحرر من وصاية تلك
السُــلط التي أمعنت في تغييبها وحكمت عليها بـ "الموت" والتكفير،
وبالنتيجة فقد عزلت الفكر العربي عن مسيرة الفكر الإنساني وتقدمه، وتداعى
معه التفكير الفلسفي بعدما تقوّضت أركانه وتزلزلت جدرانه.


