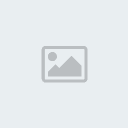
لم يفعل سيوران سوى تثمين
وتبنّي بعض المواقف التحقيرية التي كانت موجودة سابقا لدى بعض التقاليد
العريقة في مناهضة الحياة. تكمن إضافته النوعية في دفع الاستفزاز إلى حدوده
القصوى. لقد انتقم مع مرور الكتب والتصريحات الصحفية والمراسلات الخاصة
انتقاما أدبيا فظيعا من الحياة. لقد جذّر المعارضة. ثار ضدّ أولائك
الولودين المجانين ونددّ بــأهل ’’التناسل والتكاثر"، ذلك التنظيم الغريب
للنّسل الذي تدعو إليه الديانات المسمّاة سماوية. وصف الحياة تارة بــ
"الأكال الذي يسري على وجه الأرض" وبــ"الوباء" في مرّات أخر. يقول في شذرة
من أجمل ما كتب من شذرات:"أعتقد أنّ إقامة إمبراطورية سيكون أسهل لي بكثير
من تكوين أسرة".
لقد تعوّدنا مع الوجوديين قبل ذاك على تلك النظرة المندّدة بهذه الحياة
الناقصة، وتعلّمنا النظر إليها بعين الريبة، وعدم ائتمان جانبها، بل
وتحويلها إلى نقطة استفهام كبرى. ولكن إن كانت رهن التحقيق دوما وفي قفص
الاتهام في أحيان كثيرة لدى جان بول سارتر وألبير كامو وإخوانهما في
الفلسفة، فإنّها تبقى قابلة للتحسّن افتراضيا. تبقى محافظة على الأقل على
حقّها في الاستئناف والطعن. فكيركغارد يكتب "إنّ الحياة التي أحيى ليست
حياتي" مثلا، فكأنّما يأمل في حياة أخرى، حياته الحقة! لكن على نقيض مؤلّف
"مصنّف اليأس" وأكثر الدانمركيين شهرة، وعلى عكس جمهور الوجوديين على
اختلاف مشاربهم، دفع سيوران بهجومه على الحياة إلى مداه الأقصى. استعمل
الأسلحة الثقيلة بل تلك المحرّمة دوليا ودينيا وأدبيا. حكم على الحياة حكما
سلبيا مؤبّدا، فالولادة والحبس صنوان عنده، فما أن يبصر الإنسان النور حتى
يرى القيود.
ماذا يقول لقارئه عن هذه الدنيا التي لا تستحقّ أن تعاش؟ "لقد
هجوتها على الدوام وكل ما قلته فيها يبقى صحيحا. فلست مستعدا أن أحذف كلمة
واحدة ممّا كتبت"، يؤكّد في كتابه "الخالق السيّئ"، كتابه الحادي عشر
المنشور سنة 1969 وكان ذلك قبل صدور "مساوئ أن يكون الإنسان قد ولد "
و"التمزّقات" و"تمارين الإعجاب" وآخر كتبه " اعترافات ولعنات"*، وقد كانت
في مجملها كتب حرب حقيقية ضدّ الحياة، وإن كانت حربا طريفة، كان القصف
فيها بعصا القهقهة وأناقة العبارة ولسعات الهزل والمزح الأسود، إذ قبل أن
تكون الحياة هنة كبرى فهي في نظره قلّة ذوق لا يصحّحها الموت ولا الشعر.
منذ "على ذرى اليأس"، كتابه الأوّل الصادر في بوخارست سنة 1934 ولم يكن
قد تجاوز بعد الحادية والعشرين خريفا، إلى آخر كتاب نشره سنة 1987 وكان قد
بلغ من الحزن عتيّا، بقي غضبه الأدبيّ هو هو. خمسون سنة كاملة تفصل بين
الكتابين الأوّل والأخير، ولم يغيّر من مواقفه قيد أنملة. لم يفعل سوى
العودة بطرق مغايرة إلى حبّه القديم، زيارات تفقّد ليس إلا، كما يقول هو
نفسه. وتبقى الحياة كما عهدها في شبابه "غير ممكنة وغير معقولة"، ليس لها
معنى ولن يجد لها معنى أبدا. فــ"ما العيش إلا افتراء على النفس وعلى
الغير". حكم على الحياة بالإعدام،" لم أقتل أحدا كان يقول، لقد فعلت أحسن
من ذلك بكثير ، لقد قضيت على الممكن". هل يمكن اعتبار منطوق حكمه هذا صدى
لمقولة هيجيسياس، التي قيلت منذ ثلاثة وعشرين قرنا مضت: " لا تبدو الحياة
معقولة إلا لمن لا عقل له". وهل هي الردّ القاتل على استغاثة كيركغارد :
"أعطوني ممكنا وإلا اختنقت!"
لئن كانت كتابته ذات رائحة عطرة، فإنّه يبدو لأوّل قراءة موزّع يأس
ومثبط عزائم بامتياز، ومع ذلك يبقى تشاؤمه وتطيّره من أعذب ما تقرأ قارئة
(لماذا دائما "القارئ"، "المرء"…؟) بل يتحوّل ذلك النظر السوداويّ إلى
سعادة أدبية فعلية بل كدت أقول بأنه يدفع من تقرأه ويقرأه إلى تفاؤل ما!
ألا تخلق كلماته الجميلة ضدّ الحياة "المرّة" معنى ما للحياة رغم أنف قساوة الألفاظ المستعملة؟


