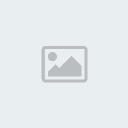
تظل الرّغبة في التغيير طبيعة بشرية. إلا أنّ الخوف من التغيير يظلّ، هو الآخر، طبيعة بشرية.
وإذ تنبع الرّغبة في التغيير من طموح الإنسان نحو واقع أفضل، فإنّ منبع
الخوف من التغيير هو التوجّس من المجهول والشعور بأنّ عملية التغيير قد لا
تقود دائماً وبالضرورة إلى واقع أفضل.
من هنا مبرّرات السؤال : ماذا لو انتهت ثورات الشارع العربي إلى وصول
الإسلاميين أو السلفيين إلى السلطة؟ قد يحدث هذا في مصر وربما اليمن أيضاً،
وقد تعمّ العدوى دولاً عربية أخرى !
بل قد يحدث الأسوأ، وهو انقلاب هؤلاء أو بعضهم على العملية الديمقراطية،
ولو من باب "فقه سدّ الذرائع". وفي غياب مؤسّسة عسكرية علمانية مثلما هو
الحال في تركيا، فقد يكون سيناريو الانقلاب الأصوليّ ضمن المتاح.
والواقع أنّ بعض مظاهر البلطجة السلفية اليوم سواء في مصر أو تونس، تجعل السؤال مبرّراً : ماذا لو وصل الأصوليون إلى السلطة؟
إلا أنّ السؤال يحتمل غير قليل من المكر؛ طالما أنه قد يدفعنا إلى
المصادرة على المطلوب. والمطلوب أن تكون السلطة خاضعة في الأصل لمبدأ
التداول، بما يجعل وصول أيّ طرف إلى السلطة ليس نهاية للتاريخ، وبما يرسم
للأغلبية حدودها ويحفظ للأقلّية حقوقها.
هناك شرط قد لا يتوفّر عند السلفيين الدعويين أو السلفيين الجهاديين : احترام الجميع لقواعد التداول السلمي للسلطة.
فما الذي يضمن لنا أن لا تنتهي مظاهر البلطجة السلفية إلى تحطيم قواعد الديمقراطية؟
السؤال مشروع لكنه قد لا يخلو، مرّة أخرى، من بعض المكر؛ لأنه قد يجعلنا ننسى مسألتين :
- قد ننسى، من جهة أولى، بأنّ البلطجة السلفية محصّلة عقود طويلة من
الاستبداد ومن ثقافة خرق الحقّ والقانون وانتهاك قيم حقوق الإنسان في معظم
الدول العربية والإسلامية. علماً بأنّ السلفية الجهادية ليست انعكاساً
سلبياً للحرية والديمقراطية، كما يروّج البعض، وإنما هي خرّيجة مدرسة
السجون والمعتقلات السرية.
- وقد ننسى، من جهة ثانية، بأنّ الإسلاميين ليسوا قوّة فوق التاريخ. وهذا ما نودّ بيانه الآن :
لم يشارك الإسلاميون في الثورة التونسية. ولم يشاركوا في اندلاع شرارتها
الأولى في مصر، ولا هم قادرون اليوم على إنهائها. وأما في الأردن فلم
تسعفهم "قيادتهم" للشارع في الانتقال من مرحلة الاحتجاجات إلى مرحلة
الثورة.
كل هذا يعني أن القوة الانتخابية والاحتجاجية، التي ظلّ الإسلاميون
يتمتّعون بها طيلة العقود الثلاثة الماضية، لا تعبّر عن حجم القوّة
المطلوبة لأجل إسقاط الأنظمة.
ثمّة اعتراض مشهور : قد يسرق الأصوليون نتائج الثورة. حدث هذا في إيران
عقب الثورة : عندما فاز المفكّر الليبرالي الحسن بني صدر في أول انتخابات
حرة (جرت عام 1981)، بنسبة أصوات فاقت بفارق كبير نسبة الأصوات التي حصدها
ممثل خط الإمام الخميني، حسن حبيبي، انقلب الخمينيون على العملية
الانتخابية، وأصدروا بعد ذلك قوانين تمنح صلاحيات موسّعة لمجلس صيانة
الدستور، وبما يجعل المنافسة الانتخابية محصورة بين أتباع خط الإمام
الخميني.
لكنّ الأجدر بالملاحظة أنّ الحماس الديني الثوري في إيران، خلال ثورة
1979، لم يجد له أيّ صدى داخل اتجاهات التصويت في أول انتخابات عقب الثورة.
ما يعني أن الحركات الدينية، بصرف النظر عن قدراتها الاحتجاجية، فقد لا
تملك أي قدرات إقناعية أمام منافسين يتمتعون بالكفاءة وبالمصداقية.
لقد اكتشف الخطاب الديني في الجزائر حدوده الثورية. واكتشف في فلسطين
والعراق حدوده التحريرية. ثم اكتشف في ثورات الشارع العربي بأنه عاجز عن
إشعال فتيل الثورة، لكنه عاجز أيضاً عن إخماد لهيبها عندما طلب منه ذلك.
فعبر المساجد وهيئات الإفتاء والمجالس العلمية، فضلا عن الصوفية
والسلفيين، جُندت الكثير من المنابر الدعوية والأصوات الدينية لنبذ الثورة،
تحت يافطة لزوم الجماعة ووجوب الطاعة وتجنب الفتن. ومع ذلك صلى الناس خلف
أئمة السلطة ثم خرجوا إلى الثورة.
لقد بدا جليّاً بأنّ قدرة الخطاب الديني على التأثير النفسي والوجداني تظل
نسبية، وأن قدرة الخطاب الأصوليّ على التجييش الشعبي مرتبطة فقط بالمجالات
التي يغيب عنها النقاش السياسي العمومي والحرّ بفعل الاستبداد وانسداد
الأفق السياسي.
هكذا نعتقد بأن الصعود المحتمل للإسلاميين في بعض الدول العربية عقب ثورات
الشارع العربي، قد لا يمثّل بالضرورة أي انتكاسة إلى الوراء، بقدر ما قد
يمثل فرصة للحركات الإسلامية لكي تنزل من سماء عالم الأوهام إلى سقف فن
الممكن، والذي يستدعي القدرة على تدبير عشرات التوافقات في اليوم الواحد.
والحال أن تقنيات التواصل الأفقي التفاعلي، التي أتاحتها شبكة الأنترنيت
ومواقع التواصل الاجتماعي، قطعت الطريق أمام الإيديولوجيات الدينية
الشمولية والتي كانت تنتعش ضمن أنماط التواصل العمودي، من قبيل أجهزة
التلفاز وأشرطة الكاسيت ومكبّرات الصوت وخطب الجمعة وعظات الأحد.
من الخطأ الاعتقاد بأن الحركات الدينية قادرة على توجيه حركة التاريخ وفق
هواها أو تبعاً لأوهامها، بل غالباً ما تضطرّ إلى مسايرة اتجاه الأمور، بما
يمليه فقه الضرورات. وهذا ما قد يستدعي دراسة مستقلة.


