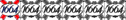ليست
هذه الدراسة مقاربة تاريخية في الحداثة أو مقارنة سوسيولوجية بين
العقليات. إنّها مجرّد محاولة في إيجاد فهم معاصر للزمن العربي ومقابلته
بالزمن الأوروبي الذي شهد في فجر الحداثة الانفصال التدريجي والحاسم عن
المؤسسات الدينية والسياسية في طريقها نحو العلمنة. والأحداث التي شهدتها
بعض الدول العربية مؤخّراً باسترجاع المجتمع لحريته في التعبير والقرار
ستساعدنا في الإلمام بهذا الزمن العربي الذي لم يلتحق بعد بالزمن العالمي،
ولكن يقع بجواره، في محاولة للوعي به، والأخذ عنه، بدرجات متفاوتة.
والتماثل في الأزمنة لا يعني التشابه في التواريخ، حيث ننطلق من "وحدة
الوعي البشري" رغم الإختلافات الواضحة والفروقات البديهية على الصعيد
الذهني والتأسيسي والثقافي والديني. أحاول إذن البحث عن أزمنة متماثلة في
تواريخ مختلفة.
I أورد في هذا السياق "تاريخاً" و"مقولة": التاريخ هو 1789 الذي شهد
اندلاع الثورة الفرنسية، والمقولة هي «لتمتلك شجاعة استعمال عقلك» التي
استعارها إمانويل كانط من هوراس صاحب المقولة اللاتينية الشهيرة (sapere
aude!) واستعملها كعنوان للأنوار الناشئة. قبل الثورة الفرنسية، شهدت
أوروبا عدّة عقود من الأنوار (أكثر من قرن)، بعد الحداثة الأولى التي
افتتحها ديكارت بإرسائه لفلسفة في الوجود قائمة على "الذات" (أنا أفكّر
إذن أنا موجود) والتي سيكون لها امتداد في الفلسفة الفردية، ولفلسفة في
البحث قائمة على "المنهج" حيث كان القرن السابع عشر بحق "قرن المناهج": إذ
لا يخلو عنوان لكتاب أو رسالة من مقولة "المنهج" لتبيان الجانب الصارم
والتنظيمي الذي بدأ يتشكّل في الوعي الأوروبي؛ وهي الحداثة التي افتتحها
أيضا بيكون مع تعميم المنهج التجريبي والذي سيكون له امتداد مع الواقعية
في التفكير الإنجليزي عند جون لوك وديفيد هيوم. هذه الحداثة الأولى كانت
بالأحرى "جنينية" لأنّ طرائق البحث عن الحقيقة لم تكن سهلة في ظل هيمنة
المنظومة اللاهوتية، والسجال الكبير الذي دار بين غاليلي والكاردينال
بلارمينو (الذي أعلن الهرطقة في حق جيوردانو برونو وانتهت بحرقه) حيث أجبر
غاليلي على التخلي عن فكرة مركزية الشمس للفيزيائي كوبرنيكوس. هذا الأمر
يبيّن إلى أيّ مدى كانت المعرفة (الفلسفية والعلمية) تتقدّم في ظلّ
المراقبة التي كانت ترعاها المؤسسات الدينية بطوائفها المتعنّتة
(اليسوعيون، الجانسينيون، الغاليكانيون) والمناهضة لكل نظام معرفي خارج
الحقائق اللاهوتية التي سنّتها الكنيسة.
لكن بدأت الموجة الثانية من الحداثة في التشكّل انطلاقا من نهاية
القرن السابع عشر (1700-1792)، بعد الموجة الأولى التي تشكّلت خلال مئة
سنة (من 1600 إلى 1700). إذا كانت الموجة الأولى قائمة على المنهج
والتجريب، فإنّ الموجة الثانية وسّعت فكرة المنهج والتجريب مع ضلوع العديد
من العلماء (بيفون في علوم الحياة) وبميلاد المعارف الإنسانية حيث تُعتبر
"أنسيكلوبيديا" ديدرو ودالمبير إحدى تجليّاتها الكبرى، بالإضافة إلى
مساهمات العديد من الفلاسفة في تشكيل نظريات حول الإجتماع البشري والسياسة
والتربية من أمثال مونتيسكيو، جون جاك روسو، فولتير وديدرو. لكن تميّزت
هذه الفترة هي الأخرى بتشديد الرقابة الدينية على المنتوجات الفكرية،
ويشهد على ذلك تدخّل اليسوعيين في منع الأنسيكلوبيديا من الظهور بعد الجزء
الأول الصادر سنة 1751. وكان أبراهام شوميكس، بمساعدة الكنيسة، رائد
الدعاية المضادة لمشروع الأنسيكلوبيديا، حيث كتب محاولة في ثمانية أجزاء
عنوانها: «أحكام مشروعة ضدّ الأنسيكلوبيديا ومحاولة في رفض هذا القاموس».
ولعلّ الدافع لمناهضة مشروع ديدرو ودالمبير هو ما تحتوي عليه
الأنسيكلوبيديا من أفكار تخالف عقائد الكنيسة، وطغيان المادية (التفسير
العضوي والسببي للكائنات الحيّة) والنزعات الإلحادية (مقالات فولتير مثلا)
على التوجّه العام للأنسيكلوبيديا. لكن الشيء الملفت للانتباه، هو أنّ
الموجة الثانية للحداثة تميّزت بانحسار سلطة الكنيسة بطوائفها المتعددة
(حتى وإن كانت تلعب دوراً لا يستهان به في إضفاء الشرعية على السلطة
السياسية ونشر عقيدة "الملك ظلّ الله في الأرض")، وتفاقم السطوة السياسية
في ظلّ الدولة الناشئة تحت حكم ثلاثة ملوك: لويس الرابع عشر، لويس الخامس
عشر، ثم لويس السادس عشر.
لا شكّ أن الفترة التي شهدتها الأنوار كانت "نيّرة" بإبداعاتها
التقنية والفلسفية والفكرية، وبأنظمتها الإقتصادية والتجارية ودور
البورجوازية في خلق الثروات والتقنيات، وهو أمر أشار إليه ديدرو في مدخل
"الفنّ" من الأنسيكلوبيديا عندما أعلن ضرورة ردّ الإعتبار إلى الفنون
الميكانيكية إلى جانب الفنون الليبرالية، أي أنّ الطبقة الوسطى التي تشمل
الصناعيين والحرفيين كانت الشرط الضروري في الحفاظ على التماسك الإجتماعي
بين عموم الشعب وطبقة النبلاء. وبإعادة الإعتبار للفنون الميكانيكية، كانت
البورجوازية في عزّ تقدّمها، لأنّ الفنون الميكانيكية تتيح صناعة الأدوات
والأجهزة والآلات التي لقيت استقبالاً ملحوظاً واستعمالاً مكثّفاً، كشيء
يقارب مما نتعجّب له اليوم من اختراع الآلات الإلكترونية والسبرانية
(الآيفون، الآيباد، إلخ). لكن هذه الفترة "النيّرة" كانت محاطة بصمت مطبق،
لأنّ الواقع كان في غاية الإنغلاق السياسي مع الحكم الأرستقراطي والمتمثّل
في الملكية القائمة على الحكم المطلق ذي الحقّ الإلهي. والأمر الذي أزّم
من الوضع هو محاولة إغتيال لويس الخامس عشر على يد روبير داميان. لقد كان
الوضع السياسي في رمّته محاطاً بهيبة الدولة بالمعنى الحديث في توسّع
المؤسسات السياسية والقضائية ومجتمع النبلاء والامتيازات وانحسار السلطة
الدينية التي كانت مجرّد التابع والخادم والمشرّع، ويشهد على ذلك حلّ حركة
اليسوعيين سنة 1764 بمرسوم ملكي، وهي الحركة الدينية التي كانت الأكثر
تطرّفا في التاريخ الحديث للمسيحية.
في هذه الفترة تشكّلت معادلة اجتماعية وهي: تفاقم التسلّط السياسي
بنشوء وارتقاء الدولة الحديثة، انحسار السلطة الدينية بتبعثرها في طوائف
متناحرة واختفاء حركة اليسوعيين، استقلال مجتمع العلماء والفلاسفة
بمعاهدهم وجامعاتهم وبحوثهم النظرية. لكن التفاوت الصارخ بين عموم الشعب
الرازح تحت الفقر وطبقة النبلاء والحكم الأرستقراطي عجّل من تفكّك الروابط
السياسية إلى جانب الحروب البرّانية التي كان يقودها الملك سواء عن صدق في
الدفاع عن مملكته، أو عن خداع بإيهام بوجود عدوّ خارجي لتمتين القبضة على
العدوّ الداخلي وهو الشعب. وهو الأمر الذي بدا في حكم لويس السادس عشر حيث
بدأ التصدّع في الحكم الأرستقراطي مع القوانين الصارمة وغير العادلة التي
تحمي الامتيازات المالية والاقتصادية التي يتمتّع بها مجتمع النبلاء. ثمّ
إنّ الأزمة الإقتصادية (شهور من الجفاف والمحاصيل الزراعية الضئيلة)
والسياسية (تمرّد المجالس العامّة) عجّلت من انهيار الحكم الأرستقراطي مع
اندلاع الثورة الفرنسية في ظرفين: الظرف الأوّل انطلاقاً من 14 يوليو 1789
بالاستيلاء على قلعة الباستيل (La Bastille) واقتراح الملكية الدستورية
وتدوين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن وتأسيس مجلس مكوّن من
البورجوازية المثقفة؛ والظرف الثاني في 10 أغسطس 1792 بنقض الملكية وإعلان
الجمهورية بعد محاولات فاشلة في التعايش وإعلان لويس السادس عشر الحرب على
النمسا كتلهية خارجية لإحكام القبضة من جديد على الغيلان الداخلي. لكن هذه
الحيلة لم تنجح لأنّ المجتمع الفرنسي بدأ في التحوّل الجذري ولأنّ الثورة
أصبحت بمثابة عقيدة تمّ الترويج لها بالحديد والدمّ حيث كان لويس السادس
عشر أوّل ضحيتها، عندما تحوّل إلى مواطن عادي إسمه "لويس كاربيه" وتمّ
الحكم عليه بالإعدام على المقصلة في 21 يناير 1793 بعد مداولات قضائية
دامت أشهراً عديدة، وتبعته في ذلك زوجته ماري أنطوانيت والكثير من النبلاء
بمن فيهم العالم الكيميائي أنطوان لافوازييه الذي أعدم سنة 1794. تحوّل
الثورة إلى عقيدة على يدّ الثوريين أمثال دانتون وروبسبيير انجرّ عنه
إرهاباً روّع كل من كان له تشكيك في الجمهورية الناشئة أو حنين إلى
الملكية الآفلة، ومن أغرب الأحداث الثورية في فرنسا أن يكون دانتون
وروبسبيير وسان جوست، الذين قادوا الثورة بيد من حديد، ضحيّة هذه العقيدة
بالحكم عليهم بالإعدام، قبل أن يطلع نابليون بونابارت على الزمن الفرنسي
كقائد يعيد الأمور إلى نصابها ويؤسّس "الإمبراطورية" قبل انهيارها بعد
هزيمة واترلو (1815). عادت الملكية مؤقتاً (ملكية دستورية) مع لويس الثامن
عشر وشارل العاشر، ولكن ثورة 1848 عجّلت بسقوطها وقيام الجمهورية الثانية
التي قادها نابوليون الثالث كرئيس هذه المرة ينتخبه الشعب وليس كإمبراطور.
II من الصدف أن يتوفى فلاسفة الأنوار في سنوات متقاربة: مونتيسكيو
(1755)، جون جاك روسو (1778)، فولتير (1778)، كوندياك (1780)، دالمبير
(1783)، ديدرو (1784)، بيفون (1788)، دولباك (1789)، ولا أحد منهم شهد
الثورة الفرنسية أو شارك فيها أو نظّر لها. ولكن كانت لأفكارهم الطبيعية
والتاريخية والاجتماعية والسياسية دوراً كبيراً في تشكيل الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والمواطن. إذ قام هؤلاء الفلاسفة بالتغيير على مستوى
"النظرية" في ظلّ اشتغالهم تحت الحكم الأرستقراطي المطلق، بينما قام
المواطن العادي بالتغيير على مستوى "الواقع" بنقض الحكم الأرستقراطي بعد
أن اجتمعت العديد من الشروط الوجودية والتاريخية والاجتماعية الآيلة نحو
التغيير. كذلك من الصدف أن يتوفى فلاسفة الأنوار العربية في فترات
متقاربة: زكي نجيب محمود (1993)، عبد الحمن بدوي (2002)، إدوارد سعيد
(2003)، محمود أمين العالم (2009) وسنة 2010 التي شهدت رحيل محمد عابد
الجابري ونصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وعبد الله شريّط. ولم يشهد هؤلاء
الفلاسفة العرب أيضاً اندلاع الثورات العربية في تونس ومصر والبلدان
الأخرى، ولكن قاموا بالتغيير على مستوى النظرية، بأدوات نقدية، وقام
الإنسان العادي بالتغيير على مستوى الواقع. وبدأ التغيير على مستوى
النظرية منذ الحداثة العربية الأولى (أو النهضة) مع رفاعة الطهطاوي ومحمد
عبده وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي شميّل وسلامة موسى وطه حسين وعلي عبد
الرازق ومالك بن نبي. على غرار الأنوار الأوروبية التي كانت تشتغل في ظلّ
نظام سياسي يستمدّ شرعيته من الحق الإلهي، اشتغلت الأنوار العربية في ظلّ
استعمار غربي (فرنسي في المغرب، وبريطاني في المشرق) مع الحداثة الأولى،
ومع الحداثة الثانية في ظلّ نظام مستقلّ هيكلياً (كدولة وأمّة ومجتمع)
ولكن تابع سياسياً للمعسكر السوفييتي السابق الذي شجّع ببنيته المعقّدة
(التاريخية والسياسية) وبحربه الباردة ضدّ العالم الغربي في تشكيل أنظمة
قمعية (البلدان العربية التي تبنّت النموذج الإشتراكي، كوريا الشمالية،
كوبا..) تجعل من العنف القاعدة ومن القانون الاستثناء.
إنّ الموجة الثانية من الحداثة العربية تختلف في الرؤية والصيغة عن
الحداثة الأولى: إذا كان همّ الحداثة الأولى هو التخلّص من الإستعمار
(مالك بن نبي) والالتحاق بالركب الحضاري (محمد عبده والتفكير الوضعي مع
زكي نجيب محمود) والتفكير في أغوار الحكم السياسي والديني (الكواكبي وعلي
عبد الرازق)؛ فإنّ همّ الحداثة الثانية هو التفكير الواعي والهادف في
أشكال الحكم السياسي التي تصلّبت بعد الاستقلال والتي، بحكم التاريخ
والعصبية، شجّعت بروز طبقة شبيهة بمجتمع الامتيازات الأوروبي السابق على
الثورة، وهي طبقة انتهت بتحويل الأنظمة السياسية إلى تجمّعات أوليغارشية
(عائلية) في سياسة الإقتصاد والحكم والإدارة والإعلام. وتميّزت أيضا
الحداثة الثانية بالاستعمال الوجيه للنقد كقيمة تاريخية وفلسفية (صدور سنة
1984 «نقد العقل العربي» للجابري، و«نقد العقل الإسلامي» لأركون)،
وبالسجال النظري والفكري (جورج طرابيشي، علي حرب). هذه الخاصية هي شبيهة
بالنداء الكانطي في عصر الأنوار الذي ألمحنا إليه في البداية ونعيد تفصيله
في هذا السياق. إذ كان المراد من الحداثة العربية الثانية هو استعمال
النقد كأداة وقيمة في فحص طبيعة العقل ونمط اشتغاله في المنظومة الفكرية
والتاريخية والثقافية للعرب. فكان للنقد أن يطال العقل بكل تركيباته
السياسية والدينية والأخلاقية (الجابري، أركون، أبو زيد، صادق جلال
العظم). من خاصية النقد الذي ثمّنه كانط في قراءته للأنوار والثورة هو
خروج الإنسان من قصوره إلى رشده العقلي. يقول كانط : «إنّ الأنوار هي خروج
الإنسان من قصوره الذي تسبّب به في نفسه. إنّ هذا القصور هو عدم قدرته على
استعمال عقله دون وصاية أحد آخر. ويرجع هذا القصور إلى الإنسان نفسه إذا
كان سبب لا يكمن في عيب أصاب العقل، بل في الإفتقار إلى الشجاعة في
استعمال العقل دون وصاية الآخرين. لتمتلك شجاعة استعمال عقلك، ذلكم هو
شعار الأنوار». وهذا ما حصل بالفعل في الثورة الفرنسية التي كانت بمثابة
خروج جماعي على السلطان الذي كان يتّخذ من الحق الإلهي عباءة في إخفاء
المظالم والتفاوت الإجتماعي بين النبلاء والفقراء. وهو أيضا الدأب العربي
في الإنتقال من "القصور" العقلي إلى "الرشد" التاريخي. وفقرة كانط التي
تفتتح مقاله «ما هي الأنوار» (Was ist Aufklärung ?) تشدّد على هذا
الإنتقال من القصور الذي يختصّ به الطفل أو المجنون إلى الرشد الذي يتميّز
به العاقل أو الكبير. لأنّ من خاصية النظام السياسي والديني السابق على
الثورة الفرنسية أن يتكلّم في مكان المجتمع وله وصاية لاهوتية وسياسية
عليه: فالمجتمع هو بمثابة "الطفل" الذي لا يتكلّم (infans) والذي ينبغي
الحديث في مكانه، واتّخاذ القرار رغماً عنه. فجاءت الثورة لقلب الموازين
وإعادة الإعتبار للمواطن العادي الذي بإمكانه الحديث (التشكيل
الديمقراطي)، وبإمكانه القرار (الانتخابات)، وبإمكانه المشاورة والتداول
(المجتمع المدني). جاء النداء الكانطي كاستجابة للأنوار في عصره بإرجاع
الرشد إلى الإنسان وحصاد الوعي في مواسم التقدّم.
ويكاد كانط يحمّل الإنسان مسؤولية البقاء في الإنفعال التاريخي
والولاء لمن يفكّر في مكانه ويتّخذ القرار في غيابه إلى درجة إلجامه
ومصادرة صوته وإخضاعه. هناك ما أسمّيه "لابدّية" تسري في الحركة البشرية
تجعل من الإنسان يرتقي إلى مرحلة أخرى عبّر عنها أبو القاسم الشابي
بالأبيات المعروفة التي كانت بمثابة الإعلان الرسمي للثورة التونسية
يرددها الشباب في مواجهة القمع: «إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بدّ أن
يستجيب القدر، ولا بدّ لليل أن ينجلي، ولا بدّ للقيد أن ينكسر». إنّ هذه
"اللابدّية" هي استجابة للنداء الكانطي في حثّه على تحمّل المسؤولية
التاريخية في الخروج من القصور العقلي واستعمال العقل دون وصاية، أيّا
كانت مصدرها وأيّاً كانت السلطة التي تتمتع بها الجهات الوصيّة. يتعلّق
الأمر بالإستعمال الوجيه والسديد للعقل، قصد تشكيل ثقافة تضع على محكّ
النقد كل السلطات (سياسية، دينية، رمزية، أبوية) التي تجعل من السيادة
والهيمنة قانون اشتغالها وعلّة وجودها. لكن هل العقل سابق على الثورة أو
لاحق عليها؟ كيف ومتى يتدخّل العقل في صناعة ثقافة الرشد العقلي التي كان
ينادي بها كانط؟ بأيّ معنى تصبح هذه الثقافة ملاذنا في ظلّ اهتزاز
الأرضيات السياسية والأنظمة الفكرية والتقاليد العرفية التي تتحكّم في
مصائرنا منذ مئات السنين؟ لمن يعيب على المجتمعات العربية عدم وعيها
بتاريخها ولمن يضفي عليها عدم النضج أو أنّها مجرّد آلة تعبث بها القوى
الأجنبية مثلما تعبث بها الأقدار، هو تبسيط مخادع للوقائع المعقدّة،
واختزال فاحش للمعطيات، وقراءة سحرية، خرافية، قَدَرية للتحوّلات الجارية.
لا شكّ أنّ الذي يكتفي بإرجاع الوقائع إلى أجندات أو مؤامرات يخفي بشطحة
نرجسية تحليله ويعفيه عن كل أجندة أو مؤامرة، أي أنّه ينفي عن موضوعاته
الإرادة والحرية ليخصّ بها فقط تحليلاته ورؤيته الواهية للأمور.
لا شكّ أنّ الثورات ليست بالأمر "السحري" الذي يقع لمجتمع بشري. في
كلّ ثورة هناك إمكانية الإخفاق والمصادرة والسرقة والعبث وهو أمر مرّت به
الثورة الفرنسية التي لم تحقّق أهدافها سوى عقود بعد انفجارها. والثورة هي
أساسا شرخ يقع في نظام الزمن وفي منظومة الفكر والفعل، ينتقل بها الوعي
إلى ظرف جديد ببنيات مغايرة. قد يحتفظ بالأساليب نفسها لكن عندما يطال
التغيير "النواة الصلبة" لكل نظام أو منظومة، فلا رجوع إلى الوراء، حتى
وإن تكرّرت بعض الأساليب والأفعال في شكل "عَوَد مستمر"، ولكن ينتهي
بالتلاشي والاندثار التدريجي. الثورة هي "دورة" في الزمن كما يقول قاموس
تريفو (Trévoux) من القرن السابع عشر، عندما تعود النجوم إلى دائرة البروج
(revolutio)، وتحدث استدارة في الزمن بالعودة إلى الأصل (revolvere). هناك
عودة إلى نقطة البداية تتّخذ شكل الذروة وتنبئ عن بداية جديدة. الثورة هي
انعطاف حاسم في المسار البشري، هي شكل من الانعراج، يقوم بليّ الزمن
والخطابات والأفعال، لتنتقل إلى مرحلة جديدة لا تدلّ فيها الكلمات على نفس
الأشياء. فليس غريباً إذا كان العالم والمؤرّخ الإبستمولوجي توماس كوهن قد
استعمل مصطلح "الثورة" في الدلالة على انتقال المنظومات العلمية في شكل
طفرات يعبّر عنها انهيار نموذج (براديغم) ليقوم على أنقاضه نموذج آخر، وفي
هذا الإنتقال تتغيّر الرؤية نحو الأشياء، فلا ترى العين نفس الواقع بنفس
الرؤية السابقة. هناك شيء يتعدّل أو يتعرّج لتصبح رؤية مختلفة أو مغايرة
تتغيّر معها المؤسّسات والممارسات والسلوكات.
III هذا ما يمكن استشفافه في الثورات العربية التي تتغيّر فيها الرؤية حتى
وإن لم تتغيّر الممارسات في ذاتها. لكن بتغيير الرؤية فإنّ الخطابات
والممارسات تتغيّر، والتي تغيّر بدورها نمط اشتغال المؤسسات. لقد أقرّ
ماركس في «أطروحات حول فيورباخ» في مخطوطة 1845 وخصوصاً في الأطروحة
الحادية عشر على أنّ «الفلاسفة لم يقوموا سوى بتأويل العالم بأشكال
مختلفة، وما يهمّ الآن هو تغييره». لكن مذهبنا ليس هو تغيير العالم الذي
يتغيّر كل يوم، بشكل حرباوي وبألوان مختلفة، ويتغيّر بنا أو بدوننا، ولكن
هو «تغيير اللغة التي تؤثّر في العالم». فعندما تتغيّر زاوية النظر، أو
تتعدّل الرؤية، فإنّ اللغة بدورها تتغيّر لتؤثّر في الوقائع التي تصفها.
وهو ما ألفناه في الثورات العربية التي شهدت ابتكار مفردات أو معاجم أو
ملاحم: "الشعب يريد إسقاط النظام"، "إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بدّ
للفيسبوك أن يستمرّ"، إلخ. وشهدت أيضاً تغييراً في الأساليب والسلوكات
بهجر الدعاية ومتابعة الوقائع، بالالتفاف والتضامن ونبذ محاولات التشكيك
والتخوين. إذا كانت الثورة هي انعطاف حاسم يقع في زمن قصير تهتزّ بموجبه
المنظومات والقيم السابقة، فإنّ العقل يشتغل في زمن طويل ويقوم بالتأمّل
في هذا الزمن العابر والعنيف القاضي بنقض أنظمة الحكم وأشكال التعبير
والتفكير. إذا استعدتُ تمييزاً عند ميشال دو سارتو، الثورة هي "الحدث"،
بينما العقل هو "الواقعة". الحدث هو ظرفي بوصفه بؤرة تنطلق منها الوقائع
اللاحقة. وهذا شأن أي حدث منفرد ومتميّز، مثير وخلاّب، مدهش ومروّع، يجعل
القراءات اللاحقة ممكنة. فهو ينتاب الوعي ويفاجئه من حيث لا يحتسب، وهو
لحظة الانبثاق أو الصدور تُحدث شرخاً في نظام الوجود، أو قطيعة بين السابق
واللاحق، أو فاصلاً بين الحالي والآتي. الحدث هو لحظة الوجود ولحظة
الشهود، ينعدم فيه التعبير أو الخطاب، مثل الزلزال كحدث مروّع ينتاب الوعي
ويحدث شرخاً في نظام التصوّر (فزع، قلق) قبل أن تعقبه وقائع تقوم بتخليده
عبر التساؤل أو الاستفسار (الأسباب الطبيعية، احتكاك الصفائح الجيولوجية،
المخاطر البيئية، النتائج الإجتماعية والاقتصادية..)، أي عبر الخطاب وفائض
الصورة والتعليق. العقل هو هذه الواقعة الخطابية التي تلي الحدث وتسعى
لتفسيره أو تأويله بالبناء عليه والولوج في أغواره وأسراره. ما نكتبه هو
"وقائع خطابية" لأحداث برّانية تسعى للإحاطة بها والوقوف على بنيتها ونمط
اشتغالها وأساليب انتشارها وتأثيرها وعوامل تلاشيها وخمودها.
هذا شأن الثورة كحدث، وكتأسيس لحداثة جديدة، حيث يتيح التغيير على
مستوى النظرية تغييراً آخر على صعيد الأفكار والأدوات والأساليب
والتصوّرات والممارسات. ويتقدّم هذا الأمر ببطء ويختصّ به العقل كواقعة
نظرية وخطابية تعود إلى الوراء لفهم ما تعذّر استيعابه لحظة "الانفجار"
التي هي أيضا لحظة "الانفراج" إذا استعملنا "القلب" بالمعنى الذي طرحه
جلال الدين السيوطي في «المزهر في علوم اللغة». وأشكال الانفراج بعد لحظة
الانفجار بيّنة لدى المجتمعات العربية التي لم تكن تتمتّع بالحرية الكافية
والشافية، لأنّها كانت سجينة "الطفولة العقلية" التي فرضتها عليها الأنظمة
السياسية. الإنتقال من الطفولة العقلية إلى الرشد الواعي انجرّ عنه سقوط
الأساطير والإيديولوجيات في عصر المعلومات والتداوليات. إذ تهاوت صورة
الداعية الرسولي والمثقف النخبوي والسياسي الراعي وهي قيم كانت فاعلة في
العصور القديمة ولم يعد لها تأثير بارز في المجتمعات الراهنة. حتى وإن لا
تزال بعض الثنائيات الصلبة سارية المفعول (أولوية الرجل على المرأة،
أسبقية الشيخ على الشاب، طهارة المؤمن ونجاسة الكافر، رشد الكبير وقصور
الصغير، وصاية الأب وطواعية الإبن، إلخ)، فإنّ طريقة إدراكها واشتغالها
تتغيّر تحت وطأة هذه الأحداث المتسارعة. إذ شدّدت الثورات على أمر هام
وبارز وهو التخلّص من كل ما هو "هرم" (بكسر الراء وفتحها)، أي كل ما هو
بالي، هشّ، عقيم لا يتلاءم مع تطوّر العقليات وارتقاء الأزمنة، وكل ما هو
متسلّط، مركزي، علوي، كبريائي لا يتلاءم مع تعميم الحقوق العالمية للإنسان
والمواطن.
فلا مراء أنّ الحميّة التي بدت على الشباب العربي الثائر هي محاولة
الإنقلاب على أنماط بالية وسقيمة في التفكير والتعبير والتدبير لا تتلاءم
مع تطلّعاته وآفاقه وأحلامه وآماله. فلا يمكن الحكم في ظلّ مصائر عالمية
متشابكة بأدوات سلطوية سليلة المعسكر السوفييتي السابق القائمة على العنف
والقوة، حيث لا مجال فيها للحديث أو الحوار أو التداول أو التبادل ("عدم
الكلام" أو "الإينفانس" بالتعبير اللاتيني). جاءت هذه الثورة لتقرّر حقّ
الإنسان في التعبير، ما دام أنّ الكلام أو الصوت كان منذ فجر البشرية
تيسير عن الهموم، وترويح عن النفس، وتخفيف عن الضغط، وإبراز للخفيّ، وبسط
للمطويّ. فبالكلام يتسنّى الحوار والتبادل، والكلام هو أساساً اللغة
والعقل، أي الخطاب والحِجاج إذا استندنا إلى مفردة "اللوغوس" (logos)
الإغريقية. إذ كان الشباب العربي يبحث عن لغة وعقل، عن تعبير وتفكير،
بالخروج من الطفولة المفروضة بالقوّة والحديد إلى الرشد الذي يترادف مع
المسؤولية واتّخاذ القرار، دون سلطة علوية أو سيادة عاتية. كذلك تتواقت
إرادة الخروج من الطفولة العقلية مع هدم الأساطير الأبوية التي تفرض على
الوعي الجمعي، طواعية أو كرهاً، صورة المنوّر أو الداعية أو القائد أو
الصفوة. إذا كانت هذه الوجوه الرمزية أو الأسطورية فاعلة في العصور
النبوية أو النخبوية، فلا مجال لها اليوم مع تعميم الحقوق العالمية وتشكيل
المجتمعات المدنية، حيث لكلّ فرد الحق والواجب في التعبير عن رأيه دون
وصاية، وألاّ يتحوّل "الممثّل السياسي" إلى "الوصيّ الرسولي"، وألاّ يصبح
"المفكّر الباحث" إلى "المثقف النخبوي"، وألاّ يتصلّب النظام المنتخَب
فيصبح جماعة مصالح أو زمرة أوليغارشية.
ذلكم هو المغزى من انتفاضة الشباب العربي: قلب الموازين بين ثنائيات
مانوية ومتصلّبة، تشكيل حداثة جديدة على أنقاض أنظمة هشّة وبالية،
الإنتقال التدريجي نحو الرؤية الواعية والمسؤولية العملية، تفكيك البنيات
العقلية بإعادة تركيبها تبعاً للأزمنة المستديرة والمعايير المغايرة. هل
تكفي هذه الإرادة في إرساء تقاليد جديدة؟ ليس العيب في الأخطاء الممكن
ارتكابها، ولكن في المحاولات التي لا يتمّ القيام بها. إنّ الزمن العربي
يجتاز فترة مماثلة لما مرّت به الحداثة الأوروبية: استفحال الشكّ والقلق
والتشكيك في السلطات. وكانت الثورة بمثابة الانفجار الذي أتاح الانفراج.
إذا كان السير نحو هذه الهزات الوجودية والتاريخية أمراً لا مفرّ منه
عندما تجتمع الشروط وتتجمّع الدوافع، فإنّ الحصافة هي قراءتها في سياق
انبثاقها وتأثيرها، بمعزل عن الانفعالات المفرطة، أو المخاوف الإيديولوجية
المشكّكة في أصالتها، أو التهم غير المشروعة في النوايا الخارجية، على
غرار الطفل الذي يتمّ إسكاته بفزّاعة الغول.