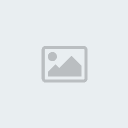
بعد غياب، يعود اليوم مصطلح الثورة للتداول في توصيف ما جرى ويجري في تونس
ومصر وما يشهده غير بلد عربي من تحركات شعبية واسعة تنادي بالديمقراطية،
لكنه مفعم هذه المرة، وأكثر من أية مرة، بالرغبات والانفعالات الوجدانية،
ربما بسبب شدة توق الناس إلى التغيير وإلى روح الثورة وأخلاقياتها وربما
لغرض التعبئة السياسية والشعبية، ما أدى إلى تداخل الحدود وتضييع الفواصل
بين مصطلحات عديدة كالثورة والتغيير والإصلاح يجري استخدامها بدون تدقيق
للإشارة من حيث الجوهر إلى تلك الأفعال التي تحصل لتجاوز الحالة القائمة،
وتالياً إلى ضرورة وقفة مع هذه المصطلحات وتقديم ما يمكن اعتباره اجتهاداً
في تحديد محتواها والسياق الذي يفترض أن تستخدم فيه.
فالثورة هي نهضة شعبية واسعة تخرق المسار العام للحياة وقواعدها وتهز
الكيان المجتمعي بقصد إحداث تغيرات سياسية واجتماعية وأخلاقية عميقة، تبدأ
بالانقضاض على الحكم لإلغاء النظام السياسي واستبداله بنظام جديد، وقد لا
تنتهي إلا بتغيير نمط العلاقات القائم وإعادة تنظيم وبناء الكيان الاجتماعي
بناءً جذرياً، وقد درج على تسمية هذا النوع من الثورات بالثورات
الاجتماعية التي تعمل ليس على قلب نظام الحكم وإنما أيضاً على تبديل عميق
للبنية الاقتصادية والاجتماعية السائدة، كالانتقال من الملكية الإقطاعية
إلى الجمهورية الرأسمالية كحال الثورة الفرنسية(1789) أو كإلغاء الملكية
الفردية والاستعاضة عنها بالملكية الجماعية كحال الثورتين الشيوعيتين في
روسيا (1917 ) والصين( 1949 )، أو الحالة المعاكسة في ثورات أوربا الشرقية
بدءاً من عام ( 1989 ) لإسقاط الأنظمة الشمولية والانتقال إلى الديمقراطية
واقتصاد السوق، وذلك لتمييزها عن ما يسمى الثورة السياسية التي تكتفي بنقل
السلطة من يد إلى يد مع الاحتفاظ بطابع ومحتوى العلاقات الاجتماعية
والاقتصادية القائمة، فثمة ثورات سياسية قامت ضد انتخابات زورتها أنظمة
استبدادية أو شبه استبدادية، وأخرى ضد أنظمة فاسدة أوصلت مجتمعاتها إلى
حالة لا تطاق من القهر والفقر كما هو حال الثورات التي جرت في إيران
والباكستان ومن ثم في مصر وتونس مؤخراً.
ونادراً ما تأتي الثورات السياسية تراكمية ومتصاعدة لكنها غالباً ما تتم
بصورة سريعة ومفاجئة، بينما يمكن للثورات الاجتماعية أن تطول لسنين عديدة
حتى تتمكن القوى الجديدة من إنجاز تحول عميق وجذري في الأوضاع السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية. وإذ نتفق على أن محرك
الثورات هو اليأس وغياب الأمل وانسداد أفق الإصلاح والتغيير، فهي تتخذ صور
وأشكال متنوعة كالتمرد والعصيان المدني والتظاهرات والاعتصامات، لكنها تبقى
في الاتجاه العام سلمية حتى في حال استخدام العنف والإرهاب ضدها من قبل
السلطات، وأحياناً تعرف فترات ومراحل قصيرة من الصراعات المسلحة وربما
الحروب الأهلية.
أما التغيير فلا يختلف من حيث الجوهر عن الثورة في دعوته إلى تعديل البنى
والهياكل القائمة في المجتمع، وهو غالباً ما يعني انتقال جذري وشامل وليس
جزئي في مختلف مناحي الحياة وأنشطتها، من وضع الى وضع آخر مختلف تماماً،
مثلاً من سلطة تابعة ومرتبطة إلى سلطة وطنية مستقلة، ومن نظام استبدادي إلى
آخر ديمقراطي، وقد يتم التغيير من حيث الظاهر على شكل الثورات ويتميز
بدرجة واسعة من المشاركة السياسية والشعبية، أو على صورة حركات تحرر أو عبر
آليات متنوعة من الضغط والتجاذب بين مختلف مكونات المجتمع والسلطات
القائمة في سياق عمليتي هدم وبناء مترابطتين، تصل إلى إزالة البنى والآليات
القديمة وإحلال بنى وآليات جديدة على أنقاضها. وربما يتم عبر انقلابات
فوقية بحيث يقوم جزء من السلطة الحاكمة نفسها بتغيير نظام الحكم القائم
بطرق غير شرعية وغالباً ما يكون الجيش هو أداة التغيير. في حين يبقى
للإصلاح سياق مختلف وهو يعني إجراء تعديل ينصب على البنى القائمة ذاتها
بتبديلها أو تبديل بعض مكوناتها لضمان تطورها وقدرتها على الاستجابة لأوضاع
وحاجات مستجدة، أو قد يرمي الى إعادة إنتاجها بصورة جديدة في شروط متغيرة
وإزالة المثالب المعيقة لصالح مقومات التفاعل الايجابي والتقدم. وللإصلاح
أنماط متعددة، قد يكون شاملاً وهنا يقترب بالملموس والى حد كبير، من مفهوم
التغيير أو ربما يقتصر على حقل واحد أو أكثر من حقول النشاط الاجتماعي،
فيصح عندها القول بإصلاح اقتصادي وآخر إداري وثالث سياسي ورابع ديني أو
قضائي أو ثقافي وهكذا، وبالتالي يلتزم الإصلاح، بما هو مستوى معين من
التغيير، بأهداف تحدد محتواه بصورة مسبقة فلا يمكن الحديث عن إصلاح بالعام
أو عن مشاريع إصلاحية مجردة، ثم تبعاً للهدف المتوخى إنجازه تندرج القوى
المعنية فيه كرافعة وحاملة له.
وإذا كانت كل ثورة تعني بالضرورة التغيير وتتضمنه فإن كل تغيير يعني
بالضرورة إصلاحاً ويتضمنه. وأي مفهوم من المفاهيم السابقة يتحدد ويتمايز عن
الآخر تبعاً للمهام الصريحة التي يتنطح لها ولطابع القوى المدعوة للمشاركة
فيه وتلك المؤهلة لقيادته، فطالما تقوم الثورة على مشاركة شعبية واسعة
لإنجاز هدف الانقضاض على الحكم القائم، يقوم التغيير على صور ضاغطة من
المشاركة بين فئات من الشعب والنخب السياسية والثقافية لإزاحة القوى
العتيقة ومحاصرة قواعد تجددها، وهو غالباً كما الثورات يسقط الرهان على دور
السلطة الحاكمة والأطراف التي يفيدها استمرار القديم، بينما تتم حركة
الإصلاح في أغلب الأحيان تحت سقف السلطة السائدة، وينجز أحياناً بقيادتها
أو بالتعاون معها أو مع بعضها، متجنباً إحداث تبدل كبير في علاقة هذه
السلطة مع الدولة والمجتمع، وأيضاً في طابع التفاعل بين حقول السياسة
والاقتصاد والاجتماع والإدارة والثقافة…الخ.
وبالتالي على الإجابة عن سؤال، ما هي القوى الاجتماعية المشاركة في
الثورات وفي عملية التغيير أو الإصلاح، نعرف إن كانت الأمور سوف تتم بصورة
فوقية وغامضة أم بشكل علني ومكشوف، ويمكننا أن نفهم حدود ما يجري من
التطورات وتحديد مدى عمقها وآفاقها، ويزيد الأمور وضوحاً طابع الوسائل
الكفيلة بإنجازها والشكل الأنجع الذي تتخذه، أهي تراكمية وتدرجية أم عبر
قفزات وقرارات نوعية تفتح الطريق أمام تطور سريع للقوى الجديدة وتبلورها،
وهنا يجد الكثيرون أنه مع استمرار ممانعة الأنظمة ورفض تقديم أي تنازلات في
طرائق حكمها الاستبدادية فان عملية التغيير الديمقراطي سوف تتجه إلى مأزق
واحتقان ولن ينجح إلا الضغط والإكراه لإجبار أهل الحكم على اتخاذ خطوات
جدية لتغيير علاقتهم مع الدولة والمجتمع، وغالباً عبر ثورات شعبية عارمة
كما حصل في تونس ومصر، ما يعني أنه لا يمكن الرهان على تغيير أو تجديد
حقيقيين للبنى القائمة ومعالجة تشوهاتها الخطيرة ومشاكلها الكثيرة دون
إصلاحات سياسات صريحة تعيد الاعتبار لدور المجتمع وقواه الحية، وأن أي
تغيير وكي يصل إلى مبتغاه لابد له أن يركز الجهد أولاً على مهمة عتق الناس
وتحرير إرادتها.
وبالفعل فإن من يدقق في الأوضاع العيانية لمجتمعاتنا العربية وتشابه
أسباب أزماتها، لا يحتاج إلى كبير عناء ليكتشف أن من العبث الرهان على نجاح
أية إصلاحات إدارية أو اقتصادية أو غيرها إذا لم تكن مسبوقة بإجراءات
سياسية تطلق دور الإنسان وتحرره من القهر والوصاية، وتفضي إلى بناء حياة
جديدة تقوم على قواعد من الحرية والتعددية والمشاركة. ما يفسر هذا التحول
السريع للحراك الشعبي في كل من تونس ومصر وغيرهما من مناطق الحراك الشعبي
من شعارات مطلبيه، كتأمين رغيف الخبز وفرص العمل، إلى شعارات سياسية تتعلق
بتغيير النظام القائم وضمان الحريات وحقوق الإنسان، وكأن الشعوب استشعرت أن
التغيير في ميدان السياسة هو الخطوة الصحيحة التي توفر فرص نجاح عملية
التغيير بأبعادها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أو لعلهم
أدركوا ربما بحسهم العفوي أن دعم الديمقراطية وقيم المشاركة يرتبط ارتباطاً
وثيقاً بالعدالة في توزيع الثروة، وأن النخبة الحاكمة لا تستأثر فقـط
بأشكـال ممارسة الحكم وإنما أيضاً بكيفية التصرف بالمال العام، أو ربما
خبروا من تجاربهم المريرة أن تحسين المستوى المعيشي للناس مثلاً لا تصنعه
الوعود ولن يستقيم ما دام دورها السياسي غائباً، وأن معالجة ظاهرة البطالة
وإيجاد فرص عمل لجيش من العاطلين لا يصح إذا لم يسد مناخ من الحرية
والتعددية كفيل بتنشيط حركة التنافس والاستثمار، مثلما لا جدوى من محاربة
الفساد المستشري دون إرساء أجواء من الشفافية والمحاسبة وإعلام حر ينتصر
لمعايير الكفاءة والنزاهة.
إن مفتاح الثورات أو التغير أو أي إصلاح جدي هو الميدان السياسي وتغدو
الدعوات لرفع أدوات القهر والقمع هي البداية الصحيحة التي توفر فرص نجاح
عملية التغيير أو الإصلاح بأبعاده المختلفة، خصوصاً وأن المجتمعات العربية
تحتاج في الظروف المأزومة والحرجـة التـي تمر بها إلى نموذج في العلاقة بين
السلطة والمجتمع قادر على بلورة حد من الإرادة الجمعية وتمثيل المصالح
المتعددة والمتباينة لكل طبقاته وفئاته. ما يعني أن الإصلاح الشامل المتعدد
الوجوه والحقول والذي يقترب كثيراً من مفهوم التغيير الديمقراطي هو ما
يفترض أن يكون محط اهتمام الساعين لإنقاذ بلدانهم مما هي فيه، وهو الضرورة
الملحة التي تمليها حاجات المجتمعات ومسارات تطورها الطبيعية.
صحيح أن محتوى الإصلاح ووتيرته وآفاقه يتعلقون بشدة بخصوصية الحاجة إليه
في كل مجتمع على حدة وتنوع أنماط الحكم في العالم العربي وتمايز مصادر
شرعيتها، وهنا يصح تصنيف النظم السياسية القائمة في البلدان العربية إلى
نمطين يتوزعان بين النظم الجمهورية والنظم الملكية أو الأميرية، لكن الجامع
بينها مع احترام وحفظ المسافات والتباينات هو ضعف قوامها الديمقراطي بصورة
عامة، وتتفاوت درجة الضعف بين نظم تعادي أبسط مظاهر الحياة الديمقراطية
بغياب أدنى حقوق الإنسان وحرياته وهي الأغلب عدداً وبين أخرى يتمتع إنسانها
ببعض حقوقه وحرياته، وتالياً إذ تختلف هذه النظم بين بعضها من حيث شدة
أزمتها ودرجة حاجتها للإصلاح والحاحيته وطابع مهامه، وحقيقة القوى المؤهل
للمبادرة فيه، فإنها تتفق من حيث جوهر الأمر على هدف واحد هو إعادة إنتاج
مصادر شرعيتها، على النحو الذي تلغى فيه المصادر الشمولية والتوتاليتارية،
لتحل محلها الشرعية الديمقراطية الدستورية المستمدة من الرجوع إلى الناس
ومن التوافق الوطني العام. ولعل عنوان هذا التحول هو إسباغ المعاني
الجمهورية على النظم الجمهورية بتحريرها من أساليبها الأوتوقراطية ومن
قوامها التسلطي وأيضاً تحويل النظم الملكية والأميرية إلى ما يشبه الملكيات
الدستورية وخلق مقومات لتنشيط تفاعلها مع الدينامكية الاجتماعية والسياسية
واستحقاقاتها.
لقد دق ناقوس التغيير، والتطورات التي حصلت وتحصل في عدد من البلدان
العربية أيقظت قطاعات واسعة من الرأي العام وشجعتها على تحسس همومها
ومصالحها ومنحت فكرة الانتقال نحو الديمقراطية حضوراً قوياً لتشغل الحيز
الذي يليق بها في بناء المجتمعات وسبل تقدمها، ما يعني أنه بات من المطلوب
من كافة الأنظمة العربية المبادرة لإنجاز انفتاح واسع وجريء على الشعب
وقواه الحية وإزاحة حالة التسلط والاحتكار التي سادت لزمن طويل، والاعتراف
باستحالة مواجهة الانسداد القائم اليوم وهذا الإخفاق الذريع في مسارات
التنمية دون انجاز تغيير أو إصلاح سياسي حقيقي يدشن، دون تقويض أو تدمير،
عملية الانتقال من أشكال حكم مأزومة إلى الحكم الديمقراطي.


