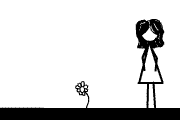استهلال:
لقد تبين في كل حين أننا لا نعرف الكثير عما نظن أننا نعرفه تمام المعرفة، وحالتئذ فالاهتمام بـ “أرنست رينان” وسجاله مع “الأفغاني” يقتضي منا الإلمام بوضعية حركة الاستشراق في القرن التاسع عشر، كما أنه بات واضحا أن الاشتغال على المفاهيم والمناهج من شأنه أن يمهد الثنايا لمقاربات نقدية مقصودها الانفلات من متاهات السجالات الإيديولوجية. وحتى يتسنى لنا الظفر بالأفق الذي يصبح عنده الإشكال الذي نقصد إيضاحه منظورا، نحن مطالبون – استئنافا للبدء – بالانتباه إلى أن القرن إياه، يعد ” قرن الاستشراق بمعناه التخصصي بحق “[1] إذ اتخذ في هذه المرحلة شكلا منظما صارما وتوّسل طرقا ومناهج جديدة مستوحاة من علوم إنسانية مختلفة، ليكون أقرب إلى العلم والمعرفة الموضوعية. فقد نشطت الحركة الأستشراقية على نحو لافت[2]. إلا أنه من الحري بنا أن نوضح تزامن هذا النشاط مع اتساع الظاهرة وانجلاء المطامع واختراق المستعمرات، اختراقا رج الأسس من جهة، واتصال المؤسسات الاستشراقية وارتباط كثير من المستشرقين بالأجهزة والمؤسسات الاستعمارية[3]. ضمن هذا الفضاء الإشكالي سنحاول أن نفهم السجال الذي دار بين “رينان” و “الأفغاني” ذاك السجال الذي اتسعت مساحته النصية و كان محل اختلاف و نقد و تعليق . فما هي مرتكزات ومستندات أراء “رينان” “التي استنفرت “الأفغاني” من أجل استعادة عالمه الذهني المهدد بالانهيار ؟ و إلى أي مدى استطاع “الأفغاني” أن يتابع وأن يفكك بنى و آليات الخطاب الاستشراقي و الوقوف على خلفياته ورهاناته ؟
1- في الخطاب الاستشراقي: بين التّصور الوضعاني والطموح العلموي:
لقد بات واجبا علينا إذن أن نشدّ العزم إلى “النصوص” : “نص الأفغاني”[4] و”نص رينان”[5] الذي انكّب “الأفغاني” على تفحصه، ولكن حقيق بنا أن نشير إلى أن “رينان ” إنما يمثل جيلا من المستشرقين سعى إلى صياغة أفكاره بلغة حديثة حتى تتسم أحكامه بـ “العلمية” وتكتسب في تاريخ الاستشراق بعدا تصحيحيا فاختار “فقه اللغة” مدخلا، سيما وقد بدا في أوج الحماس الوضعاني في القرن التاسع عشر منهجا مخبريا، عبره يستطيع أن يقوّض الفكر الغيبي. ويذهب “إدوارد سعيد” إلى أن “رينان” اعتمد أسلوبا استقاه من الدراسات المعاصرة في النحو المقارن والتشريح المقارن والتطورية العرقية وقد أضفى ذلك على استشراقة امتيازا”[6] وعلى الحقيقة لا يهمنا هذا الأمر إلا من جهة ما هو السياق الذي ظهرت في غضونه تأكيدات ” رينان” اعتداده بالمنهج العلمي والعقلانية، عنوانا للفكر الحديث، مشيرا إلى “أنه روح كل مجتمع لأن العلم هو العقل”[7]. وكان على وعي بالعلاقة الوطيدة و الصلة الدقيقة بين “فقه اللغة” والثقافة الحديثة، إذ يعتبر فقهاء اللغة المؤسسيين الحقيقيين للعقل الإنساني، و قد تيسر عبر هذا المنهج “الفلولوجي” اختزال موضوع بحثه في جذور لغوية أو عرقية واستنتاج خصائص وصياغة تمثلات حرص على تثبيتها وإن بدت مناقضة للعلم نفسه، فاللغات عضوية حية ولا عضوية، و اللغة السامية بالذات “ظاهرة أعيق تطورها و توقف بالمقارنة مع اللغات و الثقافات الناضجة للمجموعة الهندو-أوروبية[8]“وتبعا لذلك فالساميون أصحاب هذه اللغة ليسوا مخلوقات حية و لا يملكون عقولا متطورة . لا يخفين على الأذهان أن أراء ” رينان ” بشأن “الإسلام” و”العرب” مبثوثة في جل ما كتب وإن ما طرحه في محاضرة: “الإسلام والعلم”[9] ليس بعيدا عما ورد في كتابه “تاريخ اللغات السامية” من تسذيج للجنس “السامي” وإنكار المقدرة على التفكير أو الاستعداد له أصلا. ونرى مفيدا في القصد الذي يعنينا أن نوضح أن “رينان” إنما كان حريصا على تأكيد أن: علومهم نقلية وشعرهم شخصي ينعدم فيه التخيل، وليس ما يحتاج إليه بيان أنه إنما يذهب إلى أنهم إنما هم إجمالا “الآخر” الضد للجنس الآري فـ “الأخلاق نفسها ينظر إليها الساميون نظرات تخالف نظرتنا إليها، والأنانية تتمثل فيهم بأجلى مظهرها ” [10]. وإذا نحن أنعمنا النظر للاحظنا أن ما وجدناه مسندا “للساميين” بوجه عام في الكتاب السابق يوجهه إلى “العرب” و”الإسلام” في “الإسلام والعلم” و تلك قرائن ستفصح عن أشياء لم يمط اللثام عنها بعد. من أجل ذلك يجدر بنا إذا ما رمنا بمطلوبنا فوزا أن نشير إلى أن “رينان” منذ بداية “المحاضرة” إياها، يعلن هدفه ومطمحه من نصه وهو ” الكشف عن أخطاء رائجة في عبارات من نوع “علم عربي” و”فلسفة عربية” و”فن عربي” و”علم إسلامي” ذلك أن مثل هذه العبارات تروّج أفكارا جوفاء تنتج الكثير من الأخطاء والأحكام الخطيرة أحيانا “[11] وليس يمكننا حالتئذ وفي هذا الموضع بالذات إلا أن نتدبّر ما كان قد أشار إليه قبلئذ من طعن وعداء في نسبة العلوم أو الفنون إلى “العرب” أو “الإسلام”. ولدراء اعتراض المعترض إذا اعترض يستند “رينان” في التأكيد على صحة مسعا، إلى حجج، أولها التدني والتخلف الذي يهيمن على المجتمعات التي تدين بالإسلام والتي تتميز بانغلاق التفكير ورفض مطلق للعلم وما لا يمكن أن تخطئه عين المتأمل الحصيف، استناد “رينان” إلى قول احد المفكرين الشرقيين الذي يتفق وما يذهب هو إليه “علم هذه الملة الذي تفخر به إنما هو علوم اللغة والعروض والقوافي والإنشاء، أما الفلسفة فإن اللّه ما علّمهم منها شيئا وما جعلهم أهلا لها”[12] ثم إن الإسلام يلغي ملكة التفكير والتفسير ليحل محلها الاتكال والاستسلام فإلى اللّه توكل الأشياء جميعا – اللّه أعلم – جواب المؤمن وهو جواب يكرّس المنطق الغيبي، ويقلص المنطق العلمي. ولأنه لا يرى في “العرب” عزما على الفعل، يبين أن ما عرفته الحضارة العربية من ازدهار في “العهد العباسي” ما هو بالفتح المبين، إنما مردّة “الفرس” لا “العرب” وضعف “الإسلام” لا قوته والعلوم التي راجت كانت علوم “اليونانيين”وما كانت الترجمة العربية لها إلا تشويها.
ويصل حرص “رينان” على الطعن في نسبة هذه العلوم إلى “العرب” أو “الإسلام” حدّ التشكيك في إسلام بعض “الخلفاء” فهم مسلمون في الظاهر، بل هم بالكاد مسلمون، وحد التحسر الصريح على عدم اضطلاع “البيزنطيين” بمهمة الترجمة بدلا عن “العرب”، وحدّ الطعن في انتساب من نبغ من العلماء إلى “العرب” أو “الإسلام”، ويعثر “رينان” على مصداق لفكرته في “الشيخ – الرئيس” و تلك دلائل يستند إليها في ربط النبوغ بالعرق.
لقد بان مما فات أن “رينان” يضن على “المسلمين” بالقيمة والفضل فيما أنتجوه من معارف، إذ الفضل كله إنما يعود إلى أصولهم التي منها ينحدرون أو أوطانهم التي إليها ينتسبون، ولا نصيب “للعرب” في هذه العلوم إلا الشكل، فهم مجرد لغة صيغت بها تلك المعارف، أما حقيقة و جوهر تلك الفلسفة العظيمة فـ “إغريقية”، “ساسانية”.
ويشير “رينان” إلى أنه إنما نحن “تعودنا أن نسميها عربية لأنها كتبت بالعربية لكنها في الحقيقة إغريقية ساسانية “[13]. وأنه في أفق هذا الفهم يؤكد “رينان” على عداء “الإسلام” للعلم واضطهاده للعلماء مبينا أن كلمة ” فيلسوف” باتت مرادفة لكلمة “زنديق” عندهم، وإن الطور الأول من تاريخ “الدولة الإسلامية” لما كان الأمر كله بيد “الأمويين العرب”، ما كان للعلم صدى يذكر وحتى زمن ازدهار العلم فإن “الإسلام” كان عاجزا عن صده. ومما لا نزاع فيه عنده أن ” الإسلام كان متحررا عندما كان ضعيفا وكان عنيفا عندما كان قويا “[14] وتلك أصداء لفكرة مركزية : حول “استبداد الشرق” و”طغيانه” [15] ويمضي في نظرته العرقية المكشوفة بنبرة أشد وطأة وأثقل تأثيرا مؤكدا لعداوة جوهرية في “المسلم” وخاصية أساسية تجعل منه “الغل الأثقل الذي تحتمله الإنسانية “[16]. ولأن “رينان” يتكئ على نسق إسناد ومرجع و يستند إلى جهاز مفهومي نمطي يميل ميلا غير يسير إلى الرؤية الاستشراقية، يبقى أسير مفاهيم المجال المعرفي التقليدي، على رغم كل الادعاءات اللفظوية، تلك التي غايتها التوحيد والاختزال، ولأن المركز يتحدث عن الهامش، حديث الوحدة عن التعدد، حديث الغياب عن الحضور، يبرز الطابع ألاستبعادي، القمعي. في ضل هذا التمثل يضرب”الطهطاوي” وتعليقه على “العلوم الغربية” وقوانينها -وفي نفسه ريبة عريضة -، مثلا و دليلا على عداء المسلم الطبيعي للعلم، ونفوره منه.
- ولأن مأرب “رينان” الانتصار “للعلم” روحا للمجتمع، تنتهي المحاضرة علامة على حضور العقل وأساسا لكل تقدم، وإن ما هو لافت حقا – ما كنا قد أشرنا إليه طي هذا المدخل – اللغة الموسومة عنده بميسم الدعوة، وانشداد وعيه انشداد تلازم إلى وعي “الداعية”.
لعل من الأفيد الآن أن نذّكر – كما سبق و أن أومأنا – أن “رينان ” جاء إلى الاستشراق من “فقه اللغة” متوسلا منهجه وكان على ثقة بنجاعته. والناظر في “المحاضرة” يقف على تصرف ” رينان” في آليات ذلك المنهج، تصرفا يمنح خطابة قوة وسلطة كفيلة بصنع “الشرق” وإعادة إنتاجه، فنلاحظ ميل “رينان” إلى إطلاق أحكام صارمة تثبت الثقافة في جواهر انطولوجية جامدة، وخروجه بأحكامه من حيز الوصف إلي حيز التقييم والمفاضلة لصالح “الغرب”. فهو كجل معاصريه الوضعانيين مشدود أيما انشداد إلى ايدبولوجبا عصره “[17] تلك الايديولوجيا العنصرية الاستعمارية التي تنزع إلى تهميش الشعوب ثقافيا وروحيا، فتبدو هشة وقاصرة وتنضوي إراديا أو لا إراديا في الثقافة المركزية. وهكذا تتضح ملامح خدعة فللولوجية وخدعة علماوية. ذلك أن “رينان” يتعامل مع مادة بحثه تعاملا انتقائيا تجزيئيا ويقيم أحكامه على افتراضات اعتباطية “فالحديث عن اختصاص قسم من شعوب العالم بالنزعة العقلية أو النزعة الإنسانية دون القسم الأخر هو بذاته افتراض لا تاريخي”[18]. ولم يستطيع “رينان” التحرر من مسلماته التصنيفية العرقية، ومحاولاته إلغاء تعدد الثقافات وتنوعها[19]، مما صبغ آراءه بكثير من المغالطات وظلت منهجيته المقارنة، وهي تعتمد القياس في غياب الشروط الموضوعية والحضارية: سطحية.
- وكانت تعبيرا عن ذهنية متعصبة للوضعانية والعلماوية من ناحية، مؤسسة للمركزية الأوروبية من ناحية ثانية، مجسدة لعداء معلن على “الإسلام” و”الشرق” عموما من ناحية ثالثة. فـ” ليس من الإغراق في شئ أن يقال إن مختبر “رينان” اللغوي هو الموضع الفعلي للمركزية الأروبية”[20] .
لقد استقام لدينا أن “رينان” تناول في هذه المحاضرة، جوانب جوهرية وعميقة في شخصية المسلم وثقافته ودينه، هي بمثابة الثوابت في رؤيتة لنفسه ولعقيدته. ولذلك كان لهذه المحاضرة رغم صبغتها “العلمية ” بعدا استفزازيا[21]. ولأن غرضنا أن نتعقب أطوار “المناظرة” بين “رينان” و”الأفغاني” نأتي الآن إلى تحليل ما كان من ردود مقصودها، ” الذب عن الدين والوطن”: وليكن منا على بال في هذا الموضع بالذات، أن تلك “الردود” استطاعت أن تخترع مقاما للتسآل: عن من هم الذين ليسوا نحن؟ بيد أن ما يعنينا هنا هو: هل استفادت “الردود” من المفاهيم والمساءلات وتمكنت من انجاز تحولات في بنى الخطاب ومن جعلها مدخلا وهاديا لمشاريع قراءات نقدية؟ أم أن التصور الأخلاقي للنفس التي تخصنا ينتصب عائقا رئيس أمام التمثل التاريخي؟
2 –الأفغاني بين عقدة الأصالة واختراق الاستشراق:
نوّد أن نبين في البدء أن “الرد” لم يكن ردا فوريا، كما انه لم يكن ردا عدوانيا يكيل الاتهامات لـ “رينان” وإنما كان ردا هادئا شديد “الترفق ” إلى درجة ساير فيها “رينان” في الكثير من الملاحظات التي أبداها عن اضطهاد الإسلام للعلماء، والتمس لـ “رينان” العذر فيما أطلق من أحكام و كان دفاعه عن الإسلام “دفاعا مقتضبا ومتوشحا بالعقلانية الهادئة”[22] ولكنه على كل حال لم يخل من العمق ولا من الطرافة. فقد بدا “الافغاني”ملما بمضامين “المحاضرة” إياها، لذلك ركز نظره على النقطتين الأساسيتين: اتهام الإسلام بعدائه للعلم واضطهاد للعلماء وطعنه في قدرة “العرب” على التفكير العلمي والفلسفي واستعدادهم له ونزعه العروبة عن الكثير من المفكرين والفلاسفة أمثال “ابن رشد” و”ابن سينا” و”الفارابي”.
وإذا كان “الأفغاني” قد رام التوقف عند الطابع العام لطروحات “رينان” فإنما كان ذلك للإمساك بالخيط الناظم لأفكاره، وبالتالي نحى منحى التمييز بدءا بين “الإسلام المحض” أو “الإسلام الحق” و”الإسلام ممارسة”: تشارك فيه عناصر كثيرة، منها طباع الشعوب التي اعتنقته و لكنها لم تتخلص نهائيا من أخلاقها وطباعها.
ومن هنا كان التساؤل عن أصل الشر/ الانغلاق و التخلف ومعاداة العلم: “أصادر هذا الشر عن الديانة الإسلامية” أم كان منشؤه الصورة التي انتشرت بها الديانة الإسلامية” [23] . و لا يكتفي بتبرئته “الإسلام المحض” مما أوكل إليه من تهم بل يهتم بـ “الإسلام ممارسة” عبر مقارنة بين ما حدث للعلماء في ضل “الإسلام” وما لا يزال يحدث للعلماء في ظل الكنيسة، ليثبت أن الأمر لا يتعلق بالإسلام دون غيره من الديانات. ثم أن إنعام النظر في هذا الشأن يجعله يلاحظ أن: “رؤساء الكنيسة الكاثوليكية المبجلون لم يلقوا أسلحتهم بعد وهم عاكفون على محاربة ما يسمونه بالتدليس و الضلال ” [24] . وحتى يكون المعنى مستبينا يشرع في دحض الاتهام الثاني الذي يطعن في قدرة “العرب” على التفكير و استعدادهم لتقبل العلم ، فيبين أنه ليس من المبالغة في شيء الإشارة إلى سرعة تكيف “العرب” مع “العلوم اليونانية” ، و إحيائهم للعلوم المندثرة و إثرائهم للعلوم المترجمة توضيحا و تنسيقا ، وإنه هنا بالذات إنما ينكشف ملمح من فرضية مفادها أن علاقة “العرب” بالعلم طبيعية “أوليس هذا دلالة بل برهانا على حبهم الطبيعي للعلوم”[25]. ولأنه يعتقد أن ذلك شيء قد لا تكون السبيل إلى معرفته يسيرة يوضح أنه لم يشر من المسألة إلا إلى أظهر أنحائها فـ “الغرب” على قربه من تلك المناهل المعرفية “اليونانية” ما اقبل عليها إلا عندما اتخذت صبغتها “العربية” مما يثبت ما سبق وأن أومأ إليه، وبهكذا يبلغ “الأفغاني” إلى هذا الزعم الرائع والذي مفاده أن “العرب” لم يكتفوا بالنقل – فهم على ظمأ بهم إليه – بل أضافوا فبلغوا بتلك العلوم “مرتبة من كمال تدل على سلامة الذوق و تنطوي على التثبت و الدقة النادرين “[26] فـ “الأندلسي” ظل عربيا و إن تغير موطنه و” الحرّاني ” عربي الأصل واللغة تاريخيا و إن حافظ على ديانة مغايرة : “الصابئة” ولا يذر “الأفغاني” موضعا دقيقا في “المحاضرة” إلا ويقارع عنده، غير أن أقطع ما يذهب فيه هو أن الانتماء إلى “اللغة” و”الثقافة” أقوى نسبا من الانتماء العرقي . ويلجأ إلى قياس مفحم ، مضمونه أنه “لو فعلنا ذلك لقلنا “نابليون” لا ينتمي إلى “فرنسا” و لما صح لـ “ألمانيا” و لـ “أنقلترا” أن تدعى كلتاهما الحق في العلماء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصولهم إليها من بلدان أخرى ” [27]. في الحقيقة لم يكن وقع هذه “المقالة” اخف من وقع “المحاضرة” فهي بطبيعتها الهادئة لم ترض تطلعات المسلمين فقد ” كان رده هادئا في بعض نقطه”[28] وبطريقة ذات دلالات عالية “يعقب”، “رينان”، مشيدا بـ”ذكاء” ، “الأفغاني” وعمق نظره وتحرره والذي يعود يقينا إلى “أصوله المنحدرة من أعلى “إيران” المجاور للهند حيث لا يزال العرق الآري نشيطا”[29] . وهكذا فهو يجعل من “الأفغاني” عينه حجة ودليلا يثبت به ما يزعمه ويدعيه في “المحاضرة”. أما عن القضايا التي جادل فيها ” الأفغاني” فإنه ينطلق في تناولها من إقرار علميتها بمعنى أنها لم تكن أحكاما انطباعية وإنما هي نتائج قاد إليها النقد التاريخي. فإذا كانت “المحاضرة” تؤكد على الطعن في “عروبة” العلماء وانتسابهم إلى “الإسلام” فإن “التعقيب”، يضيف بأنه ليس كل ما كتب باللاتينية، لاتينياً، ولا كل ما أنجز في البلدان المسيحية ثمرة للمسيحية وهو ما أشار إليه “الأفغاني” “لم يحض “غاليللي” بـمعاملة أحسن من الكاثوليكية، من المعاملة التي حضي بها “ابن رشد” من الإسلام ” [30] . ويستنتج “رينان” أن الأمر إذن لم يعد مقصوراً على الإسلام: -عداء الدين – بل إنما هو صفة مشتركة بين الأديان كافة – وهو عين ما ألمع إليه “الأفغاني” [31]– . وبالتالي فإن المطلوب من العقل الإنساني مسلماً أو مسيحياً “أن يتحرر من كل عقيدة قائمة على الخوارق لتشييد العلم الوضعي” . لقد تميز رد “الأفغاني” حقا عن ردود مزامنة له أو لاحقه و لم يسقط في رصف الاتهامات، وقد تحرى في نصه منهج علميا وبرهانيا قائما على الموضوعية والعقلانية والواقعية أيضا.
فهو لا ينكر كل ما ورد في نص “رينان” سيما والشواهد التاريخية تؤكده، كأخذ “العرب” عن “الفرس” و”اليونان” ولكنه أيضا لم يقر الأحكام المطلقة التي قامت على مغالطات كبرى والتي لا ترى من ماضي الإسلام والمسلمين إلا ما يجعله العدو اللدود للعلم والعلماء. ومن هنا كان “نصه” منسجما مع مطمح فكري سعى له “الأفغاني” في جل كتاباته وهو ” هدم الآراء الخاطئة عن الإسلام التي تبناها المسلمون ودحض الانتقادات التي يوجهها إليه الأوروبيون “[32]. فتاريخ الإسلام لم بكن دائما انتصارا “لـ النقل” على حساب “العقل”، و الإسلام في جوهرة لا يتعارض مع مبادئ العقل والعلم، و بذلك فهو لم يكن عدوا للعلم والتقدم بل حافزا عليها. إن “الأفغاني”يقرأ الإسلام ويقدمه إسلاما جديدا يحمل في طياته “رسالة عالمية”، وكان حريصا على إثبات ألا تعارض بين جوهر الإسلام وجوهر العقلانية الحديثة ذاتها. لذلك كان طريفا في الرد على مطاعن “رينان” ، دقيقا في كشف زيفها، ولكن ما يبدو واضحا هو أن حافز “الأفغاني” إنما كان الدفاع عن الأصالة، أصالة العلوم العربية الإسلامية وإسهام “العرب المسلمين” في صنع الحضارة الإنسانية، إسهاما يتجاوز الترجمة أو النقل. أما الوعي بخصوصية الخطاب الاستشراقي وطبيعته: سلطة وإنشاء، ومكوناته و الخلفية التي يستند إليها، فإنها أشياء كانت بعيدة إلى حدّ كبير عن تفكيره. ” كان “الأفغاني” كعدد كبير من المفكرين على غير وعي بالشروط الموضوعية و التاريخية و المنهجية التي كانت توجه من الداخل نظرة الأروبويين إلى تاريخ الفلسفة خلال القرن الماضي – التاسع عشر – وبداية القرن- العشرين – وهي ذات الحقبة التي نشطت فيها الحركة الاستشراقية”[33]. لا نجد في رده تحليلا للخلفية العنصرية التي يؤسس عليها “رينان” خطابة والتي تكرس تفوق العرق “الآرى” على العرق “السامي”. هذه الخلفية التي كانت الإطار الموجه لجل المستشرقين، فهم يتحركون في إطار المركزية الأوروبية[34] والفكر الأوروبي “الذي نبغ أول أمره في بلاد اليونان وظل يشق طريقة غربا إلى أوروبا الحديثة ” [35] فقد كان حسب “رينان” “الإغريق المصدر الوحيد للمعرفة والفكر المستقيم “[36]. ولكن ومن ناحية ثانية فإن أفكار “الأفغاني” – الواردة في الرد – تكشف عن زيف هذه المركزية و تقوضها من الأساس ” فـ “الأفغاني” يخشى الاختراق الاستشراقي بمقدار ما يخشى الاحتلال السياسي ” [37] ولكنا نصل إلى التأكيد على إن “الأفغاني” -سياسيا- كان على وعي تام بخطر التدخل الأوروبي وبضرورة التصدي للمطالع الغربية وذلك بالتحرر من النظرة التمجيدية للماضي والاستجابة إلى مقتضيات الحاضر: فقد أن الأوان “للمسلم” أن يحاول فهم الآلهة الأخرى التي تؤمن بها شعوب أخرى وذوات بشرية مختلفة. لقد كان على اطلاع على ما يروجه “الغرب”[38] من تشويه للإسلام و الحضارة الإسلامية، وعلى وعي بالصلة الدقيقة بين مثل هذا التشويه و قتل الإرادة والاعتزاز بالذات لذلك كان يدعو إلى قراءة الإسلام والتراث عموما قراءة جديدة وفهمها “فهما يساعد المجتمعات الشرقية المهدد بخطر تفاقم السيطرة الاستعمارية على مواجهة هذا الخطر “[39] خاتمة:
لقد كان مرادنا تبيان أن الاستشراق نمط مختلف من المعرفة التاريخية وخطاب متميز له نسيجه الخاص، وباستواء الرؤية على هذا النحو توضح أنه خطاب “لا يعكس حقائق أو وقائع بل يصور تمثلات أو ألوانا من التمثيل حيث تتخفى القوة و المؤسسة والمصلحة ” [40] ذلك أنه علينا أن نحترس فـ “المستشرق” منتج مخصوص له تصور واضح لدوره باحثا محترفا في المجال الذي اختاره وهو ما من شأنه أن يزيح النقاب عن أنه أيضا في ارتباط بالثقافة التي ينتمي إليها، وليس يتم ذلك بغير الوعي بطابعه الإشكالي. ومهما كان الطموح الذي نفصح عنه فلسنا نستطيع اتخاذ موقف معاد ورافض للإستشراق على اعتبار المدونة الاستشراقية الضخمة كمّا هائلا من التقييمات السلبية تصور صورة “الشرق” وتقزّمها في مرآة نفسه قبل غيره، إنما غرضنا يكون بالضرورة تفكيك المركزية التي يقوم عليها الاستشراق والتي تؤسس لعنصرية وأحادية ثقافية.[41] ولن يتم انفضاح المحورية الغربية وإبانة تصدع كثير من مرتكزاتها وتفكيكها بالانكفاء على الذات وقد انطوت في ركن ركين تحاصرها الاتهامات، وتلهث بحثا عن أدلة تثبت براءتها وآيات تبطل مطاعن ومزاعم مستشرق مفعم بالتلذذية والنزوع العجائبي. كما لا يتم ذلك بالعداء المعلن أو المضمر ولا بالردود السجالية المتسرعة ولا بإنكار كل ما يصدر عن المستشرق ولا باللجوء إلى “ابتكار الاستغراب جهازا نهضويا من أجل كسر هذه العلاقة وتنظيم عملية تحرير الشرق من ربقة الغرب”.[42] فمثل هذا المنهج يولد استشراقا معكوسا ويخلق تمركزا جديدا لا يحرر الثقافة بقدر ما يجعلها أسيرة ذلك الوهم الاستشراقي: الدونية والعجز “وهذا مأزق يجب تلافي السقوط فيه “[43] وإنما يتم ذلك – تفكيك المركزية وإبطال هيمنتها – بالتعامل الموضوعي الواعي بأهمية الاستشراق من حيث هو رؤية الأخر للذات، عدا ما قدمه الاستشراق للثقافة العربية – مما لايمكن أن نحصي – من نشر وتحقيق العديد من المخطوطات ” فمعظم كتب التراث الإسلامي حققها مستشرقون أجانب” [44] . ثم إن الخروج من نير تلك الهيمنة يقتضي الوعي أولا بأن اهتمام “الغرب” بالشرق لم يكن في أية حال من الأحوال من أجل “الشرق” بل كان دوما من أجله هو (=الغرب) ويتم ثانيا بتحليل الفكر الأوربي عموما والفكر الاستشراقي بخاصة تحليلا نقديا من الداخل فـ “مراجعة الاستشراق الأوروبي لا تقوم بنقد الاستشراق فحسب بل بنقد الفكر الأوربي ذاته”[45] فقد نسي الأروبيون ما يدينون به للفلسفة واللاهوت العربيين، إنه نسيان ينبع من تمركز حول الذات [46] فمثل هذا التحليل يوقفنا على الرؤية التي تحدوهم والمنهجية التي يسلكونها ورصد الآليات والأساليب التي يتوسلون بها، فتحدث خلخلة جذرية ونقد يقظ يهز نظام المفاهيم والمعرفة السائد، بل قل البناء النظري، الذي يتأسس عليه هذا الاستشراق، هذا الاقلاق هو الذي يزحزح علاقتنا بالاستشراق[47] و”خلخلة تلك الإشكالية بإحداث رجة نقدية في مفاهيمها الأساسية تعني نهاية المعرفة المؤسسة عليها ” [48] والتملك النقدي للفكر الغربي، من موقع التجاوز التحرري.