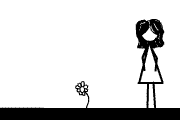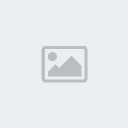منزلة النصّ
د. سعيد عدنان
أريد أن أتبيّن منزلة " النصّ " في إحسان العربيّة ، وإجادة التعبير بها نطقاً وكتابة . وليس بخافٍ ما تردّت إليه اللغة العربيّة عند أهلها ؛ فقد اضطربت على الألسن ، مثلما اضطربت على الأقلام . أريد أن أتبيّن أسباب الاضطراب ، وأن أقترح سبيل العلاج . والأمر كلّه ، بجملة واحدة ، هو أنّ إغفال النصّ الأدبي في دراسة اللغة ، والخروج إلى ما سواه قد أفضى إلى أن تتردّى اللغة في مهاوي الركاكة ، شيئاً فشيئاً ، وأن يضعف مبناها ، ويختلّ معناها عند أهلها .
كانت العربيّة في ما قبل الإسلام تجري على جبلّة أهلها ؛ إذ ينشأ الناشئ منهم في بيئة فصيحة ، تُنزل الألفاظ منازلها ، وتحسن التعبير بها عمّا تريد ؛ فلا يتطرق إلى الأذهان زلل ، أو فهاهة . ذلك أنّ البيئة كانت عربيّة ، ليس فيها ما يصرف الناس عن لغتهم . وكلّ أبنائها يلتقون عند قدر جامع من الفصاحة والبيان ، ثمّ يكون ، من بعد ، للشعراء ومن إليهم مزيّة أخرى في سعة اللغة ، وبلاغة تأليف الكلام .
وطريق التفاضل ، يومئذٍ ، في تملّك اللغة إنّما يكون ، بعد الجبلّة ، برواية الشعر ، وحفظ بليغ الكلام ؛ ذلك أنّ الرواية والحفظ يُغذّي كلٌّ منها ملكة اللغة ، وينهج بها سبيلها ، ويجعلها على جادة العربيّة ؛ تُبين بها ، بل تبلغ من البيان أبعد مداه .
وقد عرف الشعرُ العربيّ قبل الإسلام الشعراءَ الرواةَ كمثل زهير إذ كان راوية أوس بن حجر ، وكمثل كعب بن زهير إذ كان راوية أبيه زهير ، وكالحطيئة وروايته عنهما ، ثمّ يجيء في الإسلام هدبة بن الخشرم فيتمّ الرواية في سلسلتها . وقد أدرك النقّاد من شعر هؤلاء الإجادةَ ، والاستواءَ ، والخلو ممّا ينبو ، والبعد عن مرذول القول . وكان الشاعر الراوية أعلى منزلة من الشاعر الذي لم يزاول الرواية ؛ ذلك أنّ من يروي الأشعار فإنّما يصقل ملكته بها ، ويتعلّم منها مناحي القول ؛ وإنّما الرواية أجلُّ مدارس البيان ، وأعلاها قدراً . وقد كان من شأن أولئك الرواة الشعراء ؛ العناية بقصائدهم ، وتقليب وجوه الرأي فيها حولاً كريتاً ، والصبر على التجويد ؛ حتّى تخرج القصيدة من بين أيديهم نضيجة مستوية محكّكة ، عليها رونق البلاغة ، وسيما الفصاحة . وقد نعت الأصمعي أولئك الشعراء بعبيد الشعر . أي الذين يُجلون مقام الشعر ، ويفونه حقّه كاملاً غير منقوص . وممّا له دلالة سنيّة أن يجيء طه حسين ، من بعد الأصمعي بقرون ، فيقول : إنّي أحبّ عبيد الشعر!
وبقيت للرواية بعد الإسلام منزلتها ؛ فمن رام قول الشعر كان عليه أن يروي شعر الفحول ممّن سبقه ؛ يحفظه ، ويتفهّمه ، ويتشرّب المعاني وطرائق البيان ؛ حتّى إذا قال الشعر قاله صحيحاً مستقيماً جارياً على أصوله .
وكلّ شعراء الإسلام إنّما كانوا يروون شعر الجاهليّة ؛ وعندهم أنّ مقادة الكلام لا تسلس لهم من دون الرواية والحفظ .
ومثلَ الشعراء كان الكتّابُ ، الذين نشأوا مع نشوء الدولة العربيّة الإسلاميّة ، إذ طفقوا يحفظون روائع النثر ؛ من بليغ الخطب ، ورفيع الأمثال ممّا هو مستودع اللغة ، وذخيرتها .
وقد قيل لعبد الحميد الكاتب : ( ما الذي خرّجك في البلاغة ؟ فقال حفظ كلام الأصلع ، يعني عليّ بن أبي طالب . ) وبيّنٌ أن من سأل عبد الحميد كان يعتقد أنّ البلاغة لا تجيء على الفطرة وحدها ، وأنّها لا بدّ فيها من التخريج والتأديب ؛ ولا يكون ذلك إلّا بحفظ نفيس الكلام .
وقد كان الكتابُ العزيز أوّلَ مورد يرده من يروم الخطابة ، أو الكتابة ؛ وآثاره واضحة في خطب الصدر الأوّل ؛ فكلّهم قد حفظ القرآن الكريم ، ووقف على سموّ بلاغته ، وراض نفسه على أن يدنو من بيانه .
وكان قد استقرّ عند أعلام الأدب ؛ أنّ الشاعر لا يتخرّج إلّا بحفظ الأشعار وروايتها ؛ فلقد رُوي أنّ أبا نواس في أوّل عهده بالشعر قصد أبا محرز خلفاً الأحمر يسأله الرأي ؛ فقال له خلف : اذهب واحفظ خمسين ألف قصيدة ، فذهب أبو نواس وحفظ ، ثمّ عاد إلى خلف وقال له : قد حفظت . فقال له : اذهب وانسها ؛ فذهب أبو نواس يلهو حتّى تناسى ما حفظ ؛ ثمّ عاد إلى خلف وقال له : قد نسيتها ؛ فردّ عليه : الآن قل الشعر ! يقول أبو نواس ؛ ما أردت شيئاً من الشعر بعد ذلك فاستعصى عليّ !
وحدّث عنه ابن المعتز في طبقات الشعراء قائلاً : ( وحدّثني ناس عن أبي نواس أنّه قال : ما ظنّكم برجل لم يقل الشعر حتّى روى دواوين ستين امرأة من العرب منهن الخنساء وليلى فما ظنّكم بالرجال ؟ )(ص 194 )
وكذلك شأن غيره ممّن كان يروم مزاولة الكلام ، ويتطلّب الفصاحة والبلاغة .
لقد كان حفظ الشعر والنثر شرطاً لا يستقيم من دونه حسن استعمال اللغة ، والبيان بها .
وقد كانت اللغة يومئذٍ ، في القرون الأولى ، وثيقة الصلة بالحياة ؛ لا تنفصل ألفاظها عمّا تدلّ عليه . وكان الفكر حيّاً قويّاً يخوض غمرات التجربة الإنسانيّة كلّها من دون حذر أو وجل ؛ فلا غرو أن تكون اللغة مثله في القوّة والحيوية .
وكلّما كان الفكر حيّاً خصباً كانت اللغة حيّةً خصبةً ، أمّا إذا انطفأ الفكر ، وخبت جذوته فإنّ اللغة تيبس ، وتنطوي على نفسها ، وتنفصل شيئاً فشيئاً عن الحياة .
لقد بقيت العربيّة حيّةً مشرقةً على الألسن والأقلام حتّى تقهقرت الأمّة ، ، وفاتها مكانُ السيادة ، ودبّت أقوام أخرى فبسطت نفوذها على الأرض ، وجعلت العرب تحت جناحها ؛ فجفّ الفكر ، وغاضت ينابيعه ، ولقيت العربيّة من ذلك ما آذاها ، وأضرّ بها .
وقد مرّت قرون من الظلام ؛ ضعفت فيها اللغة عند أهلها ، وشاعت لهجاتٌ بين الناس ، وقلّ من بقي حريصاً على سلامة العربيّة وفصاحتها ؛ حتّى مطالع عصر النهضة إذ شرعت الأمّة تستفيق ، وتسعى أن تستردّ ما كان لها ، وأن تحيي لغتها ، وتجعلها قادرة على مواكبة العصر .
وقد سلك رادةُ النهضة سبيل الرجوع إلى أعصر العربيّة الأولى ؛ يتزوّدون منها ، ويجعلونها منطلق الإحياء ، واستعادوا مبدأ تعلّم العربية القديم : حفظ الأصيل الجميل من النصوص ؛ فحفظوا من الشعر الجاهليّ ، والإسلاميّ ، والعبّاسيّ شيئاً كثيراً ؛ أدّى إلى استقامة ألسنتهم ، وفصاحة أقلامهم . وكان محمود سامي البارودي عَلَم الإحياء الأدبي ، وكلُّ من جاء بعده سلك سبيله في الرجوع إلى منابع اللغة .
وكلُّ نهضة إنّما تبدأ باللغة ؛ ترعاها ، وتصلح من شأنها حتّى ينهض الفكر بها . وقد شهد القرن التاسع عشر ، في نصفه الثاني ، من الإمام محمّد عبده مجدّداً في الفكر والدين واللغة ؛ وقد كان من حميد أثره في ساحة اللغة ؛ أن أدخل كتابي عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة إلى الأزهر الشريف ، وهما ما هما ؛ في إدراك البيان وتذوّق الأدب الرفيع . وأدخل معهما الأدب من شعر ونثر ، وصارت له حلقة في الأزهر تدرّسه . وقد كان ألمع من وقف درسه في الأزهر الشريف على الأدب ؛ يدرّس الشعر القديم ، ويشرحه ، ويجعله دانياً من طالبيه ؛ هو الشيخ سيّد بن علي المرصفيّ ، الذي تخرّج به جلّة شيوخ الأدب في مطالع القرن العشرين كمثل طه حسين ، والزيّات ، ومحمود محمّد شاكر ، وغيرهم . وكانت طريقته خير طريقة في تكوين الملكة الادبيّة ، وصقل الذوق ، وتعليم الكتابة ؛ يقول طه حسين عن المرصفي ومذهبه : ( مذهب الأستاذ المرصفي نافع النفع كلّه إذا أريد تكوين ملكة في الكتابة وتأليف الكلام ، وتقوية الطالب في النقد وحسن الفهم لآثار العرب . ) . وهو خير منهج يصل الدارس بتراثه العربيّ القديم ، ويجعله على بصيرة في الأدب القديم . وقد كان لهذا النهج الآثار الحميدة في ما شهده الأدب العربيّ الحديث ، وشهدته الثقافة كلّها في مطالع القرن العشرين ؛ من وضوح البيان ، وحسن بلاغته .
غير أنّه لم يقدّر لهذا المنهج في دراسة الأدب أن يبقى حيّاً ؛ إذ سرعان ما أفل ، ونشأ منحيان آخران في معالجة الأدب ؛ الأوّل : تاريخ الأدب ، والثاني : معالجة الأدب العربيّ بمناهج النقد الأوربيّ . وقد نحّى كلٌّ منهما " النصّ " وصبّ عنايته على أمر آخر . فلقد عُني تاريخ الأدب بالبيئة ، والسياسة ، وشؤون العصر ، وأخبار الأديب ، وبكلّ ما يقع في السياق ، واكتفى من النصّ بالشاهد اليسير . وصار الدارس يقف عند العصر وتاريخه أكثر ممّا يقف عند النصّ وتذوّقه . ونشأت أجيال لا تحفظ من الآثار القديمة شيئاً . ثمّ اتّجهت العناية نحو مناهج النقد حتّى تقدّم المنهج على النصّ ، وأضحت الغاية أن يبسط المنهج وعناصره ، ثمّ يُؤتى بالشاهد اليسير على كلّ ركن من أركانه ؛ وكأنّ المراد أوّلاً المنهج وليس النصّ !
لقد وقف هذان المنحيان : تاريخ الأدب ، والإقبال على مناهج النقد ؛ يحولان بين القارئ والنصّ ، ويزهّدان الناشئة بالحفظ ، وتأمّل النصوص ، ويُريان الدارسين أنّ المعرفة الصحيحة إنّما تكون في ما يأتي به تاريخ الأدب ، أو ينبثق عن مناهج النقد .
ولا ريب في جدوى تاريخ الأدب ، ولا ريب في جدوى مناهج النقد الأدبيّ ، ولكنّ لا يصحّ أن يُبعدا المنهج القديم القائم على الحفظ ، والشرح ، والتذوّق ؛ إذ هو وحده القادر على تكوين الملكة اللغوية !
لقد أدرك اللغةَ الضعفُ حين ابتعد الناشئة عن حفظ الآثار الأدبيّة القديمة ، وتأمّلها ، وتذوّقها ؛ ولكي يرجع للغة بيانها ، وترجع إليها متانتها ، وفصاحتها لا بد من أن يستعاد المنهج القديم في تلقي اللغة ، وتذوّق آثارها ، ويجعل إلى جوار المناهج الحديث في دراسة الأدب ونقده .
أقول : لا بدّ من حفظ النفائس حتّى ترجع اللغة حيّة مشرقة ؛ وأوّل ما ينبغي حفظه : القرآن الكريم ؛ تُحفظ آياته وسوره مع تفهمها ، والوقوف على أسرار البيان فيها ، ويُحفظ من الشعر القديم مع شرحه ، والوقوف على جوهر البيان فيه ، ويُحفظ أشياء من النثر .
ولا بد أن تُعنى مناهج الدراسة في المدارس أوّلاً ، وفي الكليّات ؛ في أقسام اللغة العربيّة ؛ أقول لا بد أن تُعنى بالنصوص وحفظها وتذوّقها ، وأن يكون لها المحل الأوّل في مدار الدراسة ، وألّا يتقدّم عليها ما سواها.
إنّ سبيل رعاية العربيّة ، وحسن القيام عليها لا يكون إلّا بإنزال " النص " منزلته الرفيعة ، وتقديمه على ما سواه ...!