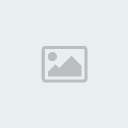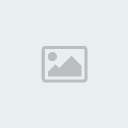
تــقــديـــم
يسعى هذا المقال، على عكس النقد (السهل جدّاً) للاستشراق، أن يذكّرنا بأنّ الدراسات الإسلاميّة (الإسلاميّات) المتولّدة عنه، ما يزال لديها ما تعلّمه للمثقّف غير المختصّ حول ثنائي الإسلام (السنّي) والسياسة داخل العالم الإسلامي المتوسّطي. فالدراسات الإسلاميّة السابقة تقودنا أوّلاً إلى فهم المفردات السياسيّة العربيّة الإسلاميّة، لترسم من ثمّة صورة الإنسان في مدينة يحكمها الإسلام التاريخي، قبل أن تقوم بإبراز استخدام محدّد للزمن ينعكس على اشتغال الناس بالسياسة ضمن نظرتهم إلى عالم شكّله الإسلام. وحول هذه النقاط الثلاث، يوفّر الاستشراق، المتحوّل بشكل أو بآخر إلى دراسات إسلاميّة، معارف أساسيّة سيتمّ تتبّع آثارها في بعض المقاربات المعاصرة لثنائي الإسلام والسياسة التي قدّمها باحثون من داخل المدار الإسلامي أو من أفق فكري شكّله الإسلام.
ففي الوقت الذي تتفشّى فيه فورات حمّى الانغلاق على كامل ضفاف البحر المتوسّط، يبدو من العاجل تسليط الضوء على منجزات العلوم الاجتماعيّة في مجال العلاقات بين الدين والسياسة، أكثر من أيّ مجال آخر. وهذا ما يدعو إليه دانيال ريفي من خلال مقاربة تثبت وجود استمراريّة لا قطيعة فيها، بين الإسهامات السابقة للاستشراق الذي تنحدر منه الدراسات الإسلاميّة المعاصرة، وبين إسهامات الباحثين الحاليّين الذين يستأنفون أحياناً مع مفكّري الإسلام حواراً كان توقّف بسبب الصراعات الاستعماريّة والوطنيّة خلال القرن العشرين، مقدّمين مقترحات متجدّدة حول هذا الثنائي الإشكالي.
***************
لا نستهدف في هذا المقال إعادة تأهيل الاستشراق كفرع من المعرفة حُكم عليه بالإعدام من قبل هيئة الباحثين عند المنعطف المعرفي لسبعينات القرن الماضي حين طالب فوكو وبورديو، والمتأثّرين بهما، بإنشاء علاقة جديدة بالعلم، والإجهاز على النزعة الإنسيّة القديمة المتحجّرة داخل تابوت الأعراف الأكاديميّة النخرة. وهذا ما امتدحه مؤتمر المستشرقين الذي عقد في باريس في عام 1973 (بعد مرور قرن على المؤتمر التأسيسي) بكلّ سرور معلناً نهاية الاستشراق وتشتيته على عدّة علوم إنسانيّة. ولعلّه من المهمّ أن نذكّر بأنّ العلماء (وليس فقط لويس ماسينيون Louis Massignon) قد وضّحوا لمعاصريهم أنّ الإسلام لم يكن ديناً أثريّاً يتدثّر به المستضعفون لبعض الوقت: إلى حين تتمكّن سياسات التنمية (العالم الثالث في نسخته التكنوقراطيّة) أو القطيعات الكلّية مع النظام الاستعماري (العالم الثالث في نسخة المثقفين من طراز فرانتز فانون Frantz Fanon) من تحويل المسلمين إلى أناس منمّطين، وبالتالي غير قابلين للتغيّر، وإلى إنسيّة جديدة مؤسطرة لن يكون فيها للدّين، بوصفه عكّازة المستغلّين، أيّ سبب للوجود، أو ليكون فحسب، السمة المميّزة الضامنة لأصالة الأمّة.
إنّ إسهامات الاستشراق لا يمكن كنسها إلى مزبلة العلم. فنحن مدينون لعلماء الإسلاميّات السابقين بإثبات أنّ سكّان الضفّة الجنوبيّة للبحر الأبيض المتوسّط يواصلون، متوغّلين في القرن العشرين، قبول المقدّس الذي يصدم تصوّرنا [الأوروبي – م] التطوّري والغائي للتاريخ ويُزعج فهمنا لمكانة الدين في بناء المدينة. فتعريفهم البليغ لعلاقة المقدّس بالسياسة يُغضب باحثي اليوم المقاومين لكلّ تعميم والمعتبرين الإسلام سديماً لا يضمّ داخله سوى حالات خاصّة وإعادة تركيب مستمرّة. إنّ عدداً من العلماء المعاصرين يرفضون، في الواقع، تسمية “علماء الإسلاميّات” (بديل “المستشرقين”) لابتساره تعريف من يعيش في ديار الإسلام من خلال بُعد واحد: الدين. وهم يجادلون بأنّنا لا نتحدّث عن “علماء مسيحيّات” ولا “علماء يهوديّات”. إلاّ أنّهم يكتفون بتفكيك مقولات الفكر والمعارف المتوارثة عن أسلافهم، ولا يقومون، باستثناء علماء السياسة منهم، باقتراح مقاربة فوقيّة للمسألة تعتمد شبكة قراءة محدّدة.
فلويس ماسينيون يعرّف الإسلام بأنه “ثيوقراطيّة علمانيّة ومساواتيّة”، ومونتغمري وات (Montgomery Watt) بأنّه “حكم الشريعة الإلهيّة” (nomocratie divine). فيما يتحدّث عالم الاجتماع جان بيير شارناي (Jean-Pierre Charnay)، وهو الأقرب إلينا زمنيّاً، عن “حكم كلام إسلامي” (logocratie musulmane) والفيلسوف حسن حنفي عن “ثيو- ديمقراطيّة” (théodémocratie). لكن لنتوقّف عن اللعبة التي تضع العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام ضمن معادلات، فهي تقليديّة بالضرورة رغم أنّها مثيرة. ولنلحظ أنّ أفضل محلّلي ثنائي الإسلام والسياسة على الضفّة الأخرى للمتوسّط (هشام جعيط، عبد الله العروي، الخ) يتعثّرون مثلنا بشأن هذه العدّة المصطلحيّة غير المتجانسة في ذاتها. ولنوضّح أنّ هذه اللمحة عن الاستشراق القديم، ومساهمته في تعقّل التمفصل الإشكالي للغاية بين الإسلام والسياسة في منطقة البحر المتوسّط، لا تغطّي سوى جزء ضئيل من المعرفة التي بناها علماء الإسلاميّات، إذ هي لا تخصّ سوى بعض المؤلّفين الفرنسيّبن أو الذين ترجمت أعمالهم إلى الفرنسيّة. ولنضف أنّ مراجعة المدخلات الرئيسيّة لموسوعتي الإسلام، توفّر معرفة أساسيّة غير مدرجة ضمن هذه اللمحة التي يدرك كاتبها جيّداً ما يعتريها من ثغرات ونواقص. فلنر ماذا علّمتنا الدراسات الإسلاميّة في نسختها القديمة.
مقاربة مسرد للسياسة متولّد عن لغة المقدّس
لنتذكّر أنّ الدراسات الإسلاميّة هي فرع معرفي أكاديمي وريث، سواء بنسب عمودي أو أفقي، مقبول أو مرفوض، للاستشراق. ومن هذه المعرفة الجالبة للسخرية، وهي سخرية ستتعاظم في فترة النزعة العالمثالثيّة ما بعد الاستعماريّة عنها في فترة إنهاء الاستعمار، حافظت الدراسات الإسلاميّة على شغفها بالمعجميّة والالتزام بفقه لغة نقدي للتاريخ. وقد علّمتنا، من خلال الحفر والتنقيب وفكّ ألغاز النصوص المعياريّة للإسلام، الانفكاك من المعنى الواحدي والقسري للكلمات التي صاغت المفردات السياسيّة للإسلام. فالولوج إلى المعجم السياسي الإسلامي تكتنفه صعوبات جمّة، ولا مندوحة من الاحتكاك به عن قرب لتجنّب الوقوع في فخّ حرفيّة الكلمات، وبالتالي الفهم الخاطئ للمعاني. ويؤكّد لويس ماسينيون أنّ اللغة العربيّة الفصحى تركّز على الفعل لا على الفاعل، وأنّ سيولة الأصل تحت غطاء الدقّة المتناهية للشكل، كانت مولّدة لازدواج المعنى، كما تشهد بذلك وفرة الكلمات الأضداد في جوهرها، وكثرة الترابطات المتعارضة.
ولندقّق في بعض هذه المصطلحات التي تغيّر معناها عبر التاريخ دون أن تفقد أبداً وبصفة تامّة كثافتها الأصليّة: الدولة، القوميّة، الملك، الحكم، الأمّة... دون أن نستعرض جميع المفردات السياسيّة في العربيّة، فهي من الثراء بما لا يُقاس.
دولة: لم يُستخدم هذا المصطلح للدلالة على الدولة العربية الحديثة إلاّ مرّة واحدة في القرآن الكريم (آل عمران، 140). وهو يعني في الأصل تناوب السعد والنحس، أي عجلة الحظّ الذي ترفع بعض القبائل وتخفض أخرى، أي دورة الأسرات الحاكمة. وهذا ما يعنيه ابن خلدون في استخدامه هذا المصطلح في مقدّمته. وبهذا، فإنّ المصطلح المعبّر عن الدولة المعاصرة في العالم العربي ضعيف المضمون الدلالي المضاف. وليس من قبيل الصدفة أن الناس يعانون في آنٍ من إفراط ومن تفريط في الدولة.
قوميّة: انتشر هذا المصطلح المولّد منذ عام 1923 على يد منظّر العروبة ساطع الحصري، وهو حلبي الأصل ولد في اليمن في عام 1880 وتلقّى تعليمه باللغتين التركيّة والفرنسية في اسطنبول. وهو يشير إلى الأمّة العربيّة (“الأمّة الكبرى” عند يعاقبة فرنسا في السنة الثانية للثورة) رغم نبرته المشحونة بالسلبيّة عند المتلقّي، إذ يحيل إلى القبليّة والطائفيّة، وحتّى الانفصاليّة. وهذا التحول في المعنى يثبت المصادرة اللغويّة للويس ماسينيون الزاعمة أنّ المعجم العربي يتكثّف من خلال الارتداد، كما هو الحال في حديقة مغلقة، حيث يعمّق جذوره القديمة التي يغلّف بها كلماته الجديدة، هذا حين لا يقوم باستلحاق كلمات أجنبيّة (ديموقراطيّة، بورجوازيّة،...).
ملك: هل نعرف أنّ هذا المصطلح المستخدم لوصف العاهل في الأنظمة الملكيّة العربيّة المعاصرة وتمييزه عن السلطان في التشكيلات السياسيّة ما قبل الحديثة، لا يذكره القرآن الكريم سوى مرّة واحدة (سورة يوسف) للدلالة على الفرعون (يوسف، أربعة تكرارات في الآيات 43-54)؟ وأنّ استخدامه بعد ذلك في الأدب الكلاسيكي قد اقتصر على الحكّام غير المسلمين (ملوك الكفّار)؟
حكم: هذا اللفظ المستخدم في القرآن الكريم يعبّر في آنٍ عن الحكمة وعن العدالة، ويشير إلى السلطة المكلّفة بمهامّ القضاء. إنّه لفظ قرآني في جوهره وذو شحنة أخلاقيّة عالية – كما يحاجج في ذلك رجل القانون المصري سعيد العشماوي المتشبّع بالثقافة الإسلاميّة دون أن يكون منتمياً للإسلام السياسي – التقطه اثنان من أكبر مفكّري الإسلام السياسي وقاما بتحويل غير مقبول لدلالته قبل إسقاطه على مجال معنوي لم يكن له في الإسلام الكلاسيكي. إنّهما أبو الأعلى المودودي، وبعده سيّد قطب الذي نحت من لفظ (حكم) لفظاً جديداً (الحاكميّة) للدلالة على مطلب دولة قائمة على سيادة حصريّة لله وعلى القطع مع المجتمعات العربيّة المتغرّبة والمرتدّة إلى الجاهليّة. وكما نرى، فإنّ الدراسات الإسلاميّة الكلاسيكيّة تشترك مع الإنسيّة العربيّة الإسلاميّة في التذكير بالمعاني الشرعيّة للألفاظ والسطو عليها من قبل دعاة الإسلام السياسي: إنّها حرب كلمات، ومعركة من أجل احتكار المعنى وفرضه على أنصاف المثقفّين.
أمّة: سيستوقفنا هذا اللفظ وقتاً أطول، وقد كان موضوع تفسير رائع من قبل لويس ماسينيون. تعني هذه الكلمة التي تحيل إلى (الأمّ) في السياق القرآني الجماعة التي عقدت ميثاقاً مع الله من خلال خاتم أنبيائه. تولد جماعة المؤمنين هذه من خلال التوتّر المكوّن للأصول، وتبني نفسها من خلال نكران علاقات القرابة أو الحدّ منها ونكران الروابط بين سيّد وخدم. وهي تتطلّب قفزة نحو كونيّة تقلب الأعراف والممارسات الاجتماعيّة المتوارثة عن الأجداد. وبالتالي، فإنّ (الأمّة) تتعارض مع (الشعب)، أي مع شعب القبيلة أو مجموعة التضامن المحدودة التي ترعى خصوصيّتها من خلال العصبيّة، وهو المفهوم الذي دخل المعجم السياسي العالمي بفضل ابن خلدون. ولكن الأمّة ينبغي تمييزها بشكل واضح عن الجماعة، وهو مصطلح لاحق من حيث الاستخدام على النصّ القرآني ويعني جملة الجسم الاجتماعي، وبالتالي: “الجموع المسلمة”. وقل نفس الشيء بخصوص (الملّة) التي تعني في الأصل المذهب (بالمعنى الأنغلوساكسوني).
ولا نقصد من هذا الاستطراد بخصوص لفظ (أمّة) تمريناً معجميّاً مجانيّاً. فقد استعيد هذا المصطلح للدلالة على الأمّة في معناها الحديث (nation)، وليس فقط للدلالة على المنزل أو الموطن، وهو ما يترجم عنه لفظ (الوطن) المقترض من الشعر البدوي القديم والذي يعني في الأصل مخيّمات الظعن ويُكنّى به عن الحنين إلى المكان وإلى مسقط الرأس. حتّى أنّنا شهدنا في مصر، قبل عام 1914 بفترة وجيزة، هذان المصطلحان يتنافسان في الحقل المعجمي، فنجدهما يتقابلان ويتداخلان للتعبير عن الوطنيّة التي كانت تشهد فترة مخاضها. بل إنّ أوّل حزبين سياسيّين بالمعنى الحديث، تبنّيا بشكل لا يخلو من مفارقة، الاسم الأكثر علمانيّة أو الأكثر تجاوزاً للطائفيّة، وهو (الأمّة)، والاسم الأكثر اصطباغاً بالدلالة الدينيّة، وهو (الوطن).
والحقّ أنّ القوميّة في صيغتها العربيّة الأكثر علمانيّة لم تنفصل مطلقاً طوال القرن العشرين، عن التطلّع، المشوب نسبيّاً بالعلمانيّة، نحو استعادة الأمّة، لا بوصفها جماعة المؤمنين بالمعنى التقليدي للكلمة، بل بوصفها جماعة المصطفين والمتمرّدين المهزوزين في العمق بتاريخ نصف مقدّس ونصف مدنّس، آتٍ من بعيد وما تزال شحنته العاطفيّة قويّة. هذه القوميّة التي ساهم في تحديدها عدد كبير من المسيحيّين العرب ما تزال تخترقها رغبة جامحة في الاندماج من خلال العودة إلى بداية التاريخ (Urvolk عند الرومانسيّين الألمان، والشعب العربي الأصيل عند القوميّين العرب) ونقل القيم التي عاشت عليها الجماعة خلال القرون الأولى، حتّى أنّه لم يحدث قطّ فصل واضح وكامل بين النهضة العربيّة والإصلاحيّة الإسلاميّة .
ولكي ننهي هذا التمرين الموجز على تشذيب المعجم السياسي العربي، نقول على خطى برنارد لويس (Bernard Lewis)، إنّ اللغة الدارجة المستوحاة من الإسلام في مجال السياسة أقلّ تطبّعاً بخطاب الهيمنة بكثير ممّا نجده في اللاتينيّة أو اليونانيّة، وأنّها لا تكرّس بداهة ثقافة الخضوع. هل هي بحقّ صدى أخلاقيّات الثورة التي أعلنها النبيّ محمّد ضدّ الأخلاقيّة المدنيّة البدويّة غير المساواتيّة مطلقاً، قبل أن تُخترق بسمات منتمية إلى الإيديولوجيا الإمبراطوريّة ذات المنحى البيزنطي والساساني؟ ولكن هنا أيضاً لا يجب أن نقع ضحيّة ألفاظ ذات معنى مزدوج أو لا يتوافق استخدامها مع السياق الذي ولدت فيه. فلفظ (صاحب) على عهد النبي يعني علاقة صحبة غير متناظرة نسبيّاً، وهو يعني في المشرق في العصر الحديث، السيّد والرئيس، بينما يعني في المغرب الأقصى قبل الحماية، مجموعة الرجال المحيطين بسيّد (مولى) ويقيمون معه علاقة تناظر كاذبة. إنّهم الأتباع، رجال مدينون لرجل كبير يشكلّون حاشيته، يكسبونه قيمة ويخدمونه، ليكونوا عند الاقتضاء يده التي يبطش بها. وهنا، يحجب المعنى القرآني مظهر علاقة التبعيّة، ويُستغلّ كقناع لإخفاء الهرميّة الاجتماعيّة.
ولعلّ أهمّ ما يمكن القيام به في المقام الأول للتخلّص من تمثّل جامد لإسلام سياسي يُنظر إليه كثابت بنيوي، هو استعادة ألفاظ المعجم السياسي العربي في استخداماتها الأولى، ثمّ الإشارة إلى القيم المتعاقبة التي اكتستها على مرّ العصور، وأخيراً قياس تأثيرها على المخيال العربي الإسلامي المعاصر. فالرؤية التي يؤيّدها المنتمون إلى الإسلام السياسي ويعملون على إدامتها من خلال فرض لغة فوقيّة تنزلق إلى الكلامولوجيا (الكلام الأجوف) تتجاهل تحديداً أنّ للكلمات تاريخ. وهنا مرّة أخرى، يعزّز الأديب المسلم الحديث نهج عالم الإسلاميّات. فمحمّد سعيد العشماوي، المذكور آنفاً، يحتّج على استخدام كلمة (الشريعة) في المطلق المعياري من قبل الإسلام السياسي، إذ لا نجد في القرآن الكريم، سوى أربعة مواضع يُذكر فيها هذا اللفظ الفاتح لكلّ المغاليق. ثلاث مرّات للدّلالة على الطريق الموصل إلى الله، ومرّة واحدة لبيان ضرورة حتميّة: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا (الجاثية، 18). وبين هذه الوصيّة، وهي دعوة إلى بناء الذات، والمعنى المعاصر، يتدخّل كلّ عمل التفسير والتأويل الذي ولّده الفقه مخضعاً الفرد إلى الضمير الاجتماعي لزمانه.
توصيف لنمط إنسان يعيش في دولة تسعى إلى أن تكون مسلمة
ما تعلمّنا إيّاه الدراسات الإسلاميّة في درجة ثانية، هو أنّ الإسلام، المعاش أو المقرّر، أقام أسلوب حياة شكّل إنساناً مدفوعا بالسعي نحو تحقيق مثل أعلى تاريخي ملموس. وبالطبع، فإنّ نمط الإنسان هذا (نحن نتجنّب عمداً العبارة الفيبريّة “النمط المثالي”) منغرس في أماكن وتواريخ متقاطعة مع ثقافات فرعيّة دينيّة.
أهميّة المكان: في كتابه الإسلام الملاحظ (Islam observed)، بيّن كليفورد غيرتز (Clifford Geertz) أهميّة المكان من خلال المقابلة بين النمط الغيور الذي يميّز حسب قوله الوليّ المحارب المغربي، والصبغة المطمئنّة التي تجلّل الحكيم المحبّ للسلام والمسامح في تصوّف جزيرة جاوة . لكن بما أنّ الأمر يتعلّق بمنطقة البحر المتوسّط، فإنّه يجب علينا الاحتراس من هذه الصورة النمطيّة. ففي شرق المتوسّط وتخومه، سعى المثقفّون البارزون في المكتب العربي الذي أنشأته وزارة الحرب البريطانيّة في القاهرة في عام 1916 لدعم حركة “الجهاد العثماني المدعوم من ألمانيا” (سنوك هرغرونجه Snouck-Hurgronje) إلى إقامة تعارض بين العربي البدوي في الداخل والمشرقي الذي يعيش على ساحل البحر المتوسّط. فالأوّل ما يزال غارقاً في الأجواء التاريخيّة للمدينة الإسلاميّة الأصليّة، وهو يمثّل، وفق تصوّرهم، نموذج العربي الأصيل، فيما يمثّل الثاني، المنهك بجرعة زائدة من الاتّصال بالحضارة الأوروبيّة، نمط العربي المنحلّ تقريباً.
لذا، فإنّ للأماكن أهميّتها، ولكن يجب التنبّه إلى صعوبة عدم الوقوع في فخّ التنميط العرقي. إنّها تواريخ في المقام الأوّل يكمن قاسمها المشترك في أنّها محبوسة داخل تصوّر للسياسة مستند إلى مثال إسلامي ما يزال ينتج مفاعيله على السلوكيّات المدنيّة للمسلمين في البحر المتوسّط في القرن العشرين. ويكمن الخطر هنا في تجميد الإنسان الإسلامى (homo islamicus) وتنميطه كما يزعم أنور عبد الملك أو إدوارد سعيد بحجج قويّة.
لقد وضع مفكّرو التقليد السني (أهل السنّة والجماعة) نظريّة لحكم المدينة الإنسانيّة تجمع بين المقدّس والسياسي انطلاقاً من معطى قرآني مضمر حول هذا الموضوع. فنحن نعرف فحسب أنّ الإنسان في القرآن الكريم، هو “خليفة” النبيّ على الأرض وفقاً لعبارة لويس غارديه (Louis Gardet). فالأرض، بالنسبة للمؤمن، هي في الواقع أمانة مكلّف بإدارتها، وعليه أن “يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر” (آل عمران، 110، وعدد من الآيات الأخرى). ومن هنا، فإنّه محمول عليه أن ينشر الإسلام في كلّ مكان وفق مثال للأخوّة الإنسانيّة العالميّة، ولكن ذلك لا يخلو من خطر إقصاء المشكوك في إيمانهم أو المنافقين وأهل الكتاب (اليهود والنصارى)، وهم غير متمايزين بوضوح عن المشركين أو الوثنيّين (الكفّار)، ويمثلّون الهدف الرئيسي للجهاد، أي “القتال في سبيل الله” ضدّ غير المؤمنين، وهو ما يستمرّ تعريفه وشروط تطبيقه مثار جدل كبير بين المسلمين. هل يميّز هذا التصوّر الذي يجعل من الإسلام دين الحقّ، بين الروحي والزمني؟ إنّهما مصطلحان متمايزان في القرآن، ينتمي أحدهما إلى المجال الديني (الدين) والآخر إلى “الحياة الدنيا”. يمكننا القول فيما يتعلّق بالفكر الإسلامي الكلاسيكي، كما بالنسبة للإصلاحيّين المسلمين في القرن التاسع عشر، وإن بشيء من الاختزال، إنّ “الإسلام دين ودنيا”، ولكنّه ليس كما يعتبره الإسلام السياسي “ديناً ودولة”. وهذا يعني أنّه حيثما لا يشرّع القرآن (خلافاً للاعتقاد الشائع، فهو لا يشرّع إلاّ القليل)، يتسرّب السياسي وتتوطّد السلطة الزمنيّة، وهي سلطة لا تقتصر مهمّتها فحسب في منع الانقسامات بين المسلمين وانتشار الفوضى المدمّرة للمدينة، أي الفتنة، وهي التي يعتبرها القرآن أعلى مراتب الشرّ بوصفها اشدّ من القتل. ومن هنا كانت المهمّة الأساسيّة لخليفة النبيّ (الخليفة) هي العمل على إقامة نظام عامّ ودائم يضمن المؤمنين القدرة على العيش كمسلمين أينما كانوا، وهو ما يفترض تحديد المصلحة المشتركة بين المؤمنين (المصالح المرسلة) التي تمثّل الحجر الأساس للفكرة الحديثة حول المصلحة العامّة.
إلاّ أنّه يوجد بين السلطة المثاليّة، التي تقع على عاتق الخلافة، والسلطة الحقيقية التي تُفرض بالقوّة، نفس الهوّة بين السلطة الشرعيّة التي تقنع (auctoritas) والقوّة اللازمة التي تجبر (potestas). وقد اصطدم كلّ البناء الفقهي السياسي الذي أقامه العلماء وكبار مثقّفي الإسلام السنّي بهذا التشوّه، وتحايلوا من أجل التوفيق بين الطوبى والضرورة. وقد أدّى الجمع بين المصطلحات الثلاثة (الدين والدنيا والدولة) إلى بناء مدوّنة انتهى الفقهاء إلى الانتصار فيها على الفلاسفة وعلى دعاة المنافحة عن الإيمان (المتكلمّون). وقد كان لإغلاق حركة الفكر التي تحكم العلاقة بين الله والمدينة (الذي لم يمسّ الإسلام الشيعي) تأثيراته الممتدّة حتّى القرن العشرين. فنحن نلاحظ عند العلماء، الذين تحولّوا تدريجيّاً إلى هيئة مهنيّة ضمن دائرة مغلقة أضحت مجرّد وظيفة في أواخر العهد العثماني، وجود تصوّف بارد، باستثناء قلّة قليلة تجرّأت على ممارسة حقّ النصح للأمير حسب الأمر القرآني. ولكن معظمهم خضع للشعار الذي أطلقه الغزالي منذ القرن الحادي عشر: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. وعند الرعايا، كان هناك مزيج من روح الخضوع ومن التمرّد، إذ كان الخضوع للأمير مشروطاً بقوّته وعدله، وهو تمثّل للسلطة ما يزال ينعكس على القدوة السياسيّة اليوم. فما يطلبه الإنسان العادي أوّلاً من الحكومة، حين لا يكون متعلّماً ومتكيّفاً مع الحداثة السياسيّة، ليس استشارة الجسم السياسي الأوسع، بل أن تكون الحكومة عادلة. فالرغبة في العدل أقوى من المطالبة بممارسة الحرّيات. وقد أشار عالم الاجتماع اللبناني أحمد بيضون بحقّ، بخصوص أعمال الشغب في المدن التي ميّزت السنوات 1970-1980 في العالم العربي المتوسّطي، إلى أنّ الناس يطلبون الخبز متنازلين عن الحرّية.
“حكم الحاضرة”: إسلام متوتّر وليس منصهراً، هذا ما كتبته باقتدار مليكة الزغل حول هذا الماضي الموروث الذي يواصل تأثيره في ضمير المواطنين البسطاء في البلدان الممتدّة من تركيا إلى المغرب الأقصى على طول البحر المتوسّط. فكلّ شيء يتمّ وكأنّ أصواتاً من الماضي ما تزال تنقل إلى الحشود، التي تعيش موجات من المدّ والجزر السياسي كان يؤمّل التوليف بينها في القرن العشرين، نوعاً من التذبذب النوّاسي بين الحكم الفردي والفوضى، أي بين الاستبداد والحرّية المفرطة.
علاقة خاصّة بالزّمن: بين المقدّس والتاريخ
وأخيراً وليس آخراً، فقد أكّدت الدراسات الإسلامية العلاقة الخصوصيّة بالزمن التي تلفّ الفعل السياسي والروحي للمسلمين، فهم يفضّلون زمن التأسيس الذي يشمل اللحظة النبويّة وحقبة الخلفاء الراشدون الأربعة، بما يجعل الحنين إلى الأصول يسكن منذ ذاك الحين ومنذ قرون عديدة ميراث المؤمنين. وقد أدّى بهم هذا الشعور بالفقد، وبالغياب، وبالابتعاد المخيف عن اللحظة التي شهدت انبثاق المقدّس في التاريخ، إلى تصوّر علاقة مع السلطة تتميّز بالخضوع المتردّد وبالتمرّد المضمر. فنجد الانقياد في الظاهر، أو المكتوب، فيما نجد في العمق توتّراً أخرويّاً يفعل فعله في المخيال التاريخي لأتباع الإسلام السنّي في حوض المتوسّط. إنّها نار كامنة تحت الأرض نجت من الانقراض الذي مسّ التيّار الشيعي، وهو انتظار منقذ، ذاك المهديّ الذي يعود آخر الزمان ليهدي إلى الصراط المستقيم هذا العالم المتردّي في الخسران.
هذا الاعتقاد الشائع بأنّ التاريخ يبدأ مع ولادة الإسلام، وأنّه ذاهب إلى الخسران منذ الاختراق الذي لا يمكن تجاوزه والذي تحقّق لحظة التأسيس، يغذّي ثقافة فرعيّة ريفيّة وشفويّة أكثر منها حضريّة كتابيّة. وهي ثقافة تشقّ تاريخ الإسلام المتوسّطي وتكتسي نظرة للعالم توجّب على القوميّة محاربتها، وهذا ما تشهد به جميع مرويّات تأسيس القبائل والمدن. فالتاريخ المحلّي يبدأ مع وصول الإسلام لينحطّ من لحظتها، مستمرّاً في التضاؤل على مرّ القرون. لقد كان الناس سابقاً أعظم خَلْقاً وخُلُقاً، والزمن يُفسد الإنسانيّة الذاهبة إلى البوار. وقد أدرك هنري لاوست (Henri Laoust) تماماً هذا الشعور بالتمزّق الذي يسند تمثّل التاريخ عند الإصلاحيّين المسلمين في منعطف ثلاثينات القرن الماضي في مقال لم يفقد جدّته بعد. فقد كان هؤلاء يرون الدورة التاريخيّة التي قطعها الإسلام “ابتعاداً تدريجيّاً عن حالة أصليّة من النقاء والبساطة والتوحّد العقائدي والطقوسي والسياسي، تحت التأثير المشترك لاستمرار عناصر من الجاهليّة، والجهل بالكتاب والسنّة... وفوق كلّ ذلك التأثيرات الخارجيّة”.
ولكن الإسلام المتقبّل والممارس بهذا الشكل لا يغذّي فحسب طوبى منتكسة متميّزة بنوع من متلازمة التكرار القهري: العودة إلى زمن التأسيس، والشعور بالاطمئنان في المناخ البدائي للمشهد الأصلي. وحسب لويس ماسينيون، فإنّ الإسلام يولّد إدراكاً للزمن بوصفه لا يتدفّق بشكل خطّي بين لحظة وُجدت بالفعل (زمن النبيّ) ولحظة لم تحن بعد (نهاية العالم)، بل هو يتراجع، ويعاود التشكّل، ويتخلّق ويتجدّد في كل لحظة حسب مشيئة الله (عبارة “إن شاء الله” المتجاوزة كونها مجرّد صيغة خطابيّة). فالزّمن لا ينسج نفسه ضمن لحمة متّصلة، ولا ينتج ديمومة متلاحمة. إنّه كوكبة من اللحظات العرضيّة، من النقاط المنفصلة التي تمثّل بالأحرى إشارات على المقادير الإلهيّة التي لا يمكن إلاّ لأهل العلم فكّ طلاسمها. بل إنّ عدداً كبيراً من المسلمين العرب عاش وعاين حرب الخليج في ضوء هذه الرؤية، بعد تتالي الحروب العربيّة الإسرائيليّة منذ عام 1948 إلى عام 1973. ومن شأن هذه الطريقة في التفكير وعيش جريان الزمن أنّها تولّد شعورا بالقنوط تجاه مجرى التاريخ، وتشاؤماً غير فعّال بخصوص قدرة البشر على التأثير في الأحداث.
ولعلّ ما يؤيّد هذه الحقيقة، هو الدراسة المتأنيّة لأوّل توجّه علماني هزّ الإسلام المتوسّطي بين عامي 1920 و 1960، كما تشهد عليه الكماليّة في تركيا والعروبة ذات التوجّه العلماني النشطة من حلب إلى الدار البيضاء. فالعلمانيّة تجد في كلّ مكان معارضة من خلال الحفاظ على وظيفة الدين/الملجأ الذي ضمنه الإسلام منذ بداية الحقبة الاستعماريّة. وبهذا، فإنّ الإسلام لم يستمرّ، حسب ملاحظات أكبر محلّلي أواسط القرن العشرين، متماسكاً فحسب، بل أصبح كذلك المورد الأسمى لإعادة بناء شخصيّة تخلخلت بفعل الصدمة الاستعماريّة المباشرة في شمال أفريقيا، والأقلّ مباشرة شرق طرابلس. وللتعبير عن هذا الشعور بالتمزّق، استخدم المثقّفون العرب العبارة القاسية: “الغزو الفكري”، أي ما يمكن ترجمته بـ“العدوان الثقافي”. وهذا لعمري نقل آخر لمصطلح قديم إلى العربيّة الحديثة يترجم/يكشف كثافة الشعور بفقدان الهويّة. فانطلاقاً من الجذر اللغوي “غ ر ب” (التوجّه غرباً) اشتقّ المصدر “اغتراب”. لقد كان التمزّق الذي أصاب النظرة الموروثة عن الإسلام غير الحديث من الشدّة بحيث تسبّب في ردّة فعل أخذت شكل حرب روحيّة تصيب الحشود التي يخلقها التحضّر بحالة انتشاء، مؤسّساً لسياسة محدّدة، هي السياسة التي بناها الإصلاحيّون المسلمون الذين يتمّ اليوم مناقشة أبوّتهم للإسلام السياسي، وخاصّة في حالة الجزائر.
لذا، فإنّه لمن المفارقة ما نسمعه مؤخّراً حول عودة الإسلام على مسرح التاريخ في منطقة المتوسّط وما صاقبها، والحال أنّه لم يندثر قطّ في أعمال الكتّاب الأكثر اطّلاعاً منذ أكثر من نصف قرن. فقد أظهر كليفورد غيرتز في الستّينات كيف قامت النزعة النصّية، في المغرب كما هو الحال في إندونيسيا، بالتوافق مع هذا التحدّي المتمثّل في مواجهة الإيمان للعقل الأداتي لـ“الغرب” عبر اختراع “تقليد للتبرير”. كما أنّ لويس ماسينيون لم ينخدع في السنوات 1940-1950 بصعود قوميّة تمّ تشبيهها آنذاك بشيء من التسرّع بحركة القوميّات على طراز إيطاليا الفتاة أو رابطة الفضيلة الألمانيّة (Tugendbund)(**) لأنّها اقترضت مفرداتها وتقنيات تعبئة الحشود ووسائل تأطير متحزّبيها من أوروبّا، في وقت أضحت فيه السياسة مشغل الجماهير المنجرّة إلى الأديان العلمانيّة التي نعرفها. إنّ ماسينيون يفكّر من خلال مصطلحات مستوحاة من التحليل الظاهراتي للدين لا يمكن أن يلقى قبولاً عند من يرفض التفكير على غرار بيغاي (Peguy) بإمكانيّة تخفّي الديني في لبوس الزمني. فقد سعى، في ذروة إنهاء الاستعمار، إلى استقصاء “معاناة المسلمين المتعطّشين إلى الوصول إلى المساواة المدنيّة الدوليّة دون أن تكون مرضاً طفوليّاً”. وهو يرى أنّ “استعادة الوعي” التي تهزّهم ثمثّل في آنٍ “أزمة نموّ ترقّيهم” و“مكابدة عدم تكيّف” مع عالم حديث في سبيله إلى التعلمن، ويبرهن على أنّ استعادة الجهاد يحرّر صرخة ثورة المستضعفين الذين “يشعرون بنداء داخلي من الله يجعلهم جموحين”. ويشير إلى أن مقاتلي جبهة التحرير الوطني الجزائريّة “يشهدون”، وهذا قول جلل في ذلك الوقت داخل وسط فكري مطلق العمى بفعل الذهنيّة السائدة وقتها بشأن الجهاد الذي قام عليه كفاح الجزائريّين ضدّ فرنسا من أجل خلق أمّة.
إلاّ أنّ القوميّة لم تنحطّ بالفعل إلى قوميّة شموليّة في العالم الإسلامي المتوسّطي بسبب أنّ الإسلام يشكّل ترياقاً ضدّ إغراء الشموليّة، وهو ما يجعلها دائماً متوقّفة على الدين الشعبي المتولّد عن الإسلام والمتغذّي منه، حتّى وإن كان روّادها، ونحن نعرف كيف كان أغلبهم في المشرق من أصل مسيحي، يهدفون إلى علمنتها في غياب أيّ توافق مع المعطي الديني. ففي المغرب الأقصى خلال الثلاثينات، نظر الناس إلى الوطنيّين الشبّان الذين كان يلهبهم علاّل الفاسي، على أنّهم أتباع طريقة صوفيّة جديدة، لا أتباع حركة سياسيّة، وأطلقوا عليهم اسم “العلاّليين”. ويمكننا توسيع قائمة الالتباسات والمفاهيم الخاطئة التي انتشرت بين الناس البسطاء الذين حوّلوا إلى مصطلحات دينيّة دعوة الناس للتحرّك كمجتمع سياسي ووطني، كما بين قادة الحركات الوطنيّة في السنوات 1930-1960. فقد وقع هؤلاء وأولئك في فخّ الكلمات، وعادوا من حيث لا يدرون إلى أبجديّات معجم البدايات الأوّل. وهكذا فإنّ كلمة (حزب)، وهي تحيل على فكرة الشِقّ المقسّم وحدة الأمّة، ستغدو دالّة على التشكيلة الحزبيّة الحديثة في إطار لعبة سياسيّة تعددّية مقبولة (على مضض) في عهد الاستعمار (الأحزاب الوطنيّة) ومبسّطة إلى أقصى حدّ بعد الاستقلال (الحزب الأمّة المتشكّل في الحزب الدولة)، وبموافقة من الأغلبيّة. ذلك أنّ الكثير من المسلمين إنّما قبلوا على مضض المعنى الجديد للمصطلح، إذ يرون أنّه لا يمكن أن يوجد إلاّ حزب واحد فقط، هو حزب الله، وأنّ وجود أحزاب سياسيّة سيكون سبيله كسر الإجماع الذي تطالب به أمّة المؤمنين.
في ما وراء الاستشراق: اختلافات وشظايا أصوات
يتعلّق الأمر هنا باكتشاف بضع زوايا النظر والتدقيق في بعض مقترحات قراءة الثنائي الإسلام والسياسة المقدّمة من قبل باحثين معاصرين منحدرين من الإسلام المتوسّطي. ولا نهدف بهذا، رصد بعض الاستمراريّة غير المعلنة للاستشراق الميّت عندهم، بل إبراز حيويّة هذه “الإسلاميّات التطبيقيّة” التي يضطلع بها ويمارسها محمّد أركون وآخرون من نظرائه. فهؤلاء لا يتورّعون على الاتّكاء على المعرفة الموروثة عن الدراسات الإسلاميّة السابقة، شرط إخضاعها إلى العقل النقدي للعلوم الاجتماعيّة، لا إلى تيّار النقد التاريخي فحسب. ولكن القيام بذلك، يستوجب الفصل بين المعرفة العلميّة والنزعة الإنسيّة العربيّة الإسلاميّة، وهذا ما لا يتوفّر دائماً على الجانب الآخر من البحر المتوسّط.
فمنذ مدّة قريبة، انتقد المفكّر السياسي المصري عزيز العظمة المثقّفين العرب المسلمين بقسوة، متّهماً الكثير منهم بالخجل من علمانيّتهم التي يعيشونها في الواقع. فهم لا يعيشونها كواقع اجتماعي مكتسب بفضل مكانتهم المعترف بها كمثقّفين، ولا يضطلعون بها مطلقاً بوصفها نظاماً للقيم، بل يمارسونها وكأنّها ضريبة يدفعونها مقابل الامتياز المريب من كونهم مزدوجي الثقافة، وهو ما يعزلهم عن العدد الأكبر من الناس. إنّ بصمة الدين في الثقافة السياسيّة والسلوك الاجتماعي لا تزال ذات معنى إلى حدّ أنّ تبنّي طريقة علمانيّة في التفكير والتصرّف داخل المجتمع، يبقى أمراً يعرّض صاحبه إلى خطر أن ينظر إليه على أنّه غير مؤمن أو على الأقلّ مشكوك في إيمانه ومُشتبه في مغالاته في التأورب (التفرنج الذي كان يصم في النصف الأوّل من القرن العشرين، العرب المسلمين شديدي الاحتكاك بالأوروبّيين). ولكنّ ذلك لا يمنع أنّ تفكيراً متحرّراً من أغلال التعميمات النمطيّة حول الثنائي الإسلام والسياسة هو حاليّاً بصدد التقدّم سواء هنا أو هناك، وأنّه لا شيء يمكنه إيقافه.
ويؤكّد رجل القانون التونسي عياض بن عاشور أنّ المغرب العربي الحالي يعاني بالدرجة الأولى من حقيقة أنّ الدولة متقدّمة على الأمّة. فالدولة الأداتيّة العقلانيّة القانونيّة موجودة، ولكنّها تتحدّث لغة غريبة عن الناس الذين لم يعودوا رعايا، ولكنّهم لم يصبحوا بعدُ مواطنين. لقد تمّت ترقية اللغة العربيّة الحديثة إلى مرتبة اللغة الوطنيّة والرسميّة، ولكنّها ليست (بعد؟) لغة الناس العاديّين للتفكير في الجدل السياسي ولعيش المواطنة. فاللغة الحيّة للمواطنة (العربيّة الدارجة والفرنسيّة والبربريّة) مكبوتة وتعامل على أنّها لغة ميّتة، في حين تحظى اللغة المغمى عليها (العربيّة الكلاسيكيّة) أو المفروضة (العربيّة الفصحى) بمكانة لغة حيّة. ومن ثمّة، فإنّ كلّ شيء يسير بطريقة خاطئة ويعزّز بعضه بعضاً كي يصنع الثلاثي المعاصر: الاستبداد الإلهي، ولغة الدين، والإطلاقيّة السياسيّة. ولعلّه من المفيد وضع هذه الرؤية التي تعزو مشكلة الفصل بين السياسة والمقدّس إلى تقديس اللغة العربيّة بوصفها لغة الطقوس الإسلاميّة، على المحكّ.
ولا يخفى على محمّد أركون أنّ حركات الإسلام السياسي لا تنخرط في قطيعة مع الإسلام المقرّر والمعاش منذ قرون، وهو يتصلّب تحت وقع صدمة الغزو والاحتلال الاستعماري. بل إنّ تلك الحركات، على ما يشير أركون، إنّما قامت بتجذير التوقّعات المهدويّة للحشود المتعطّشة للكاريزما وإضفاء القداسة على التاريخ، وذلك مند ولادة عهد التنظيمات في عام 1839، حيث لم تر في التنظيمات سوى يد الأجنبي، دون أن تتبيّن أبداً أنّها كانت استراتيجيّة دفاعيّة للتحديث الذاتي. وقد لعبت الثقافة الملقنة للأجيال المولودة بعد الاستقلال والتي ترى أنّ الأوروبي لم يعد جاراً مغتصباً بل أجنبيّاً رُدّ قسرا إلى الضفّة الأخرى وأصبح بالتالي الآخر المطلق، دوراً أساسيّاً في ذلك. فقد لاحظ أركون مثلا أنّ الكتب المدرسيّة في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنيّة والدينيّة تجعل الشباب الجزائري يعيش في “عالم خطابي مجرّد” دون اتصال جسدي مع الأرض والأمكنة، ودون ارتباط، فيما يتجاوز الفجوة الاستعماريّة، مع المؤثّرات والمرجعيّات المحليّة التي يعود تاريخها، في بعض الحالات، إلى ما قبل الفتح العربي الاسلامي.
وتؤكّد القراءة الدقيقة التي قام بها عالم الاجتماع محمد العيّادي لكتب التربية الدينيّة المدرسيّة في المغرب الأقصى، والتي استكملتها دراسة حول 865 من تلاميذ المدارس الثانويّة وطلبة الجامعة في الرباط في أفريل 1995 بهدف تقييم أثرها الرجعي، وجود ثقافة فرعيّة قائمة على انغلاق الذات والخوف من الآخر، يتمّ تمريرها من خلال تلك الكتب المزدرية “لما هو غربي” والممجّدة للذات. فهذه الكتب الرسميّة تبني عند طلاّب الجامعات رؤية ثنائيّة لعالم يتجابه فيه الخير والشر: الإسلام ضدّ الغرب اليهودي المسيحي أو الشيوعي، وهذا في حدّ ذاته جريمة، حيث نجد “العلمانية متعارضة مع الإسلام”، ممّا يغذّي عند الشباب الاعتقاد في مؤامرة متعدّدة الرؤوس تستهدف الإسلام من جميع الجهات. فيتمّ المزج بين “الحملات الصليبيّة” و“الغزو الثقافي” و“الاستشراق” و“التنصير” و“العلمانيّة” و“الماركسية” في خلطة عجيبة بوصفها وجوهاً متعدّدة لنفس المؤامرة التي تستهدف الإسلام المحاصر من قبل الغرب الذي تمثّل الصهيونيّة تعبيرته الأكثر اكتمالاً، فيما يمثّل اليهود، بصفتهم يهوداً، قادة المؤامرة التي تغدو “مؤامرة يهوديّة ضدّ الإنسانيّة وضدّ الأديان”.
وللهروب من عالم خارجي شديد التهديد، فإنّ النموذج السياسي المناسب هو الديمقراطيّة الإسلاميّة كما تمّ بناؤها من قبل إصلاحيّي السلفيّة وأوائل مفكّري الإسلام السياسي؛ فيغدو الإسلام “ديناً ودولة”، شرط أن يكون وحده أساس المبادئ الدستوريّة لبناء الدولة، وأن يكون وحده المحدّد لقوانين اللعبة المسيّرة للحياة السياسيّة. وهنا يتمّ استدعاء الكلمات المفاتيح في ترسانة الفكر السياسي الإسلامي: مفهوم القوّة الشرعيّة (الحكم) الذي يرسم الخطّ الفاصل بين دار الإسلام والعالم، ومبدأ الشورى بوصفه آليّة تأمين ضدّ الاستبداد، وواجب الطاعة تجاه السلطة حين تكون عادلة وفاضلة، الخ... وهنا، يُبرز الجدل الذي يغذّي التربية على الخوف من الآخر والانغلاق على الذات “خصوصيّة” و“تفوّق” السلطة السياسية في الإسلام، مقارنة بالعالمين الرأسمالي والشيوعي.
وبالتأكيد، فإنّ ما تقرّره تلك الكتب ليس هو المعاش، وأنّ الطلاب الشباب المغاربة يستخدمون عدّة مدوّنات مرجعيّة وأرصدة لتعريف أنفسهم بالنسبة للعالم وللتفكير في السياسة أو الدخول في السياسة. إلاّ أنّ ذلك لا يمنع أن تعتقد الغالبيّة العظمى من المغاربة الشباب الذين شملتهم الدراسة، أنّ الإسلام دين ودولة، لا كمرجعيّة فحسب، بل كمبدأ فعل يجب أن يوجّه عمليّة تنظيم شؤون المدينة. ولا تتجاوز نسبة من يرفض منهم أيّ تدخّل للدين في السياسة 8.6٪، وهذه نسبة أقلّ بكثير من تلك المسجّلة في أوائل الثمانينات من قبل الباحث السياسي محمد الطوزي الذي كشف أنّ 57٪ من الطلاب المستجوبين في الدار البيضاء كانوا معارضين لأيّ تداخل وثيق بين الديني والسياسي (17). ومن خلال مقارنة هذا الاستبيان بسابقيه، يبدو أنّه يمكننا تكميم عمليّة المدّ والجزر التي تنتاب المعتقدات الدينيّة والسياسيّة، حتّى وإن كان ذلك مخصوصاً ببيئة محدّدة (شباب المدارس خلال فترة قصيرة). والأكيد أنّ تضاعف الدراسات حول هذا الموضوع من شأنها الإحاطة، بأقلّ دغمائيّة وأقلّ انطباعيّة، بالكيفيّة التي يتمفصل بها الثنائي السياسة والإسلام في منطقة المتوسّط، وقياس مدى وسرعة انتشار ظاهرة العلمنة.
وعلى النقيض من هذه الدراسات الإسلاميّة المتجذّرة في ظرف فريد والمركّزة على حالة مخصوصة، تأتي المحاولة الذكيّة لعبد الله حمّودي لتعرية النظم السياسيّة الاستبداديّة التي تحكم منذ نصف قرن إقفال العالم العربي من المحيط إلى الخليج. فهذا الباحث يبيّن، متأثّرا في ذلك بالإناسة التأويليّة لكليفورد غيرتز، كيف تمّ التقاط العلاقة الممزّقة بين الخضوع والتمرّد التي تحكم العلاقة بين الشيخ ومريديه في الزاوية الصوفيّة في القرن التاسع عشر، من قبل السلطة المركزيّة في المغرب الأقصى من أجل بناء علاقة سيّد برعايا. وقد جلبت السلطة الاستعماريّة تكنولوجيا السلطة الملائمة لكسر التمرّد وتعزيز الخضوع، فيما عزّزت دولة ما بعد الاستعمار هذه العلاقة التي تستقوي فيها الخشية التبجيليّة الواجبة تجاه المليك الشريف بروح الطاعة الذليلة تقريباً الواجبة تجاه الشيخ الطرقي: إنّنا هنا إزاء حالة مثيرة من “اختراع التقاليد” ينفذ فيها المقدّس إلى قلب مجال السياسي. ففي عهد الحسن الثاني، نشأ تطابق مثالي بين ثلاثة وجوه للسلطة: تلك الواجبة من القبيلة تجاه زعيمها الأبوي، والواجبة من الطريقة تجاه شيخها الروحي، وتلك الواجبة من رعايا المخزن تجاه عاهل إقليمي لن يكون من الآن فصاعدا باسطاً سيادته على كلّ الأنحاء بينما هو لا يحكم إلاّ مناطق معيّنة وبشكل متقطّع.
إنّ أحدث ما في هذه القراءة للاستبداد السياسي في الإسلام المتوسّطي هو الكشف عن النمط الثقافي الذي تقوم عليه علاقة الشيخ بالمريد. ففي تدرّجه نحو الولاية، يخضع المريد إلى عمليّة قلب: إنه يستسلم تماماً لشيخه جسداً وروحاً. وهو يقبل، وهذا أقصى درجات الإذلال، أن يتحوّل إلى أنثى، ويستبطن قيم الطاعة والخدمة الواجبة على النساء للرّجال، و يستدمج صورة الأنوثة أو على الأقلّ صورة الخنثى في عالم يستبعد النساء. هذه الخطاطة التوضيحيّة مفيدة في فهم الخطاب الملكي، وطقوس البلاط والسلوك القاعدي للرعايا، المواطنين المزيّفين، لنظام تشكّلت فيه الأصوليّة الدينيّة السياسيّة تدريجيّاً على امتداد الفترة المعاصرة. ذلك أنّ حمّودي يتجنّب فخّ الثقافويّة ويطبّق نظريّته خارج المغرب الأقصى على أنظمة غير ملكيّة، حين يقوم رجل قويّ بترويض الجماهير الهائجة، على غرار مصر والجزائر.
ولكي نختم، كيف لا نلاحظ وجود تقارب قويّ بين مفكّري الإسلام الذين يساهمون في نشر وعي إسلامي جديد بالعمل ضمن مجال الفكر المدني والإعلامي، وبين الباحثين حول الإسلام الذين يحاولون، من داخل المجال الأكاديمي، تجديد التيّار التاريخي النقدي بالاستناد إلى العلوم الاجتماعيّة. فكلاهما يقرأ للآخر ويضاعف الاقتراض المتبادل، وهم في جميع الحالات يتقدّمون داخل حقل فكري أكثر مرونة وانفتاحاً. إنّهما يستأنفان، من خلال الجدل وعدّة مفاهيميّة جديدة بالكامل، الحوار الذي قام بين المستشرقين وقادة الإصلاح الإسلامي الأكثر انفتاحاً في أواخر القرن التاسع عشر، وهو الحوار الذي انقطع مع الانتقال من الاستعمار إلى الامبرياليّة وانبثاق القوميّات المنغلقة بعضها عن بعض. لدينا إذن، من جهة أولى، أنصار النهضة العلميّة الجديدة على جانبي البحر المتوسّط، ومن ناحية أخرى، دراسات إسلاميّة بالمعنى الأكاديمي للكلمة، بصدد مزيد الانفتاح على العلوم الاجتماعيّة. ولعلّ الرهانات المعرفيّة في هذا الخصوص، هي من الأهميّة بحيث تمنع حدوث أيّ تآلف مصطنع. ولكنّ الشيء المهمّ هو أن يعيد مفكرّو الإسلام الجدد قراءة الإسلام بوصفه مجال إيمان وواقع حضارة متجاوزين نظرة المختصّين في الدراسات الإسلاميّة، وأن يقوم جيل جديد من الباحثين في الإسلاميّات بإعادة التفكير في موضوع بحثهم انطلاقاً من هذه المعرفة الجديدة، وهي ليست بالضرورة ذات طابع أكاديمي، وأن يقبلوا بإعادة النظر في مسلّماتهم على ضوء هذه المعرفة غير المقيّدة، وعلى ضوء هذا العلم الذي جاءهم بصفة أساسيّة من غيرهم.