إدوارد سعيد سياسياً في كتاب الاستشراق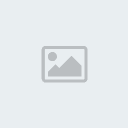
نشر بتاريخ :24 07 2012 | الساعة 12:44بقلم : . . صادق جلال العظم
إدوارد سعيد سياسيّا في كتاب الاستشراق صادق جلال العظم أودُّ، في هذا العرض، أن أطرح ثلاث نقاطٍ تنبعث من كتاب إدوارد سعيد
الاستشراق و/أو تتعلّق به. ترمي النقطة الأولى إلى إبراز جانبٍ سياسيٍّ
معيّن من جوانب كتاب سعيد الشهير. فقد كان سعيد، بوصفه أميركياً مخلصاً
وفلسطينياً ملتزماً على حدٍّ سواء، عميق العناية وشديد القلق حيال ما
أدعوه بمفارقة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط العربي بوجهٍ عامّ،
وإزاء فلسطين والفلسطينيين بوجه خاص. ذلك أنّه في حين تقع جميع مصالح
أميركا الحيوية واستثماراتها النفطية في العالم العربي، إلا أنّ
استراتيجياتها وسياساتها لطالما انحازت إلى إسرائيل ودعمت أهدافها
التوسعية ذلك الدعم غير المشروط، وكلُّ ذلك على حساب العرب وبأذيّةٍ
بالغةٍ أُلحِقَت بالفلسطينيين.
منذ ولادة دولة إسرائيل شكّلت هذه المفارقة مصدر إحراج بالغ (بل مصدر
تهديد) بالنسبة للأنظمة العربية التي تحالفت مع الولايات المتحدة خلال
الحرب الباردة. وقد احتاجت هذه الأنظمة جميعاً، ودوماً، إلى "تفسيرٍ" ما
لما تبدو عليه أمريكا من عدم القدرة على إنتاج سياسات تتناسب مع مصالحها
الحيوية في المنطقة من جهةٍ أولى، ومن عجز عن تلبية الحدّ الأدنى من
توقّعات أصدقائها المقرّبين وحلفائها الإستراتيجيين العرب، من جهةٍ ثانية.
والنظرية السائدة –التي لطالما حبّذتها المملكة العربية السعودية ورعتها-
تنحو باللائمة في ذلك على المنظمات، والقوى، وجماعات الضغط، والمصالح
الخاصة، واللوبيات، ورؤوس الأموال، ووسائل الإعلام، والمؤامرات
اليهودية-الصهيونية في تشويه تقدير أمريكا لمصالحها الحيوية في الشرق
الأوسط، وفي إساءة تحديد الجهة التي ينبغي أن تقف بجانبها في المنطقة.
وهذه أمثله على الكيفية التي فعل بها هذا التكتيك فعله في الممارسة، وهي
أمثله مستمدَّة من بعض الإعلانات والتأكيدات السياسية العربية السابقة:
(أ)- "وهكذا نجحت القوى الصهيونية والأمريكية المؤيّدة لإسرائيل في
جعل الرئيس الأميركيّ يتراجع عن التزامه بعبارة الحقوق المشروعة لشعب
فلسطين".
(ب)- "استسلم الرئيس الأميركي للضغوط الصهيونية وتخلّى عن مساندة الحقوق العربية".
(ج)- "إنّ أصدقاء إسرائيل في الكونغرس والخارج مارسوا الضغط على
الرئيس الأميركي وأقنعوه بعدم الإفصاح عن آرائه الحقيقية علناً نظراً إلى
أثارها الضارّة بالنسبة لإسرائيل".
ولقد عَمِلَ هذا التفسير بصورة ملائمة على إعفاء الرئيس الأميركي من
مسؤوليته عن سياساتٍ لا تحظى بأية شعبية في العالم العربي، كما عمل على
التخفيف من إحراجات أنظمة المنطقة التي تربطها بذلك الرئيس أوثق
التحالفات. والحال، أنّ الحكّام العرب راحوا يزعمون، في دعايتهم وقتها،
أنهم قد حققوا تقدّماً على صعيد تبديد المفارقة التي تعاني منها السياسة
الأميركية في الشرق الأوسط بمساعدتهم الأميركيين على أن يروا، بصورة صائبة
وواضحة، أين تكمن مصالحهم الحيوية طويلة الأمد في المنطقة العربية.
وما أريد قوله هنا، هو أنّ كتاب إدوارد سعيد، الاستشراق، قد قَصَدَ
أيضاً إلى تقديم تفسيرٍ أشدّ إتقاناً ورهافةً لمفارقة السياسات الأمريكية
في العالم العربي باللجوء إلى نظرية الخطاب الفرنسية في طبعتها الفوكوية
(نسبةً إلى ميشيل فوكو). فما يشوّه الرؤية الأميركية في المنطقة ويحدّد ما
تنتهجه هنالك من سياسات ضارّة هو سجن الخطاب الاستشراقي الضخم الّذي بُني
خلال قرون واستوعبه الآن جميع صنّاع القرار، وراسمي السياسات، والمدراء،
والحكام، والدبلوماسيين، والخبراء، والمختصّين، والأكاديميين، والموظّفين،
والقادة العسكريين، والمساعدين الغربيين (خاصة الأميركيين)، في تعاملهم مع
هذا الجزء من العالم. فحوالي نهاية كتابه يشرح سعيد موقفه على النحو
التالي:
إنّ لمنظومة التخيّلات الأيديولوجية التي أدعوها بالاستشراق نتائجها
الخطيرة ليس لأنّها مشينة فكرياً وحسب، فالولايات المتحدة تستثمر اليوم
بكثافة في الشرق الأوسط وعلى نحوٍ يفوق الكثافة التي نجدها في أيّ مكان
آخر على وجه الأرض: وخبراء الشرق الأوسط الذين يُسدون النصح لصناع السياسة
قد تشبّعوا بالاستشراق جميعهم دون استثناء. ومعظم هذا الاستثمار مبنيّ على
الرمال، إذا ما استخدمنا هذه الاستعارة الملائمة بما يكفي، ذلك أنّ
الخبراء يقيمون السياسة على أساس تجريدات يسهل تسويقها مثل النخب
السياسية، والتحديث، والاستقرار، ولا يعدو معظمها أن يكون صوراً نمطيةً
استشراقية قديمة أٌسبغت عليها رطانة سياسية، ولا يصلح معظمها البتّة لوصف
ما حدث مؤخّراً في لبنان أو قبل ذلك في المقاومة الفلسطينية لإسرائيل.
ولاشكَّ في أنّ الكتاب قد رمى إلى تبديد هذا التّشوه – بفضح الجهاز
الاستشراقيّ الهائل الذي يشكّل أساساً له– على أمل التوصّل إلى سياسات
أميركية أحسن وأكثر واقعية حيال العرب عموماً والفلسطينيين بشكل خاص،
وإبراز هذا الجانب من كتاب سعيد، الاستشراق، إنّما يكشف كم كان هذا الكتاب
سياسياً في العمق وكم كان فلسطينياً في حقيقته.
وفي النقطة الثانية، أودّ أن أنطلق من مثال على "الاستشراق" بالمعنى
الأسوأ الذي يسبغه سعيد على هذا المصطلح، وهو مثالٌ مستمدٌ من كتاب
جوناثان رابان، بلاد العرب في المرآة:
أن تحيى في اللغة العربية يعني أن تحيى في متاهةٍ من الالتواءات
الزائفة والمعاني المزدوجة. فما من جملة تعني بالضبط ما تقوله. وكلّ كلمة
يمكن أن تكون طِلَْسماً يستحضرُ شبحَ عائلةِ الكلمات المتحدّرة منها
بأكملها. أمّا النحو العربي فهو خرافيُّ في تعقيداته المراوغة. العربية
لغةٌ أقيمت تماماً لكي تعبّر بفصاحةٍ هائلةٍ عن لا شيء، لغةُ تكـلُّّف محض
لا يكاد أن يكون فيها أية معانٍٍ حرفية على الإطلاق ويشكّل الإيماء الرمزي
فيها كلَّ شيء. والعربية تجعل الإنكليزية تبدو ساذجةٍ، والفرنسية مجرّد
رطانة يرطن بها خبراء المحاسبة وأسعار السوق. ويكفي أن تحدّق عبر شقٍّ في
حائط هذه اللغة لكي ترى عمق وقتامة غابة الالتباس تلك. فلا عجب إذاً أنّ
القرآن قد ذاع صيته على أنه لا يترجم.
من الواضح هنا أنَّ العربية يُحْكَم عليها (ويُرَى أنّها شديدة
العَوَز)، تبعاً للمبادئ التي يشتمل عليها التصوّر الديكارتي للغة، وهو
تصوّر يقوم ضمناً على مذهب "الأفكار الواضحة والمميزة"، وعلى صدارة
الاستدلال شبه المنطقيّ من نمط: "أنا أفكّر فإذاً أنا موجود"، وعلى
الطبيعة المنطقية التي يجب أن يتّسم بها كلّ قولٍ أو فهمٍ أصيل، وعلى
الإمكانية الكاملة لتحديد المعنى القابل للإيصال وتمييزه.
فإذا ما تحوّلنا الآن إلى مقاربةٍ للّغةِ تفكيكيّةٍ ما بعد حداثيةٍ
تقوم على مبادئ مثل انفصام كلّ من العلامة والدالّ والمدلول عن بعضها،
وعلى المخادعات التي تنطوي عليها تقلّبات المعنى إلى ما لا نهاية، وعلى ما
يتّسم به المعنى من ارتياب دائم، وعلى أنماط الالتباس السبعة عند ناقد
ومنظّر أدبيّ كبير مثل وليم إمبسون، وعلى ما يتّصف به انعكاس الفكر على
ذاته من ضروب العبث وما إلى ذلك من مبادئ تفكيكية مشابهة، ألا تبدو
العربية التي يصفها رابان أشبه باللغة المثلى بالنسبة لمن أثقله القلق من
"دازاينات" الشرط الإنساني ما بعد الحداثيّ كما بالنسبة لمقدرة هؤلاء على
التعبير عن حالهم؟
بروحيةٍ مماثلةٍ، يتبنّى داريوش شايغان نظرةً مشابهةً (ويوردها
باستحسانٍ) عبّر عنها مستعرب فرنسي مشهور هو جاك بيرك. يقول شايغان:
"يلاحظ جاك بيرك بحقّ، في إشارة إلى روح اللغة العربية، أنَّ اللسان
العربيّ، الذي تفضي فيه كلّ كلمة من كلماته إلى الله، قد صُمِّمَ لحجب
الواقع، وليس لفهمه". ويعيد ماليز روثڤن، في كتابه الممتاز الإسلام في
العالم، إنتاج هذا النوع من الأحكام باقتباسه وصفَ جوناثان رابان اللغة
العربية الواردة أعلاه ومن ثمّ تأكيده: (أ) أنّ العربية تمتنع على الترجمة
إلى اللغات الأوروبية أكثر من معظم اللغات الأخرى و(ب) أنّها "لغة تلائم
التعبير الدينيّ كلّ الملاءمة". ثمّ يكمل روثڤن ليفسّر هذا الوضع الغريب
فيقول:
اللغة العربية هي لغةٌ أقيمت حول الأفعال. فالأسماء والنعوت هي على
الدوام مشتقّات من الأفعال، وعادة ما تكون صيغ فاعل أو مفعول أو أسماء
فعل. فالشخص الذي يكتب هو كاتب، والكتاب هو مكتوب. أمّا الطائرات والطيور
فهي أشياء تطير. وبالمقابل، فإنَّ اللغات الأوروبية، على تعدّد أصولها،
تضرب بجذورها في الجواهر: معظم الأسماء في الإنكليزية هي أشياء في ذاتها
وليست أجزاء من أفعال التي هي صيرورات. وما يجعل اللغة العربية لغة تلائم
التعبير الدينيّ كلّ الملاءمة هو على وجه الدقّة أنّها تحجم عن تصنيف
الكلمات في أجزاء متمايزة، وتبقي عليها بدلاً من ذلك في علاقة منطقية
ومتوازنة مع مفهوم مركزي، هو جذر الفعل.
مرة أخرى، ألا تبدو العربية أشبه باللغة المثلى في ضوء هذا التحوّلٍ
في الإطار المفاهيمي الديكارتي (تحول في البارادايم) صوب: (أ) نقد
الفيلسوف ألفرد نورث وايتهيد كلَّ الفلسفات الأرسطية القائمة على فكرة
الجوهر والماهية والتموضع البسيط، ودفاعه عن الواقع باعتباره صيرورة
دائمة، أو (ب) نقد هنري برغسون الشديد للشيئية Chosismeورفضه فكرة الأشياء
كما هي في ذاتها لمصلحة واقع هو سيلان كوني متحرك على الدوام كما لمصلحة
شكل من أشكال التطور الخالق المتواصل أو (جـ) رفض لوكاش للتشييء بمختلف
ضروبه دفاعاً عن واقع هو لا أكثر من أحداث وظروف وصيرورات.
إذا كان صحيحاً أنه "في البدء كان الكلمة"، فهل كانت "الكلمة" فعلاً
أم اسماً؟ كانت فعلاً بالنسبة إلى اللغة العربية واسماً بالنسبة إلى
اللغات الأوروبية، وفقاً لما يقوله روثفن. وسؤالي إذاً، أيّهما أقرب إلى
روح الحداثة: الانطلاق من الاسم الساكن أم من الفعل المتحرّك؟ على أقلّ
تقدير، فإنَّ جواب فاوست واضح من ترجمته الجديدة للآية الأولى من إنجيل
يوحنّا على النحو المعروف: "في البدء كان الفعل".
بالإضافة إلى ذلك يمكنني أن أذكر الاعتبارات التالية دفاعاً عن اللغة
العربية: أوّلاً، وجهة نظر روسو في مقالته حول أصل اللغة والتي تفيد أنّ
اللغة المجازية هي التي ولدت أولاً، أمّا المعنى الصحيح فلم يكتشف إلاّ
آخرًا، وهذا ما يتوافق مع الأطروحة التي ترى أنَّ لغة "مجازية" مثل
العربية لا بدّ أن تأتي أوّلاً، أمّا اللغات المكرّسة للمعنى الحرفيّ
الصحيح (مثل الإنجليزية والفرنسية) فلا بدّ أن تأتي آخراً. ثانياً، فإنَّ
العربية كما صُوِّرَتْ أعلاه لا بدّ أن تلائم تماماً فكرة "إرجاء المعنى"
عند فيلسوف مثل جاك ديريدا، كما مع قولته الشهيرة: "ما من شيء خارج
النصّ"، كما مع الفكرة التفكيكية القائلة بـ "نهاية المعنى" كلياً.
ثالثاً، حقيقة أنَّ العربية بـما فيها من "غابات التباس"مفترضة (على حدّ
وصف رابان) تبدو أشدّ تلاؤماً من الإنجليزية، مثلاً، مع الترسيمة النقدية
الشاملة لدى أستاذ ومنظّر أدبيّ عظيم مثل وليم إمبسون، خاصةً حين يثني على
"الالتباس" بالعبارات التالية:
يمكن لـ "الالتباس" ذاته أن يعني نوعاً من عدم الحسم بشأن ما نعنيه،
ونيَّةً في أن نعني أشياء عديدة، واحتمالَ أن يكون شيئاً أو آخر أو كلا
الشيئين قد عُنيا، وحقيقةَ أنَّ لقولٍ ما معاني عديدة… هكذا، قد تكون
لكلمة ما معانٍ متعدّدة مميّزة أو معان عدّة مرتبطة ببعضها، أو عدّة معان
يحتاج واحدها الآخر كي تكمل معناها؛ أو معانٍ متعدّدة تتّحد معاً كي تعني
الكلمة علاقة واحدة أو صيرورة واحدة.
هنا، بمقدورنا أن نرفع الرهانات إلى درجة أعلى بهذا الصدد: (أ) بأن
نتخيّل التحرّر الذي يمكن للغة العربية أن توفّره مما دعاه ستيورات تشيس
ذات مرّة بـ "طغيان (أو استبداد) الكلمات"، و(ب) أن نتخيّل تلك التفريعات
المعقّدة التي يمكن للعربية أن تضعها في متناول محاولة إمبسون أن يوضّح
معنى النقاشات المرفوعة إلى الدرجة الثانية أو الثالثة حول فكرة "التباس
الالتباس" أو تضعها في متناول محاولة ناقد مثل أي. أ. ريتشاردز لأن يقبض
على "معنى المعنى". لذلك أقول إنّه على جميع عشّاق فيلم أكيرا كوروساوا
الكلاسيكي راشومون (1950) أن لا يُعْجَبوا بالعربية لخصائصها الراشومونية
المتأصّلة وحسب، بل أيضاً أن يُعْلوا من شأنها بوصفها الأداة الطبيعية
"للواقعية السحرية" ولتعليق معايير الواقعيّة التقليدية جميعاً.
أمّا في النقطة الثالثة فأودّ أن أضع أمامكم الرواية التالية لتجربةٍ
مررت بها وذلك بسبب عجزي إلى هذا اليوم عن تصنيف تلك التجربة ضمن سياق
الاستشراق أو الاستغراب نظراً لما فيها من التباس عميق ولافت يبدو أنه
يتحدّى مقولاتٍ مثل الشرق والغرب ويتجاوزها.
منذ فترة ليست بالبعيدة، شاركتُ في مؤتمر مهيب في "مركز الهند الدولي"
في نيودلهي عُنِيَ بعلاقات الهند مع الشرق الأوسط وعُقِد بتوجيه من
الدكتور سينغ، السياسي والبرلماني والباحث الهندي الرفيع وبرئاسته. وبذل
الزملاء الهنود في هذا المؤتمر ما بوسعهم لدفعِ أجندةٍ معينة حيث أرادوا
أن يُسقطوا بالكامل مفهوم "الشرق الأوسط" من الاستعمال مع كلّ ما يلحق به
من حمولة ومضامين واستعمالات نظراً لأصوله الاستعمارية ونبرته الاستشراقية
ومرجعيته في المركزية الأوروبية الصارخة.
غير أنّ ما أفزعني وصدمني هو اقتراحهم مفهوم "غرب أسيا" كبديل، أي
كتسمية "صحيحة" وملائمة للجزء الذي أنتمي إليه من العالم، (الشرق الأوسط
العربي)، على أساس أنَّ هذا المفهوم يتفوّق على مفهوم "الشرق الأوسط"
التقليدي بأصالته، ودقّته، وكفاءته.
ولقد زعموا، على وجه الخصوص، أنَّ مفهوم "غرب أسيا" يعيد ما شاعت
تسميته بـ "الشرق الأوسط" إلى "مرساته الأسيوية" (كما دعوها)، وأنَّه
"يتجاوز التصنيف المركزي الأوروبي للبلدان والثقافات والشعوب إلى شرق
أدنى، وشرق أوسط، وشرق أقصى بحسب بعدها عن أوروبا أو قربها منها". فرددتُ
في الحال مجادلاً: إِنْ كان عليّ أن أختار، على سبيل توصيف الذات و/أو
تحديدها، بين رؤيتكم الطبيعية لنا بوصفنا "غرب أسيا" ورؤية أوروبا
الطبيعية لنا بوصفنا "الشرق الأوسط"، فلن أتردّد لحظةً في اختيار التسمية
الثانية، أي الشرق الأوسط، انطلاقاً من أسباب وجيهة تدفع إلى ذلك. وأوضحت
للمؤتمر:
أوّلاً، من بين هاتين الطريقتين المنحازتين والمشوّهتين أصلاً في
النظر إلينا وتسميتنا، فإنَّ تسمية "الشرق الأوسط" لها ميزة الانتشار
الواسع، ومزيّة الاستخدام الثابت المديد، وهيبة انبعاثها من المركز الفعلي
للعالم الحديث (أي أوروبا) وإشارتها إليه.
ثانياً، أنّ تسمية "غرب آسيا" تنتهك على نحوٍ منفّر الطريقة الأساسية
التي ننظر بها إلى أنفسنا بوصفنا عرباً "شرق أوسطيين"؛ لأنها تقطعنا عن
مصر الواقعة في أفريقيا!؟ وبالمقابل، فإنّ ما من نظرةٍ استشراقية، أو
تعريف مركزي أوروبي، أو تصوّر استعماري لـ "الشرق الأوسط " سبق له أن فصل
مصر عن بقية المشرق العربي؛ أي عن الجناح الشرقي للعالم العربي، كما نشير
إلى أنفسنا أيضاً. ولقد ألححتُ كذلك على أنَّ تسمية "غرب آسيا" هذه تطيح
بصورةٍ أخرى لدينا عن أنفسنا كجزءٍ لا يتجزّأ من عالم عربي يضمّ شمال
أفريقيا في حين تبدو التسمية الجديدة وكأنها تحيل شمال أفريقيا برمّته إلى
مجال ثانٍ أو عالم آخر.
ثالثاً، إنّ تسمية "غرب آسيا"، بخلاف تسمية "الشرق الأوسط"، تسلبنا ما
لوجودنا وتاريخنا وتصوّرنا لذاتنا من بعدٍ متوسّطي، لطالما كان مرتبطاً
ومتشابكاً مع الضفّة الأخرى من بحيرتنا، أي مع الشاطئ الأوروبي للبحر
الأبيض المتوسط. وهنا، كان عليّ أن أتقدّم بحججي جميعاً، فقلت: فكّروا
بالاسكندر المقدوني، وروما، وهانيبعل، وذهاب المسيحية إلى أوروبا من
عندنا، وبتوسّع الإسلام إلى إسبانيا وأبعد منها، وبالصليبيين حين جاؤونا
وبالعثمانيين في أوروبا، وبالاستعمار الأوروبي الحديث لبلادنا وهلم جرا.
فكّروا بحقيقة أنَّ هذين الجانبين من المتوسّط يتقاسمان التراث اليهودي-
المسيحي- الإسلامي، والإرث اليوناني- الروماني، وهبوط الإسلام على بيزنطة
وعلى الشرق الأوسط المسيحي اليوناني ثقافياً، وبالهلّينستينية التي شكّلت
أساس العقل السكولائي القروسطي لليهودية، والعقل السكولائي القروسطي
للمسيحية الشرقية، كما للمسيحية الغربية، والعقل السكولائي القروسطي
للإسلام وتقاسمها كلها أفلاطون، وأرسطو، وأفلوطين، وآدم، وحواء، وإبراهيم،
وموسى.
وختمتُ بالتأكيد على أنّ هذا النوع من الديالكتيك التاريخي العابر
للثقافات واللغات والقارات لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يستوعب في
مفهومٍ هزيل مثل "غرب آسيا"، ولذلك فإنني أتشبّث بمفهوم "الشرق الأوسط"
على الرغم من عيوبه الواضحة ونقائصه المعروفة.
وعليّ أن اعترف أيضاً أن تدخّلي هذا قد أزعج مضيفيَّ الهنود وزملائي
هناك- خاصة في اليوم الأوّل من الاجتماع - لما أثاره في الحال من اضطراب
في أجندة المؤتمر. غير أنّ الجوّ تحسّن لاحقاً، لكنّني لم أستطع أن أتجنّب
ما تنامى لديّ من ارتياب شديد بأنّهم كانوا يتوقون كلّ هذا التوق إلى
تسميتنا بـ "غرب آسيا" لأنّهم يستوردون معظم بترولهم ممّا يُعَدّ بالنسبة
إليهم غرب آسيا بالفعل.


