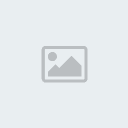
الخطاب الديني المعاصر، خاصة
في شكله الإعلاميّ في الفضائيات، خطاب مسكون بمخاوف عديدة: هناك الفزع من
تفكيك الثوابت. وهناك الفزع على قداسة النصوص الدينية من محاولات البعض
تأويلها تأويلا عقلانيا. وهناك الخوف من أن يصير العالم الإسلامي، مثل
أوروبا، في حرياتها التي بلا ضوابط ولا روادع، وفي سلوك نسائها المتبرجات
المنحلات. وهناك فوق ذلك كله خشية على المرأة المسلمة أن تنجرف في هذا
السيل، فتسترجل، وتفقد أنوثتها وجمالها الذي جعله الله راحة للرجل ومرفأ.
وهذا الإشفاق على المرأة هو إشفاق على النشء، الذي وُكِّل أمرُ تربيته
للمرأة. إنّها "الأسرة" التي يحميها الخطاب الديني بدعوته لحماية المرأة من
مغريات الانحلال والانحطاط في الغرب.
وتكمن المفارقة أن كل هذه المخاوف ترتبط بمخاوف من نوع آخر: الخوف من
الإرهاب الذي يشارك الخطاب الديني نفس المنطلقات الفكرية، ولكنه يسعى
للتخلص من مسببات المخاوف السابقة كلها بالبتر والقتل. الخوف من الإرهاب
يضع الخطاب الديني في محنة حقيقية: فالإرهاب يقوم بعمل تطهيري نبيل المقصد،
لكنه لا يميّز في عماه – هكذا يقول بعض الدعاة – بين الحقّ والباطل. من
هنا الدعوة إلى عودة الأبناء الذين ضلّوا طريق الحقّ والصواب، ومن هنا
الترحيب بالمراجعات والتوبة وعودة "الإبن الضالّ" – الإرهاب – إلى حضن
أبيه.
الخوف الآخر الملتبس هو خوف "العولمة": لا بأس من الاندماج في اقتصاديات
السوق: إنها تجلب الرخاء؛ فالنبي عليه السلام كان تاجرا، وقد أحلّ الله
البيع وحرّم الربا. لهذا تنشأ بنوك لا تتعامل بالرّبا – البنوك الإسلامية –
يباركها الخطاب الديني ويشجّع المسلم على التعامل معها تجنّبا لحرام بنوك
"العولمة". لكنّ المشكلة أن هذه البنوك الإسلامية تتعامل في سوق المال –
سوق العولمة – الذي لا يخضع لمعايير الحرام والحلال، فما هو الحلّ؟ في
الحلّ تكمن الأزمة: تغيير الأسماء يحلِّلُ المحرّم، أي أنّ الحرمة لا تكمن
في المسمى، بل في الإسم. وهذه حيلة لها جذور تاريخية في "الحيل الفقهية"،
وهو موضوع يحتاج لبحث مستقل.
الخطاب الديني الرائج والسائد، خاصة في الفضائيات، يستخدم أرقى المنتوجات
التقنية للحداثة في ترويج مقولاته، ولكنه مسكون بالفزع من الأفكار
والفلسفات الحديثة، التي لولاها لما تم إنتاج هذه التقنيات. المشكلة تكمن
في الواقع الاجتماعي – الذي يتحرك فيه هذا الخطاب ويأمل التأثير فيه – الذي
استوعب كثيرا من منجزات الثقافة الغربية، خاصة في جانبها التقني العملي،
دون "الفكر" الذي أنجز التقدم العلمي، المسئول عن التقدم التقني الذي قلب
حياة الإنسان – وما يزال – رأسا على عقب.
في طفولتي كان التليفون أعجوبة الأعاجيب. التليفون الوحيد في القرية كان
موجودا في مكتب عمدة القرية. ثم شاهدت قريتي الراديو، فكان أعجب، ثم
التليفزيون في الستينات، فكان أعجب وأعجب. ثم الفاكس، الذي كان ثورة مدهشة،
ثم البريد الإلكتروني، والإنترنت والفضائيات. ما أعجب الإنسان، وما أروعه،
وما أخطره: حربان عالميتان، وهولوكوست، وحروب أهلية في كل مكان، لأسباب
عرقية ودينية، ثم أخيرا "الإرهاب" بقوّته الشيطانية المدمّرة ووجهه الخفيّ.
لبسنا قشرة الحداثة بالكامل، ولن أقول ما قاله نزار قباني "والروح
جاهلية"، بل أكتفي بالقول والروح ماضوية. صارت الحياة في شكلها المادي، في
أيّ عاصمة عربية، لا تختلف كثيرا عن شكل الحياة في عواصم العالم المتقدّم،
وإن تخلّفت عنها في الانضباط والدقة، وربما في النظافة. الفكر الإسلامي
الراهن، في أرقي تعبيراته الفلسفية، لا يرى في الحضارة الغربية سوى التقدّم
المادي، وينعي عليها كلّ السلبيات التي ذكرتها في المقدمة، معتبرا أنّ
منشأ هذه السلبيات غياب الدين، الذي هو ما تتميّز به حضارتنا. هذا المنطق
يسمح باستيراد التقنيات، معزولة عن أساسها العلميّ، الذي ما كان يمكن أن
يتحقّق قبل ثورة الإصلاح الديني.
الآن، ومع ظاهرة الدعاة الجدد، التي تزعج المؤسّسة الدينية أيما إزعاج،
نحن إزاء خطاب ذي وجهين: وجه يبرّر للأثرياء متعة النعم التي من الله بها
عليهم - صار الثراء نعمة بصرف النظر عن مصدره - طالما أنهم يعطفون على
الفقراء والمحتاجين ويؤدّون حقّ الله في المال. نصيب الزكاة الشرعية 2.5%،
لا ذكر للضرائب على الدخل لأن ذلك موضوع ينتمي للقانون الوضعي والعياذ
بالله. الوجه الثاني: أداء حق الله من صلاة وزكاة وصيام وحج، التشريعات
العبادية. لذلك ليس للدعاة الجدد باع في المعاملات، والتعقيدات الفقهية
والتشريعية. إنه خطاب بسيط واضح سهل الفهم سهل الهضم، في لغة عصرية متخلصة
من المصطلحات المعقدة، كما تخلّص ممثّلوه من الزيّ التقليدي للشيوخ
واستبدلوا به الزي العصري. هذا الخطاب، بكلّ هذه المزايا التي تسحب البساط
من تحت أقدام رجال الدين التقليديين، يزيّف الواقع ويزيّف التاريخ معا.
هكذا تتعقد الأزمة.
ظاهرة التكفير: تنامي ظاهرة "التكفير" واستفحالها يعني – وهذه مفارقة ساخرة – أنها تفقد
خطورتها. تنامي ظاهرة مصادرة الكتب، واللوحات، والأغاني، وإغلاق الصحف
والمجلات، نكتة غير مضحكة في عصر الإنترنت والسماوات المفتوحة. كل هذا يعني
أن الظاهرة تتفكّك، وهذا ما يفسّر حالة "الهياج" و"السعار" في دوائر
مرتزقة الفضائيات. لكن يجب أيضا أن أنبّه إلى الظاهرة المقابلة – ولا أقول
النقيضة – وهي صراخ مدّعي الحداثة في <نفس الفضائيات.
مسألة نطقي الشهادة في أول محاضرة ألقيتها بعد رحيلي من مصر عام 1995 كان
المقصود منها توصيل رسالة إلى الجمهور الغربي بأنّني لست ضد الإسلام كما قد
يتوهم البعض. قلت: إذا كنتم تحسنون استقبالي وتحتفلون بي ظنّا منكم أنني
أنقد الأسلام من منظور المرتدّ فقد أخطأتم العنوان، ثم نطقت الشهادة. كنت
أخشى من الاستقبال الخاطئ نتيجة الحكم الجائر الذي صدر ضدي أنا وزوجتي؛ ذلك
أن كثيرا من الذين اضطرّتهم ظروف شبيهة للهجرة للغرب استثمروا هذه الظروف
أسوأ استثمار بأن تحولوا كارهين – وليسوا ناقدين - لثقافتهم. لهذا رفضت
اللجوء السياسي، وأفخر أنني ما أزال أحمل جنسيتي المصرية وحدها. أؤكّد ليس
هذا تقليلا من شأن من تضطرهم ظروفهم ازدواج الجنسية، لكنّ حرصي منشؤه تأكيد
حقيقة أنّني باحث ومن شأن الباحث أن يكون ناقدا للثقافة التي ينتمي إليها.
الانتماء لا يعني عدم النقد.
الشعبي والشعبوي:
القاعدة الشعبية للدين – ما يسمى بالدين الشعبي العفوي – تمّ تجريفها
تجريفا تامّا، منذ بدأ الإصلاحيون يصبون جام غضبهم على هذا التدين، واصمين
إياه بالوثنية. بدلا من تفهّم هذا التدين الشعبي، وبدلا من محاولة ترشيده،
شارك في هذا الاحتقار للتدين الشعبي كلّ المثقفين من "الخاصة". كان هذا
الاحتقار والتحقير شارة أن تكون "متعلما" أو"مثقفا". هذا أدّى، مع انتشار
نظام التعليم التلقيني، إلى خلق كوادر من الشباب، تتقبل دون تردّد صيغة
التديّن السلفيّ المتشدّد، المعادي لتسامح وأريحية التدين الشعبي،
المُشبَّع بالروحانية والأخلاقية، ومسئولية التضامن الاجتماعي. صارت هذه
الكوادر من الشباب نصف المتعلم/نصف الأمي الأرضية الخصبة لدعوة الإخوان
المسلمين في الثلاثينات من القرن الماضي، وهي ما تزال الأرض الخصبة لانتشار
فكر التطرّف.
ما هو شائع الآن، هو ذلك التديّن الشعبويّ خاوي الوفاض من العمق الروحيّ
والأخلاقي، الذي خبرناه في تديّن أبائنا وأمّهاتنا، في الأربعينات
والخمسينات، وشطرا من الستينات في القرن الماضي. "القاعدة الشعبية" الأن
تخاصم العقل. تحتاج الأرض – القاعدة - إلى حرث لكي تتعرّض من جديد للشمس
والهواء فتستردّ خصوبتها، التي جرَّفتها الأمراض، التي سردت بعضها فيما
سبق. أنتفق مع "كانط" بأنه لا تغيير حقيقيا مستداما يمكن تحقيقة من أعلى،
لا بدّ من تثوير وعي القاعدة، فهي وحدها صاحبة المصلحة في التغيير وصاحبة
الحقّ في حمايته.


