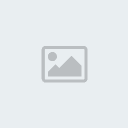
في
كتابها القيم "يا مال الشام" والذي يمكن عدّه توثيقا تاريخيّا قلّ نظيره
في الأدبيات العربية للحياة في مدينة دمشق ولأسرة شامية عريقة، ترصد سهام
ترجمان، في بداية الأربعينات، تطوراً بالغ الأهمية حدث لمؤسّسة الحريم
وأسّس لستّينات التحرّر. فقد بدأت العائلات الدمشقية من الطبقة الوسطى
المتنوّرة بممارسة طقس اجتماعيّ حديثٍ، هو إقامة سهرات احتفالية مشتركة
للجنسين من أبناء العائلة الواحدة، تضمّ أبناء العمومة والخؤولة ومن
شابههم في درجة القرابة، حيث يلعب فيها المشتركون ألعاباً جماعية يشارك
فيها الطرفان.
وكان هذا انتقالاً من مرحلة الحريم التاريخي التي امتدت لمئات السنين،
وتجذّرت في الثقافة العربية، خالقة لدى الإنسان العربي عقلية بالغة
التخلّف، انعكست في موقفه من المرأة إلى صيغة أخرى للحريم، أدعوها
بالاجتماعيّة، وهي مقاربة جملة الممارسات التي تخلق ذلك الإطار المسمّى
بالحريم من زاوية أهمّيتها الاجتماعية في اللحظة الراهنة؛ وليس من زاوية
أهميتها التاريخية، لتصل تلك المقاربة إلى نبذ تلك المؤسسة.
لقد اعتمد هذا التطوّر على اللياقة الاجتماعية التي يملك منها الدمشقي
الكثير الذي استمدّه من تمدّنه الضارب في أعماق التاريخ؛ وسنجد شيئاً
مشابها لدى المجتمعات المدينية في بلدان عربية أخرى.
لقد قطعت المرأة من الأربعينات وإلى الستينات شوطاً يصعب تخيّله الآن،
بعد أن فرض على مجتمعاتنا إسلام مسيّس كجزء من عملية تسييس الثقافة
والحياة تسييسا شاملا، سبّبتها دولة شمولية قدّمت لأفكار التطرّف عمقها
الذي طغى على العمق التاريخي لأيّ مؤسّسة ثقافية كان يمكن أن تخضع لمعادلة
التاريخي – الاجتماعي في تحوّلاتها.
هذه التحوّلات كانت جزءاً من النهضة التي قادتها البورجوازية العربية
الناهضة وقدّم لها الفكر الليبرالي الصياغات الحياتية التي نراها الآن
مذهلة. لقد كانت المدينة حاضنة النهضة البورجوازية الليبرالية، وعنى ذلك
تمفصل المقولات الفكرية لهذه النهضة على القاعدة الثقافية للمدينة.
لقد حاولت الحركة الإسلامية السياسية بعد فشلها في الوصول إلى السلطة
أسلمة المجتمع، أي فرض رؤية للإسلام تنسجم مع ما قدّمه مفكّروها من سيد
قطب إلى أبو الأعلى المودودي، ولكنّ عملية احتواء المجتمع فشلت، وذلك
لانتصار ضرورة مدنية فرضها واقع أكثر وأعمق موضوعية من أن يحتوى بعملية
سياسية.
وظهرت ظاهرة الفتيات اللواتي يجمعن في ثيابهن بين الحجاب وملابس بالغة
العصرية لتقول إنّ المجتمع يتابع تطوّره إلى الأمام، بعيداً عما ترغب به
وتخطط له جماعات بعينها. وكانت هذه التجربة هي الجزء الظاهر للعيان من
ممارسات عديدة جمعت ما بين القديم والحديث.
إن تقييم جملة هذه الممارسات من حيث الإيجابية والسلبية يتوقف على
زاوية النظر إليها. ففكر التطرّف يقوم على التحرّك ما بين نقيضين، سالب
وموجب، وذلك كجزء من رؤيته الإيديولوجية التي تعتمد إلغاء المتناقضات في
الحياة، وإنتاج حالة منمّطة تنسجم فيها جميع المصالح والأفكار مع بعضها في
سيرورة تقود إلى الهدف السعيد.
وذلك ينطبق حتى على الإيديولوجية الماركسية التي تقوم فكرياً على
الديالكتيك الذي يقول صراحة إنّ الحياة تقوم على وجود التناقض؛ وإنّه مصدر
التقدّم والتغيير في الحياة، ولكن، على صعيد الممارسة، فقد تمّ تهميش
الديالكتيك كجزء من تحوّل الماركسية إلى إيديولوجية تتمحور حول التبرير،
لا حول التفكير النقدي العلمي.
فخضعت هي أيضاً لظاهرة رؤية الحياة في إطار نقيضين سالب وموجب. إن رؤية
التطور الاجتماعي الجاري في المجتمع من خلال هذه النظرة سيقود بالتأكيد
إلى اعتبار حالات الجمع ما بين عناصر قديمة وأخرى جديدة حالة فصام،
فالمطلوب هو الانتماء الهوياتي لحالة بعينها، وتشترك في تأسيس هذه الرؤية
الماركسية العربية مع الإسلام السياسي، وكلّ من يدور في فلكهما.
ولكن النظر إلى هذه الظواهر على أنها حالة مواءمة إنّما هو أمر يتمتّع
بالقدرة عليه من ينتمي في رؤيته إلى حالة النمو الطبيعي غير المخطط، والذي
لا يستجيب لفلسفة إرادوية تمنهج الحياة، بل تتفاعل مع ما تقدمه في إطار
ديناميكيات غير خاضعة لرغبة إدارة مشاريع سياسية نهضوية أثبتت حتى الآن
فشلها التامّ.
وهكذا تخضع نفس القيم الاجتماعية الحياتية السائدة في المجتمع العربي
لديناميكية تجاور العمق مع الضحالة في سياق اجتماعي معين، تفقد فيه القيم
صلتها مع جذورها التاريخية لتخضع لدى حامليها إلى تقييم من نوع آخر قائم
على أهميتها الحالية لحياتهم؛ فلا يجري التخلي عنها تماماً، بل يجري
التعامل معها انطلاقاً من السياق الاجتماعي الذي توجد فيه، فيمارس حاملها
دوراً اجتماعياً يمثل انتماءه لجانب من جوانب هذه القيم، وعند تقدم سياق
ديني يلتزم المرء بلعب دور يعبّر عن انتمائه لهذا السياق، فيما يمارس
دوراً اجتماعياً آخر لدى تقدم سياق اجتماعي آخر، دور تعنونه الحداثة
الاجتماعية، ويكون للمرأة فيه دور كبير في تحديد خياراتها الحياتية، ولا
تكون محكومة بالضرورة بالنص الديني الذي شحن سياسياً ليتمتع بقوة إقصائية،
تلقي إلى الجانب السلبي كل من لا يتوافق معه.
إن سيطرة هذه الديناميكية في مجتمعاتنا القادمة، تعني أنه، و من أجل
إجبار الناس على تبني فلسفة الفصام في رؤيتهم لعملية المواءمة، يجب خلق
سياقات تطرف بالغة الشدة، وجعلها المسيطرة اجتماعياً، ولكن الظروف
السياسية، والحالة الثقافية أيضا، لا تسمح بذلك، إلا لدى فئات اجتماعية
معينة لا تتمتع بالتوازن الاجتماعي الذي يؤهلها تحقيق المواءمة في
شخصياتها، ولكنها ليست الفئات المسيطرة سياسياً ولا اجتماعياً.
فالمرونة التي تملكها الفئات المتوازنة ستمنع إقصاءها وفكرها الذي لم
يصغ بعد في صورة ناضجة، وهذا بالضبط هو ما تحتاجه لمرحلة بناء المجتمع
الجديد. لقد ظهرت محاولات هذه الفئات الاجتماعية -التي يمكن وصف فكرها
بالوسطية لبلورة فكر يسمح لها بممارسة حياتها وفقاً لما يناسبها- خلال
فترة سيطرة الدولة الشمولية، ولكن هذه المحاولات أحبطت، فالمسموح، ومن
يمكن أن يكون جزءاً من النظام العربي هو فكر إقصائي، وفقط على ما كانه
الإخوان المسلمون، مما سمح لهم بأن ينتموا إلى النظام العربي السائد، الذي
لم يكن يسمح لفكر تنويري حقيقي بالوجود. فكر يقبل الآخرين.
فكان أن وجدت هذه الحالة الاجتماعية على صعيد الممارسة فقط، ولكنها
اليوم تحتاج إلى أن تنضج بالنسبة للجميع كثقافة تتواجد على المستويات
كافة؛ بدءاً من الشخصي واليومي والعادي ووصولاً إلى الفقهي والنظري
الفلسفي. ويعني ذلك قدرتها على أن تقدم للبشر حلولاً لما يواجههم من
مشكلات تكيف مع الواقع الجديد، وعليها أيضا أن تطور مناعة تجاه الأفكار
الإقصائية الإيديولوجية، التي مازالت تستند على هوامش سياسية وحياتية
واسعة، وموضوعية الوجود، مما سيتابع منحها دوراً كبيراً في صناعة حياة
أبناء المجتمعات العربية.


