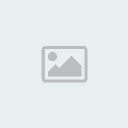
ما قبل الجامعة..
يعدّ الظفر بمقعد دراسي في إحدى الجامعات السورية حلماً يكبر مع جميع
الطلبة منذ سني الدراسة الأولى. وغالباً ما يدور هذا الحلم في فلك كلية
الطب أو الصيدلة، وبشيء من التواضع في الهندسات. ولكن ما أكثر الذين يقولون
إن أحلامهم وآمالهم خابت ورضوا قسراً بمتابعة دراستهم الجامعية في كليات
كانت أقل بكثير من مستوى طموحاتهم، وليست بالضرورة أقل من مستوى إمكاناتهم
الذهنية، وذلك بسبب بضع علامات في الشهادة الثانوية لا أكثر.
تعكس هذه الصورة التراجيدية لحال الغالبية العظمى من الذين يتطلعون إلى
الدراسة الجامعية مدى ابتذال المفاهيم والتصورات التي تصنف الدراسة والتخصص
تصنيفاً طبقياً جائراً مزدوج الصيغة. من جهة أولى تصنفها حسب درجة ذكاء
الفرد، فالفروع التي تتطلب معدل القبول الأعلى هي "من نصيب الذين منّ الله
عليهم بالذكاء الوافر"، ولا يقاس الذكاء هنا بالمعايير العلمية التي تأخذ
بعين الاعتبار إجمالي القدرات الذهنية النقدية والتحليلية وشروط الاستجابة
النفسية المثلى، بل يقاس وفق المعيار الاجتماعي السائد وهو القدرة على
الحفظ وتمثل المعلومات حرفياً. ومن جهة ثانية تعتمد التقسيم التمايزي
الاجتماعي من الأعلى إلى الأسفل، أي من "الأرفع إلى الأوضع" حسب قيمة
العائد الماديّ للمهن العلمية وأهميتها الوظيفية الفاعلة في البنية
الاقتصادية. وهذا أس الخراب الأول الذي يشل فاعلية التعلم والتعليم
فالخيارات الدراسية لا تنبني أبداً على الميول النفسية والاستعدادات
الفطرية وهي شروط الإبداع والابتكار الأساسية، بل تستجيب لشروط التفضيل
الاجتماعي اللاعقلاني.
الجامعة والتعليم..
تحددت النية النبيلة من التعليم الجامعي في تعليم الطلاب العلوم العصرية
ونقل المعارف العلمية وتشجيع البحث العلمي، وذلك لإعداد الشباب المتنور
العقلاني للمشاركة في تطوير المجتمع وبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
يتكشف واقع التعليم الجامعي في سوريا، ونحن اليوم في عصر الثورة التقنية
والمعلوماتية، عن حال رديء بكل المعايير. فهو لم يحقق غايته المأمولة في
الشباب المتنور، وليس لهذا الشباب من العلمية أو العقلانية إلا القشور، ولا
أدل على ذلك سوى انتشار وسيطرة الأفكار والعقائد التقليدية الماورائية
والخرافية على أذهان الغالبية العظمى!! ولم يحقق غايته في خلق الشخصية
المبدعة التي تعي تاريخها حاضراً ومستقبلاً وتعي مشكلات مجتمعها الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، وتتصدى بدافع من وجدانها العلمي للتفكير والبحث
لتجاوز أسبابها.
بل ولم يفلح هذا التعليم في مهمته الأساسية وهي تخريج المفكرين والباحثين،
بل أقله الكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلاً كافياً للانخراط في الحياة
المهنية، ويحتاج الخريج إلى سنوات حتى يصقل معارفه النظرية ويدعمها بالخبرة
العملية، هذا إن لم يكتشف أن جلّ ما تلقاه من معارف نظرية يتأخر زمنياً
بعدة عقود عن الإنجازات العلمية الراهنة.
وتثبت التجربة الواقعية أننا كنا على الدوام في حاجة ماسة إلى الخبرات
الأجنبية، فأغلب منشآتنا الصناعية والإنتاجية الحديثة التي تلعب دوراً
هاماً في الاقتصاد الوطني (النفط والغاز والسماد والكهرباء والاتصالات) تم
إعدادها ودراستها في شركات أجنبية ولا زلنا حتى الآن بحاجة للإشراف عليها
من قبل خبراء أجانب.
ومن أهم مظاهر الخلل في نظامنا التعليمي العالي هي:
- منهجية التعليم التقليدية: التي تعتمد الحفظ والتلقين، بينما يتميز
التعليم الحديث بكونه ليس مجرد نقل آلي للمعارف والعلوم النظرية، وليس
حفظاً للمعلومات واستظهارها مهما كانت عصرية. إنه بالأساس تفجير الطاقات
الكامنة والإمكانات الفعلية عند المتعلمين وخلق روح التفكير النقدي
والتحليلي وتنمية القدرة على التعلم الذاتي والسعي وراء المعلومة أينما كان
مصدرها، والقدرة على التفكير في المشكلات وابتداع الحلول لها. ويتطلب ذلك
الاستقلالية، والحرية التي تضمن حرية البحث والتفكير والاعتقاد، ولا يستقيم
هذا مع حالة الإخصاء الفكري ومسح الشخصية ومع مبدأ الوصاية الفكرية
والعلمية الذي يمارسه الأساتذة الجامعيون ضد طلابهم.
- طرق التدريس التقليدية: تعتمد أغلب الكليات على الكم النظري الهائل وحشد
المقررات بشكل عشوائي وعمومي، فبينما تتجه أغلب الجامعات في الدول
المتقدمة إلى تعميق دراسة التخصصات الدقيقة ما تزال جامعاتنا تتبنى
التخصصات الشاملة العمومية. وتكتفي بتدريس المقررات بالاعتماد على مرجعية
الكتاب الجامعي ومحاضرة الأستاذ فقط دون الاعتماد الكافي على المخابر
والتجهيزات الحديثة الضرورية للتطبيق العملي، أي حصر مصدر المعرفة بشخص
الأستاذ مهما تقادمت معارفه فليس للبحث والاختبار والتجريب أي أهمية، وهذا
بدوره لا يفضي إلا إلى إنتاج شخصية علمية هزيلة تهاب الواقع والآلة وتتقزم
أمامهما.
- تقادم المناهج التعليمية: بينما تتطور معظم العلوم اليوم باطراد، وتغتني
في كل لحظة في ظل الانفجار المعرفي وثورة وسائل الاتصال، يعجز أغلب
الأساتذة الجامعيين عن تحديث محتوى المناهج ومضمونها، وذلك إما بسبب العجز
المادي أو العلمي؛ فقسم كبير من الأساتذة في الأساس تنقصه الكفاءة والجدارة
العلمية نتيجة الانقطاع عن البحث العلمي وانعدام التواصل مع مراكز الابحاث
والمؤتمرات العلمية العالمية.
- تدني قدرات التواصل مع مصادر المعرفة العصرية: إن أهم وسائل التواصل مع
مصادر المعرفة والعلوم هي اللغة الإنكليزية وشبكة الانترنت، فمعظم ما تنتجه
البشرية من جديد المعارف والعلوم يكتب وينشر بالإنكليزية، وتتيح الشبكة
الوصول الآني إلى الحدث، والأمية في المعيار العلمي العصري هي الجهل باللغة
الإنكليزية ومهارات استخدام الكمبيوتر.
لكن جامعاتنا لا توفر المكتبات المجهزة بشكل كاف يكفل لأعداد الطلبة
الوصول إلى شبكة الإنترنت، كما لم تتبنَّ حتى الآن سياسة ناجحة في تعليم
اللغة، ويتضح العجز في المحاولات الفاشلة لتأصيل تدريس بعض المقررات باللغة
الإنكليزية لأن معظم الكادر التدريسي والطلاب لا يتقن اللغة.
الجامعة والتثقيف.. إن فصل العلم عن الثقافة، مهما ارتقت عملية التعليم،
لا يخدم ارتقاء المجتمعات بالمعنى الإنساني. والعلم بلا إطار ثقافي ينحل
إلى مجموعة من الرموز والمعادلات والنظريات تستقر في الأذهان دون أن يغير
في نظرتها إلى الكون والإنسان، بل وتتجاور الأفكار العلمية مع الأفكار
الغيبية والخرافية في انسجام وسلام.
وإذا ما انحدر دور الجامعة إلى الوظيفة التعليمية فقط، فإنها بما هي
مجموعة من البشر ستمتثل في المطاف الأخير إلى نمط الثقافة السائدة في
المجتمع بكل سلبياتها وسيحمل الطلاب والأساتذة سلوكياتهم وأنماط تفكيرهم
التقليدية والموروثة إلى داخل الحرم الجامعي، وستفقد الجامعة بذلك قدرتها
على خلق جيل جديد يحمل رؤى التغيير والتطلع إلى مستقبل أفضل.
إن أخطر ما تعرضت له جامعاتنا، فوق كل بؤس التعليم ونتائجه، هو نزع دورها
التثقيفي والتنويري التحديثي. وبدل أن تكون الجامعات هي ساحة التلاقح بين
التيارات الفكرية السياسية المتنوعة وعقول الشباب، وساحة التفاعل والتلاقي
بين الشباب على اختلاف منابتهم وانتماءاتهم الذي يضمنه مناخ التعدد
والانفتاح والحرية، كانت على عكس ذلك؛ فقد أفضت سياسات التأطير إلى تعزيز
روح الامتثال والإذعان والجمود الفكري، كما أدت سياسات الإقصاء والتخوين
إلى تنمية البغضاء للآخر المختلف فكرياً وسياسياً، وخنق فرصة التغاير
والاختلاف الثقافي على قاعدة الوحدة الوطنية الجامعة.
إن تغييب ثقافة التفكير والحوار والتفاعل الحر وثقافة العلمنة والعقلنة في
ظل انهيار منظومة القيم الوطنية هو الذي يسمح بكل أنواع الارتكاسات
والنكوص إلى سلوكيات ما قبل مدنية وما قبل وطنية. وليس الاحتماء بالطائفة
والعشيرة، وصولاً إلى الفراغ الفكري وانعدام الهوية والتغرب، إلا نتيجة
طبيعية لذلك.


