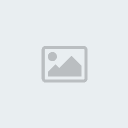
عندما حصل يورغن هابرماس على
"جائزة السلام" التي يمنحها اتحاد الناشرين الألمان سنويا، ألقى أثناء حفل
التسليم في العاشر من أكتوبر سنة 2001، خطابا، مثلما تقتضي العادة، تناول
فيه موضوع "الإيمان والمعرفة" (Glauben und Wissen). ولعله من النادر أن
يجد خطاب مناسباتيّ لكاتب أو مفكّر من الاهتمام، ما وجده خطاب هابرماس الذي
جاء إثر شهر تقريبا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتضمّن آراء وملاحظات
ظلّ صداها يتردّد في الساحة الثقافية الألمانية لوقت طويل. وكان أكثر ما
حظي بالتعليق والمساءلة فكرة "مجتمع ما بعد العلمنة" والدعوة إلى تغيير
النظرة للدين باعتباره أكثر "من بقايا ماضٍ ولّى ولن يعود".
اتّخذ الكثير من الردود على الخطاب شكل سيل من الانفعالات تراوحت
بين الاستغراب والإعجاب، لكنها تحوّلت إلى ما يشبه الدخان الذي يحجب
الحقيقة. وحتى اللقاء الذي أجراه هابرماس سنة 2004 بالأكاديمية الكاثوليكية
البافارية مع الكاردينال جوزيف راتسنيغر -الذي سيصبح البابا فيما بعد -
فقد اختلط صداه بالخطاب المذكور، وبقي شبه محجوب عن الكثيرين رغم صدوره في
كتاب يحمل عنوان "جدلية العلمنة، حول العقل والدين"(1). يجد قارئ هذا
الكتيب برهنة فلسفية متينة توضّح أفكار هابرماس حول أسس الدولة العلمانية
وعلاقتها بالدين، بأسلوب بعيد عن الخطابة ومقتضياتها، وعن متاهات التصريحات
والأحاديث الصحفية التي كثيرا ما تجتث من سياقها. ولعلّ العودة إلى هذا
العمل الهامّ على صغر حجمه، من شأنها تبديد الأحكام المسبقة التي علقت ببعض
أفكار هابرماس والوقوف على ما فتحه من آفاق، حول مسألة ربما لم تأخذ حظّها
من التفكير الفلسفيّ، وإن تراكمت بشأنها أطنان من الخطابات الايديولوجية
والشعارات التي تنشد أمرا آخر غير البرهنة المنطقية الصارمة.
نجد في الكتيّب محاضرتين، الأولى لهابرماس والثانية لراتسينغر،
تسبقهما مقدّمة لفلوريان شولر مدير الأكاديمية الكاثوليكية البافارية
بمونيخ، تحدّث فيها عن ظروف اللقاء الذي تمّ بين الشخصيتين، مع الإشارة إلى
أنّ موضوع الحوار كان باتفاق الطرفين "الأسس ما قبل السياسية والأخلاقية
للدولة الليبرالية".
يقسم هابرماس مقالته إلى خمسة أجزاء يقيم من خلالها بناء للعلمنة
باعتبارها أحد تجليات الدولة الدستورية الحديثة. فهو يبحث في الأسس النظرية
للدولة الدستورية العلمانية، قبل أن يتناول مبرّر التضامن بين المواطنين
في تلك الدولة، وما قد يتهدّده من مخاطر ليخلص فيما بعد إلى طبيعة مسار
العلمنة ونوعية العلاقة بين العلمانيين والمؤمنين بالدين في الدولة
الحديثة.
تتأسّس الدولة الدستورية العلمانية على مصادر مستمدّة من العقل
العمليّ بمفهومه الكانطي، ولا يتبيّن ذلك حسب هابرماس إلا بتفسير مشروعية
المسار الديمقراطي كأساس للقانون، وكيف أنّ الديمقراطية وحقوق الإنسان
يتشابكان منذ لحظة ولادة الدستور. ويظهر ذلك من خلال البرهنة على أنّ
المسار الديمقراطي الذي يلبّي شروط بناء الإرادة الجماعية وبلورة الرأي
العام، ينبني على افتراض القبول العقلانيّ لنتائجه من قبل المواطنين. كما
أنّ ترجمة المبادئ الديمقراطية إلى مؤسّسات يفترض الضمان المتوازي للحقوق
الأساسية للمواطنين على المستويين الفردي والسياسي. وبعبارة أخرى فإنّ
الدولة الدستورية الحديثة تستمد مشروعية مبادئها من ذاتها، على أساس قبولها
العقلاني من طرف جميع المواطنين ولا تحتاج إلى تبرير آخر. إنّ مبدأ
الاستقلالية أو "التشريع الذاتي" للدولة الحديثة يحرّرها من أصول مفترضة
خارجة عنها، مثل الجدلية التاريخية أو النشأة القومية أو الشرعية الدينية.
وبالتالي فإنّ الدولة الدستورية لا تحتاج إلى أيّ مبدأ ماقبلي، وهو ما يعكس
جذرية طرح هابرماس من حيث المنطلق. ولكن يبقى أن نفسّر التضامن الذي ينشأ
بين مواطني الدولة الحديثة الذين هم أفراد أحرار. إذا كان دستور الدولة
الحديثة المستندة إلى الحرية يستمدّ شرعيته من ذاته وبشكل مستقلّ عن مصادر
ميتافيزيقية أو دينية، فإنّ ما يمثّل الرابط بين مواطني الدولة الحديثة هو
حسب هابرماس المسار الديمقراطي ذاته، باعتباره "الرباط الموحد"(Das
eingigende Band) للجميع ضمن "ممارسة تواصلية" رهانها الفهم الصحيح
للدستور بفضل الحوار.
في هذه المرحلة الثانية من مسار برهنة هابرماس، تتأكّد استقلالية
البناء الاجتماعي باعتباره مستندا إلى أسس عقلانية. وهكذا تكون الدولة
والمجتمع بناء حصينا باستنادهما إلى العقل من حيث النشأة والتكوين. أمّا ما
قد يهدّد الرباط الاجتماعي، فلا يأتي من داخل الدولة بل من الخارج، مثلا
بسبب انحراف مسار تحديث المجتمع بشكل من الأشكال. ويحذّر هابرماس في هذا
السياق من النظر إلى استمرار وجود الدين في المجتمع كمجرد ظاهرة أو واقع
اجتماعي، إذ على الفلسفة فهم تلك الظاهرة من الداخل على أنها "تحدٍّ
معرفيٌّ" وأخذها مأخذ الجدّ.
رغم وضوح الطرح وجذريته في تأكيد الأساس ثمّ البناء العقلاني
المحض للدولة الحديثة، فإنّ هابرماس يدعو إلى إعطاء منزلة جديدة للدين،
بحيث يصبح مجتمع العلمنة أقرب إلى الظاهرة المركّبة التي تفترض وجود طرفين
هما العلمانيّ والدينيّ. وتكون العلمنة بذلك "مسارا تكامليا" بين الطرفين،
بل يعتقد هابرماس أنّ من مصلحة الدولة الدستورية الحديثة مراعاة كلّ
المصادر أو الينابيع الثقافية التي يتغذّى منها التضامن بين الناس وينمّي
وعيهم بالقيم. ولذا فإنّ المؤمنين والعلمانيين في الدولة الدستورية الحديثة
ينبغي عليهم التعامل باحترام متبادل. أما الأساس الفلسفيّ لتلك العلاقة،
فهو مبدأ عدم التوافق بين العلم والإيمان كأحد مبادئ الدولة العلمانية.
ولكنّ هذا المبدأ لا يجد له ترجمة معقولة حسب هابرماس إلا عندما يتمّ
الاعتراف للقناعات الدينية بمنزلة ابستيمية مختلفة، والكفّ عن نعتها
باللاعقلانية.
أمّا مقالة الكاردينال راتسينغر، فتركّز على مسألتين هما من ناحية
نسبية مبادئ الديمقراطية والعلمنة وحقوق الإنسان، وهي مبادئ لا تنطبق حسب
رأيه على مناطق واسعة من العالم يخص منها بالذكر الصين والعالم الإسلامي.
ويعتبر ذلك دليلا على أنّ حقوق الإنسان "اكتشاف غربيّ" خاص. كما يلحّ إضافة
إلى ذلك على أنّ بداهة الطرح العلمانيّ لا وجود لها خارج سياق الثقافة
الغربية.
أمّا النقطة الثانية التي يشدّد عليها راتسينغر، فتتعلّق بالتساؤل
عن جدارة العقل بالثقة، ردّا على من يشكّك في الطابع الإيجابيّ للدين.
فالقنبلة النووية كما يقول، هي من إنتاج العقل، شأنها شأن الانتقاء أو
استنساخ البشر.
ذلك أهمّ ما ورد في الكتاب. فما الذي قدّمه هابرماس من جديد؟ إنّه
أوّلا تأسيس عقلانيّ متين للعلمنة، مع جذرية في الطرح لا تمنع الانفتاح
على آفاق جديدة. أمّا الجانب الثاني فهو تغيير النظرة للدين واعتباره جديرا
بمنزلة ابستيمية مختلفة، بل وتحدّيا للفلسفة.
ولكن هل ما قاله هابرماس ينطبق فقط على المسيحية أو على الغرب؟ لا
نجد في برهنة هابرماس تخصيصا للمسيحية بالحديث، رغم أنّ مخاطبه رجل دين
مسيحيّ، ورغم أنّه تحدّث عن تأويل جديد لإحدى أفكار العهد القديم المتمثلة
في أنّ الله خلق الإنسان على صورته، كتجسيد لمفهوم المساواة في الكرامة بين
البشر، بقطع النظر عن ديانتهم، واعتبر ذلك ترجمة حديثة "منقذة".
هل أقصى هابرماس بذلك بقية الأديان؟ إنه لم يستثن أيّ ديانة في
الحقيقة، كما لم يذكر صراحة أيّ دين، فكلها تتساوى على ما يبدو في الدولة
الدستورية الحديثة. غير أنه يمكن التساؤل لماذا يعطي هابرماس للدين منزلة
ابستيمية مختلفة ويعتبره تحدّيا للفلسفة؟ فالأمر ليس بالبداهة التي قد
يتصوّرها المرء في أوروبا على الأقل لو نظرنا إلى المسألة من الجانب
السوسيولوجي. هناك مفارقة ظاهرية لا يمكن أن تغيب عن هابرماس إذ أنّ
الكنيسة المسيحية في ألمانيا مثلا، سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية،
تعرف منذ سنوات تراجعا واضحا في عدد أتباعها. ولكنّ الأمر في الحقيقة ليس
متعلّقا بدور الدين في المجتمع بقدر تعلّقه بإشكالية العلاقة بين الإيمان
والمعرفة كما يتجلّى على سبيل المثال في التحديات التي تطرحها
البيوتكنولوجيا على المستوى الايطيقي.
وعلى أية حال، فقد تبدو أفكار هابرماس تراجعا في النظرة للدين، أو
تنازلا مجانيا، ولكنّ الأمر يختلف إذا ما نظرنا إلى المسألة في سياقها
العامّ، فرؤيته تجمع بين مقاربة يمكن نعتها بالتواضع المبرّر معرفيا وبين
الثقة في النفس كمدافع عن فلسفة حداثية عقلانية. والتحدّي المعرفيّ لا يعني
إقرارا بامتلاك محتمل للحقيقة من جانب الطرف المقابل (أي الدين في هذه
الحالة) بل ترك مجال للشك. وإقرار العلمنة بالدين كتحدّ لن يغيّر شيئا، بل
هو، بشكل من الأشكال، انسجام للعلمنة مع مبادئها باعتبارها مسارا مفتوحا
ولا تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة. أما الدين، أو على الأقل النزعات
الأصولية كمنظومات مغلقة، فهي التي لا تقبل بأيّ تحدّ معرفيّ خارج عنها.
ولعلّ أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه يعدّ مساهمة في تأصيل
العلمنة فلسفيا، مع تنزيلها في عصرها بوصفها ظاهرة حيّة تتفاعل مع ما
حولها، وليست مؤسّسة جامدة أو قانونا أو منظومة شاملة "صالحة لكلّ زمان
ومكان". أمّا الجانب الآخر المهمّ في الكتاب، فهو أنّه يؤكّد حداثة تفكير
هابرماس فيما يتعلّق بالعلمنة، تماما مثلما يتبيّن من نظريته العامّة في
الفعل التواصليّ. فهو فيلسوف حداثيّ لم يجعل من عصر التنوير سوى مصدر
للإلهام، ولم يعتبره منظومة من الأفكار التي تستعاد باستمرار بحيث يتحوّل
إلى مجرّد مفكّر محافظ مثلما اعتقد البعض. ولعلّ نظرة بسيطة إلى أحد
مفاهيمه وهو مفهوم "الوطنية الدستورية" تؤكّد هذا، إذ أنّ المفهوم جديد
تماما ويقطع مع كلّ التصوّرات الماضية حول الوطنية والقومية فضلا عن كونه
مفهوما مستقبليا بامتياز.
أمّا ما شاع حول موقف هابرماس من المسيحية كمصدر وحيد للثقافة
الأوروبية الحديثة، فهو مجرّد حديث صحفيّ مناسباتيّ لا يمكن فهمه بغير
العودة إلى سياقه، وهو لا يرقى بأيّ حال إلى مستوى الموقف النظريّ العامّ
لدى هابرماس. فمعروف عن هذا المفكّر مثلا أنّه يساند دخول تركيا ذات
الثقافة المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنه رفض بحزم موقف السياسيّ
الهولندي فلدرز باعتباره استفزازا غير مبرّر للمسلمين. إنّ ما ينبغي أن
يحاسب عليه الفيلسوف أو المفكّر هو كتاباته النظرية.
تبيّن إذن من خلال العودة إلى هابرماس، أنّ الاختبار الفلسفي لأسس
العلمنة يؤكّد صلابتها ومتانة بنائها الداخليّ، ولكن دون ادّعاء الحقيقة
المطلقة. وقد ثبت أنّ مثل ذلك الادّعاء لم يكن ضمانا لاستمرار سيطرة
الأديان أو الاديولوجيات، فمن باب أولى وأحرى أن لا يلتصق بالعلمنة. ولذا
فإنّ وعي العلمنة بحدودها مثلما يتجلّى في برهنة هابرماس، لا يفضي إلى ما
بعدها، بل إليها وحدها وقد ازدادت حيوية وقوّة. إنّ الاعتراف بالدين كتحدّ
يتحوّل في نهاية المطاف إلى تحدّ للدين ودعوة له للاعتراف بنفس المنزلة
للعلمنة. وربما كان في ذلك معنى "جدلية العلمنة" بوصفها سيرورة اجتماعية
تاريخية حيّة، تتعالى على جمود المؤسسات وتقادم القوانين، وعلى الأوهام
التي تفرزها الايديولوجيات. ولعلّ استعمال مصطلح العلمنة Säkularisierung
عوضا عن العلمانية، طريقة للتأكيد على أنها مسار متواصل مفتوح، في حين
يوحي مصطلح العلمانية بمنظومة متكاملة ومنتهية. فالعلمنة عند هابرماس
"جدلية لم تكتمل"، وهي في كلّ الأحوال تيّار أو مسار يمثّل أحد تجلّيات
الحداثة وأفق مفتوح و"تواصليّ". والمسار تعبير عن ديناميكية يفرزها مجتمع
معيّن، ويمكن أن يختلف باختلاف المجتمعات، وهو ما نلاحظه حيث أنّ العلمنة
تختلف حتى داخل المجتمعات الأوروبية نفسها. فالفصل المؤسّساتي بين الدين
والدولة لا وجود له أصلا في دول مثل بريطانيا بعض البلدان الاسكندنافية،
ورغم ذلك فهي ليست أقلّ علمنة من فرنسا حيث يسود الفصل التامّ بين الكنيسة
والدولة.
تلك إحدى الدروس العملية التي يمكن استخلاصها من كتاب يؤسّس لعودة
الحوار بين العلم والإيمان على أساس الاحترام المتبادل الذي يفترض ضمنيا
الفصل بين المجالين. ولا يخشى الحوار إلا أتباع التطرّف والتعصّب، فلولاهم
لما بقيت المناظرة التي جرت بين الشيخ محمد عبده والمفكّر فرح أنطون مثالا
يتيما في ثقافتنا العربية منذ حوالي قرن من الزمان.
هامش:

