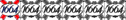حين قررت غوغل مد المتظاهرين في مصر بتقنية تتيح لهم إيصال رسائلهم إلى
موقع تويتر عبر خطوط هواتف أرضية، كانت الإدارة الأميركية تراقب الأوضاع في
مصر بمزيج من القلق والتردد. غوغل هي واحدة من درر تاج الأمبراطورية
الأميركية، وقد تكون الأثمن على الإطلاق. لكن الإدارة السياسية تتعامل مع
الافكار والمواقف أما الإدارة التكنولوجية فتتعامل مع الوسائل والوسائط. في
هذه الثورة نجحت الوسائط في إثبات جدراتها بتصدر المشهد العام في كل بلاد
العالم، لكن الأفكار ما زالت حتى اللحظة أعجز من أن تجد حلولاً للمشكلات
المزمنة. إنها ثورة غوغل
ونظرائه، لقد تسيدت أميركا على هذا القرن الطويل منذ بداياته!
الإدارة الأميركية مثلها مثل أي إدارة سياسية في العصر الحديث تقرأ
الأوضاع في أي بلد من بلدان العالم بناءً على مراقبة تشكيلاته السياسية
والإجتماعية وقواه الناشطة اقتصادياً، وطوائفه وفئاته. والمتظاهرون في مصر
وقبلها في تونس لم يكونوا مسجلين على الأجندة الخاصة بدبلوماسيي الولايات
المتحدة ولا حتى على أجندات دبلوماسيي مصر أو تونس. السي أن أن أكثر وسائل
الإعلام العالمية تقرباً من الحدث المصري، سمت الثورة في واحد من برامجها:
ثورة بلا قيادة. واقع الأمر أنها كذلك فعلاً، لكن غياب القيادة لم ينتقص من
جدارتها في تصدر الأحداث. وهذا طبيعي. إنما، والأرجح بسبب الغريزة
الصحافية العالية الحساسية، عرفت السي أن أن، أو لنقل عرف مراسلوها
وصحافيوها، أن هذه الثورة التي حصلت في مصر لن تتصدر الأحداث فحسب، بل
ستتصدر التاريخ في الآتي من الأيام.
النظام المصري نفسه لم يكن يرى الثورة التي تحدث في شوارع المدن المصرية
ثورة عابرة. أصلاً، هو أدرك منذ اللحظة الأولى عجزه عن القمع العادي، وأدرك
منذ اللحظة الأولى أيضاً أن مثل هذه الثورات تحتاج خططاً جديدة لمواجهتها.
تفتق ذهن بعضهم عن قمعهم بطريقة سياحية، فأُنزلت الجمال والأحصنة إلى
الساحة لتدهس المتظاهرين. لكن الذهن الذي تفتق عن هذه الطريقة المبتكرة في
القمع خاب أمله كلياً. كان مشهد الجمال والأحصنة وهي تدهس الشبان الذين
يحسنون الاتصال بكل وسائل الاتصال الحديثة مفجعاً على نحو غير مقصود. فبدوا
على ظهور الجمال والأحصنة كما لو أنهم برابرة الكهوف يريدون دهس الحضارة.
الجمال في مواجهة غوغل؟ يا للمسافة الزمنية التي تفصل بين تفاحة آدم وتفاحة
ماكينتوش.
لقد قامت هذه الثورة مدججة بأسلحة لا يسهل نزعها. في التوصيف، هذه الفئة
الاجتماعية التي تقوم بثوراتها اليوم هي فئة مدللة اجتماعياً: شباب،
متعلمون، يجيدون استعمال تكنولوجيا الاتصالات، يتقنون اللغات، ثم أنهم
مسالمون. إذاً كيف يسع النظام، حتى لو كان نظاماً مستبداً، قمعهم؟ لقد صُرف
وقت كثير في مديح التكنولوجيا الحديثة وفي ضرورة الاتصال بالعصر، حتى في
الانظمة الأكثر عتواً في القمع والتنكيل بشعوبها. وخطب كثيرة لا تحصى عدداً
قيلت في مديح التكنولوجيا الحديثة. الآن أبناء هذه التكنولوجيا يعترضون
ويتظاهرون ويثورون، الأرجح أن الأنظمة السياسية لم تجد الوقت الكافي لبلع
خطبها السابقة وتبني خطباً أخرى تدين التكنولوجيا وتضيق الخناق على
مستعمليها. ومن سوء حظ السلطات المصرية أنها عرفت ذلك في لحظة الحقيقة،
فلجأت إلى تعطيل الأنترنت والشبكات الهاتفية الخلوية وبث شبكات التلفزيون
العالمية، وظنت أنها ستنجح في قطع أواصر الصلات بين المتظاهرين الثائرين.
إنما كان ذلك بعد فوات الأوان.
من هم ثائرو اليوم؟ ثمة إجماع لا يمكن دحضه يفيد أن منظمي ثورات اليوم والفئة الأكثر قدرة على
تحديد مطالب الثورة وحصرها ومن ثم صياغتها ونشرها بين الجموع هم من فئات
عمرية شابة تنتمي إلى الطبقة الوسطى في هذه المجتمعات. يمتلكون وسيلة
الاتصال الاجتماعي الأكثر فاعلية، بسبب من شموليتها وتجاوزها للحدود
والمسافات، ويتشاركون في ما بينهم، على وجه العموم، بضعة مبادئ كبرى وعامة:
تفضيل النظام الديموقراطي على غيره من النظم، رفض العنف المنزلي والعنف ضد
الأطفال والنساء، مساواة الأعراق والأجناس والشعوب وحتماً المساواة بين
الجنسين، تبني حقوق المثليين الجنسيين والدفاع عن قضاياهم، أو على الأقل
عدم الاعتراض عليهم. ثم والأهم من ذلك كله أنهم يتبادلون خبراتهم وتجاربهم،
وهم في معنى من المعاني، لا يكونون موجودين إذا كانوا صامتين. الواحد منهم
في حاجة دائمة لأن يعبر عن رأيه، تويتر وفايسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع
التواصل الاجتماعي تجبر المرء على التعبير. المرء في هذا العالم حين يصمت
يموت، لذلك هو مضطر أن يعبر عن همومه، عما يجول في خاطره (what’s in your
mind) على ما يقول فايسبوك، وتالياً فإن الاضطرار إلى التعبير بالرأي
والكلمة، والتعليق على الصور التي تصبح بالنسبة لهم أحداثاً ولا تبقى
صوراً، هو في معنى ما حث للخطى نحو حيازة صفة المواطنة التي كانت حنة أرندت
تنشدها. أي المواطن صاحب الرأي. لكن هذا الاتجاه العام نحو الكتابة
والتعبير، لا يعني في حال من الأحوال أن الخطاب الفكري والسياسي لهؤلاء
جاهز والتشكيل الحزبي او التنظيمي مرتب على أتم وجه، ولم يعد ثمة غير
انتظار ساعة الصفر. في الأساس، ورغم أن هذا الضرب من وسائل التواصل
الاجتماعي والسياسي يحض على التفكير، إلا أن ما هو مطلوب ابتكار حلول له
والأزمات المطلوب مواجهتها تكاد تكون عصية على الحل. لذا فإن الرأي او
الآراء المتعددة في هذه الحال، لم تكن تعكس روحاً ثورياً، بل على العكس،
كانت تعكس جنوحاً نحو المسالمة والتسامح والتراجع عن المتكسبات إن لزم
الأمر. والحق أن هذا الميل إلى التسامح والمسالمة هو ما جعل السلطات
المصرية، والتونسية من قبل، تؤخذ على حين غرة، وتجر من ناصيتها نحو الخضوع.
ذلك أن القمع العاري لا يجدي مع المسالمين المتسامحين وقتاً طويلاً، قد
يحقق نتائج قصيرة الأمد، لكنه في النهاية سيرتد على أصحابه وتتحول مصادر
القوة والسلطة إلى سبب للهزيمة والضعف والإدانة المسبقة.
والحال، أفضل طاقات المجتمعات تثور وتخرج إلى الشوارع، وعلى السلطات أن
تستجيب لمطالب، كانت تبدو غير واقعية قبل يوم واحد فقط. إذ ما الذي يجعل
هذه الثورات راغبة في أن تقدم السلطات لها ضحية أو أكثر؟ ولو كان الأمر
صراعاً سياسياً تقليدياً، لما استطاع أي طرف من الأطراف المتصارعة أن يطالب
برحيل الرأس المدبر والقائد للطرف الآخر. وبكلام أوضح، لو كان الصراع بين
حزب الوفد المصري مثلاً والحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، واستطاع حزب
الوفد أن يثبت أنه قادر على حشد المصريين وراء مطالبه، لما كان سيطالب
برحيل حسني مبارك في المفاوضات التي سيجريها لتقاسم السلطة مع الحزب الوطني
الحاكم، بل كان حسني مبارك نفسه هو من سيقدم له التنازلات وهو الأقدر على
تقديمها بطبيعة الحال. لكن هذه الثورة طالبت برحيل الرئيس، ووالتها أحزاب
المعارضة على ما تريد، إنما من قال أن ثوار هذه الثورة يحبون المرشد العام
للأخوان المسلمين، ولا يفضلون أي أخواني آخر عليه؟ مطلب رحيل الرئيس لم يكن
سياسياً على أي وجه من الوجوه، لكنه كان مطلباً رمزياً. أبناء الثورة، أو
هذه الفئة الاجتماعية الصاعدة والمقررة، يريدون التأكد من مدى سطوتهم على
اجتماعهم الحديث، فيطلبون ما لا منطق له. ذلك أن مخالفة الدستور بدعوى أن
الرئيس مدد لنفسه خلافاً لروح الدستور ليس مطلباً حكيماً من مطالب الذين
يريدون الخضوع إلى القانون. وتالياً تحميل فئة قليلة شرور المجتمع كلها،
ولو كانت هذه الفئة هي الرئيس وأبناءه وعائلته والمقربين منه، ليس أمراً
منصفاً. مع ذلك كان انتفاء العدالة والإنصاف في هذا المطلب ضرورياً لإثبات
القدرة وللقول للجميع، معارضة ونظاماً وموالاة، أن اليد العليا في المجتمع
من الآن فصاعداً ليست يد أي منكم. على كل حال بدا مشهد أحزاب المعارضة
المصرية وهي تتردد في إعلان مطالبها، وتحاول التماهي مع مطالب ارتجالية كان
يرفعها المتظاهرون مضحكاً ومبكياً في آن. والأرجح أن الحكومات التي ستتشكل
في مصر وتونس من إئتلاف قوى المعارضة والموالاة في المستقبل القريب، ستكون
حكومات المحكومين المنتظرين تنفيذ الحكم.
لا سياسية المطالب، وجنوحها الرمزي، لم يكن جنوناً مطبقاً. الثوار في تونس
وفي مصر قرروا منذ البداية، أنهم مع الجيش وضد النظام السياسي وشرطته
ورجال أمنه ورجال أعماله. هكذا قرروا منذ اللحظة الأولى إحداث شرخ عميق في
بنية النظام الحاكم، لكنهم حرصوا، بسبب من سلامة الغرائز السياسية
والاجتماعية التي تحركهم، أن يبقى النظام متماسكاً. ليس ثمة ماراتون منهك
نحو المجهول، فقط ثمة تعديل أساسي وبالغ الأهمية في موازين القوى السياسية،
يستند أساساً على التعديل الذي حصل أصلا في موازين القوى الاجتماعية من
قبل، وليكمل النظام والبلد مسيرته مثلما كانت مخططة من قبل، مع إضافة أخرى
مهمة جدا تقول: من يعطي شرعية لهذا المسار لم يعد الحزب الحاكم بل الفئة
الاجتماعية التي أثبتت أنها الأقوى في المجتمع والأكثر قدرة على التماسك،
والأهم من ذلك كله التي لا يستغنى عنها. والحال فإن مطلب اسقاط الرئيس في
تونس ومصر كان مطلباً في محله تماماً، ذلك أن الفئة الاجتماعية الصاعدة في
هذه المجتعات، أرادت ان تثبت أنها هي التي تقود النظام وأنه حين يحين أوان
المفاضلة بين هذه الفئة وبين الرئيس والقائد ومجلس قيادته، سينحاز المجتمع
والنظام والعالم كله إلى هذه الفئة وينبذ الرئيس. إذ لم يمر خطاب سياسي
واحد في شرق العالم وغربه من دون أن يكيل المديح للفئة الثائرة اليوم
بوصفها فئة مسالمة أولاً وبوصفها تجسيد حي لطاقات المجتمع الواعدة. هذا،
ورغم أن غوغل انحازت مبكراً، إلا أن الولايات المتحدة السياسية أدركت
متأخرة نسبياً أن لا مفر لها من الانحياز.
لماذا مصر؟ ثورة مصر ليست أولى الثورات، يمكن ان نتذكر بسهولة أربع ثورات سابقة.
2005 في لبنان، 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، 2010 في إيران، ومطلع 2011 في تونس.
لنبدأ بالثورة الغريبة على هذه الثورات كلها. أي الثورة الأميركية. بطبيعة
الحال، لم يطلق أحدا على ما جرى في أميركا تسمية "ثورة" وحتى في تونس ومصر
وليبيا وإيران ولبنان، ثمة كثر ترددوا في دعوة هذه الضروب من الحراك
الإجتماعي بـ"الثورات". مع ذلك يمكن القول أن هذه الحركات الإجتماعية ملكت
جميعا ما يمكننا أن نعتبره أهم خصائص الثورات على ما تحددها أرنت، ذلك أنها
كلها اشتركت في توليد مجالس محلية تناقش وتقترح في لحظة اعتراضها. والحق
أن الثورة بمعنى من المعاني هي سلوك اجتماعي طارئ، أي أن الناس في زمن
الثورة ومسارها تتسلح بالأمل في تغيير الأوضاع المشكو منها، وكل فئة أو
مجموعة تشكو من أوضاعها بطبيعة الحال، مما يجعل الثورات عبارة عن مجموعات
متنوعة وكثيرة ترفع مطالب متنوعة ومعظمها غير قابل للتحقق، لكنها في
المحصلة تجتمع على نبذ النظام القديم على أمل أن يحقق لها التغيير ما تصبو
إليه. وبكلام أدق، الثورة تولد أملاً عارماً لكنها أيضاً صانعة إحباطات،
تعقب هذا الأمل، وهذا ما حدث في لبنان وإيران وأميركا ومرشح لأن يحصل في
مصر وتونس وسائر البلدان الموعودة بالثورات.
لم تحدث ثورة الأميركيين في الساحات، ولا نزلت أيضاً كصاعقة في يوم مشمس.
وأساساً كان لهذه الثورة قائد يتحدر من صلب التشكيلات السياسية الأميركية
التقليدية. وعلى غرار الثورات الأخرى التي سبقتها وتلتها، كانت الثورة
الأميركية تولي اهتمامها للرموز. حرص باراك أوباما وفريقه الانتخابي على
تفعيل الشبكات الاجتماعية على الأنترنت، على مواقعه، وفي المواقع الأخرى
التي أنشئت على وقع ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية، حصلت ثورة في
المناقشات، ردود وردود متبادلة، فجأة وجد صناع الرأي العام أنفسهم في حيرة
أقرب إلى الصمت.
يكتب فريد زكريا مقالة في النيويورك تايمز، فيرد عليه ألوف القراء. طبعاً
ثمة من يستطيع القول أن الذين يقرأون فريد زكريا هم حتماً اكثر من الذين
يقرأون ما كتبه القراء رداً عليه، وهذا صحيح صحة لا جدال فيها، لكن المسألة
في مكان آخر. المعلقون على فريد زكريا يريدونه حجة لقول ما يريدون قوله،
إنهم بمعنى آخر يعلنون أنهم يريدون من الآن فصاعداً أن يحولوا آراءهم
الخاصة إلى رأي عام.
في هذا السياق يجدر بنا تسجيل ما يمكن اعتباره علامة لا تدحض على تسيد
أميركا على هذا القرن مرة أخرى بعدما تسيدت أو كادت على نصف القرن الماضي.
يبقى نقطة أخرى يجدر بنا تسجيلها في ما يخص الثورة الأميركية، إنها تلك
المتعلقة بما سمته حنة أرنت المجالس المحلية التي تنشئها الثورات وتلازم
بالضرورة كل ثورة مهما قصر عمرها، مجالس محلية هي عبارة عن منتديات
للمناقشة، على مستوى الحي أو المصنع أو المبنى أو البلدة والمدينة، وفيها
يتخذ المواطنون قرارات ويتبنون آراء ويدافعون عنها. الذي حدث أن الحملة
الانتخابية لأوباما صنعت إطاراً للدردشات على الأنترنت وحولت الدردشات إلى
نقاشات، وحولت مقاهي الدردشة السبرنطيقية إلى مجالس محلية، وهذا والحق يقال
ما زال قائماً ومستمراً، ولو أردنا متابعة أرنت حتى النهاية لوجب علينا
القول، ان الثورات على ما ترى أرنت لا تنهزم وتخلفها أنطمة استبدادية إلا
حين يتم الإطاحة بهذه المجالس، على ما فعل روبسبيير وسان جوست وعلى ما فعل
لينين وستالين من بعده. والحال، ما زالت المجالس هذه موجودة، وما زال
بالإمكان أن تكرر عرض القوة نفسه الذي عرضته في انتخابات 2008، وتفرض على
المرشحين للرئاسة معايير لم تكن مراعاتها سابقاً من الشروط الضرورية. ذلك
أن حل هذه المجالس اليوم ليس بالسهولة نفسها التي كانت في ما سبق من ثورات.
فهذه المجالس قائمة بذاتها ولذاتها على صفحات المواقع الاجتماعية في شبكة
الأنترنت وليس ثمة قيود تستطيع ان تحد من انتشارها. لقد أسقط في يد السلطات
السياسية تماماً، ثمة مجالس ثورية أصبحت عبارة عن مؤسسات اجتماعية راسخة
وليس ثمة طريقة لتخفيف حدة أثرها.
في مصر ولبنان وتونس وإيران كانت المجالس السبرنطيقية قائمة ولا تزال. في
لبنان كان قصب السبق للرسائل النصية ولإجادة ترتيب العلاقة مع شبكات البث
التلفزيوني، في إيران كان ثمة هواتف ذكية تلعب دورها الأكثر براعة وحدة، في
تونس ورغم التضييق على صفحات المواقع الاجتماعية استطاع الشبان أن
يتواصلوا عبر شبكات الدردشة والرسائل النصية، في مصر كانت السلطات تنظر إلى
ما جرى في تونس وتقرر يجب أن نقطع الهواء عن هذه الفئة الاجتماعية، أوقفت
شبكات الهواتف الخلوية عن العمل وضيقت على المراسلين الصحافيين وشبكات البث
التلفزيوني وعطلت شبكة الانترنت، لكن هذا كله جرى بعد فوات الأوان. هذه
الثورات، المنتصر منها والمقموع، لم يحدث أن استطاع سان جوست ما تحويل
مجالسها إلى ركام، على المستوى السبرنطيقي بقيت المجالس حية. إنما اختلفت
الحماسة وحدة الرجاء. على أي حال، هذه مسألة تتشارك فيها ثورة أميركا مع
الثورات الأربع، كلها حافظت على مجالسها سالمة، وكلها أصيبت ببعض الإحباط
وخفتت فيها جذوة الأمل. لكن ما كان ممكناً في أميركا تحققه من دون عراضة في
الشوارع لم يكن ممكناً أن يحصل في بلاد الثورات الأخرى. ذلك أن الفئة
الاجتماعية التي تستعد اليوم للإمساك بأعنة المجتمعات شرقاً وغرباً هي فئة
مكتملة النصاب في أميركا، لكنها ليست كذلك في مصر أو لبنان أو تونس أو
إيران. وبمعنى آخر، ليس ثمة ما يمكن توقعه أو استيضاحه في المشهد المصري
لمجرد معرفتنا أن ثمة هذا العدد المعين من مستخدمي الأنترنت هناك، أو ان
عدد المدونين كذا وكذا. المسألة في مصر، ولنقل في الشرق الأوسط عموماً أعقد
من مثيلتها في أميركا لأسباب عديدة.
ولنبدأ بالسبب التقني: المجتمع الأميركي على ما وصفه توكفيل وعلى ما قرأت
ثورته حنة أرنت هو مجتمع مهاجر. والأميركيون عموماً أكثر شعوب الأرض قدرة
على التعايش مع المتغيرات، اجتماعية أم طبيعية أم اقتصادية، وغالباً ما
يتعاملون مع المؤسسات والصناعات والتجارات بوصفها كائنات تولد وتنمو وتهرم
وتموت. كل عقد أو عقدين ينهار قطاع اقتصادي من القطاعات الأميركية المؤسسة
والضخمة تحت ضغط المنافسة الخارجية، لكن الأميركيين يحثون الخطى نحو توليد
قطاع آخر ويقررون الاستثمار فيه، وهذا القطاع سرعان ما يصبح أكثر القطاعات
قدرة على صناعة صورة أميركا الاقتصادية والاجتماعية. على أي حال لن نخوض
طويلاً في الشغف الذي يصنع اقتصاد أميركا وصورتها، إنما يجدر بنا القول أنه
من الواضح والبديهي في مجتمع تتغير أحواله على إيقاع علماني حديث، أن يفرد
أو يتوقع أن تحتل الصناعة الرائجة وزبائنها ومستهلكيها في المشهد العام
(الأميركي على وجه التحديد) حيزاً أساسياً. الاتصالات بكل قطاعاتها هي
صانعة وجه أميركا اليوم، من غوغل إلى آي فون وبلاك بيري، وصولاً إلى
آفاتار، وكان حرياً بمجتمع يعرف هوسه هذا أن يتوقع أن تتحول الآغورا لديه
من الساحات العامة إلى الفضاء السبرنطيقي.
في مصر أو في لبنان كانت هذه الفئة في حاجة ماسة لأن تثبت وجودها جسدياً
في الساحات. ذلك أنها لو بقيت في العالم الافتراضي لما استطاعت السلطات أو
المجتمع برمته أن يلحظها. خرجت إلى الساحات، وهي تطلب عناية السي أن أن.
ذلك أن المجتمعات هناك كانت وما زالت تراقب أحوالها ومستقبلها على شاشة
السي أن أن او الأي بي سي. لهذا السبب تشابهت الثورات الأربع في ادعاءاتها،
سواء في بيروت أو في إيران أو في مصر وتونس، كان الشاب الذي يتظاهر يريد
أن يشاهد صورته وهو يتظاهر في اللحظة نفسها على الشاشة، ويريد أن يثبت أنه
ضحية نظام القمع، ويريد أن يثبت أيضاً أنه بطل مصيره ومقرره في آن واحد.
والحق أن كل هذه الأدوار افتراضية، فلا نظام القمع يستطيع أن يقمع الفئة
الأكثر مسالمة ودلالا على نحو ما يقمع الطبقة العاملة أو أي طائفة صغيرة من
الحرفيين أو أقلية دينية أو اتنية، ولا المتظاهر ضحية نظام القمع، لأن
ظهوره على الشاشات لا يعني حكماً أنه ضحية، ذلك أنه يترجح دوماً بين دورين:
الضحية والمنتصر. فهو في لحظة منتصر ويعلن عن هزيمته لنظام القمع، وفي
لحظة أخرى ضحية ويعلن أن نظام القمع يقمعه قمعاً يلامس شغاف روحه.
يبقى أنه علينا ان نعالج مسألة نظرية تتعلق بتسيد أميركا على هذا القرن
منذ بداياته. وهو تسيد لا يشبه كثيراً الريادة التي حققتها والقدرة الفائقة
على المقاومة التي أثبتتها في مواجهة الحراك الشيوعي في النصف الثاني من
القرن العشرين. وإذ يجمع المحللون والسياسيون جميعاً أن الهزيمة التي مني
بها الفكر الماركسي، تجربة ونظاماً كانت من صنع أميركي في معظمها فإن أحداً
لا يتذكر، حسب علمي، واحداً من أهم الأسباب التي جعلت المجتمعات
الإشتراكية مسقطاً في يدها تماماً منذ ستينات القرن الماضي على أقل تقدير.
والحق أن أميركا التي وجدت نفسها في منتصف الستينات من القرن الماضي وبداية
سبعيناته أمام تحديات منافسة شرهة من أوروبا واليابان يومذاك، وجدت نفسها
تخسر شيئاً فشيئاً أعمدة اقتصادها الرأسمالي واحداً تلو الآخر، فانهارت
صناعات كبرى صنعت صورة أميركا يوم كانت هي التي تنافس أوروبا على النحو
الذي نافستها فيه ألمانيا واليابان في ما بعد، لكن أميركا المهاجرة في كل
شيء كانت قد ثبتت قبل عقود ضلعاً ثالثاً في المعادلة الاقتصادية الموروثة
من آدم سميث والمشدد عليها ماركسياً. كان ماركس يرى أن الاقتصاد يقوم على
ركيزتين أساسيتين: وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج. وهاتان الركيزتان هما ما
يصنعان كل شيء، حتى الذوق الفردي وطرقنا في التعبير عن أنفسنا، وكيفية
تظهير الصورة التي نريد أن نبدو عليها. أميركا دمجت هذين العنصرين في عنصر
واحد ووضعت في مقابلهما عنصراً آخر هو المستهلك. ومع النشاط الأميركي الذي
هدف إلى فتح السوق الأمركية نفسها أمام استهلاك السلع تحول المواطن
الأميركي من مجرد قوة إنتاج إلى مستهلك، وحاز هاتين الصفتين على مدى العقود
التي تلت. سرعان ما وجد المستهلك في كل مكان من العالم طريقه لإثبات
سلطته، والحق أن بعضاً مما لم يجد له النظام الإشتراكي حلاً هو بالضبط
ثقافة الاستهلاك هذه، فإذا كان مفهوماً أن يحتاج العامل أو سائق التاكسي
إلى ارتداء حذاء رياضي وسروالاً من الجينز، بسبب طبيعة عمله، فإن ما لم يكن
مفهوماً بالنسبة للفكر الاشتراكي، المبني أساساً على تقصي الحاجات ومحاولة
إشباعها، أن يصر العامل أو سائق التاكسي على ارتداء حذاء من ماركة أديدياس
أو نايكي وسروالاً من ماركة ليفايس مثلاً. وكان الأمر الأكثر مدعاة لبلبلة
الفكر الاشتراكي أن يرغب المهندس أو الممثل أو مدير المصرف في ارتداء حذاء
رياضي من ماركة معينة وسروال جينز من ماركة معينة دون غيرها.
لا داعي للإطالة في هذا المبحث الذي صرف في إيضاحه وتثبيته وقت طويل، لكن
المستهلك، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والدول الإشتراكية أصبح مواطناً
عالمياً. أي أن المستهلكين لم يعودوا أميركيين وحسب، بل صاروا سعوديين
وروساً وهنوداً ويابانيين. هكذا وجدت أميركا نفسها مرة أخرى من دون قدرة
على المنافسة في الريادة الفكرية على مستوى اختراع الحاجات البشرية. لم
يلبث الأمر طويلاً عند هذه النقطة، حتى انفجرت ثورة الاتصالات. والتي نحن
في متنها اليوم. هذه الثورة قادتها أميركا واخترعت الحاجة إلى استهلاكها في
العالم كله، بمعنى أن العالم كان يسير سيراً طبيعياً من دون أنترنت، لكن
الأنترنت اليوم باتت حاجة ملحة لأنها ربطت العالم كله بخدماتها. الذي حصل
بعد وقت قليل أن فئة اجتماعية تكونت في اميركا وبدأت بمد سلطانها على
العالم كله من أقصاه إلى أقصاه. هذه الفئة ورثت الدور الذي كان المستهلك
يؤديه في العقود التي سبقت، لكنها تفوقت على المستهلك لتداني في معنى من
المعاني في ولادتها الحدث التاريخي الجلل، ذلك أن ولادتها تشبه في التاريخ
ولادة الطبقة العاملة. لقد اخترعت أميركا فئة جديدة يمكن تسميتها
بالمستخدمين، فئة الذين يستخدومن تقنيات الاتصال، والحال لم يعد اليوم
مهماً إن كنت تحمل جهاز آي فون أو بلاك بيري، بل المهم أن ترسل الرسائل
النصية عبره ولم يعد مهماً إن كان حاسوبك الشخصي من ماركة أتش بي أو توشيبا
بل المهم ان يكون لديك حساباً بريدياً في غوغل أو ياهو مرتبطاً بفايس بوك
وتويتر ويوتيوب، وقابلاً لأن يصلك بعالم البلوغرز الواسع والذي يتسع طرداً
كل يوم. ولادة المستخدم كفئة اجتماعية هو صناعة عالمية بمعنى ما لكنها حصلت
وتنامت برعاية أميركية من دون شك، وليس أقل الدلائل على هذه الرعاية أن
معظم محركات البحث الكبرى ما زالت اميركية المنشأ والمآل. غوغل مرة أخرى،
هو العملاق الذي يسمح لنا أن نتحول من مستهلكين إلى مستخدمين. وهؤلاء
المستخدمين هم من نشط في تنظيم الثورة الأميركية والثوارت التي سبقتها
وتلتها.
هشاشة الديموقراطية: قد تكون المفارقة الكبرى أننا في عصر جموح الصور وانتشارها المفرط، وجدنا
أنفسنا تحت وطأة الكلمة مرة أخرى. ذلك أن ثورات مصر ولبنان وتونس وإيران
جرت أحداثها أمام الكاميرات. وحولت الصورة التي يتم بثها إلى العالم كله
بعد لحظة البث المباشر إلى حدث حقيقي، لتنزع عنها كل صفاتها كصورة. ذلك أن
الكلام الكثير الذي قيل وتناثر حول الثورات الأربع استند إلى صور قليلة
جداً، كانت الشاشات تكرر بلا انقطاع عدداً محدوداً من صور القمع، رغم
وفرتها طبعاً، لكن مقارنتها بالكلام الذي قيل عن ثورة مصر والتحليلات التي
قدمت لهذه الثورة، بل وأيضاً الوقت الذي صُرف في الإدارات السياسية والخطب
والمؤتمرات الصحافية التي عقدها المسؤولون في العالم أجمع أوفر بما لا يقاس
من حجم الصور. وبمقارنة سريعة مع أحداث سابقة تم نقلها على الشاشات يمكن
إدراك هذا االفارق اللامع، ففي حرب لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008 كانت
صور الموت تتوالد بلا انقطاع على مدى أسابيع طويلة وممضة، لكن الخطب
السياسية التي خرج بها أطراف هاتين الحربين كانت تشبه التكرار الرتيب لصوت
البكاء والنواح: موت عميم ودم يسيل كشلالات لكن الخطاب السياسي لم يكن يقول
أكثر من ترجيع خالص للكراهية والحقد بين معسكرات الصراع. بالمقابل وخصوصاً
في الثورة المصرية لم يكن في وسع أي محطة تلفزيونية أو وكالة أنباء أن
تغذي وقت الكلام عن القمع بصور كافية من دون تكرار متواتر للصور الأكثر
عنفاً أو الأكثر دلالة. لم تكن هذه الثورات حافلة بالصور لكنها كانت عامرة
بالكلام. كان دم هذه الثورات أضأل حجماً من خطابها، وكان عنفها المادي
والعاري أقل حدة من الاعتراض على العنف. ما تغير منذ حرب الخليج الأولى
وصولاً إلى ثورات اليوم كان أبعد كثيراً مما قاله بودريارد في حرب الخليج
الأولى بداية التسعينات، يمكن الحكم ببساطة اليوم أن هذه الثورات حدثت
لأننا رأينا صورها على الشاشة، وليس العكس. لكن هذه الصور التي لا تستطيع
أن تكذب على ما تقول السي أن أن، لم تعد تستطيع أن تتواتر من دون انقطاع
مثلما كانت من قبل من دون أن نصرف النظر عنها، بمعنى أننا كنا نحتاج إلى كم
قليل من الضحايا ليتسنى لنا التفكير ولا تبهظنا أعداد القتلى الهائلة فلا
نعود نجيد غير الصراخ والبكاء أو حتى في أحسن الأحوال كتابة ملاحم الرثاء.
الذي تغير منذ حرب الخليج الأولى (عاصفة الصحراء) أن الصورة التي لا تستطيع
ن تكذب أصبحت فعلاً قرينة إثبات، هكذا لم نعد نستطيع أن نصور كيفما كان،
لأن الصورة لم تعد تأبيد لحظة عابرة، بل صارت الصورة حدثا مكتملاً في حد
ذاتها. بمعنى آخر لم يحدث قمع في مصر يفوق الوصف مثلما نعرف القمع أو نقرأ
عنه، كما حدث في عهد ستالين مثلاً أو هتلر أو كما حدث في مدينة حماه
السورية في بداية ثمانينات القرن الماضي، حيث قصفت المدينة عن بكرة أبيها
وحتى اليوم لا يستطيع أي كان أن يحصي الضحايا الذين ذهبوا ضحية القمع
الدموي الذي مارسه نظام حافظ الأسد يومها بحق شعبه، وإن كانت أكثر
التقديرات تسامحاً تشير إلى عشرات الألوف. اليوم لا يمر مثل هذا القمع أو
الأقل منه من دون حساب عسير. هذا في السياسة، لكنه أيضاً متعلق بالتغير
الكبير الذي طرأ على الصورة وتحولها من تعليق على الحدث إلى حدث في حد
ذاته. تقنياً كان المصور يلتقط مئات الصور لوجه واحد ثم ينتقي منها عددا
قليلا لعرضه، لأن الصورة هي تعليق على الوجه المصور، اليوم كل صورة مهما
بلغت رداءتها تعرض مئات المرات لأنها أصبحت حدثاً في حد ذاته، ذلك أنها
فريدة ولا مثيل لها ولم يصورها المصور من زوايا متعددة، لهذا هي مفاجئة ولا
تتكرر مثل الحدث وليست منتقاة ومرتبة ومتموضعة مثل الصور. وبات المتظاهر
لا يخرج إلى التظاهرة من دون أن يضمن توثيق الحدث تصويراً من خلال هاتفه أو
كاميرته الرقمية ومن ثم بثه إلى العالم الذي يشاهده ألوف المرات. كانت
الصور أقل عدداً من حجم الثورات ونتائجها، ذلك أن الأحداث نفسها كانت أقل
هولاً من مترتباتها التي نجمت عنها، لهذا تحولت الكلمة مرة أخرى إلى أداء
وظيفة التعليق على الحدث، وعلى صور لا يتجاوز وقتها الساعات القليلة من
الثورة المصرية مثلاً وبعضها تم بثه مئات المرات، قيل كلام كثير ومتنوع ولا
يمكن الإحاطة به، تحليلاً وتدقيقاً وأحكاماً وتوقعات.
هكذا يمكننا القول أن الكلمة التي من صفاتها أنها بالأبيض والأسود انتصرت
على الصورة التي من صفاتها أنها مكتملة الألوان، هذا الانتصار حدث نوعياً
وكمياً، فمن جهة أولى كان الكلام رغم عدم نضوج الخطاب السياسي أوفر بما لا
يقاس من الصور القليلة، ومن جهة ثانية كان الانحياز واضحاً منذ البداية،
إلى حد أن أحداً لم يناقش إذا كان مطلب المتظاهرين رحيل زين العابدين بن
علي عن البلاد والسلطة وملاحقته مع أقاربه مطلباً عادلاً ومنطقياً ويوازي
حجم الجرائم التي اقترفها. في ثورة لبنان كانت هذه المسألة أوضح بما لا
يقاس، نزل اللبنانيون إلى الساحات وطالبوا برحيل النظام، وحيث أن عمدة
النظام الذي كان قائماً هناك، كان مستنداً إلى جيش وأجهزة أمن خارجية، (
الجيش السوري ) فإن المطالبة برحيله بدت منطقية وشرعية. لكن ما حدث بعد ذلك
لم يكن إلا انهياراً كاملاً للنظام وتسيد الطوائف وقادتها على المشهد
العام، ذلك أن الدولة المستبدة التي صنعتها أجهزة الأمن السورية في لبنان
انهارت انهياراً كلياً ولم يبق ثمة ما يمكن أن يستند إليه اللبنانيون غير
البنى الطائفية التي تتخلف عن منطق الدولة والحداثة زمناً وسياقاً. في مصر
وتونس وإيران كان المتظاهرون يطالبون برحيل فئة من النظام دون غيرها. منذ
البداية اختاروا الانحياز إلى جهة من جهات النظام وقاتلوا الفئة الأخرى،
هزموا في إيرن ونجحوا في مصر وتونس. لكن الثابت أن هذه الثورات لم تحدث
تغييراً كبيراً في النظام، لأنها إن غامرت بمثل هذه المطالب، فإنها كانت
ستقع حكماً في هوة الفراغ اللبناني.
الأرجح أن السبب الكامن في تردد الثوريين اليوم في رفع مطلب التغيير
الشامل يعود إلى ضحالة الأفكار التي حركت هذه الثورات. كانت هذه الثورات في
كل مكان تريد تغيير حال السكون إلى حال متحركة، لكنها لم تستطع أن تخرج من
شكل هذا المطلب إلى معناه. ما الذي يعنيه أن نطالب بانتخابات حرة في مصر
في وقت نؤبد فيه أهلية الجيش وأجهزته على حفظ النظام وضمان المستقبل؟
الأرجح أن مثل هذا المطلب كان يعني في عمقه، أن المطلوب هو إحداث حركة
سياسية واجتماعية على سطح الحياة السياسية والاجتماعية الراكد. بشرط أن
يبقى الاستقرار مصاناً عبر الجيش الذي نزه في حالتي تونس ومصر وأيضاً في
لبنان إلى حد ما عن كل خطأ أو خطيئة. وهذا يقودنا إلى التفكر في التحولات
التي طرأت على معطيين أساسيين: المعطى الأول متعلق بهشاشة الديموقراطيات
وقدرتها المحدودة جداً على مواجهة الأزمات الطارئة، مما حدا بهؤلاء
الثائرين إلى استلهام النموذج الأميركي في توليد ديموقراطية ذات مخالب
وأنياب، والثاني يتعلق بحجم الاسئلة المطروحة على مستقبل المنطقة العربية
في ظل هيمنة فلسفات الحداثة على المنطقة من دون رادع أو منافس حقيقي.
في المعطى الأول يمكن أن نلاحظ أن الديموقراطية الأميركية هي الديموقراطية
الوحيدة في العالم التي تستطيع الدفاع عن نفسها بالقوة، وكثيراً ما يناط
بها الدفاع عن أنظمة ديموقراطية عريقة في أوروبا وسائر العالم. ومرد ذلك
على الأرجح أن الديموقراطية الأميركية تنبى على طبقتين أساسيتين، طبقة تمثل
المواطنين في عموم الولايات المتحدة، الذين يعيشون في دول شبه مستقلة
لكنها ليست معنية بشؤون الدفاع والسياسات الخارجية والاقتصاد الكلي، وطبقة
تمثل موظفي السلطة الفيدرالية والشركات العابرة للولايات والقارات أحياناً.
ديموقراطية كاليفورنيا أو فرجينيا أو نيوجرسي تشبه ديموقراطيات فرنسا أو
ألمانيا أو أسبانيا، لكن السلطة الفيدرالية في الولايات المتحدة لا تمت
بكثير من الصلات إلى هذه الديموقراطيات. ذلك أن المرء لا يستطيع الانتماء
إليها إلا بعد الخضوع إلى امتحانات في السلوك والأهلية والجدارة والتاريخ
الإجرامي والسياسي والعقائدي. وهذا يعني أن ليس ثمة شعب تنظر هذه السلطة في
مشكلاته، فهذا يقع عموماً على عاتق حكومات الولايات، والحال لدينا دولة
فيدرالية وشعب من الموظفين. هذا من جهة أولى، ثم أننا من جهة ثانية نلاحظ
أن السلطة الفيدرالية تقيم منشآتها السياسية على أرض مستأجرة، المدينة
الوحيدة التي تعود مكليتها إلى هذه السلطة هي مدينة واشنطن، وهي مدينة
يتغير معظم سكانها مع تغير المقيم في البيت الأبيض، وتالياً ليس ثمة شعب
مقيم بصورة دائمة على أرض هذه المدينة. أما القواعد العسكرية وثكنات الجيش
ومراكز الاستخبارات فتقام أيضاً على أراضي الولايات أو في قفارها على وجه
التحديد وفي عرض البحار والقواعد العسكرية المقامة في ارجاء العالم الواسع،
وتالياً لا تستطيع أي دولة في العالم أن تواجه دولة لا تقيم على أرض محددة
بحدود وتهزمها، كما أنها لا تستطيع ان تهزم دولة بلا مواطنين، وكل
مواطنوها هم موظفون يخضعون لعقود العمل وليس لقوانين الجنسية، يبقى أن
الشركات العابرة للولايات والقارات في أميركا هي شركات متحركة على الدوام،
فد أكس تجول في أجواء العالم، أما شاحناتها فتواصل السير من دون انقطاع من
شواطئ المحيط الهادئ إلى شواطئ الأطلسي شرقاً وغرباً ومن شواطئ لويزيانا
الهشة إلى شواطئ البحيرات الكبرى وشواطئ ماين الصخرية. إنها أمة على دواليب
ولا يمكن إصابتها في مقتل أو موضع. والحال، تقليد الديموقراطية الأميركية
في مصر مثلاً يستوجب فصل فئة من المجتمع عن حقوقها في المواطنة ودفعها
دفعاً إلى أداء وظيفة أساسية وهي حماية حدود الأمة في الداخل والخارج، وهي
مهمة الجيوش بطبيعة الحال.
مصر وتونس وإيران ولبنان من الدول التي تعلقت بأهداب الحداثة الغربية في
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، في هذه الدول تم التخلي عن
الزي الوطني مثلاً واستبدل بالزي الغربي، وهذا من الأمور التي لم تحصل في
الهند أو باكستان أو في الخليج العربي. ونخب هذه الدول بين دول أخرى طبعاً
كانت ترى في الديموقراطيات الأوروبية مثالها الأعلى. لكن ما حدث أن
الديموقراطيات الغربية في أوروبا أثبتت عجزها عن حماية منجزاتها وبقيت طوال
القرن الماضي أو في حربيه الكبيرتين تعبر عياناً عن هذا العجز، ففي
الحربين حدث أن أميركا هي من هزم خصومهم مع مشاركة فاعلة للاتحاد السوفياتي
في الحرب الثانية.
إذاً كان لا بد أن ينهار النموذج الأوروبي بوصفه ليس نموذجاً قادراً على
الصمود، وأن يحل محله على التوالي الاتحاد السوفياتي والأفكار الماركسية
منذ خمسينات القرن الماضي وحتى تسعيناته وأن تتصدر أميركا منذ عقدين على
الأقل صلة هذا العالم المتوتر والحافل بالمشكلات المستعصية بالحداثة على
نحو ما.
المعطى الثاني يتعلق بحيوية الأسئلة المطروحة على هذه المجتمعات وصعوبة
إيجاد الأجوبة لها. وهذا على الأرجح ما جعل الثورات الحديثة تنطلق من هذه
المنطقة من العالم دون غيرها. ذلك أن الحداثات الغربية قامت في أصل نشوئها
واستقرارها على تجانس مطلق، إذ لم تتسع الحداثة الغربية – الأوروبية
تحديداً، للمختلف دينياً وعرقياً وقامت ثوراتها أصلاً وأساساً استناداً إلى
العلاقة مع الكنيسة الكاتوليكية، اعتراضاً عليها وتأييداً لها. ونظراً
لكونها استندت إلى الكنيسة الكاتوليكية على الأغلب الأعم، فإنها عجزت عن
معالجة مسائل الأقليات الدينية والأتنية عجزاً مطبقاً، فكان أن هاجر اليهود
الأوروبيون سياسياً وقانونياً ومواطنة إلى إسرائيل، وطبعاً لم تتسع هذه
الديموقراطيات للمسلمين الذين ما كانوا يشكلون يومذاك تحدياً داخلياً.
وعليه تم تصدير التنوع الذي يؤدي إلى الاضطراب إلى منطقة الشرق الأوسط،
لتشكل هذه المنطقة منذ ولادتها ما يشبه مكب نفايات الحداثات الغربية. على
أي حال بروتستانت أميركا تم تصديرهم إلى العالم الجديد قسراً على نحو ما،
وهناك بنوا ديموقراطية متجانسة، لكنها هذه المرة استندت على الكنيسة
البروتستانتينية وليس على الكنيسة الكاتوليكية.
اليوم ثمة مشكلات كثيرة تحف بالديموقراطيات الغربية وتواجهها من كل جانب،
لكن المشكلة الأكبر تقع في الأصل والأساس في منطقة الشرق الأوسط. فهناك
يجدر بالنخب الاجتماعية الجديدة اجتراح الحلول الديموقراطية الأكثر ملاءمة
للمحافظة على التنوع الديني والأتني والثقافي، لأن تفاقم هذه المشكلات
واستمرارها قيد التداول اليومي سيعيد هذه المنطقة برمتها إلى عصور الظلام.
أليس هذا ما اقترحه أسامة بن لادن حين افترض أن مقاومة الهيمنة الأميركية
تكون بعودة المسلمين إلى العيش في الكهوف والخروج من المعاصرة خروجاً
كاملاً وحاسماً؟ لا شك أن وجود شاينا تاون في نيويورك يعبر عن عجز
الديموقراطية الأميركية عن دمج الصينيين الوافدين في المجتمع الأميركي،
وكذا الامر بالنسبة لجزائريي باريس أو هنود لندن أو إيرانيي لوس أنجلس، لكن
المشكلة في هذه المدن ليست متفاقمة على النحو الذي ينذر بالخطر، ذلك أن
الخطر الحقيقي يقع في منطقة أخرى من العالم، في الشرق الأوسط تحديداً، حيث
يتوجب على نخب هذه المنطقة أن يبتكروا نظاماً ديموقراطياً يتسع لكل الطوائف
والأتنيات من دون أن تشعر أي فئة أو طائفة من هذه الطوائف أو الفئات
بالغبن السياسي أو القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
لهذه الأسباب تقوم الثورات في تلك المنطقة عياناً، ولهذه الأسباب أيضاً
تجد هذه الثورات نفسها بلا أفكار. ذلك أن المهمة الملقاة على عاتق هذه
الفئة الاجتماعية التي تملك اليوم الموارد التي تؤهلها لقيادة مجتمعاتها
بالغة الصعوبة، ولا ينفع في حلها الأفكار المجردة بل على هذه الفئة أن تثبت
بالسلوك اليومي في ثوراتها وفي إقامتها في هذه الثورات أنها قادرة على جعل
التنوع ثقافة حياة.
في لبنان احتشد شباب لبنان في ساحة واحدة لأنهم كانوا يريدون التعرف على
بعضهم بعضاً بعدما فرقت الحرب الأهلية في ما بينهم، وفي مصر قامت الثورة
بعد وقت وجيز من تفجير كنيسة الإسكندرية التي بدت كما لو أنها إنذار
لاندلاع صراع أعمى ومسلح بين الأقباط والمسلمين، وكان لافتاً على نحو حاسم،
رغم كل ادعاءات السيد خامنئي وتمنياته، أن ثوار مصر لم يهاجموا السفارة
الإسرائيلية أو الأميركية ولم يعتدوا على أجنبي واحد. ألم ترفع ثورة إيران
شعارات من قبيل: أوقفوا دعم حزب الله في لبنان؟