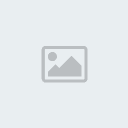
البدايات
المظلمة؟ عنوان كتاب لكارل هاينس اوليغK. Ohlig (1) من جامعة سارلاند ـ
ألمانيا، والذي يقود نخبة من باحثي تاريخ الأديان، من أمثال غيرد بوين
G.R. Puin المدير السابق لفريق البحث في المخطوطات القرآنية التي عُثر
عليها عام 1972في جامع صنعاء الكبير، ولكسنبرغ C. Luxenberg صاحب القراءة
الآرامية للقرآن، وفولكر بوب V.Popp الباحث في تاريخ المسكوكات والنقوش
القديمة، ويهودا بيفو، ويوديت كورين وغيرهم، والهدف هو البحث والتنقيب في
ماضي الإسلام المبكر. وإزاحة ركام الأسطرة عن تلك الحقبة من القرن السابع
ميلادي. حيث أن نجاح دراسات أركيولوجيا الكتاب المقدس، وكشف أسطورية عصر
الآباء (من إبراهيم إلى سليمان) وخلخلة البناء اليهو ـ مسيحي، بدأ يُغري
بتطبيق تلك المناهج النقد ـ تاريخية على الإسلام. من خلال مراجعة لأهم
المصادر والنقوش الكتابية المبكرة. وتأويلها بمعزل عن قسر وإرغام دلالات
التراث الكتابي الإسلامي، الذي أصبح بنظر البعض مجرد أدب ديني وليس تاريخا
بالمفهوم العلمي لكتابة التاريخ. وقبل التعرض للتفاصيل وإبداء الرأي أجد
ضرورة للتوقف عند بعض المفاصل النقدية، التي تمهد وتعترض بآن معاً طريق
هذه الرؤى الجديدة.
في مطلع القرن 19 أعرب الباحث بتاريخ الإسلام غوستاف فرايتاغ (1788ـ
1861) عن عدم ثقته بأخبار الموروث الإسلامي ووصفها بالمكذوبة والملفقة،
خصوصا تلك التي تناولت الطقوس الوثنية حول كعبة ما قبل الإسلام، فالروايات
عن أصنام البانثيون المكّي، حملت الكثير من التناقضات، سيما وأن المكان
تحوّل بعدها إلى شعيرة إسلامية (بأوامر إلهية؟!)، ناهيك عن تعارضها مع روح
القرن السابع م. وإجتياح التصوّرات اليهو ـ مسيحية للمنطقة، والتي أبطلت
عبادات التماثيل الحجرية منذ زمن طويل، وأيضا فيما يكشفه الموروث الإسلامي
من إرتباك عند حديثه عن الأحناف والشعر الجاهلي، وما تضمنه من أفكار
قرآنية مباشرة، تصل أحياناً حد التطابق في العبارة والدلالة، ناهيك عن أن
فضاء الخطاب القرآني يعكس صورة عن جدل حاد بين أهل الكتاب، ممزوج بمرارة
الشكوى، ولا يعكس جدلاً مع عبَدة تمائيل حجرية كما أراد الموروث أن
يوهمنا. ولعل تحوّل الكعبة إلى طقس إسلامي، دليل دامغ على زيف تلك
الإدعاءات.
في نهاية القرن 19 حاول كارل فولر ورودلف غاير تفحّص التاريخ التحريري
للقرآن، وإعادة بناء لبعض المقاطع الشعرية في السور القصيرة المقفاة،
وإفتراض وجود نص قرآني قديم تم طمسه معالمه فيما بعد، وتحويل مضمونه ليمنح
ترابطا جديدا للمعنى الديني ـ التاريخي، وهذا ما تابعه غونتر لولينغ
G.Lüling (2) في سبعينيات القرن20 بإفتراضه أن تلك السور هي صلوات طقسية
ونتاج أدبي يعود للمسيحية السورية. ثم أعقبها بدراسته عن الكعبة ومراحل
تطور بنائها في أزمنة مختلفة (3) وتعقّب إشارات الموروت الإسلامي التي
دلّت على وجود رموز مسيحولوجية داخل الكعبة تم إزالتها بعد فتح مكة، وكذلك
الروايات عن وجود ستة أعمدة حملت سقفها الخشبي (حاليا ثلاثة) والتي كانت
مصطفة على خطين متوازيين بحيث أتاحت للمصلّين آنذاك بالإتجاه نحو الحُجر
(وبالتالي نحو القدس) وكما يُستدل من الموروث فإن هذا الحُجر (حاليا محاط
بجدار قوسي قليل الإرتفاع) كان أيام الجاهلية وزمن عبدالله بن الزبير
مسوّراً بجدار عال مسقوف ويتصل فضاؤه بداخل الكعبة ويقوم بدور مذبح
الكنيسةAltar . وبهذا أعلن لولينغ أن الكعبة كانت كنيسة مريمية؟! وأن
اللات والعزة ومناة لسن سوى مريمات عربيات، وأن الصراع لم يكن مع كفار
قريش بل مع قريش مسيحية بيزنطية، تناقضت أقانيمها الثلاثة مع الكنيسة
السورية التوحيدية (التي ضمّت أتباع الطبيعة الواحدة في كنيسة الغساسنة،
ذات التقاليد التوراتية، المشبّعة بالعداء لبيزنطه ومؤتمر نيقيا)
وهكذا جاء بإطروحة مركزية مفادها أن دعوة القرآن للعودة إلى دين
إبراهيم وإسماعيل هي على المستوى الرمزي، عودة إلى الإله البدئي Pagan
للجزيرة العربية وتجلياته في جذور اليهو ـ مسيحية، حيث كان الإله يسمع
مناجاة إبراهيم ويقسّم له تخوم أرضه، وهذا قد جرى طمسه في المرحلة المابعد
نبوية، وبالتالي طمس صورة الأعداء الذين حاربهم الإسلام المبكر، والذين
كانوا من أتباع المسيحية الهلينية (قريش) إذ تم وُصمهم بعبادة الأوثان
والإشراك، وهم بالحقيقة من أتباع الأقانيم الثلاثة ومقدسي الأيقونات
والصور، وهذا الطمس والتعتيم جاء لتجنيب الإسلام الفتي صداماً لاهوتياً مع
يهو ـ مسيحية ذات تراث كتابي لاهوتي واسع، وكأن الإسلام قرر حينها أن يخسر
على الطاولة ما ربحه في ساحة الحرب، والقول هنا لغونتر لولينغ
لكن الإضاءة المهمة حول تاريخ مكة كان قد قدمها راينهارد دوزي عام
1864في كتابه "الإسرائيليون في مكة" والتي رفضها (عمدة الإستشراق)
فلهاوزن، مع أنها فتحت الطريق أمام دراسات التوراة، سيما وأن جغرافيا
فلسطين باتت تُكّذب نشوء الحدث التوراتي لعصر الآباء على ربوعها؟! وفكرة
دوزي قالت بأن مكّة هي التي ذكرها مدوّنو تاريخ الأنتيكا حتى القرن الثالث
م. بإسم "ماكاروبا" ووردت في العهد القديم "ماكاروبا" بمعنى "ميدان
المعركة الكبير" ثم إختُصر الإسم بإزالة الصفة "روبا" (كبير) لتبقى ماكا:
ميدانا للصراع. ثم يشير إلى ما ذكرته التوراة عن خروج سبط شمعون من رابطة
القبائل الإسرائيلية زمن داوود (حوالي 1000 ق.م) وإستيطانهم أرض الحجاز،
الأمر الذي دفع المحرر التوراتي بعد السبيّ، لنعت هؤلاء الشمعونيين
بالإسماعليين (لاحظ التشابه بين لفظي شمعون وشمعيل) حيث إعتبرهم أقارب
غرباء (من هاجر وإسماعيل) وهناك من يجزم بأن قصة إسماعيل وأمه هي حشو
متأخر في سياق الرواية التوراتية، واللافت كانت العلاقة التي وجدها دوزي
بين صنمي الصفا والمروة "إساف ونائلة" وبين لفظين آراميين: "آسوف ونوالي"
بمعنى: مزبلة أو مكان رمي الفضلات، والقصد هنا أن الصفا والمروة كانت
أماكن لرمي بقايا الذبائح والقرابين التي كانت تُنحر حول الكعبة. ثم دُعمت
أفكار الهولندي دوزي بأبحاث فريتز هومل مطلع القرن 20 المعززة باللقى
الأثرية المسمارية من منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية (جنوب العقبة)
حيث تشير النقوش إلى أن تلك المنطقة (الشمعونية/الإشماعيلية) كانت تسمّى
لغاية القرن السابع ق.م "مصر"، الأمر الذي دعى هوغو فنكلر للقول بأن مصر
(جنوب العقبة) إلتبست دلالتها على جيل ما بعد السبي وأصبحت تسمى: مصراييم
التوراتية أو مصر الحالية (أم الدنيا). فالميول الحديثة للبحث التوراتي
تذهب أيضا إلى أن أسطورة الخروج بقيادة موسى هي قصة متأخرة، أقحمت على
السرد في زمن متأخر.
إن ربط مصر بلفظ المديانيين (سكان شمال غرب شبه الجزيرة) هو أقرب لفهم
مخطط الجغرافية التوراتية، وهذه الصورة تتناغم مع الإيحاءات القرآنية التي
تصوّر الأنبياء بقبيلة ميثولوجية ليس بعيدة زمكانيا عن فضاء الحجاز.
وتنسجم مع قصص الموروث الإسلامي عن هجرتين لقبيلة جرهم وتقاليدها اليهودية
وإستيطانها حول مكة، والذي حصل بالتوازي مع حكاية تدمير المعبد الأورشليمي
في القرن السادس ق.م والأول م (بالمعنى الرمزي وليس التاريخي)
أما النقلة الثانية في الموضوع فيأخذنا إليها الباحث الفرنسي المعروف،
رونالد دوفو R. De Vaux (إرتبط إسمه بمخطوطات قمران) ففي كتابه "اللاويّة
المعينية" يكشف النقاب عن لاويين في مدينة معين (مصران) شمال اليمن، وعن
إلتباس وغموض دور اللاويين في السرد التوراتي الذي إعتبرهم سبطاً إضافيا
لإنقاذ الرقم 12 بعد دمجه لسبطي منسي وإفرايم في سبط يوسف. إضافة لتصويرهم
بمثابة كهنة جوالين لم يشملهم توزيع أراضي التوراة كبقية الأسباط. ولابد
أن اللاويين قد عانوا أثناء الإصلاح الديني لملك يهوذا يوشيا ( 609ـ
640ق.م) الذي قام بمركَزة العبادة والطقوس في معبد أورشليم، وتحريم وجود
معابد أخرى في أرجاء البلاد، فضاقت حياة هؤلاء (الكهنة) اللاويين
المتجولين، الشيئ الذي نسمع صداه في سفر عزرا (19: 8ـ 15) حيث يروي أن عدد
اللاويين العائدين من السبيّ البابلي كان معدوماً (عائلتان فقط)، والعجيب
كانت أخبار التلموذ التي ذكرت أن نبوخذ نصر (605ـ 662ق.م) قام بترحيل
ثمانين ألف من فتيان اللاويين إلى الجزيرة العربية.
وفي كتابه "محاضرات نقدية في نشوء المسيحية 1906" خصص برنهاد كيدرمان،
فصلاً عن المعينين (عرب الجنوب) وقال بأنهم المينيم Minim، إحدى الفرق
اليهودية المهرطقة التي إنتشرت في كل العالم القديم، وهم من كتب عنهم
هيرونيموس أحد آباء الكنيسة قائلا: لقد لعنت الكنيسة هؤلاء
المينيم/المعينين في وصيتها الثانية عشرة ومعهم أيضا لعنت النوصيريم
Nuserim (النصارى؟!) وتمنت أن تُنتزع أسماؤهم من كتب الأحياء وأن لا
يُدوّنوا في كتاب العدالة. الباحثون اليهود قالوا إنهم عبارة عن مسيحيين
يهود، أما الباحثون المسيحيون فإحتجوا على وضعهم في خانة النوصيريم،
فالتراث الرابيني اليهودي ينظر إلى هؤلاء المينيم/المعينين كإسرائيليين
رفضوا التوحيد وإعتقدوا بآلهة متعددة.
ويمكن التصورّ بأن المعينيين قد أغضبوا الأرثودوكسية اليهودية إبان
الحقبة المقدونية، وهم عبارة عن "تجار بخور" عاشوا عصراً ذهبيا في جنوب
الجزيرة العربية، وملكوا تقاليد مشابهة لقبيلة جرهم، أي أن هؤلاء الهراطقة
اليهود سواء كانوا
(مينيم/معينين/لاويين/شمعونيين/إشماعليين/ جرهميين) قد ورثوا تجارة
البخور العالمية من العماليق (هوبرت غريم قال عام 1904 بأن إشتقاق إسم
العماليق حسب اللغات المسمارية يعود ل"مِلوخقا" Melukhkha ويعني: تجار
البخور) فكل تلك المُسميات مرادفات لغوية لمجموعات إنتشرت بين حضرموت
وقتبان، وإحتكرت تجارة البخور وسيطرت على طرق القوافل مع مصر واليونان
وبلاد النهرين، عبر الجزيرة العربية (مرورا بمكة، جدة، جزيرة الفيلة
بإتجاه قرطاج أو عبر العريش بإتجاه سيناء) ولابد أن تنظيماً قبلياً قد
ربطهم خلال مئات السنين، ومكنّهم من إقامة مستعمرات تجارية في جزيرة
الفيلة وقرطاج، وهذه الرابطة يمكن فهمها من خلال قانون الدم (العصبية)
القبلي، الذي حددته آنذاك السمات السياسية الإجتماعية والدينية لمنطقة
الجزيرة العربية. والذي يقوم على مبادئ: الحُرّمة وحق الضيافة، ونظام
الدخيل، فهي الضمان الوحيد للسفر وسلامة القوافل. وهذا يشرح أيضا كيف أن
اللاويين أو السبط 13 الذين نُذروا للمعابد وقبلوا أفكار موسى المصري
(بمعنى:المدياني) وحوّلوا ديانات الخصب إلى عقيدة يهوى الرب، قد إضطروا
للرحيل والهجرة، بعد (تأميم) الملك يوشيا للمعابد وحصر طقوس العبادة في
المعبد الأورشليمي. الهجرة إلى أين؟ إلى جزيرة العرب، إلى حيث يحميهم
قانون الدم القبلي ونظام الدخيل، الذي يتيح تبني وحماية الغرباء.
هذه المقدمة المطوّلة، هي خلاصة لبعض أطروحات لولينغ (4) وتعكس إهتمامه
بدراسات أنتربولوجيا التاريخ لليفي شتراوس، وعدائه للإستشراق الكلاسيكي
الذي مثّله يوليوس فلهاوزن. وقد إخترتها كمقدمة لا غنى عنها، في الحديث عن
بدايات الإسلام، خصوصا وأن مجموعة باحثي "البدايات المظلمة" تجاهلوا دور
الحجاز ومكة كلياً وأغفلوه، ونقلوا مسرح الحدث الإسلامي المبكر إلى الشمال
حيث تُركت وقائعه تدور على مساحة جغرافية تمتد بين سوريا وفارس الساسانية.
وهذا الأمر يجافي الواقع، رغم مافيه من حجج منطقية، فالسياق التاريخي
العام يوحي بأن الحجاز كان أحد المراكز الدينية المهمة لليهو ـ مسيحية
القديمة، وربما تزداد أهميته حالياً بسبب فشل البحث الآركيولوجي في تحديد
جغرافية عصر الآباء. ومن جهة أخرى فإن هذه الجماعة اوليغ/بوين، لا تفسر
لنا هذا الكم التدويني الإسلامي الكبير (السردي، والفقهي) الذي أنتجه
القرن التاسع ميلادي، فحتى لو إفترضنا بأسطرة روايات الموروث الشفهي،
فلابد من وجود فضاء عقلي ما خلف تلك الروايات. ومن المحال أن تُنتَج من
العدم. لكن قبل إبداء الرأي النقدي بعمل اوليغ.. أقدم فيما يلي ملخصا
لآرائه كما وردت بخط يده (5) أثناء حملة الترويج لكتابه عام 2005:
يقول اوليغ: من السائد والمعروف أن النبي محمد (570 ـ632م) وعظ بوحيّ
الله بين مكة والمدينة، ثم نجح في تحويل قبائل الجزيرة العربية إلى أمة
واحدة، تحت سلطته الدينية والسياسية، فحياته وأصله وزيجاته وآثاره وهجرته
من مكة للمدينة عام 622م. وحروبه تم تفصيلها وسردها في المؤلفات
الإسلامية. وبعد وفاته بدأت قصة النصر الديني والفكري في عهد الخلفاء
(632ـ 661م) وفي عصر الأمويين في دمشق (661ـ 750م) والعباسيين إعتبارا من
عام 749، وإنشاء بغداد عام 762م. تشكّلت دولة إسلامية كبرى.. فلماذا
الحديث إذاً عن بدايات مظلمة؟
من المعلوم أن قليلا من علماء الإسلاميات إلتفتوا إلى أن القرآن
لايُقدم أية إشارات عن سيرة محمد المكّي [هنا أرجو التعوّد على هذه
المصطلحات، التي تميز بين محمد مكّي، وبين محمد Prädikat بمعنى: شخصية
إعتبارية] فكل المعلومات عن سيرته نجدها في كتب السير لبداية القرن 9و 10
م. أولها سيرة إبن هشام المتوفي عام 768م. والتي إعتمدت سيرة مفقودة لإبن
إسحق المتوفي أيضاً عام 768م (ولا ندري إن كان ذلك حقيقة أو وهم). ثم كتاب
المغازي للواقدي (توفي عام 822م.) وكتاب طبقات إبن سعد (توفي 845م.)
وتاريخ الطبري (توفي 922م.) ومجموعة كتب الصحاح في القرن التاسع م.
للبخاري الذي توفي عام (870م.) ومسلم (875م.) وإبن داوود (888م.) والتلمذي
(892م.) والنسائي (915م.) وإبن ماجه (886م.) [شخصيا أضيف بأن أقدم
المخطوطات المتوفرة حالياً لهذه المؤلفات تعود لنهاية القرن الخامس هجري
ومطلع القرن السادس، والشيئ الغريب أن كل صحاح السنّة كُتبت تقريبا خلال
جيل واحد من الكتاب، وهذه مسألة في غاية الأهمية؟!]
ويضيف أوليغ: وبموجب النقد التاريخي فإن هذه المدوّنات التاريخية،
يُنظر لها بتحفظ، فقد جُمعت في زمن أصبح فيه محمد رمزاً لهوية إمبراطورية
قوية، وبما يوازي ذلك تمت صياغة شخصيته ونمذجتها. فالسمات المؤسطرة في
شخصيته، تفرض نفسها على أية قراءة نزيهة، لأن كثيراً من المسائل التي
طرحتها تلك المدوّنات، لم تكن ذات أهمية في ذلك العصر المُحتمل لحياة
النبي. فتلك المصادر نسبت السيرة إلى القرآن (المكي والمدني) [ بمعنى أن
تدوين القرن التاسع قام بنسج وإسقاط سيرة محمد لتوافق النص القرآني. طبعا
من خلال تأويل هذا النص، ففي القرآن لا يرد إسم محمد إلا أربع مرات ناهيك
عن غياب تفاصيل الأسماء والأزمكنة إلا بإستثناءات قليلة مثل: المسجد
الحرام ببكة، والمسجد الأقصى وأسماء قليلة أخرى، وحتى هذه يمكن أيضاً
تأوليها أثناء عملية التدوين الديني] ثم يضيف: لهذا فإن شخصية النبي
العربي من الناحية التاريخية تظلّ ضبابية، وبتعبير قاسي: إن تاريخيته موضع
تساؤل.
ثم يتعرض لمقولة رودي باريت التي إفتتح بها ترجمته الشهيرة للقرآن "لا
يساورنا شك بأن كل آية في القرآن، تعود لمحمد" فيقول اوليغ: لماذا ياترى؟
ومن أين له أن يعرف ذلك.؟ وماهي المصادر التي إعتمدها؟ فثمة تواتر واضح في
النص القرآني، وثمة تقاليد مترادفة وأحياناً متناقضة، تشير إلى أعمال
لأقلام لاحقة، وهذا تُظهره النسخ الخطيّة القديمة لصيرورة النص القرآني،
ووجود دلائل متأخرة جداً على النبي [بمعنى تأخر ظهور إسمه على النقوش
والمسكوكات] فمن غير المعقول أن يتم القفز على هذه الإشكاليات، إضافة إلى
أن القصة التكميلية للتمدد الإسلامي قد دُونت بأيدي مسلمي القرن التاسع م.
مع ندرة الوثائق من القرنين الهجريين الأولين.
وهنا يستشهد بأهم باحثي الإسلام المبكر جوزيف فان إس J. van Ess: هناك
وثائق قليلة من القرن الأول هـ، تتمثل ببعض النقوش الكتابية على قبة
الصخرة، والمسجد الأموي، وبعض المسكوكات. وكل النصوص الإسلامية مشتبه
بإسقاطها رجعيا في أزمنة لاحقة، لهذا غادر فان إيس القرن الهجري الأول
ودخل فى الثاني، وهناك لاحظ أيضا غياب الوثائق الأصلية. أي أن القرنين
الأولين مُبهمان ويقعان في ظلمة التاريخ. والسؤال: لماذا لم تترك الدولة
الإسلامية أية وثائق؟ ولماذا لم يترك خصوم العرب ورغم وجود كتاب بيزنطيين
ويهود ومسيحيين كثر، عاشوا تحت السلطة الإسلامية (المزعومة) لماذا لم
يتركوا أية وثائق؟ وهنا يشير إلى أن كتاب "البدايات المظلمة" محاولة لرسم
خطوط مسار هذين القرنين. من خلال الشواهد القليلة المؤرخة (كالمسكوكات
والنقوش). ويضيف لقد تمت البرهنة على أن هذه النقوش الكتابية على
المسكوكات وقبة الصخرة في القدس هي رموز مسيحولوجية* تخص اللاهوت السوري.
وبإختصار يقول كارل اوليغ، بأن النقوش على قبة الصخرة والمسكوكات، تدل
على محاولة مسيحية سورية لوضع حدود مع كنيسة بيزنطه ذات الأقانيم الثلاثة،
وتوثّق محاولتها الفخورة في المحافظة على هوية خاصة بها، ويضيف: لقد أصبح
واضحا بأن عام الهجرة قد إستخدمه العرب المسيحيون في حسابهم عام 622م.، ثم
جرى تحويره ليصبح إسلامياً، ولغاية القرن الثامن، كانت مناطق المشرق
العربي وشمال أفريقيا، تخضع لزعامات مسيحية، وأن الحكام الأمويين وأوائل
العباسيين كانوا مسيحيين، وحتى بداية القرن الهجري الثاني كانت الشخصية
الإعتبارية "محمد" متماهية مع صورة "المسيح"، ثم إنفصلت عنها في القرن
الثامن، حيث منحت إمكانية لنشوء هوية عربية إرتبطت بالنبي محمد بصفته
المستقلة، بعد ربطها بالمدن المقدسة العربية مكة والمدينة. وفي هذا المفصل
نشأت مؤلفات السير وكتب حديث السنّة وتواريخ الملوك وذلك بإسقاطها رجعيا
على تاريخ إسلامي متسلسل، وهذه الصيرورة المُدهشة تشبه تماما ما فعله
محررو التوراة (أسفار موسى الخمسة)، عندما أسقطوا الأحداث رجعياً على
أزمنة غابرة، ثم جرى تعليلها وتأوليها ومنحها الشرعية. ويضيف بأن نسخ
القرآن في القرن الثامن، كانت تحتوي على أخطاء كتابية، ثم إنتظرت قرناً
إضافياً لتأخذ صياغتها القانونية الإسلامية، وقد حدث ذلك في العراق وفي
محيط كتابي يهو ـ مسيحي.
ويختم بإشارته لقراءة لكسنبرغ الآرامية للقرآن، التي حاولت البرهنة على
إرتباط المباني القواعدية لعربية القرآن بقواعد السورو ـ آرامية، وكيف أن
دراسته أعطت قراءة جديدة لبعض آيات القرآن، بعد أن رفعت اللبس عن أخطاء
التنقيط وذلك بإرجاع الدلالة إلى الجذر اللغوي الآرامي. والجديد هو كشف
لكسنبرغ لأخطاء مردها إشتراك الخط العربي والآرامي في أربعة حروف هجائية،
تتشابه أو تتطابق في كتابتها (رسمها) وتختلف في نطقها (هجائها)، وأدى هذا
التشابه في رسم الحروف لإلتباس المعنى أثناء نقل وكتابة المادة القرآنية
بالخط العربي. ويختم قائلاً بأن المسيحية العربية قامت بتأليف كتابات
وشروح وتفاسير للعهدين القديم والجديد بلغتها السورو ـ آرامية تتناسب مع
رؤاها، وهذه قد نُقلت للعربية في عهد عبدالملك 705م. أو إبنه الوليد 715م.
الذي جعل العربية لغة الدولة الرسمية. وإن الإشارات التي تدل على إتلاف
النصوص القرآنية (المخالفة) وإبقاء النص العثماني، تعود للقرن التاسع م.
وتعني إتلاف النصوص السورية الأصلية، التي سادت حتى بداية القرن الثامن م.
في الجزء الثاني: أتعرض للمقولات المركزية في أطروحات جماعة اوليغ من
خلال كتابيهم: البدايات المظلمة (2005) والإسلام المبكر (2007) خصوصا ما
يتعلق بالنقوش والمسكوكات المبكرة.


