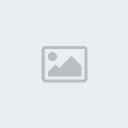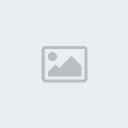
رغم تكوينه العلمي العالي واهتماماته الأكاديمية البحتة (دكتوراه في
الفيزياء الفلكية)، درس الشاب جوسلان بيزكور (1) الظاهرة الدينية دراسة
جدية بالعودة إلى مصادرها وملاحظة تجلّياتها في المجال العامّ. هو مناضل
تحرّريّ لا يهادن في مسألة العلمانية وذاك ما جعله من المتابعين
(والمناهضين) للمدّ الأصوليّ الإسلاميّ-المسيحيّ-اليهوديّ في أوروبا.
جوسلان معروف بكتاباته ومحاضراته المشرّحة لمنهج عمل الأصوليين وبتدخّلاته
الصريحة الكثيرة عبر أوروبا ضدّ تدخّل الدين في الحياة العامّة، كما يلقى
موقعه حول الإلحاد(2) إقبالا كبيرا. من كتبه 'ضدّ بنديكت السادس عشر،
الفاتيكان عدوّ الحريات' و'الكنيسة الكاثوليكية ضدّ الثورات الفرنسية
والعلمانية 1789-1905'.
في هذه المقابلة، حاولت أن أبحث معه مسألة المدّ الأصوليّ الإسلاميّ في فرنسا.
هل نعيش فعلا محاولة ممنهجة لأسلمة الجيل الجديد من ذوي الأصول العربية في فرنسا؟
لا يمكن ردّ انتشار الإسلام في فرنسا إلى مؤامرة خارجية. طبعا
لا أحد ينكر ذلك الطموح الإسلاميّ الكونيّ الغازي. فالتاريخ شاهد على ذلك
منذ 14 قرنا. في حالة فرنسا، ينبغي البحث عن أسباب أخرى أكثر عينية : لقد
استغل الحركيون الإسلاميون في دعوتهم مسألة البطالة والتمييز في مجال
العمل والسكن وكلّ ما يعانيه الفرنسيّون المنحدرون من بلدان إسلامية من
إقصاء. وكان هذا ميدانا مثاليا للمتعصّبين المسكونين بفكرة الأسلمة. وهكذا
تضاعفت القاعات السرّية للصلاة وازداد معها توزيع المنشورات المتطرّفة
وترسيخ القراءات الظلامية للدّين بشكل رهيب وترتّب عن كلّ ذلك إقبال كبير
على الممارسات الدينية الإسلامية فأصبحت اليوم أكثر ظهورا مقارنة بما كان
عليه الحال بالنسبة لأجيال المهاجرين الأولى. أصبح الإسلام موضة لدى البعض
من الشبّان يرفعونه كراية : ارتداء الحجاب بمختلف أنواعه وأشكاله.إطلاق
اللحى وبروز علامات على الجبهة أحيانا للتدليل على المواظبة في أداء
الصلوات الخمس، تغيّر ملفت في لغة الشبان وعلى سبيل الذكر تكرار كلمة
'أخي' بين جملة وأخرى. وقد امتدّت عدوى الموضة إلى غير المسلمين وبدأنا
نرى بعضهم يتحوّلون إلى الإسلام ويصبحون أكثر حماسة في إظهار خضوعهم
الروحيّ. ويبدو أنّ جزءا كبيرا من المنقّبات ومرتديات البوركة هن من أصول
أوروبية التحقن بالإسلام مؤخّرا. ويتمّ كل هذا تحت خدعة كبيرة يتمّ عبرها
تقديم الشعائر الدينية على أنها ثقافية : بدأ صوم رمضان يتحوّل شيئا فشيئا
إلى واقع مجتمعيّ فقط، ولا أحد يشير إلى الألم المسلّط على الجسد (إثبات
الإيمان عن طريق إماتة البدن) ولا عن تعارض الصوم مع النشاطات المهنية
(انخفاض الإنتاجية)، ولا عن أخطاره على الصحة (خطر ارتفاع نسبة السكر في
الدم عند الإفطار)، خطورة سياقة السيارة في حالة صوم (الإنهاك الجسدي)
وغير ذلك من الأشياء الأخرى السلبية.
تتمّ عملية الأسلمة أيضا عن طريق الضغوطات التي يتعرض لها
الفرد من طرف الأقارب: نظرة العائلة، الأصدقاء، الجيران.. فضلا عن
تهديداتهم المحتملة، كل هذا يقنع الذين يبدون بعض تردد أو تحفظ حيال
الانخراط في عملية التمظهر الإسلامي. لكنّ الأخطر والمأساوي هو تلك
الأسلمة التي ترتكب في السجون الفرنسية حيث يجد بعض المساجين أنفسهم
مضطرّين إلى الدخول في الإسلام وآخرين للعودة إليه تحت ضغوط متعصبين
خطرين. وهنا نكون أبعد ما يكون عن موضة : "هذا من حقّي، هذا من اختياري" :
وإنما هو انضمام قسريّ إلى مشروع سياسيّ شموليّ وطريقة تطبيقه العنيفة.
كيف يتدخل
المُؤَسلِمون أو الذين يتولون مهمة الأسلمة في فرنسا كمسجد باريس وليون،
والجمعيات الإسلامية كــ 'اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا' وغيرها …
يدخل تحت تسمية المُؤَسلمين كما تسمّيهم كلّ هيئة أو فرد يعمل على نشر
الإسلام. وبما أنّ التوسّع من طبيعة الإسلام، فإنّ المنظّمات التي تنضوي
تحت لوائه تتصرف كجندي مطيع في خدمة قضيته الكبرى. ينقسم المؤسلمون إلى
ثلاث مجموعات : المساجد، الجمعيات، المحاضرون. باجتذابها للأفراد وتعويدهم
على ارتيادها، تعتبر المساجد بمثابة الداعي والناشر الأوّل للإسلام في
فرنسا. فمسجد عمر في حيّ بارباس بباريس ومسجد الفتح وكذلك مسجد خالد بن
الوليد، مساجد تغذّي تعصّبا يمكن قياس شدّته وملاحظة شراسته كلّ يوم جمعة
حيث تغلق الشوارع من طرف مئات المصلّين. في سنة 2005 راح رجل في مسجد عمر
ضحية عملية ادعى أصحابها انتشال الشيطان من جسده. عشر سنوات قبل ذلك تمّ
اغتيال الشيخ عبد الباقي صحراوي، أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الإسلامية
(الجزائر) في قاعة صلاة مسجد خالد بن الوليد. وعلى الرغم من ادّعاء
الانفتاح وتنظيم اللقاءات الثقافية، لم يتوان مسجد الدعوة الكائن بشارع
طنجة من دعوة مُنظّر متعصب للجمود مثل هاني رمضان. أمّا مسجد باريس تحت
زعامة دليل أبو بكر فهو اختار الخنوع أمام السلطة، ويمكن أن نتحدّث بشأنه
عن إسلام تابع يمارسه معتدلون مزيّفون أو بالأحرى هم رجعيون حقيقيون. وإذا
كان مسجد باريس عبارة عن ملحق لسفارة الجزائر، فلا يتأفف مسؤولو المساجد
الأخرى في حضرة البترودولارات، فأثناء الجولة التي قام بها السعودي عبد
الله تركي سنة 2002 عبر التراب الفرنسي سارع كثير منهم نحو الرأسمالي
الورع للحصول على نصيب من القفة البترولية.
من بين الجمعيات الإسلامية الكثيرة العدد والمتزايدة باستمرار
فرض 'اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا' نفسه كأهم جمعية موحدة ويعتبر
ملتقاها السنوي عملية ضخمة تمكّن من قياس مدى قوة الإسلام في فرنسا. يهرول
ألوف الناس إلى الجناح التجاري، القاعة الكبرى المخصصة للصلاة أو المربأ
العظيم الذي تنظم فيه المحاضرات. وكل ذلك مع فصل تام بين الرجال و النساء
في هذين الفضاءين. يدل مظهر النساء المحجبات في معظمهن على تصاعد الإسلام
السياسي. تتخذ الأسلمة طرقا لها عبر كتب زهيدة الثمن، ظلامية المضمون، لا
تشجّع على التفكير بقدر ما تقدم إجابات بسيطة سريعة الاستهلاك لتقطع
الطريق أمام كل تساؤلات جدية. فليس من مهمة لهذه المنشورات الهابطة سوى
'إبعاد العوام عن علم الكلام' وحرمانهم من التفكير بأنفسهم ليرددوا
كالببغاوات ما يتفوه به غيرهم من الدعاة.
وأخيرا يقدّم المحاضرون الزاد النظري الضروري الذي يضمن
الخضوع المبتهج للجماهير. ويمثل ملتقى 'اتحاد المنظمات الإسلامية في
فرنسا' و كثير من المساجد وقاعات الصلاة والجمعيات المحلية ميدانا مفضلا
للمتدخلين الأكثر شعبية وشهرة مثل حسان إيقيوسن، طارق رمضان وأخيه هاني
(الوجه الآخر من العملة). ولكن لا تكتفي عملية الأسلمة بكل هذا بل يأتيها
دعم غير مؤمّل من جامعيين ومسؤولين جمعويين فرنسيين غير مسلمين معروفين
تحت تسمية الإسلامو- يساريين. هؤلاء الذين يخيل لهم أن الإسلام دين
المظلومين، ينخرطون في نسبية ثقافية، تسجن من جهة الأشخاص المنحدرين من
بلدان إسلامية في هوية لا يتماهون معها بالضرورة ومن جهة أخرى تقلل من
أهمية الظلم الصارخ الذي يمارس في المحيط الأسري والجِواري. ويمثل هذا
الاتجاه : فنسان غيسييه، مروّج كلمة الإسلاموفوبيا (3)، مولود عونيت، رئيس
الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (4)، ورفائيل ليوجييه،
مدير مركز مراقبة الظاهرة الدينية(5).
ما هي مسؤولية الحكومات الفرنسية المتعاقبة؟ كانت مسؤولية الحكومة الفرنسية أمرا حاسما في تقبلها للإسلام
كشريك سياسي. بإنشائه لمجلس الديانة الإسلامية ما بين 2002-2003،استعاد
نيكولا ساركوزي رهان وزير الداخلية في حكومة جوسبان الاشتراكي جان بيار
شوفنمان الهادف إلى السيطرة على انتشار التعصب الإسلامي بمأسسته في هيئة
كان يؤمل أن تضعه على سكة الديمقراطية. وكان ذلك جهلا بواحا بحركة لا
تعترف بقانون إن لم يكن مصدره النص الديني المقدم كمقدس وذلك قبل الاعتراف
بالقوانين التي يصادق عليها البرلمانيون المنتخبون من طرف الشعب. بسلوكها
هذا، تتصرف الحكومة الفرنسية الحالية مثل كثير من الحكومات السابقة التي
كانت تنظر إلى الدين أولا كملحق إضافي للمحافظة على النظام العام. في
النهاية لا تهم روحانية الدين المسؤولين إلا قليلا، ما يهمهم بالأحرى هو
قدرة الدين على جعل المؤمن يخضع للسلطة والتي تعده مقابل ذلك بامتيازات
حقيقية. لقد تنبه نابليون وتيارس وغامبيطا أن التعاون مع الكاثوليكية
المؤمنة بالجبرية تساعد على إبعاد الشعب من إغواء التمرد والعصيان أو
المطالبة بحياة أفضل. لا يفعل ساركوزي شيئا آخر حينما ينتقل إلى الفاتيكان
أو إلى مسجد باريس : رغم علمانية الدولة في فرنسا، لا يمر رمضان دون أن
نرى ممثلا للحكومة (الرئيس، رئيس الحكومة أو وزير آخر) وهو يؤكد لمسجد
باريس وعميده صداقة الجمهورية. من أجل أن تشتري سلما اجتماعيا تعمل الدولة
على إيهام الناس بإمكانية وجود إسلام يتواءم مع اللائكية ومبادئ
الجمهورية. ولكن ليس معنى ذلك البرهنة على تلك المواءمة أو حتى تجنيد
الفقهاء لهذه المهمة بل لإقناع كافة المواطنين على أن الدولة تتعامل مع
أفراد غير مشكوك فيهم و يعملون من أجل تحررهم. ولكن الواقع غير هذا تماما
إذ أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورغم مرور 7 سنوات من اختلاقه إلا
أنه برهن عن عدم قدرته على تسيير ممارسة المسلمين لشعائرهم. المنافسة بين
الأشخاص، عدم القدرة على الحديث بصوت واحد، التناقض الشامل بين الخطاب
العلماني المنتظر والخطاب الإسلامي الممارس في الأعماق، كل هذا جعل هذا
المجلس يبقى عديم الجدوى.
إن المطالبة عبر هذا التنظيم بأن يتبنى كل المسلمين المتواجدين على
الأراضي الفرنسية خطابا موحدا لهو العبث عينه : كيف يمكن أن نوائم بين
سنّي و شيعيّ، بين سلفيّ وتركيّ مرتبط بحكومة بلاده، بين موفد من السلطة
الجزائرية ورعية من رعايا محمد السادس، بين مناضل من جماعة التبليغ ومسلمة
تطالب بحقها في عدم ارتداء الحجاب؟ لا يتوفر للمسحيين في فرنسا هيئة جامعة
ينضوون تحت لوائها جميعا إذ أن الكاثوليك و البروتستانت والأرتودكس
والمجيئيين وغيرهم.. كلهم يكونون نحلا وطوائف غير قابلة للتصالح فيما
بينها. نفس الفشل نجنيه إذا طلبنا من المسلمين التوحد. تتلخص جهود الحكومة
في خرافة الإسلام المتفتح الإنساني في مناوراتها اللغوية. فلفظ
إسلاموفوبيا وكذلك روليجوفوبيا ( الخوف من الدين ) الأكثر عمومية، فهو
يعبر أساسا عن رفض مطلق للدين و لكن كثيرا ما حرف نيكولا ساركوزي
الكلمة وجعلها كأنها تحمل عنصرية تجاه الأفراد. وبغض النظر عما إذا كان
ساركوزي غير قادر على التفريق بين نقد دين ما ورفض ونبذ المؤمنين به، أو
كان ذلك استراتيجية مقصودة في التلاعب بالمصطلحات فالأمر سيان لأنه في
النهاية قذف صريح. فمهما كانت قوة وحتى وقاحة الهجوم ضد دين من الأديان،
فهذا لا يعني أبدا المساس بكرامة تابعيه. فكثيرا ما يفصل بينهم وبين دينهم
فجوة كبيرة جدا لسببين اثنين: أحيانا لا يعرف المؤمنون مذهبهم معرفة وافية
(قليل هم الذين درسوا التوراة أو القرآن ) وأحيانا أخرى يعبرون عن عدم
اتفاقهم مع نقاط معينة في دينهم تبدو لهم غير مقبولة انطلاقا من قيم
أخلاقية مؤسسة خارج الإطار الديني. وفي حالة ما إذا تقبل المؤمن كليا
المضمون التوتاليتاري لدينه، فإن النظر إلى التنديد بالأيديولوجية التي
يحمل كعنصرية فهذا يدل على نهاية حق نقد كل فكرة، كل قناعة، وكل منظومة
سواء كان ذلك في مجال الدين أو غيره.