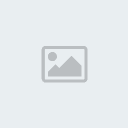
لا
أتَصَوّرُ فكراً حَيّاً دون حُرِّيَةِ، أو دون فكرٍ نقديّ. فما سَمَّاهُ
المتنبّي في ثقافتنا العربية، بـ "النَّفْسِ الحُرَّة"، هو تعبير عن هذا
التصوُّر ذاتِهِ. وهو نفسُه تقريباً ما كان سَمَّاهُ نيتشه بـ "الفكر
الحُرّ".
حين نَأْسَرُ الخيالَ، أو نَحْجَرُ عليه، فالكلامُ آنذاك، يَتَوَقّفُ
عن إنتاج المعرفة وعن النقد، وتصيرُ الدلالات بالتالي، لا تحمل في نفسها
أية قيمة، لأنَّ في تقييد الكلام، تقييدا لما يحمله من تأويلات، وما يمكن
أن يَفْتَحَهُ من آفاق لتوسيع حدود المعرفة، أو توسيع حدود الخيال بالأحرى.
لا يمكن لأمَّة لا تحترم الخيال، أو تسعى لابتداع قُيُودٍ له، وتمنع
النقد، أن تنهضَ، أو تَبْتَدِعَ أُفُقَها الحداثيّ، لأنَّ الحداثة لا
تتأسَّسُ على شَكْلِ الأشياءِ وظاهرِها، فالشَّكل أو المظهر، ما هو في
النهاية، سوى قِشْرَةٍ، أو سَطْحٍ لا عُمْقَ لَهُ.
فـي الشِّعر، كما في الرسـم، كما في توليـد الأسئلة والأفكار، لا يمكـن
ابتـداع المفاهيـم والرُّؤَى، أو تَفْتِيق ذكاء الأفـراد والجماعات، دون
أن يحظى الخيال بدور الآلة التي تُحَرِّكُ الذهنَ، وتُوقِظ قُدُراتِه على
الخلق والإبداع.
الصُّوَر التي يَبْتَدِعُها الشَّاعر، هي نفسُها التي يَبْتَدِعُها
الرسام، رغم اختلاف الوسائل. فما يحظى به الشِّعر من سَعَةٍ في التأويل،
ومن مجازاتٍ، لا تستطيع القراءة المُغْلَقَة أن تحصُرَها في معنى دون
غيره. هو نفسُه ما يجري في الرَّسْم.
أودُّ هنا أن أتحدَّث عن فـنّ الكاريكاتير، بشكل خاص. فهو فنّ، وهو رغم
طابعه التَّشْخِيصِيّ، يَحْفَلُ بجُرأةٍ في التخييل. في كثير ممّا نـراه
من أعمال كاريكاتيـرية، نذهبُ رأساً إلى الشخص، أو الجهة المعنيّة. وفنّان
الكاريكاتير، حين يرفق الرسم بالكلام، فهو يتوخَّى تحديد مَنْ يعنيه، أو
هو بالأحرى، يجعل المتلقي يُدْرِكُ الشَّخْصَ، أو الجِهَةَ المَعَنِيَةَ
بعمله هذا. هنا، في تصوُّري الشخصي، أرى أنَّ هذا المنحى التَّشْخِيصِيّ،
بقدر ما هو نقطة قُوَّة الرسم، هو أيضاً نقطة ضُعْفِه. فسرعة التأويل،
وحَصْرِيَته لدى بعض المتلقين تأتي من هذه اللحظة بالذات. هنا ينتفي
الخيال، وتصبح الفكرة مُقَيَّدَةً بالقراءة، فأيُّ تفسير، مهما حدث لن
يُقْنِع مثل هذه القراءات المُغْلَقَة، ولن يقبـل فكـرةَ الرسم، أو
الرسالة التي تسعى لِإِبْلاغِها.
إذا كان سوء الظَّنِّ في الشعر، يّسْتَعْصِي إثْبَاتُهُ، كون اللغة
مُوَارِبَة، وتعرفُ كيف تُراوِغُ مَتَلَقِّيها، أو ما يجري في بنائها من
اسْتِعْصَاءٍ، ففي الكاريكاتير، يكون هامش المُراوَغَة أقل، ويكون سوء
الظنِّ، هو الرَّاجح، وهذا ما يَحْدُثُ عادةً في حالاتٍ، يصير فيها المعنى
الواحد، هو حُجَّة القارئ، ويَتِمُّ بالتالي، حَصْر الرسم، في زاوية
ضَيِّقَة لا تَبْرَحُ ظَنَّ المُؤَوِّل، وما يَحْمِلُهُ من نوايا تُجاه
الرسم.
المُشْتَغِلُونَ في مجال قراءة العلامات وتحليلها، لهم ما يكفي من
الأدوات لتوسيع الرؤية، ووضع العمل في سياقه، وهنا لا مكان للظنِّ، أو
الشَّطَطِ في استعمال التأويلات، وتبريرها.
تحتـاج قـراءة المتخصِّص فـي فَكِّ الرموز، وفـي قراءتها وتأويلها، إلى
معارف متنـوعة ومُتَشَعِّبَةٍ، وإلى فَلْـيِ العمل وتَقْلِيبِهِ على أكثر
من وَجْهٍ، كما يقول القدماء، قبل أن "يُفْتِي" في شأنه، أو يَضَعُه في
سياق احتمالاته. لا يَقِينَ، في قراءة الخيال. والخيال هو مَجَالٌ
للتأويل، ومكانُ تناحُراتِ، في القراءة كما في التأويل.
لم يَكُن رولان بارت، حين اشتغل على كثير من العلامات التي كانت ربما
تَبْدُو قَبْلَهُ، غير ذات أهمية في المعرفة الإنسانية، يتوخَّى فَضْحَ
أَسْرارِها، فهو كان يسعى للكشف عن الدلالات التي تحملُها في طياتِها،
وإلى وَضْعِها في سياقها المعرفي، باعتبارها خطاباً قِراءَتُهُ تحتاج
لآلياتٍ، لا يمكن اكْتِسَابُها، إلاَّ بالانفتاح على حقول معرفية أخرى،
ربما قد تفيد في استنطاق ثنيات هذه العلامات، والكشف بالتالي عن مختلف
إشاراتها التي ظلَّت بعيدة عن متناول اليَدِ.
الرسم الكاريكاتيري، هو من الخطابات التي لا يمكن قراءتُها بالسهولة
التي نَعْتَقِدُها، اللَّهُم إذا كان هذا الرسم مباشِراً، مثلما يحدثُ في
الشِّعر، حين يكون النص مباشراً، لا مجال فيه للمجاز.
في المغرب، كما في دولٍ عربيةٍ كثيرةٍ، ما زال الرسم الكايكاتيري لا
يحظى بقبول الكثيرين، وما زال صادماً، كونُنا نذهبُ إلى شِقِّهِ
التَّشْخِيصي، ولا نَذْهَبُ إلى مجازاته، إلى ما فيه من تشبيه، دون أن
نتكَلَّفَ عَناءَ استعاراته. هذا في تصَوُّري ما جعل من رسومات ناجي العلي
تكون مُزْعِجَةً للكثيرين، وكذلك الفنـان المغربي الراحل المعروف بحمودة،
ومحمد الصبـان، وهو نفسُه المأزق الذي جعل قارئ رسوم خالد كداري، بجريدة
"أخبار اليوم"، لا يَبْرَحُ حُدُود التشخيص، فالتشبيه كان هو عطبُ
القراءة، والمصير الذي آلت إليه مُحاكمة الجريدة. فما قَدَّمَهُ مدير
الجريدة، و صاحب الرسم من تفسيراتٍ، و حتى المترافعين، ربما في القضية،
كان هو الحقيقة الغائبة عن العقل التشخيصي المُباشر، الذي لا يعرفُ مقالب
الاستعارات، وما تختزنُه الخطابات في ذاتها من مقالب، سواء كانت لُغَةً،
أو رسماً، أو حَلْبَة ملاكمةً، أو مُصارَعةَ ثيرانٍ.


