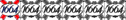لعل الملاحظة الساذجة أو المتسرعة لكتابات الدكتور مصطفى حجازي تستغرب عدم
تفصيله بشكل عميق لمرحلة التمرد والثورة كما فعل بالنسبة لمرحلتي الخضوع
والاضطهاد اللتين تناولهما بشكل معمق ومفصل. لكن القراءة النقدية
لإستراتيجية الكتابة في كل كتبه تكشف عن اتساع في الرؤية والمنظور مع
شساعة الآفاق التي ينخرط فيها فعل الكتابة عنده كمسؤولية وممارسة تحررية
وتحريرية للإنسان ومن اجل إنسانيته. ومن ثمة تخدم كل كتبه مرحلة التمرد
كأساس وبنية تحية نفسية واجتماعية ثقافية لهذه المرحلة قصد تحرر الفكر و
الوعي من سطوة السائد مما يمنح المجتمعات المتخلفة استقلالها وحقها في
تقرير مصيرها. فمهما طالت مرحلة القهر والتسلط والهدر لابد أن تأتي مرحلة
التمرد والثورة ( إن تحدي الموت وقهره يحمل في النهاية معنى الانتصار على
القهر والرضوخ اللذين يعنيان موتا معنويا ووجوديا .منذ اللحظة التي يبدأ
فيها الإنسان المقهور بتحدي الموت والظفر عليه يكون قد قلب من الناحية
النفسية الذاتية المحض معادلة التسلط أو الرضوخ وانتصر على ذاته مما يتيح
له الانتصار على قوى القهر فيما بعد .إن الانتصار على الموت هو قضاء على
اجتياف التبخيس الذاتي الذي يعني النقص والمهانة ويعني بالتالي انعدام
القيمة الذاتية )(1)
ومن ثمة يكتشف الإنسان قدرة الحياة على تجديد
نفسها، من خلال الانتصار للوجود الإنساني الذي أعاق نموه وانطلاقته الهدر
الذاتي و الاستبداد الداخلي والخارجي. بتزوير خبرة و وجدانات التجربة
الإنسانية مما أدى إلى سيطرة مظاهر الذات الاجتماعية المقنعة، في نوع من
الانشطار الذاتي والمجتمعي .( ولكن الحيلولة بين طاقة الحياة الوثابة
وانطلاقها نحو النماء والصيرورة لا يقتلها سوى ظاهريا…
يعلمنا تاريخ الشعوب المقهورة والمهدورة دائما أن لا نغتر بالسكون
الظاهري، الذي يتخذ شكل الاكتئاب أو الرضوخ المستسلم أو التبلد
واللامبالاة. فهذه ليست سوى قناع دفاعي وليست حالة أصيلة .انفجار طاقة
الحياة المتحولة إلى غضب يغلي يتخذ طابع العنف الكاسح، الذي يفاجئ المراقب
ويفاجئ ذاته بعظم وزخم الطاقة التي تتحرك . أين كانت ومن أين أتت؟ ذلك ما
يفاجئ المستبد وقبله يفاجئ الراضخين المهدورين أنفسهم)(2) و نتيجة ذلك
تخجل من نفسها اغلب النظريات والمنهجيات والمفاهيم والإيديولوجيات
والممارسات الثقافية والسياسية ،للنخبة المثقفة الداخلية، التي تم
ترويجها كنتف أفكار تمت سرقتها من أدنى الرفوف الغربية. دون تمحيص أو تمثل
أصيل يتوخى الاستيعاب النقدي والإلمام بالخلفيات الفلسفية والعلمية
المعرفية والإيديولوجية والتأسيس الابستمولوجي لها. وبذل الجهد العلمي
لاستنباتها بما يسمح بإنتاجها إبداعيا من خلال إسهامها في حركة الصيرورة
والتطوير والتنوير للذهنية وللواقع .
كما تسقط أيضا الطروحات الاستعمارية الأجنبية لبعض علماء الغرب الذين
رسموا تلك الصورة النمطية عن الإنسان، في المجتمعات المتخلفة واصفين إياه
بالطفولة الحضارية والبدائية الاجتماعية مبررين ذلك بقصوره عن تمثل
واستيعاب الحداثة والتحديث. كما حرموه من حق التمتع بما وصل إليه تاريخ
تطور الفكر البشري من تقدم مادي وقيم كونية إنسانية . لكن سرعان ما تنتقم
الحياة لنفسها ( عندها تبدو كل آليات القمع التي فرضت الاستكانة والرضوخ
وولدت الاكتئاب كقشرة هزيلة سريعة التفتت والتساقط )(3) فالتاريخ الإنساني
يشهد على جدلية السقوط والنهوض بما يؤكد أهمية مقاربة التفكير الايجابي
،والبحث عن فرص وإمكانات الحياة ،عوض الانكفاء والاستسلام القدري أو
الانجراف مع تيار عواصف الظروف القاهرة والصعبة ،التي يحاول المستبد
تكريسها كنمط وجود و منظور وحيد لرؤية الذات والآخرين والعالم ،متسترا على
ينابيع البناء والنماء والحياة (ورغم ما توحي به ظواهر الأمور فان قوى
النماء الحية لا زالت حاضرة، ولازالت تتكاثر رغم كل محاولات القمع
والاستبداد والقمقمة. فالحياة تأبى إلا أن تجدد ذاتها׃ ينهزم جيل فيأتي
غيره، ويشيخ جيل فيشب من يليه .وتعصف العواصف بالأرض الطيبة وتحل بها
الكوارث، ثم يأتي الربيع فتأخذ أجمل زينتها خضرة وألوانا وأزهارا وثمارا
وتظفر الحياة على الموت .ذلك أن نزوة الحياة الكبرى قد تنتكس لبعض الوقت
إلا أنها لا تستسلم أبدا ،ما دامت هناك حياة ،بل تجدد ذاتها في مواقع
وأشكال أخرى )(4).
فما الذي يجعلنا نفكر في علاقة التحليل النفسي الاجتماعي، كما يمارسه
الدكتور حجازي بدءا بدراسة سيكولوجية الإنسان المقهور إلى دراسة الشباب
الخليجي ، بالثورة غير موقفهما من الاستبداد ومن جميع أشكال سطوة الأنا
الأعلى التي تفرض قسريا نفي الذات داخل جحيم التوترات والقلق والعدوانية
التي ترتد نحو الذات فتحطم كل ما هو إنساني فيها وتعرضها لشتى أنواع
التبخيس والتحقير والدونية والنقص ولعصاب الفشل المزمن في الفعل والإرادة
و عدم الثقة في النفس وفي الآخرين و تتحصن بالقدر والمكتوب المحسوم أمره
أو الاتكال على قوى خرافية خارقة في تخليص الذات من واقعها الأليم وكل هذا
يتم خلال مرحلتي الرضوخ والاضطهاد اللتين تتميزان بالقهر والهدر المصعدان
إلى ابعد الحدود التي تفوق طاقة الإنسان في المرونة والتكيف والتحمل . أو
نفيها –الذات الإنسانية - خارج الوطن حين تصر على التشبث بحقها الإنساني
في السيطرة على واقعها وصناعة مصيرها بإرادة حرة واعية ومستقلة ورافضة لكل
ما يعيق نموها وصيرورتها الوجودية في أن تكون وتصير وتبني وتنجز ما يتجاوز
الأفكار النمطية والاجترار القهري لكل ما هو سائد من معتقدات خاطئة تتلبس
وجه الحرام والمقدس وتثقل عقل و لاشعور الإنسان بعذابات التأثيم من جراء
خرقه أو الثورة عليه كعبء أو عقبة تعيق النمو النفسي والمعرفي والذهني و
التفتح والتفاعل الاجتماعي بما يسمح بالرقي العقلي التجريدي في تعامله مع
قضايا وظواهر الفكر والواقع. وهذا النفي المركب نفسه هو الذي يعانيه علم
النفس والتحليل النفسي في ظل الاستبداد لأنه ينشد الثورة ويسعى إليها من
زاوية التغيير والتمرد ضد بنية الاستبداد وليس فقط في وجه أعراضها المرضية
فهو يستهدف ربط الذات بينابيع الحياة وتحرير قنوات اللاوعي بالتغلب على كل
التابوات التي شطرت سيكولوجية الإنسان المقهور الى درجة هدر قيمته
الإنسانية وزورت تجربته الوجودية والحياتية وحالت بينه وبين التعرف على
ذاته الحقيقية وما يعتمل في داخلها من طاقات وثابة وخلاقة تم تحريف
اشتغالها بآليات قهرية في جلد الذات وكرهها أو في تفريغ عدوانيتها
الاضطهادية في الأخر المقهور مثلها .
تأتي الثورة ككابوس صادم لتعيد الاعتبار للذات وقيمتها
الإنسانية و لتعيدنا إلى الواقع الذي كنا نتفنن تحت ضغط الاستبداد في
الهروب منه خنوعا وخضوعا واستسلاما و وهما وحلما وسحرا وشعوذة وتدينا
متزمتا… ونفاجأ قبل المستبد بقوة الحياة التي تنفجر في أعماقنا بشراسة لا
تقبل أنصاف الحلول في تحطيم كل الأوثان ورموزها والتي لم تعد ترغب –
الحياة - في التوقف أو الراحة من اجل الحرية التي لاحت في الأفق كفجر
جديد.
وينظر بعضنا إلى الأخر بفرح عارم وكأننا نتعاهد من جديد على كشف كل
الأسرار وإزاحة الستائر التي رسبتها في دواخلنا أنماط الاستبداد كنمط وجود
وحياة في الرؤية والتفكير والعيش والقيم والتنشئة المجتمعية وفي رسم مفهوم
الذات والعالم والمحيط… إنها كالتحليل النفسي تدفعنا إلى فتح دفتر الحساب
العسير مع الذات الفردية والجماعية والمجتمعية في تاريخها وثقافتها
وتصوراتها ومعتقداتها وتفاعلاتها وبيئتها وايكولوجتها الرحبة والشاسعة
وتضعنا أمام أشكال الاستبداد في هذا كله و نكتشف بفرح طفولي أنه من هنا
يولد المستبد. وننظر بخجل اقرب إلى النقد والنقد الذاتي إلى الناس
الأقربين منا أطفالنا وزوجاتنا اللواتي أسأنا إليهن بفعل تشوه وعينا
وإدراكنا ونفسيتنا . ونتساءل بشهيق الحسرة كم مسخنا كل ما حملناه من ارث
استبدادي تاريخي وثقافي ديني عنصري وطائفي متجاهلين عظمة المرأة( فوجئ
الناس في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا… في التعرف على الإنسان في
أعماقهم وكأنهم يتعلمون الوعي والإحساس والتفاعل الإنساني من جديد حيث غاب
التحرش وما شابهه وساد التضامن والتعاون والعطاء اللانهائي ودون تمييز
جنسي ولا طائفي أو ديني… ) نعم عظمة المرأة وليس الأم فقط في بناء ونماء
الإنسان ضد الخوف والذل والاستسلام للاستبداد كعبودية مختارة .لغة الثورة
والتحليل النفسي هي لغة التحرر والتحرير والهدم لبنية الاستبداد بعد
استحضارها وقراءتها وفهمها والبحث في كل ثناياها الغامضة والرمزية وكأننا
نعيش مخاض الولادة من جديد.وهما معا يستهدفان نفض غبار الماضي والتوجه إلى
المستقبل بثقة في الذات والحياة وبخطوات واثقة للنهوض والتأسيس لعهد
الحرية والديمقراطية والمواطنة الحقيقية…
فبعد تعبير الشعوب العربية عن رغبتها واستعدادها للتغيير و ثقتها في
الثورة كإرادة حرة مستقلة أي القبول بمنطق الثورة كأخذ وعطاء وتضحية
وانتزاع للحرية كحق إنساني يسمح للشعوب للعيش بكرامة دون الحاجة إلى إنتاج
خطاب الخوف العلني والحذر كرقابة داخلية غرستها سطوة المستبد كأنا أعلى في
عمق الذات باستبطان واجتياف داخلي يخشى انفجار المكبوت ( الشعب يريد إسقاط
النظام ׃ هذه التهمة التي سببت الاغتيال و الاعتقال والاختطاف والسجون
السرية والعلنية في التاريخ العربي الحديث والمعاصر ) مما يدفعها - الشعوب
المقهورة - إلى تزوير التجربة الوجودية والحياتية بطريقة لا تخلو من تحايل
يتناقض مع خطاب صامت سري يهدد بالانفجار في أية لحظة مما يفتح المجال
لمظاهر وأعراض الازدواجية والانشطار بصفات انفعالية عنيفة ورهيبة تدمر
القيمة الإنسانية للشعوب باستباحتها في حياتها وكرامتها وعيشها وعلاقاتها…
وللتخلص من هذا الإرث الثقيل وتحقيق الحرية تحتاج الثورة بعد انفجارها
كحالة نفسية وثقافية مجتمعية إلى جلسات أي محطات لان تحديث الوعي
الاجتماعي باعتماد القيم العقلية و المعرفة العلمية التي تعزز الحرية لن
يتأتى إلا من خلال التخلص من البنى الاجتماعية والثقافية التقليدية التي
تشتغل كبنية نفسية معرفية لاشعورية وكمخيال اجتماعي وتعمل على إعادة إنتاج
النمط الاستبدادي القهري الوسواسي في الأفكار والمواقف والعلاقات
المجتمعية في صورة نمطية تكرارية رتيبة تفرض الخوف وثقافته الاستسلامية
وتخرج الإنسان من الفعل التاريخي وتجعله سجين ماضيه هذا الذي يمارس عليه
نوعا من التحنيط الذهني والنفسي والثقافي الاجتماعي كاختلال وجودي
لصيرورته التاريخية .هكذا نرى في الثورة شيئا اقرب إلى التحليل النفسي في
رفض هذه البنى والأطر الاجتماعية الثقافية كمرجعيات تاريخية ومجتمعية
مقدسة ذات الجواب الواحد الصحيح الحق والحقيقي النازل بشكل عمودي من
السماء إلى الأرض ومن الحاكم إلى المحكوم ومن السلف إلى الخلف ومن الأبوة
إلى البنوة ومن الذكورة إلى الأنوثة وفق رؤية هندسية للكون تجهل التوازي
والتكافؤ والمساواة الأفقية فهي رؤية وثوقية يقينية إيمانية تحرم السؤال
والحوار لأنها تكره العقل والنفس الأمارة بالسوء أي اللاوعي المسكون
بالمكبوتات والممنوعات والمحرمات والنزوات …هذا اللاوعي الذي تنفرد في
احتكار المعرفة به تجعله عدو الإنسان وتختم على فوهته بالأوامر والنواهي
وتقذف به في أعماق الذات إنها رؤية مولدة لسطوة الماضي الاستبدادي كتثبيت
مرضي لكل حركة في الواقع و لكل حركة في الفكر من هنا تأتي الثورة كصيرورة
تحليلية نفسية وثقافية اجتماعية لتعيد للإنسان قيمته واعتباره وحصانته
الإنسانية كشعوب حرة مسؤولة ذات إرادة واعية فاعلة متحررة من كل المرجعيات
الناجزة والجاهزة و من اختلالات الماضي بتجلياتها التاريخية والثقافية
الاجتماعية كمقدس مسلم بنصوصه وتفسيراته هذا ما نقصده بعملية تحديث الوعي
واللاوعي الاجتماعي باعتماد القيم العقلية والفلسفية وإنتاج المعرفة
العلمية كمكتسبات تنويرية تسهم في تضاؤل أو انحسار الرؤية الدينية
الماضوية التثبيتية والقبول بموتها كتراث متجاوز ينبغي دفنه لتستأنف
الشعوب انخراطها في حاضر الصيرورة كاستيعاب وتجاوز يشرع حق الأبناء في
تكذيب وتفنيد الآباء( الأب والمدرس والفقيه …) بما يساير التطور الجنوني
السريع وانعدام اليقين وانهيار الكليات والشموليات حتى العلمية منها في
وقتنا الراهن.
ما نريد قوله هنا هو أننا نريد أن نتجاوز آباءنا وفيما صنع
الأجداد بمعنى نريد أن نمتلك الجرأة على تكذيبهم لأنهم ببساطة بشر لا اقل
ولا أكثر عاشوا تجربتهم بما لها وما عليها وتفاعلوا مع واقعهم وفق ما وصل
إليه الفكر البشري من تطور ولا نريد أن نغلطهم( المغالطة التاريخية كما
يشير إلى ذلك محمد أركون ) بما توافر لدينا من معرفة علمية ومنهجيات
حديثة لان المسافة التاريخية والاجتماعية والثقافية العلمية لا تسمح بذلك
.نحن نحبهم ولهذا نريد أن نقتلهم و إذا تجاوزنا سطحية الرمز سنعرف بأننا
نريد أن نتحول إلى مشاريع وجودية تاريخية كذوات مستقلة متحكمة في واقعها و
مسارها ومصيرها بعيدا عن الحقائق النهائية والمنجزة والمطلقة أو البحث عن
العتبات والينابيع والكهوف والمرجعيات المقدسة وما إلى ذلك من الأبوية
والحجر والوصاية على القلوب بالتحريم الديني و على العقول بالتجريم
السياسي في زمن تداعت فيه فكرة السلف والأطر الاجتماعية والثقافية
التقليدية والمعايير القيمية وصارت التنشئة الاجتماعية تفاعلية بين الآباء
والأبناء في المعرفة والثقافة والإعلام والاتصال والانترنيت وقواعد
المعلوماتية بعد أن كانت التنشئة والمعرفة حكرا على الآباء في البيت
والمسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة( قد توضح بعض الأمثلة هذا التحول في
المرجعية فالمراهق نابغة الأسرة في مجال الحاسوب والتعامل معه وعمل
الانجازات من خلاله .إنه مرجعية الوالدين والأسرة وحتى المدرسة وكل الكبار
الذين يتلقفون انجازاته . وقد أصبح الشباب هم المعلمين والمرشدين لذويهم
في التعامل مع الحاسوب والانترنيت في عالمها المدهش …لقد احل الشباب وحتى
اليافعون مرجعيةwww محل مرجعية الأهل على صعيد التعامل مع المعلومات
واستكشاف العالم والانفتاح على الدنيا وآفاقها المستقبلية .)(5)… والإنسان
اليوم هو من ينظر إلى ماضيه على انه مجموعة من الو رشات الفكرية والسياسية
والثقافية والعلمية والدينية… فتحت ولابد أن تستكمل مثلا في الحرية والفكر
والتنظيم وفي مجال المرأة و في احترام الأخر المختلف في العقيدة وتجاوز
الوصمة السيئة تجاه الإنسان كالكفر والذمي…
هذا هو الأفق الحقيقي لجميع الثورات الدينية والسياسية إنها تحتاج إلى
أتباع في وقتها كمشاركين في الفعل التاريخي بايجابياته وسلبياته في صنع
المصير .لكن الأبناء إذا لم يستطيعوا أن يتجاوزا بحسب شرطهم
التاريخي مفهوم الأبوة وعدم إعادة إنتاجه في صورته القديمة ولا في صورة
حديثة عليهم أن يتحولوا على الأقل إلى مشاريع أباء والتحرر والاستقلال
بالفعل النشط المنجز الحامل لأعباء الصيرورة في التجاوز والتغيير والتثوير
الذي لن يكون إلا من خلال التكذيب بالمعنى العلمي الذي يرحب بالجديد وغير
المألوف والإبداع في الإيمان والتفكير والمجتمع والاقتصاد والسياسة …وبذلك
يفتحون السبل لتجاوز ذواتهم باستمرار مما يجعلهم قد هيٲوا المسارات لكي
يتجاوزهم أبناؤهم عوض أن يحولهم أحفادهم إلى أوثان أو عتبات مقدسة(وهكذا
يتأسس التاريخ الجماعي والفردي في آن معا حيث يحمل الإنسان إمكانية
ومسؤولية مشروعه المستقبلي في ذاته . هنا تبدأ الحياة من خلال الاستيعاب
والتجاوز بدلا من الركود الذي ران على الأبناء فجمد كياناتهم بفعل
الاستبداد والاستئثار البيولوجيين القاتلين .ذلك أن قتل الأب بالمعنى
الرمزي الأسطوري هو فعل بداية حياة الأبناء الذين أصبحوا مشاريع آباء
تتجاوز آبائهم .انه فعل تحول من التاريخ الآسن إلى التاريخ المتحرك يطلق
قوى الحياة المتجددة )(6).
إذا لم تتخذ الثورة هذا الأفق مسارا في دفن الماضي الذي يسيطر على
الحاضر ويعيق عيش صيرورته كتوجه مستقبلي فإنها تكون اقرب إلى الاكتفاء
بالطب النفسي- إشارة إلى الأدوية الكيميائية…وان كانت هذه الأخيرة لا تفلت
من منطق السوق كسلعة تجارية - الذي يقتصر في علاجه على الأعراض المرضية
دون الذهاب بعيدا أي إلى اهتزاز وسقوط ثوابت الوعي التي تتحكم فيها بنية
اللاوعي الثقافي الجمعي .وفي هذه الحالة تقترب الثورة من الإصلاح أكثر من
التغيير الجذري الذي يستهدف التغيير العميق للبنى الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والثقافية .الشيء الذي يؤكد أن الثورة بهذا المعنى التحليلي
النفسي الاجتماعي وبالمعنى الثوري الجذري هي التي تجمع بشكل مترابط ومركب
وجدلي تكاملي بين الإصلاح الديمقراطي والثورة(أو بين الطب النفسي والتحليل
النفسي ) وفق محطات نوعية تنسجم والشروط الذاتية والموضوعية حيث افقها
الوحيد هو التغيير الشامل والجذري للمجتمع حتى يتجاوز التثبيت المرضي
ويدخل النشأة المستأنفة على حد تعبير ابن خلدون .وما يميز الثورة العربية
اليوم عن غيرها من الثورات التي عرفها التاريخ البشري هي أنها ليست شأنا
داخليا في هذا الزمن العولمي حيث تتجاذب وتتصارع وتتفاعل المصالح بين
القوى المهيمنة والمسيطرة وبينها وبين العالم المسمى بالدول المتخلفة أو
السائرة في طريق النمو …فهذا المحيط الخارجي ( وان كان اليوم من الصعب
الحديث عن الداخل والخارج بصورة قطعية ) لا يساعد ولا ينظر بعين الرضا إلى
استقلال حركة تطور المنطق الداخلي للمجتمعات العربية بما يخدم مصالح النمو
والتنمية محليا والتكافؤ والندية عالميا و يؤسس لعلاقات ديمقراطية دولية
جديدة.