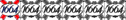عام 2000 موت الأب وبداية دولة الابن:
عام 2000 موت الأب وبداية دولة الابن:أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في تموز عام 2000 عقب فوزه في استفتاء
كان هو الوحيد المرشح فيه، عدة تعميمات شفهية ورسمية تقضي بإزالة اليافطات
والصور التي كانت تغطي آنذاك الشوارع والجدران والواجهات في كافة أنحاء
العاصمة دمشق والمدن والمحافظات الأخرى وعدم طبع المزيد من صور الرئيس
الاب او الأبن وتعليقها على نوافذ السيارات أو أي مكان آخر وعدم إطلاق اسم
الرئيس الراحل او الجديد على أي موقع رسمي دون إذن رسمي مسبق.
كانت التوجيهات الرسمية هذه تتعلق في أحد أبعادها مباشرة بمستوى
العلاقة التي تكمن بين السلطة السياسية والمواطن، أو بلغة أخرى بين
المجتمع والسياسة. كانت شوارع دمشق وأحياؤها قد تحولت بعد رحيل حافظ الأسد
الى خيمة عزاء هائلة مغطاة بعشرات الكيلومترات من اليافطات السوداء
والمكتوبة عليها شعارات وعبارت الولاء والبيعة بالاضافة الى مئات الالوف
(ان لم تكن ملايين) من صور الأب والابن باحجام مختلفة بدءاً من صور صغيرة
ملصقة على نوافذ السيارات الى تلك المبكرة عشرات المرات والمعلقة في ساحات
عامة في وسط المدينة. هدفت الخطوات الرسمية المتعلقة بإزالة الصور، أولاً
وقبل كل شيء، الى القضاء تدريجياً على بعض الملامح الفاضحة لوثنية السلطة
داخل الفضاء الاجتماعي وذلك عبر محاولة وإن كانت خجولة بعض الشيء لتهشيم
العلاقة التقليدية بين المواطن العربي وزعيمه السياسي. وهي علاقة تستمد
جذورها من الطقوس البدائية لعلاقة زعيم القبيلة بافراد جماعتها التي عليها
إتقان فن الطاعة. ويتم بناء هذه العلاقة في الفضاء السياسي العربي الحديث
على عنصر الرهبة التي تخلقها وحدانية الحاكم الذي لا يمكن الإشراك به أو
مخالفة أقواله التي تكتسب صفة القداسة حال سقوطها من بين الشفتين. وهذ ما
يؤدي الى تحويل الزعيم/الرئيس/ القائد الى وثن جماهيري معبود وعبادته عبر
الطاعة العمياء، وبالتالي إنتاج مجتمع غارق حتى الأعناق في الوثنية
السياسية. فآليات التأليه والتقديس تعتبران من الآليات الأساسية لإشتغال
السياسيات العربية حيث تبدع فيها الأجهزة والمؤسسات الاعلامية الرسمية
التابعة للخطاب الآيديولوجي الرسمي في محاولة لأسطرة شخصيات زعماء عرب
وحياتهم الذاتية.
17 من تموز 2000 بين بغداد ودمشق
عربياً كان هناك خطابان رئاسيان في يوم السابع عشر من تموز عام 2000
تميزا باختلافهما الشديد من حيث التعامل مع اللغة وكيفية الأداء الصوتي،
والأهم من حيث مقاربة كل خطاب للواقع الاجتماعي والسياسي والرؤية اليه.
أحد الخطابين ألقاه بشار الأسد الرئيس الشاب الجديد، الطبيب العائد من
لندن، الذي لم يكن يتعدى عمره آنذاك منتصف العقد الثلاثيني محرضاً أمل
التغييرعند الكثير من السوريين. بينما ألقى الخطاب الآخر دكتاتور ممل في
لغته الانشائية وظهور المتكرر بشكل دائم، صدام حسين، كان قد أمضى عقدين في
سلطة اتسمت بالقمع والقسوة والقتل وصولاً الى شن عمليات ابادة جماعية ضد
أبناء شعبه.
تجنب خطاب القسم الذي ألقاه الأسد الابن النبرة التفخيمية واللهجة
الاستعلائية، كما انه لم يلجأ الى تلك النغمة الحماسية الثورية التي
تستوجبها عادة نظرية المؤامرة والاشارة واضحاً الى وجود عدو خارجي مزمن،
وهذه من ميزات الخطابة عند الزعماء العرب حيث بدأت مع مرحلة ما بعد
الاستعمار وتشكل الدول الوطنية ولم تزل مستمرة الى يومنا هذا. حاول ذلك
الخطاب فعلاً إحداث نوع من القطيعة مع اللغة والمنطق اللذين كانا يهيمنان
على اللغة السياسية العربية وتحديدا على خطب زعمائها المليئة بالانشاء
اللغوي الذي يصر على عدم القول والمكتوبة بلغة حماسية حيث تقرأ ليس عن
طريق الفم والحنجرة فحسب بل عبر الصراخ والقبضات المرفوعة المتوترة أيضاً.
وللبرهنة على هذا الاختلاف يكفي أن نعود الى خطاب الرئيس العراقي السابق
الذي ألقاه في اليوم نفسه، والذي تحكمت به لغة انشائية ديماغوغية متكررة
الى حد الضجر هدفها الأساس تضليل المواطن والاستخفاف بعقله عبر جمل لا
يمكن للمواطن إلا الاستهزاء بها من قبيل " المؤامرة على العراق العظيم
والنصر على الامبريالية ودحر العدوان الصليبي الغربي…" وغيرها من جمل
تناقض الواقع العرقي المرئي المعاش بالمطلق. هكذا بينما كانت السلطات
العربية ماضية في انشغالها ببناء خطاب تضليلي قاس مليء بمؤامرت يحوكها
أعداء خارجيين كثر، حاولت سوريا، أو في الأقل أوحى رئيسها الشاب الجديد
التركيز مباشرة على الواقع الداخلي السوري بلغة بعيدة عن الابتذال
الانشائي والشروع بالدخول في سياق توجه تغييري عبر التركيز على مفهومي
الاصلاح والتغيير. وربما هذا ما أدى الى وهم الأمل بالتغيير حيث بدأ تحرك
المعارضين والمثقفين اليساريين والليبراليين نحو ما أسموه ربيع دمشق، وذلك
بعد ثلاثة عقود شمولية قاسية استهدفت إفراغ المجتمع من السياسة وحكرها على
السلطة وحدها. وكان ثمن هذا الأمل غالياً حيث شنت السلطات حملة اعتقالات
واسعة لاعادة تذكير المجتمع بإن السياسة وقرارتها هي شأن سلطوي محض ولا
مجال للمجتمع أو مثقفيه الخوض فيها.
لكن الطامة تكمن الآن في محاولة الرئيس السوري الأسد الابن العودة الى
الوراء أكثر من عقد من الزمن للاحتماء بذات المنطق واللغة اللذين نبذهما،
وأقصد منطق المؤامرة واللغة التضليلية التي لا تقول ولا تنتج أي معنى، في
مواجهة أزمة الاحتجاجات التي تعصف ببلاده.
ربيع 2011 : الكلام الذي يصر على ألا يقول:وبعد مرور كثر من عقد على خطاب القسم الذي كانت مصطلحات من قبيل
"التطوير والإصلاح والتحديث وأفكار جديدة" تمثل مركزها الأساس، تجتاح
البلاد مظاهرات واحتجاجت تطالب بالحريات وصولاً الى رفع شعار إسقاط
النظام. وهكذا ظهر خطاب المؤامرة. وفي زمن المؤامرت تلجأ الأنظمة الأمنية
الى الحل الأكثر سهولة والأكثر إتقانا من قبلها وهو الحل الأمني. وبدأت
الأجهزة الرسمية ورجالاتها بدءاً من الرئيس ذاته وصولاً الى محللين
سياسيين رسميين وبينهما رجالات من مجلس الشعب، تحاول إشاعة رواية إنتشار
عصابات سلفية مسلحة تستهدف إشعال فتنة طائفية في البلد. لكن ما يهمني هنا
هو الخطاب الذي حاول مقاربة أزمة الاحتجاجات، فما إسترجاعي لخطاب بشار
الأول إلا لبناء نوع من المقارنة مع خطابه الذي ألقاه في يوم 30 من آذار.
فبعد انتظار دام حوالي أسبوعين عقب انطلاق احتجاجات شعبية عارمة في
الكثير من مدن وبلدات سورية والتي أدت الى سقوط الكثير من القتلى خرج
الرئيس السوري مبتسما بل وضاحكاً ليلقي خطابه الذي كان ينتظره الشعب
السوري بنافذ الصبر. تصدى الخطاب للكثير من مفاهيم ومواضيع في غاية
الأهمية والخطورة كضرورة الإصلاح، والمؤامرة التي تستهدف أمن البلاد
واستقرارها، والثورات (وخصوصاً الموسمية منها بحسب لغة الخطاب!) التي
تجتاح البلدان العربية ومحاربة الفساد وغيرها من المواضيع، لكنه في
النهاية وقع في أزمة عدم القول و الاصرار على انتاج اللامعنى. فإذا كان
خطابه الأول واضحاً في إستخدام لغة واقعية محاولاً الابتعاد عن النغمة
الانشائية التي تتحكم بالخطب الرئاسية العربية ، لجأ في خطابه الأخير الى
استعارة اللغة الخطابية العربية ونغمتها التقليدية- ربما كان صدام حسين
خير من يمثلها- الى استعارة مصطلح المؤامرة بوصفها لغة بحد ذاتها لها
سياقها التاريخي الطويل في الذهنية العربية، والقول بانها أم الاشياء
جميعها ومحركها الأساس وهي التي تقف وراء كل ما يحدث الآن في سوريا.
وبينما حاول في خطابه الأول مقاربة الواقع السوري وانتاج معاني مستقبلية
له، بدى خطابه الأخير في يوم 30 في سياق التهريج والتصفيق وإلقاء هتافات
بدوية هزيلة من قبل أعضاء مجلس الشعب السوري، والذي أسماه أحد الصحفيين
البريطانين بـ"السيرك السوري"، خطاب اللامعنى بإمتياز، خطاب الكلام الي لا
يقول. ومما رسخ بعد اللامعنى هذا كان عنصر الضحك المتواصل من قبل الخطيب
وإلقائه النكات في وقت كانت الامهات الثكلى يندبن موت أبنائهن – لم يتعد
أعمار بعضهم 17 عاما- الذين سقطوا قتلى برصاص القوات الأمنية، وكانت
دماؤهم لا زالت تغطي شوارع مدينة درعا ومدن وبلدات أخرى.
ما بعد 17 تموز 2000 التأتأة واللعثمة السياستين:يبدو ان مشكلة بشار الاسد والمعارضة السياسة السورية آنذاك تمثلت في
عدم طرحهما الاسئلة الأكثر جوهرية حول كيفية تخطي دولة الأب وتجاوز ارثها.
حول كيفية إشراك المجتمع في العملية السياسية. أو بلغة اخرى حول هل ستكفي
هذه الإجراءات الأولية البسيطة، من قبيل إزالة الصور وخطوات أخرى من قبيل
تخفيف القبضة الأمنية قليلاً، لتهشيم معبدية السياسة التي استمرت لاكثر من
ثلاثة عقود ورمي مئات الاوثان التي تملا المدينة أرضاً دون أدنى خوف. فإذا
كانت الخطوات التي حاول خطاب القسم طرحها تمثل نوعاً من طرح مختلف وجديد
من قبل القيادة السياسية الجديدة لنوعية التعامل مع المجتمع، فالسؤال
الأخطر كان يتمثل في هل كان المجتمع المنفي من السياسة يملك حيزاً أو
مساحة مفتوحة لطرح هو الآخر رايه في كيفية بناء العلاقة مع السلطة؟ ان ارث
عقود طويلة التي عاشها المجتمع السوري وهو يمارس تعليم أبجدية الصمت
والخوف والتهميش في ظل سياسة شمولية قاسية لم يكن يجيب إلا بالنفي. وربما
تعبر النكتة السياسية التي تقول بان المواطن لا يفتح فمه إلا أمام طبيب
الأسنان عن مدى قسوة ورعب الدولة الأمنية التي تدرب المواطن في ظلها على
الصمت رعباً من الأجهزة الأمنية الكثيرة.
لذلك كانت ضرورة الأولى تتمثل في فتح فضاءات للقول وهوامش لحرية
التعبير. فقد ظل المجتمع السوري، وفي مقدمته المعارضة السياسية، يعاني من
التأتأة واللعثمة السياسية ولم يصل مطلقاً الى مرحلة الكلام وبالتالي
اكتسابه حق المشاركة في قول الرأي وصياغة القرار. لم يكن هناك من مجال
لحدوث هذا بغير تحرير المجتمع من ارث الخوف والفوبيا من الكلام، وهو ارث
بنته ورسخته مرحلة الاب طوال عقود ثلاثة اتسمت بنموذج ستاليني شمولي قاسي
في تطهير من يحاول التفوه بقول مغاير.
نزعت دولة الأب الى محاولات لتضخيم جسد السلطة ومد خيوطها العنكبوتية
الى كافة ثنايا الوحدات المجتمعية ومؤسساتها عبر النقابات والاتحادات
والتجمعات الحزبية البعثية، كما واستطاعت انتاج لغة انشائية غير عقلانية
تهمين ليس على الخطاب الاعلامي الرسمي والآيديولوجي، بل تسربت هذه
اللاعقلانية حتى الى مستوى اللغة الاجتماعية البسيطة في تفسير الظواهر
والاحداث السياسية. فالمؤامرة او المقاومة، وهما قطبان كثيرا ما يتلازمان
ويستمدان وجودهما من بعضهما البعض، كانتا الجواب السحري لكل التعقيدات
السياسية والمجتمعية التي كانت سورية تعانيها. وهكذا تم إختزال السياسة
والمجتمع بل وحتى العملية الثقافية بكل تعقيدات وتشابكات هذه الحقول الى
بضعة جمل مكررة ومستهلكة وهي في الاخير لا تزيد إلا في ترسيخ الديماغوجية
السياسية.
حارت دولة الأبن بين خطاب إصلاحي وعد بالتغيير والتحديث والانفتاح،
ويجدر الاشارة الى ان التغيير كانت الكلمة الأكثر استخدماً وشيوعاً في
الشارع السوري آنذاك ، وبين هذا الارث الكونكريتي الذي خلفته دولة الأب مع
وجود حراس يصرون على الحفاظ عليه مقدساً. فبدون إجراءات في غاية الجرأة
يقدم عليها الأبن لإزاحة هذا الأرث وتهشيم أركانه التي قضى الاب ثلاثين
عاما وهو يبنيها، لا يمكن للمجتمع تعلم فن الكلام ونطق القول وابداء الراي
وبالتالي الخروج مرة واحدة وللأبد من أسر المعبدية والوثنية السياسية التي
اغتالت كل حس نقدي وتحليل عقلاني لديه.
شباط 2011: الانفتاح فالانفتاح ثم الانفتاح:وبعد مضي احدى عشر سنة على وعده القيام باصلاحات جذرية وعملية انفتاح
سياسية في البلاد، وقبل أقل من شهر على إندلاع شرارة الاحتجاجات في سوريا
يقول الرئيس السوري في مقابلة لصحيفة وول ستريت جورنال بان المجتمع بحاجة
الى التحديث والانفتاح، لان المجتمع بحسب قوله للصحيفة " أصبح خلال العقود
الثلاثة الاخيرة، وخصوصاً في الثمانينيات، أكثر إنغلاقاً بسبب ازدياد حالة
الانغلاق في العقول التي أدت الى التطرف. لا يمكن الإصلاح بدون الانفتاح
العقلي، إذن القضية الجوهرية هنا هي كيفية انفتاح العقل، بل المجتمع كله،
وهذا يعني الجميع في المجتمع." وهنا لا يمكن مقاومة اغراء القول بان
المرحلة التي يتحدث عليها الرئيس هي مرحلة دولة أبيه، وبالتالي ليس هناك
من شخص آخر غير الأب يعتبر مسؤولاً عن الانغلاق في العقول الذي يتحدث عنه
الأبن. والذي يلفت الانتباه في سياق قراءة هذه المقابلة هو التركيز
والتشديد المغالي فيه، خصوصاً في جزء البداية من المقابلة، على كلمة
الانفتاح وضرورة إحداث انفتاح في العقول، وكان الأمر لا يتعلق بالمجتمع
السوري الذي أنتج رموز ثقافية كبيرة بل بجماعات أو قبائل مغلقة متوققعة
على ذاتها تعيش مراحل ما قبل التاريخ.
العودة الى تموز 2000 : الصورة العملاقة ودلالات القسوة:كان على المارة في سوق الصالحية بوسط مدينة دمشق ان يمروا مباشرة تحت
صورة عملاقة لبشار الأسد تم تعليقها قبيل إعلان فوزه في الاستفتاء في ساحة
العرنوس وتحديداً على الجدار البناية التي تواجه تمثال أبيه. كانت الصورة
بالاضافة الى ضخامتها (بين 25 الى 30 متراً بالعرض وارتفاع ليس أقل من 15
متر) تتميز بشيء آخر كان يبث القسوة والرعب، قبضة الرئيس التي كانت تخترق
إطار الصورة لتمتد الى خارج حيزها المخصص الطبيعي الذي هو الإطار. كانت
عناصر الصورة، النظارة السوداء التي تحيل الى السرية والبوليسية والقبضة
المتوترة على شكل وعيد وتهديد (لمن؟) والمخترقة إطار الصورة والضخامة
الهائلة، كل هذا كان ينتج دلالات قاسية للهيمنة والأبوة السياسية والسلطة
العليا على الناس/ المواطنين الذين كان عليهم ان يمروا تحت القبضة القاسية
مباشرة. لم تكن صورة هذه إلا عملية تقزيم وتصغير للطرف الآخر والمحكوم ان
يظل تحتها (المواطن).
أزيلت الصورة بعد فترة وجيزة في سياق حملة إزالة الصور واللافتات، ولكن
عملية الإزلة هذه لم تعني مطلقاً الإزالة النهائية لدلالات بنية العلاقة
بين السلطة والشعب. فإنغلاقية، ليست عقول المواطنين السوريين كما يدعي
الرئيس، بل إنغلاقية مساحات التحرك والقول أمام المجتمع السوري اضطرته، أي
المجتمع، خلال العقد الأخير الى إعادة إنتاج ذات الآليات القديمة لتعامله
مع السياسة ورموزها السلطوية. كما وأبقت هذه الانغلاقية الفضاءات السياسية
والقنوات الاجتماعية، التي تتيح لأفراد المجتمع إجتياز مرحلة فعل تعليق
الصور ووضع التماثيل بوصفهما آلية تعبير عن الولاء والبيعة ومن ثم الصمت
الى مرحلة فعل النطق فالكلام ومن ثم صياغة القول السياسي الحر بوصفها
تعبيراً عن الرأي والارادة والمشاركة السياسية، مقفلة بإحكام أمام المجتمع.
وما يحدث الآن هو محاولات شعبية عارمة لفتح مساحات التحرك والقول
المغلقة هذه التي وعد بشار بفتحها قبل أكثر من 11 سنة. ففعل إسقاط تماثيل
الأسد الأب وتمزيق صور الرئيس الأبن في الساحات العامة- التي رأينا بعض
مشاهد منها على قنوات فضائية وموقع يوتيوب ومواقع اجتماعية الكترونية
اخرى- أثناء الاحتجاجات الشعبية العارمة يقترح بدء مرحلة أخرى مغايرة من
عملية إزالة الصور واليافطات التي بدأت في عام ألفين. فهذا الفعل عبارة عن
عملية استعادة الفضاءات المسلوبة وفتح المساحات المغلقة بهدف التحرك بحرية
من خلال إفراغ الفضاء المجتمعي العام، الشوارع والميادين والساحات العامة،
من رموز الهيمنة السلطوية التي كان تعليقها يعني الولاء وحضورها يقترح
الهيمنة الشمولية وبالتالي ضرورة الصمت والإسكات. وعلي الاشارة هنا الى
انه ربما لا يكون الغضب موجها الى الصورة ذاتها او صاحبها، بقدر ما هو
ينصب على ما تبثه الصورة من رمزية إحتلال الفضاء العام وثم ضرورة الصمت
والسكوت.
فما يحدث في سوريا الآن من احتجاجات شعبية، يمثل في أحد أبعاده محاولة
استرداد السياسة وممارستها عبر تجاوز مرحلة طويلة تداخل فيها صمت المجتمع
وخوفه بالتأتأة السياسية التي عانها المعارضة، وثم باللعثمة التي كانت
تصيب لغة بشار الأسد، منذ استلامه السلطة، كلما تحدث عن حزمة إصلاحات أو
الحملة الإصلاحية التي "ستقوم بها الدولة". يكمن أحد تعاريف هذا التحرك
الشعبي العارم في الإصرار على المضي قدماً، بالرغم من عنف وقسوة الحل
العسكري من قبل الدولة، بهدف تجاوز السلطة والمعارضة معاَ والتوجه بوضوح
نحو تدشين مرحلة الدخول الى جنة القول وإتقان فن إبداء الرأي والمشاركة
السياسية.