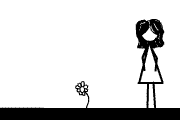- اقتباس :
يمثل القاص السوري محمد ياسين صبيح، بكتابته القصصية القصيرة جدا، التي دأب عليها منذ مستهل الألفية الثالثة أنموذجا متميزا، في مسار هذا الجنس الأدبي الحديث، فهو من موقع تجربته النقدية والإبداعية، عمل على تنشيطه وتليين قناة كتابته لمبدعيه ونقاده وقرائه، إذ خصه بصفحة إلكترونية عنونها برابطة القصة القصيرة جدا، وهي رابطة رقمية مشرعة بشتى كتاباتها على الأقطار العالمية، لذا لا غرو إن أمكنها أن تستقطب في ظرف وجيز من الزمن الآلاف ممن انضووا تحت لوائها، كما أمكنها أن تستكشف عددا كبيرا من المبدعين، وأن تحفزهم على إخراج تجاربهم من حيز الكمون إلى حيز التحقق الفعلي، خاصة بعدما جد القاص في ظروف حربية حرجة، وأقام ملتقيات للقصة القصيرة جدا في مختلف المحافظات السورية، وسعى بعدئذ إلى إصدار كتب تشمل أجود الكتابات التي احتضنتها الرابطة، وأشرفت على نشرها.
وقد أمكنه في هذا السياق عند منتصف هاته السنة - ألفين وثماني عشرة-، أن يصدر كتابه المعنون ب: نافذة بلا جدار*، الذي لاريب أنه يمثل عصارة جهد إبداعي، في مجال كتابة جنس القصة القصيرة جدا، التي تبدو من خلال القراءة المتفحصة للكتاب، أن القاص أمسك بناصية كتابتها، وبزمام توسيماتها الجنسية، واشتغالها السردي.
ويشتمل كتابه هذا على مائة وتسع قصص قصيرة جدا، أتت كل واحدة منها معنونة بلفظ واحد باستثناء قصة: هو والآخر، التي أتت معنونة بلفظين، أما العنوان الجامع الشامل الذي تضمنته الصفحة الأولى للغلاف، فقد احتوى على ثلاث كلمات: نافذة بلا جدار، وتبقى جميع العناوين عبارة عن جمل اسمية حذف منها المبتدأ واستبقي الخبر، مشحونا بشحنة دلالية ذات إيحاءات أو فراغات دالة، محفزة على التلقي، ولعل القصد منها الدلالة من جهة على أنها نصوص موازية، تبعث على التأمل، بغية استلهمام بوعي أو بحدس إيحاءات، لما سيوحي به المقول القصصي، كما أن القصد منها من جهة أخرى، الدلالة على أنها نصوص متفاعلة، تستتيح مساحة دلالية لتفاعل القارئ مع المقروء، أو بالأحرى تستتيح حرية تأويلية، أي حرية استثارة الأسئلة، وافتراض الأجوبة تبعا لعلاقة بين العنوان والنص.
وحتى نكون إجرائيا على بينة من هذا القصد المزدوج، سنتوقف عند عنوان المجموعة: نافذة بلا جدار، الذي لانعتبره نصا موازيا أو متفاعلا فقط، وإنما نعتبره كذلك قراءة اختزلها القاص في ثلاث كلمات، بغية تشكيل مع القارئ ميثاق قراءة، يبعثه على النظر إلى المقروء في شموليته، بوصفه نصوصا منفتحة على بعضها البعض، أو بالأحرى بوصفه شبكة علاقات دلالية وجنسية وبلاغية، تبدي النهائي منه في اللانهائي من الدلالات الإيحائية والتأويلية. ولعل هاته النظرة ما ترمز إليه كلمات: نافذة بلا جدار، التي فيها من التخييل النصيب الوافر، فهي لا تدل على رؤية أحادية البعد، ما دامت النافذة في سياقها غير مقيدة بأي قيد مادي، وإنما تدل على رؤية متعددة الأبعاد، أي الرؤية الحركية البانورامية الملمة بشتى التفاصيل، وهي رؤية تعادلها موضوعيا القراءة العالمة الشاملة للنصوص وفق نسق علائقي، لعل هذا ما جعل القاص لا يقصر العنوان على هذا النص، أو يقتبسه من ذاك، فمجموعته القصصية، بخلاف المجاميع التي تأتي معنونة بعنوان مشابه لعنوان قصة من القصص المتضمنة فيها، أتت مستقلة بعنوان جامع، لا يناظر عنوان أي قصة من قصصها القصيرة جدا المتضمنة فيها، وهو عنوان لا يؤشر على تلك العلاقات النسقية فحسب، بل يؤشر كذلك بمجازيته على أن الدلالة في سياقه القصصي، لا ترتهن بما تقوله اللغة وتقرره، وإنما ترتهن بما تسكت عنه وتوحي به، لذا فهي تترتب عن علاقة جدلية بين التجلي والخفاء، بين دلالة تقريرية ودلالة إيحائية، بين دلالة لازمة ودلالة متعدية، بين المدلول المباشر والمدلول غير المباشر، بين الكتابة والقراءة، مما يجعلها دلالة حركية، تتحرك على تجليات إيحائية مشرعة على احتمالات تأويلية شتى، إنها دلالة لا تشترط وجودها بذاتها، وإنما تشترطه بالذوات المتلقية، لذا فهي ليست مطلقة تتوقف على لغة موجودة بالفعل، وإنما هي نسبية تتوقف على لغة موجودة بالقوة، وهي بهذا وذاك تعبير عن توق إلى ما يشرع الكتابة على الاحتمالي، الذي يهبها قابلية للتعدد والتنوع والاختلاف.
إن عنوان القصص القصيرة جدا التي نحن بصددها، يكتمن طاقة إيحائية تسعف على استيحاء أن ما يقصه القاص من قص عبر الصفحات، ينشد إلى ثنائية ضدية متنافرة، وهي الانفتاح والانغلاق، الداخل والخارج، الخاص والعام، الانحباس والانعتاق، المرئي وغير المرئي، كما أنها تتيح لنا إمكانية أن نرى أنفسنا، وأن نرى الآخرين دون أن نُرى، وأن نعيش زمن الليل نهارا، وزمن النهار ليلا...
إوالواقع أن القص أتى ونحن نتدرج عليه قراءة منتظما، تبعا لثنائية ترادف هاته الثنائيات الضدية، وهي ثنائية الانغلاق الذاتي والانفتاح الموضوعي، في هذا السياق نسوق لما نقوله، القصة القصيرة جدا المعنونة ب: موقد
رسم بإصبعه على الجدار موقدا، ثمَّ راحَ يتدفأُ بالظلمةِ..
انساب الرماد إلى ذكرياتِه،
ولم يعد يرى غير نافذة موصدةٍ.
لم يفتحها أبدا.. لم يجد الجدارَ.. ص:57.
ولعل الناظر عن كثب إلى هذا النص القصصي، يجده بادئ ذي بدء يتناص مع العنوان الجامع للمجموعة القصصية، إلى أبعد مدى، حتى أنه يمكن أن يتنزل منزلة عنوانه: موقد.
إن هذا التناص يتجلى جليا على المستوى المعجمي، في تضمن النص لفظي:النافذة والجدار الذي تكرر، وعلى المستوى الدلالي في دلالة النص القصصي على أن النافذة بدون جدار، وفي اشتغال اللغة مجازيا وإيحائيا، وعلى المستوى التركيبي في إيراد عبارة: لم يجد الجدار، التي توازي العنوان الجامع: بلا جدار، وكذلك في إيراد عبارة أخرى متجانسة مع سابقتها: ولم يعد يرى غير نافذة موصدة. مما يجعل هذا النص أشد تعالقا مع العنوان من باقي النصوص، لهذا فهو يبرر بيسر ما قلناه، ويجلو بجلاء الثنائية الضدية التي ترمز إليها النافذة، وهي الانغلاق والانفتاح ، فعلى مستوى الدلالة التصريحية المباشرة، تعيش الشخصية في سياقنا، داخل مكان مغلق تدل على انغلاقه النافذة الموصدة التي لا تفتحها بتاتا، مؤثرة أن ترسم عالمها الخاص حيث تتدفأ بالظلمة، وتستغور ذكرياتها فيه، بينما الرماد ينساب إليها. أما على مستوى الدلالة الإيحائية غير المباشر، فإن المقول القصصي يوحي لنا إذ أغلقت النافذة على الخارج، بانفتاح تلك الشخصية آنئذ على عالم جواني داخلي، حيث ستتطهر وتخرج إلى الوجود الواقعي، أو تفتح نافذته، وهي قد اكتسبت وجودا ذاتيا طاهرا بدليل انسياب الرماد إلى ذاكرتها، ولاريب أن لهذا الرماد حمولة رمزية ثرية بالمعاني، فهو يحيلنا إلى أسطورة طائرالفينيق المقدس، الذي انتفض فيه وخرج من حريقه محلقا، وقد انبعثت فيه الحياة من جديد، والواقع أن القاص لا يومئ إلى استيحائه هاته الأسطورة باستحضاره الرماد فقط، بل يومئ إليها إيماءة قوية جدا، إذ عنون نصه بموقد الدال على الاحتراق الأسطوري، وبالتالي الانبعاث الجديد والخلود، بهذا فالشخصية المستحضرة فيه، هي معادل رمزي لطائر الفينيق، لذا فهي إذ أغلقت نافذة العالم الموضوعي، وفتحت نافذة العالم الذاتي موقعت ذاتها في موقع بين بين، أي في منطقة تقع بين الموت والحياة، اللامعنى والمعنى، اللاندلال والاندلال، العدم والوجود، الكمون والتحقق الفعلي، أي تموقعت بين ثنائية ضدية ترجع إلى مبدإ "اليانغ" الصيني الذي يعبر مع "اليينغ"، على الازدواجية الضدية التي يرتهن بها الكون، كما ترجع ضمنيا إلى البيضة الكونية، التي ترتبت عن انفقاسها ثنائية الأرض المرادفة للظلام والسماء المرادفة للنور، فالمكان الذي يتواجد فيه القاص يعادل رمزيا هاته البيضة، ففيه يتزاوج الظلام والنور: " رسم بإصبعه على الجدارموقدا، ثمَّ راحَ يتدفأُ بالظلمةِ.."، فهو مكان يدل على وجود في حالة كمون، وسعي إلى التحقق الفعلي، أي وجود بالقوة في طريقه إلى الوجود بالفعل.
إن القاص إذ يؤسطر العالم القصصي برمزيات أسطورية، يعدد أمامنا النوافذ فبعد أن أغلقت الشخصية نافذة الموضوعي، أشرعت نافذة الذاتي أو الوجود بالقوة، ووضعتنا أمام احتمال أن تشرع نافذة الاحتمالي أو الوجود بالفعل باعتباره وجود الانبعاث والتجدد، وهناك نافذة أخرى يشرعها القاص للقارئ، فهو إذ يرضخ اللغة إلى تفاعل عضوي، يضعه أمام كتابة تأويلية، لها احتمالات لا متناهية، وينبغي أن لا نغفل هنا النص باعتباره نافذة منفتحة على باقي النصوص، وهو انفتاح يدل عليه العنوان الجامع، الذي يكون في علاقاته بهذا النص وبمختلف النصوص ضربا من تكثيف الإشعاع الدلالي، الذي تعكسه بجلاء مختلف النصوص، وخاصة تلك التي تقيم معه علاقات ترتهن بالنسيج اللغوي الناظم، وبالدلالة المحايثة للكلمات، وبدلالاتها الإيحائية المساوقة، وبالتخييل المعتمد.
ولعل الإضاءة المتوقدة لهاته العلاقات تصدر عن نصوص: انعكاس، وبقايا، وهاجس، وعودة، ومحاولة، وقرار، ودهشة، وقضية، ورحلة، وحروف، ورسم، وتعلم، ووقت، ولحظة، وجلوس، وعابر، وانتظام، وتمنّ، وخاطرة، وبئر…، فمقول هاته القصص القصيرة جدا، يتضمن معجما يدل على صلته بالعنوان الجامع، فضمنه ترد كلمة النافذة، اوما يرادفها كالشرفة والمرآة، والبوابة، والباب، كما ترد كلمة الجدار، أو ما يرادفها كالحائط أو الصفحة، كما أن اللغة شأنها شأن لغة العنوان الجامع أتت في تخييلها مجازية، تشتغل على مستوى العلاقات الاستبدالية، التي هي علاقات غيابية، تقتضي تجاوز المدلول التقريري المباشر إلى المدلول الإيحائي غير المباشر، أي الانتقال من الدلالة المحايثة إلى الدلالة المساوقة، وهو انتقال يوقفنا دوما من منطلق الواقع المعيش المتعدد الأبعاد، على حقيقة الانفتاح أوالانغلاق التي ترمز إليها النافذة المتحررة من الوجهة القارة، ما دامت بدون جدار، أو بالأحرى بدون سند، وحتى نستدل على ما افترضناه، نستحضر النص القصصي التالي: وقت
حطَّمَ كلَّ الجدران،
حتى لا يعلق عليه ساعة أبدا.
لكن النافذة الوحيدة في حياته لم تتحطم..
دائماً يَدخلُ عَبرَها أنينٌ بعيدٌ..
يذكِّره بالساعة التي حبا فيها على أربعٍ.. ص: 33.
فالنص كما هو شأن سابقه يقف موازيا للعنوان الجامع، ومتناصا معه، ولعل الوظيفة اللغوية التي يحققها ضمن الوظائف، التي حدّها الباحث الألسني "رومان ياكوبسون"، تتمثل في الوظيفة الميطالسانة، التي هي وظيفة واصفة تقوم على مبدإ التساوي بين الموصوف والواصف.
أما النصوص التي بخلاف تلك لم تُقِم العلاقة المعجمية، فقد أتت دالة على ثنائية الانغلاق والانفتاح، التي تحيل على النافذة منغلقة أو منفتحة في سياق استرسالها الدلالي، وفقما تبين في النص القصصي التالي: وحدة
كان المطر يهطل غزيراً، والغيوم تتراكض بحملها الثقيل،
الغابة تئنّ من العتمة، وأصوات اللصوص والذّئاب والرّصاص
تملأ الأرجاءَ..
وأنا أسهر في قبري وحيدا لا أبالي..ص: 37.
فهنا نقف على ثنائية الانفتاح والانغلاق من خلال واقعين، أولهما واقع موضوعي مرهب، يدل عليه السارد دلالة بانورامية، وكأنه يشرف عليه من نافدة حركية غير مثبتة على جدار أو سند، وثانيهما واقع ذاتي يبعث على الرهبة، وهو يدل عليه السارد مستقلا عن سابقه الموضوعي: "وأنا أسهر في قبري وحيدا لا أبالي"، وكأنه هنا أغلق النافذة، وانشغل انشغالا عبثيا عن العالم الخارجي بالعالم الداخلي.
والواقع أن الثنائية مهما تعددت دلالاتها، وتجلياتها في النصوص القصصية، تدل على واقع مأزوم تفاقمت مشاكله ومعاناته، بشكل جعل شأن الإنسان شأن سيزيف، يدور في الحلقة المفرغة، فهو يوهم نفسه بالفرج، بينما لا فرج يعيشه، ولعل هذا ما جعل القاص يستوحي أسطورة سيزيف في النص القصصي التالي: بديل
وحيدة تدحرج السنينَ..
بينما تجفّ السواقي.. ولا تستطيعُ أن ترويَ عطشها..
لقد تصحر حُبُّها في السراب..
عند المساء تختار التيمّمَ بالرمل لتموت.. ص: 14.
فالثنائية تنكشف هنا في انفتاح الشخصية على الحياة تارة، وانغلاقها على الموت تارة أخرى، فهي ضمن النص سيزيفية، تعيش التكرار والدوران في الحلقة المفرغة، أي تعيش الموت الحركي، الذي يرمز إلى العذاب المقترن به، وهو عذاب طالما دلت عليه الأساطير القديمة، ومختلف الكتب الدينية.
وتكمن أهمية هذا الاستيحاء الأسطوري والديني، في انبناء النص وفق بناء دائري حلقي ارتجاعي، أتت فيه نقطة الختم هي نقطة البدء، إنه نص سردي تكراري، يجعل العلاقة بين المدلول و الدال علاقة طبيعية، بعدما كانت اعتباطية، أي غير معللة منطقيا وعقليا، فما يدل عليه المدلول معنى من عبثية وجود، هو ما يدل عليه الدال مبنى.
بهذا وذاك نكون قد شهدنا بعين اليقين، أن القاص قد أمعن في تكثيبف الإشعاع الدلالي للعنوان، وجعله يشع على كل النصوص، حتى يشرعها على الإيحاءات والتأويلات، ويحصن به - باعتباره ميثاق قراءة- احتمالات قراءاتها من كل انزلاق محتمل، من شأنه أن يحرفها عن مقاصدها التي توحي بها.
والواقع أن القاص محمد ياسين صبيح، الذي آل على نفسه أن يسهم في المشروع الحداثي القصصي، وأن يعمل على ترسيخ سننه الإبداعية، التي أتت استجابة لروح العصر، أمكنه أن يكتب عصارة جهد إبداعي، سيستثير أمام النقاد قضايا إبداعية عدة، ستجلو جنسا حديثا، له طواعية استجلاء المشروع التاريخي بموازاة المشروع الأدبي.