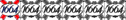“نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء و المنتأى مثلي”
عبد الرحمان الداخل مخاطبا نخلة.
كان صاحبي كُلَّما أصدر كتابا ازداد إحساسه بالاغتراب ونال منه اليأس حدّ الخوف والضجر. فبدل أنْ تَجْلُب له الكتابة أصدقاء جُددا، تَخْلُق له أعداء كُثر. وفي كلّ مرّة ينتظر فيها اعترافا لا يلقى غير التنكر. على هذا النحو راح يفكر في التوقف عن الكتابة نهائيا، اتقاء، لشرورها وصونا لذاته، وذلك على الأقلّ ممّا باتت تُكيله له من أحقاد وتُوَلِّده له من حُسّاد. كيف لا والكتابة إلى حدود اليوم لا تزيده فضلا عن التنكر والتنكيل إلا فقرا وعوزا، حتى صار مع مرّ الأعوام، يعتقد أنّ كلّ ما يلقاه في مساره الإبداعي، من تحقير وإهانة كما من سوء تقدير ولا اعتراف إنما هو استثناء يطاله هو لوحده دونما غيره. لكن هل الأمر كذلك بالفعل أم أنه بخلاف ما يظن ويعتقد تماما؟ أليس الوضع الثقافي الراهن، بالأحرى، وضعا مُهِينا لكلّ مُمْتَهِنِي القلم ومناصري الفكر؟ بل أكثر من ذلك حتى، حيث أن الكيد والبغض لا يصدران عن عامة القوم وبادئي الرأي فحسب، بل هو غالبا ما ينشأ بين أهل الدار نفسها ومحترفي الكتابة ذاتها. فلا شكّ أنّ الكتابة بطبعها على حدّ تعبير الجاحظ، لا تفتأ تنشر الحسد والعداوة، وتُفَرِّق مابين أصحاب القلم وتَزُجّ بهم لا محالة في الصراع مادام كلّ مؤلّف بتوصيف “كيليطو” “كيفما كان شأنه ومهما كان شكل تأليفه، فهو دوما محلّ ريبة صريحة أو غامضة، ولهذا قيل : لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرا أو يؤلف كتابا. ذلك أن الخطر ماثل والعدوّ بالمرصاد” . إلى هنا يتبدى أن الكتابة خصوصا والإبداع عموما، مجال للحقد ومعقل لتصريف الكراهية بامتياز؛ لكن إذا كان العداء الذي رصده الجاحظ عداء مطلقا سواء مابين الكاتب وندّه الكاتب أو ما بين الكاتب والقارئ، فتاريخ الأدب العالمي يكاد ينفي هذه القاعدة؛ وهذا هو ما نَسِيَهُ صاحبي ولم يستحضره سيما وأن الاعتراف والتقدير في مجال الإبداع لا يأتيان من الأقارب والجيران بل كثيرا ما نحصل عليه من الأجانب والغرباء. أولئك الذين يفهموننا حتى ولو كانوا لا يتكلمون لغتنا؛ ويكفينا توضيحا لهذا الأمر، أن نستدرج حالات بعينها للتأكد من أن مشاهير التاريخ ذاتهم ولئن كانوا عرضة للتهميش والازدراء المحلي فسرعان ما نالوا حظوة عز نظيرها وغدا إبداعهم عالميا بعدما كان لا يتجاوز نطاق الإقليمية. على هذا النحو، فـ“رابلي” الذي لم يلق أدنى تقدير يُذْكَر من لدن أصدقائه ومواطني بلده، هو مَنْ لم يُكْتَبْ له أن يُفْهَم بشكل جيد إلا مِنْ لَدُن روسي هو “باختين”. كما لم يُفهم “دوستويفسكي” إلا من طرف فرنسي هو “أندري جيد”؛ مثلما لم يُستَعَد نيتشه فيلسوفا في أعين مواطنيه الألمان إلا بفضل تأويلات الفلاسفة الفرنسيين؛ ولم يُستوعَب “Ibsen”النرويجي إلا من طرف إيرلندي هو “برنار شو” ولم يُهضَم“جيمس جويس” إلا على يد نمساوي هو “هيرمان بروخ”. أما “همنغواي” و“فولكنر” وثلة من المبدعين الأمريكيين، فما كان لهم أن ينالوا ما نالوه من حظوة وشهرة لولا الأدباء الفرنسيون؛ كذلك هو الشأن أيضا بالنسبة لـ“بول كلي”الفنان الكبير الذي عاش دونما أن تجد أعماله الفنية إبان حياته رغم عظمتها أدنى صدى يُذكر، فَمَكَثَ يتأسف حينها على حاله قائلا “لا وجود للجمهور”le peuple manque“؛ أما الجمهور الذي كان يُناديه الرسام حينئذ، ويستغيث به، فهو ليس أكثر من تلك القوة التي كان فَنُّه في أمس الحاجة إليها لبلوغ الذرى. لكن هذا الجمهور الذي اشتكى”بول كلي“من انعدامه هو الذي ما انفك يسجل حضوره وبقوة، بعد رحيل الرجل، مما جعل لوحاته تُحطِّم أرقاما قياسية من حيث المبيعات وتَعْرِف دونما غيرها مزادا علنيا عزّ نظيره. ذلك أن مِنْ قَدَر الإبداع عموما والفكر خصوصا، أنْ لا يُولَدَ إلا بعد ممات صاحبه: لم يظهر كتاب”الإيتيقا“ لسبينوزا، الذي كان له أثر كبير على الثورة الفرنسية، إلا عام 1677، بعد مضيّ ستة أشهر على وفاته، مُوقَّعا فقط بأحرف اسمه الأولى. إلى هذا الحد، نكون قد أوضحنا بعض عوامل الاغتراب الذي يتخبط فيه صاحبي، بدءا بمفارقة الميلاد(المرهونة بصيرورة الفكر من حيث هو كذلك) حتى قضية النظرة الإقليمية الاختزالية. وهي النظرة ذاتها التي حَكَمَت تصور الجاحظ ذاته؛ لا لشيء إلا لأن الرجل كان يحيا فترة ازدهار الأدب المحلي ويعيش لحظة سيادة الكتابة الإقليمية؛ بيد أن هذا النوع من الأدب على حد توصيف”غوته“،”لم يَعُد اليوم يُمَثّل شيئا ذا شأن، أمام وُلُوجنا عصر الأدب العالمي الذي على كل منّا عملا بوصية الشاعر الألماني نفسه، أن يساهم في تطويره“. وإذا ما استأنسنا بطرح الروائي”ميلان كونديرا“ فبوسعنا القول إنه ثمة،”سياقان أساسيان وِفْقَهما لا غير يمكننا أن نُمَوْضِع عملا فنيا: إما أن نموضعه ضمن تاريخه الوطني (السياق الأصغر) وإما ضمن تاريخ فنه العالمي (السياق الأكبر). وعليه يمكن اعتبار الموسيقى مثلا، فنا عالميا أي أنها تنتمي للسياق الأكبر لأن الموسيقى لا لغة لها: فمعرفة لغة “رولان دي لاسوس” أو “باخ” لا تعني شيئا بالنسبة لِعالِمٍ موسيقي؛ وبخلاف ذلك فالرواية، لأنها رهينة لغتها، فهي غالبا ما تُدَرَّس في كل الجامعات الدولية، ودونما استثناء ضمن السياق الوطني الصغير“. على هذا الأساس إذن يتم النظر إلى الأعمال الأدبية كما الفكرية نظرة إقليمية، بموجبها تضحى مجرد عناصر تنضاف لبعضها البعض لتشكل تاريخا يحكمه التراكم والانفصال لا الوحدة والاتصال. ذلك أن ثمة فرقا شاسعا بَيْن مَنْ يَنظر إلى الأعمال الإبداعية في إطار وحدة تاريخية موسومة بالاتصال ومَن ينظر إليها كما لو كانت تجميعا لعناصر مِنْ هنا وهناك. وإذا كنا في الحالة الأولى نُقِرّ بالتفاعل والإلهام كما التأثير والتأثر، ففي الحالة الثانية ننفي كل ذلك بالمرة، ناكرين أن يكون”ستيرن“مثلا قد تفاعل مع”رابلي“، بل وأَلْهَم”ديدرو“؛ جاهلين مدى تأثير”سيرفانتيس“في”فييلدينغ“؛ بل وكذا استرسال تراث”فلوبير“في أعمال”جويس“، وهكذا دواليك. بناء عليه يتجلى أن هذا التصنيف الذي بموجبه يُقَزَّم الإبداع سواء كان روائيا أو فلسفيا، هو أساس فشلنا الفكري الذي يصعب تداركه. إذ، بدل استحضار القيمة الجمالية والفلسفية للعمل الإبداعي يتم استحضار المعيار اللغوي، وبدل النظر إليه في إطار وحدة تاريخية يتم الالتفات إليه في سياق تراكمي لاصلة لأوَّلِه بآخِره. أليس هذا إذن هو سبب ازدراء الإبداع والمبدعين على حد سواء؟ ذلك أن العمل الإبداعي بشتى أنواعه لا يمكن اختزاله في اللغة أو الموطن، مادام لا يعترف بالحدود الجغرافية ومقرون دائما بشيء آخر يكون بمثابة صيرورته الخاصة. فكل مبدع سواء في الشعر أو الرواية أو الموسيقى أو التشكيل أو الفلسفة، يكون أثناء انشغاله في عزلة مطلقة؛ لكنها بتعبير”دولوز“عزلة مُعمَّرة بالتقاءات، مادام أن”العزلة تَجْمع بين أولئك الذين يعمل المجتمع على التفريق بينهم“على حد تأكيد”ألبير كامي“. من ثمة فرادة الإبداع الذي يجعلنا نؤسس للصداقات عن بُعد؛ صداقات أولئك الذين نقرأ لهم دونما حتى أن نَعْرِفهم أو أنْ نَرَاهم. أولئك المجهولون، الذين من أجلهم نكتب، ولأجلنا يكتبون. فنحن قَلَّما نكتب لأقاربنا، أبنائنا وزيجاتنا، إخواننا وأخواتنا؛ إننا لا نكتب إلا من أجل أناس هُم دوما غرباء وأجانب بالنسبة لنا. لذلك وجب على كل مبدع حقيقي، أن يأخذ العبرة من تاريخ الأدب العالمي، وأن يُلقي نظرة على بيوغرافيا العظماء بدل أن يكترث بأقاويل العامة وأن يُنْصِت لكلام الناطحة والمُتَردية. ويكفينا هنا، أن نُذَكِّر على سبيل المثال لا الحصر، بما جرى لـ”فيتولد غومبروفيتش“و”دانيلو كيس“، حيث أنهما لو اكتفيا بالأحكام التي صَدَرَتْ في حَقِّهما من لدن أولئك الذين يتكلمون اللغة البولونية ولغة الصرب-الكرواتيين، لَما كان أبدا لِمَنْحاهما الفني الجديد والأصيل أن يُكتشف. هكذا ظل كِتَاب”غومبروفيتش“بعنوان”ferdydurke“،”مَنْسيا لسنوات طوال، رغم أنه نُشِر في بولونيا منذ سنة 1937؛ وكان عليه أن ينتظر مدة خمسة عشر عاما لِيُقرأ أخيرا ويُرفَض من لدن ناشر فرنسي، فلم يُكْتَب للفرنسيين أن يحظوا بمتعة قراءته إلا بعد مرور أعوام أخرى“. ليس هذا فحسب، بل إن منظومة التنكر هذه، نالت حتى مِن”كافكا“الذي اعتُبِر عند الفرنسيين مجرد كاتب تشيكي، رغم أن” كافكا الذي كان منذ سنة 1918 يُعتبر مواطنا تشيكوسلوفاكيا، لم يكن رغم ذلك يكتب إلا بالألمانية. فهو دونما أدنى شك كاتب ألماني ولا يمكننا اعتباره إلا كذلك. لكن لنتصور ولو للحظة واحدة، أنه كتب مؤلفاته باللغة التشيكية. مَنْ سيعرفها اليوم؟" . وبالقياس إلى كافكا أتساءل : مَنْ سيعرف صاحبي طالما بقي يكتب بالعربية؟ مَنْ سيعرفه إذا ما بقي مُتَمَسِّكا بجذوره المحلية؟ أليست أزمتنا كَكُتّاب هي أزمة اللغة التي نكتب بها، والإقليمية التي غرقنا في بحرها؟