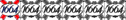من الغزَل إلى العزل
بقدر ما ذهب غبريال غارسيا ماركيز إلى كشف تحايل الأدب على الجسد في العزل، ستذهب الباحثة اللبنانيّة ريتا فرج في كتابها “امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة خطاب اللاّمساواة في المدوّنة الفقهية” ( دار التنوير، بيروت، الطبعة الأولى، 2015)، إلى كشف الاحتيال الإيديولوجي الجنسيِّ عند العرب _ المسلمين والنّصارى واليهود خصوصًا_ بعدما أفضى التّطور الجنوسي عندهم إلى نقض الغَزَلَ (الحبّ) بالعزل البيولوجيِّ للجسد عمومًا، ولجسد المرأة خصوصًا.
فالحبّ الحرُّ قبل محمد، وربّما في عصره، كان نهرًا أو فمًا يعمل بين ضفتين أو بين شفتين، فإذا به يُعزل ويُناط بطرف واحد، الذّكَر. ومن هذا الطرف الذَّكري، الطعّان والسلاّل، كما الرمحُ في جسد المرأة أو كما السيف في غمدها، نشأ التّطرف الجنسي، وهو عندنا مؤسس للتّطرف السياسي ولعدم المساواة بين البشر، إذْ الأقوى يسود الأضعف ويفعل به ما يشاء. وبمنطق علمي لا إيديولوجي نسبيًا، عملت ريتا فرج على كشف اللاّمساوة أو فوضى الشراكة بين الجنسين، انطلاقًا ممّا أسمته “امرأة الإسلام” الّتي نعمت نسبيًّا بفضيلة النسويّة المحمديّة الّتي سينسفها عمر بن الخطاب، مثلما نعمت المرأة قبل ستة قرون بنسويّة المسيح السلبيّة، الأقلّ سلبيّة من المرأة الموسويّة (أخت هاون أو بنت عمران) الّتي استعادها بولس، فتكنست من بعده. هنا جديد ريتا فرج في كشفها العلمي، وعليه لا بدّ من إطلاق بحث أدق لكشف مساهمات التوراة في تشكل صُور المرأة في الأناجيل والقرآن، ولكن بمقاربة بيولوجيّة صارمة، بعدما طغت الإيديولوجيات الجنوسيّة الدينيّة (التوحيديّة افتراضًا – نقول كيف يكون توحيديًّا مَنْ يوحد الآلهة في إله مّا، ولا يوحد المرأة والرّجل في نوع جنسي، الإنسان؟).
الحاصل أنّ ريتا فرج تقارب المسائل في كتابها الجديد بمنظار بيولوجي جزئي، إذْ نجدها منحازة لامرأة القرآن والأناجيل، وناقدة بقوة للعزل الّذي أفقد المرأة (في هذه المنطقة المهديّة الدينيّة الّتي تضجّ الآن، كما ضجّت منذ 1500 سنة وأكثر بالاضطرابات) الهويّة والجسد معًا، وبذلك أسّس لعنف سياسي/ جنسي بلا ضفاف. اللاّمساواة بين المرأة والرّجل هي في مرايا مدن السراب، هنا، تبرير لإيديولوجيا الهيمنة، بتزوير جسد المرأة وحبس أنوثتها. وأمّا المساواة المنشودة، فلن نجد تفسيرًا لها إلاّ في نطاق البيوثقافة العلميّة الراهنة.
التّطرف الدينيِّ
معياره النّصوص والأشخاص، والنّص حمّال أوجه، إذْ كلّما تغيّر العاقل تبدّل المعقول أو كلّما تغيّر العالمُ تغيّرت الكلمات، أو كلّما تبدلت زاوية النظر تغيّرت دائرة المنظور... وبما أنّ المنظور الديني، الجنسي أو السياسي، طَرَفيٌّ، فإنّه حكم متطرِّف، ومارق ككلّ سلطة في منظار ميشال فوكو وسواه. التّطرّف هو إذن مصدر كلّ عنف فينا وحولنا، وتفسيره البيولوجي _ البيوثقافي، أو البيواجتماعي سيكون أجدى من أنسنة الغزل، وفي الكشف عن حَيْوَنة الجسد، مجددًا، بعد ألهنته وشيطنته، ثمّ مكننته في أيّامنا _ فما يفتي به مفتون من إحلال خضار وفواكه محلّ القضيب في “الدرّة” الصدفيّة الموهومة _ ويهملون الاصبع أو البعص – تروجه الآن تكنولوجيا الجنوسة المصطنعة، البديلة عند الجنسين المتعنسين.
بطبيعة الحال، ربّما حال الحياءُ اللّفظي دون ذهاب ريتا فرج هذا المذهب، ونحن نتفهم تخوفها الإيديولوجي/ العلمي؛ ولكنّ البيولوجيا حيث تُطبق على الجماعات البشريّة والحيوانيّة، لا تُبقي ولا تذر مثقال ذرّة من الفقه الجنسي الديني، طالما أنّه لفظي، تشبيهي، واسترجاعي لأساطير أوّلين تخطاها من بعيد البعيد تطوّر الجسد في واقعه المعلوم بعلم. وإنّما حيث يغيب العلم عن التّفسير لواقعيّة الجسد، ينهض التّوهيم أو الإيهام للإفتاء في تخيّل الأجساد، وفي أسطرتها، كَمْن يعالج وهمًا بوهم، فيما البشريّة تواصل جنوستها الطبيعيّة، بمعزل عن ألفاظ لم تعبّر أصلاً عن واقع، ثم جاءت مجازاتها أو خيالاتها لتبرر وهماً بوهم، وهذا بنظرنا أخطر أشكال التزوير للجسد الإنساني، ولما بُني عليه من تطرّف ديني/ سياسي، وخصوصًا من كُرّه الآخر، في صورته المزوّرة، المؤسّس لكلّ أشكال العنف الفعلي الّتي تجري أفلامها أمامنا في مشاهد هذه المنطقة العربيّة المدروسة إيديولوجيًا. فمن أوهامهم الموروثة والمسوّغة حتّى اليوم تصوير الغزل ممكنًا فقط بعزل النّساء عن الرّجال، وهذا وهم لا أكثر – وهنا نكرر دعوتنا لفصل العلم عن الوهم، بفصل الفقه عن الجسد باعتباره حاليًا موضوعًا بيوثقافي بيولوجيًا اجتماعيًا- وتطرّفهم في هذا المنحى العقابي والرّقابي لعادات الجسد الأنثوي، أو بكلام علمي، لوظائفه المتعدّدة بتعدّد مراياه الخلويّة التريليونيّة (مئة تريليون خليّة- نكرر للتذكير بواقع الجسد البشري). وهنا لا نوافق ريتا فرج على تمييزها المتسرّع بين الحبّ الحرّ والبغاء أو حتّى الزنى المرتبط بثنائي الأنا والهنا، إذ هما واحد، ويحيل كلاهما على “حريّة الرّجل والمرأة في الحبّ والشراكة” (ريتا فرج، امرأة الفقهاء، م.س، ص 19). لماذا؟ لأنّ البغاء هو ابتغاء جسدين معًا، فهو إذن حبّ وجنوسة نفسيّة، وهو فقط مختلف عن الجنوسة الاجتماعيّة (الزواج – النكاح)، ولأنّ الزنى هو تزيين الشريكيين بجسدهما لما يعتمر في نفسيهما، خارج أوابد أو قيود الجماعات الناظمة للجنوسة والسياسة معًا. وعليه، تدعو البيولوجيا إلى مساواة وظيفيّة بين جنسين لا يختلفان عن بعضهما إلّا بنسبة 1% (A D N) ، وبنسبة 30% جينيًّا. ومن هذا التفاوت الأخير، سينشأ تفاوت بيوثقافي بين الشريكين العتيدين. للمثال نذكر المفارقة بين التّوهم الإيديولوجي والتّشريح البيولوجي للدّماغ: يخال إيديولوجيًّا أنّ المرأة تصدق ما لا تراه، فيما لا يصدّق الرّجل ما يراه (امرأة الفقهاء، م. س، 32) وتاليًّا على الرّجل لكي يصدّق بالله أن يصدق امرأة “تملك معرفة عن الحقيقة تسبق وتفوق معرفة المؤسّس نفسه” بوهم أنّ الإسلام بدأ في حضن امرأة حبيبة (وهذا ما ينفيه هشام جعيط- محمد في المدينة، تعريبنا، دار الطليعة، 2015). ويؤكّد التّشريح البيولوجي أنّ دماغ المرأة والرّجل واحد في تصديق ما يصله فورًا، ثمّ ينقد عليه ويكشف انخداعاته وتوهّماته.
البدويُّ والحضَريُّ
يُخال في القبيلة السيفيّة أنّ الذَّكر سيفها ورمحها، وأنّه تاليًّا مركزها؛ وعليه، جاء الفقه الذّكوري امتدادًا لإسلام بدويٍّ مناهض للإسلام الحضَريِّ (مكّة والمدينة)، إذ جعل – منذ عمر بن الخطاب إلى ابن تيميّة – “السلطة الذكوريّة/ الدينيّة لا ترى العالم الأنثوي إلاّ من خلال الإشباع الجنسيِّ...” (امرأة الفقهاء،.م.س، 66)، وبذلك سيطرت اللّغة العنفيّة على فتاوى ابن تيميّة الحنبلي، بقدر ما جُعل الحبّ أو الجنوسة “منفعة ذكوريّة”، إنعاكسًا للفهم البدويّ المسيطر على مدونات الفقهاء – وهنا معنى للبدوقراطيّة. إنّما قوبل سحر الأنوثة، في النّمط القبلي، بزعامة ذكوريّة تسوّغها ثقافة الجنوسة البدويّة: “الجنس الصحراوي” يقابله “الحبّ البدويُّ”، و“ثمة مصادرة لعقل المرأة وحواسها وإحالة جسدها على الحقل الجنسيِّ، أي محاولة تنميطها وحصر مشاعرها وعقلها في المتعة الجنسيّة (م.ن، ص 69). ونرى ذلك نتاجًا إنحرافيًّا لاسقاط التدبير، لتعطيل العقل، والاكتفاء بإعمال اللّحم المؤدلج في ألف ليلة وليلة: أكل اللّحم، ركوب اللّحم، ودخول اللّحم في اللّحم... وهذا ينم عن إسقاط الحبّ وخفضه إلى نَيْك متطرّف.
في مرايا الإسلام الحضَريّ، كما قدّمه محمد وحيًّا/ وعيًا في قرآن، هناك تلطيف التّطرف الجنسيِّ البدويِّ، (الطعن والسَّلّ) ودعوة معاشرتهنّ بمعروف وإحسان ومودة. لكنّه تلطيف نفسي، لا اجتماعي، بمعنى أنّ واقع الجنوسة العربيّة لم يتغيّر من اللاّمساواة إلى مساواة بين الجنسين – إذ أنّ إبقاء حقّ التعدّد للرّجل، دون المرأة، ينمّ عن لاوعي لتعدّد جنوستها، كما الرّجل. والحال كيف تُبنى هُويّة على الهو أو الهذا، مع إنكار الهي أو الهذي؟ من هنا صدر النّقض في مبنى الهُويّة الإنسانيّة عند العرب، بدوًا وحضرًا، إذ لا يعتدّ سوسيولوجيًّا بالفرادات والاستثناءات. ما حدث تاريخيًّا، واقعيًّا وسياسيَّا، هو عزل المرأة العربيّة بمعنى”قولبة الجسد الأنثوي وفق تصوّرات تُرضي السلطان الديني والسياسي (...) وبمعنى أنّ تزايد ارتداء الحجاب يرمز إلى أمراض سياسيّة واجتماعيّة مكبوتة تُعاني منها المجتمعات العربيّة. والأخطر في مناهج عزل النّساء تحويل العادات (عادات الجسد) إلى عبادات، إذْ كرّست المؤسّسات الدينيّة كلّ مظاهر الفصل الحادّ بين الذّكر والأنثى“(م.ن. 114).
تماثُل المسيح ومحمد وتشاكل بولس وعمر
في ابتكار جمالي أصيل، تُضفي ريتا فرج على بحثها العلمي الرصين إفتكارًا أدبيًّا رهيفًا على تماثل المسيح ومحّمد في تعاطيهما مع المرأة؛ ولكنّها تكشف التشويه لصورة المرأة في مرايا اللاّمساواة، الّتي عكسها على المسيحيّة والإسلام، تشاكلُ بولس وعمر – ونحن نضيف أنّهما كانا في ذلك، هما ومَنْ اتّبعهما من لاهوتيي العنوسة ومن فقهاء الجنوسة، ضحايا التّصوير التوراتيّ لمرأة شبحيّة، وهميّة مكروة بشدّة:” تتناقض نسويّة المسيح وانتصاره للمرأة مع نظرة بولس الرّسول إليها، فهو قد مارس الدور نفسه الّذي اضطلع به عمر بن الخطاب في الإسلام، بحيث اقترنت الأنثى عنده بالخطيئة والدّنس، لهذا كان له موقف حادّ من الزواج...“(م.ن، ص 116). لكنْ، ما هو هذا الدور المتطّرف، تروي ريتا فرج أنّ عمر كان إذا رأى أمَةً مختمرة ضربها وقال:” أتتشبهين بالحرائر؟“هنا نكتشف أنّ الجامع المشترك بين بولس وعمر هو إصرارهما على اعتبار النّساء نمطين، إماء وحرائر عبدات ومعبودات... وأنّه كان الكشف للعبدات، والسّتر للمعبودات... السّتر بقناع للوجه، فلا يُرى منه سوى ما يُتيحه الوصواص ( ثقبان في الغطاء، ترى المرأة الآخر والعالم، من خلالهما)، بوهم”وجود“علاقة تبادليّة بين الفم والفَرْج، وتاليًا بين العورة والحجب (م.ن، 122). والحال هل يُعدّ بولس وعمر من مؤسسي العُوَار (كُره العورة) في المسيحيّة والإسلام؟ هذا الأمر يستحقّ بحثًا أدقّ، وأجدى بيولوجيًّا- طالما أنّ التّعدد سمة مشتركة بين الإناث والذّكور، وطالما أنّ العائلة الوحدانيّة الصرفة، حتّى المقرونة بمنع التّسري (عند أبي ذر الغفاري والاسماعيليين والقرمطيين والدروز...) هي مجرّد افتراض نظري، نجده محصورًا في أفراد أو جماعات فاردة (راجع هامش. م.ن، ص 124)، فضلاً عن التراجع عنه، كما حدث في ليبيا ما بعد القذافي – الّذي كان قد شرعن الزواج الآحادي – أو كما حدث في تونس أو تركيا (زواج آحادي مقرون بالحبّ الحرّ أو التّسري ). وأمّا العفّة بكلّ تشكلاتها فهي منافية لقانون التّعدد البيوثقافي لجنوسة الجسد – فالعفّة القهريّة عنوفة، فيما العفّة الاختياريّة عُنوسة، حتّى في سياق”الرهبنة“الممنوعة في الإسلام، وقبله في المزدكيّة والزرداشتيّة...” إنّ العفّة ليست بيولوجيّة منظورة، بل لا مرئيّة، وجدانيّة وكامنة، وما قيمتها إذا كانت قائمة على القهر وليس على تعلّق المرأة بزوجها واحترامها له“” ( قاسم أمين: تحرير المرأة، مذكور عند ريتا فرج، م.ن، 126).
أدلجة الجسد
نشير إلى أنّه “لا مذهب للجسد” ونلاحظ أنّ البنى القبليّة في “أرض الخرافة” جعلت النّاس يعيشون ويموتون خوفًا من “خافي الألطاف” فيعتمدون في الأرياف والمدن العربيّة على حركات “إسلامجيّة” اتّخذت من الحجاب/ النقاب رمزًا لأصوليّة جنسانيّة تدّعي “أسلمة الجسد” فيما تستعمله في حروبها القوميّة العلمانيّة، فتؤدلجه إلى أقصى حدّ. وبدلاً من مجتمع شراكة، نجدنا مجددًا أمام مجتمعات انفراديّة يفجّرها البترو دولار السعودي الإيراني، لكن من وراء حجاب أو نقاب، من وراء تشادور سياسي، تُزهق عنده أرواح المسلمين، وفيه تستغلّ أخسّ مشاعرهم وأحطّ غرائزهم. القتل على الهويّة الإيديولوجيّة، بدءا من عزل الجسد الأنثوي تمهيدًا لنكاحه.. الجهادي تارة و“الاستمتاع العبادي” تارات: “أحدثت الثورة الإسلاميّة في إيران 1979 انقلابًا جذريًّا... فقد أعادت إلى الأذهان صورة المرأة السعوديّة المعزولة؛ وهنا يبدو النظامان الإيراني والسعودي متشابهين في تعاملهما مع النّساء (...) إذ الجامع المشترك بين الحركات الإسلاميّة كافّة هو النظر إلى جسد المرأة باعتباره عورة من جهة، ومركزًا لاشباع حاجات الرّجال الجنسيّة من جهة ثانية، ويستمدّ التركيز على جنسانيّة الأنثى في الإسلام إرثه من العادات البدويّة والمحركات الفقهيّة” (امرأة الفقهاء، م.س، 134). وفي مصر راجت “المُحجابتيّة” وأنتجت ظاهرة حجاب الملكيّة، مقابل حجاب الموضة.
وتخّلص ريتا فرج إلى أنّ أدلجة الجسد أفضت إلى ظهور امرأة الإسلام، إذ آثر جزء من النّساء البقاء خارج الحريم المجتمعي، وخرق جزء آخر عالم الذّكورة بحجاب أو بدونه: “والحجاب بمفهومه الفقهي والتّاريخي يهدف إلى عزل النّساء عن المجال العام الّذي كان حكرًا على الرّجال، وهذا ما يُقلق المنظومة البطريركيّة؛ الأنثوي الّذي اقترن بالمقدّس خرج من هياكل التّقديس السلبي إلى رحاب جديدة، منافسًا الذّكور الّذين يحتكرون النفوذ، وهو يُمارس اللّعبة ذاتها عبر استخدامه المقدس لإثبات الذّات، كما أنّ ثنائيّة المقدّس/ الأنثوي تدلّ على توتر الأنثوي ورفضه الضمني للحدود الجندريّة الّتي أقامها الفقهاء بين الذّكور والإناث” (م.ن، 150-151). وتختمّ فرج بإبراز علاقة متوترة بين الأنثوي والسياسي في الإسلام التاريخي، علاقة قابعة في اللاّوعي الجمعي والتاريخي والأسطورة، ولا ترتبط بعموم النّص القرآني المفتوح على التّأويل، بل تتجلّى في معالم الإقصاء لدى الفقه الذّكوري الّذي وقع فريسة الأنا الذّكوريّة. (م.ن، ص 172).
أزمة الشراكة في الحبّ
تعود هذه الأزمة المزمنة إلى احتكار ذكريّ للجنوسة في المجتمعات العربيّة، حيث ما انفك الذّكر يطلب أنثى عذراء يتّخذها زوجة، ولو أحبّها ومارس الحبّ معها قبل الزواج؛ الأمر الّذي يجعل الأنثى تحرص على غشاء بكارتها لتهديه إلى أب عذريتها. وهذا يشي بطغيان ثقافة البغاء على ثقافة الحبّ الحرّ في عادات الزواج: فما يرتضيه الذّكر للأجنبيات “ذوات الرايات” “المومسات” و “الجواري” لا يرتضيه للعربيات “وإن فعل بهنّ”. وفي كلّ حال يرتدي الجنس عند العرب رداء العنف، أي عنفوان الرّغبات الوجوديّة، اللادينيّة؛ ولكنّها تخضع للدين الّذي ينظّمها حين تظهر. وحين تُخفى، ماذا يحدث؟ يُقال: “استتروا” وكأنّ “كلّ مستتر مباح”؟ وطالما أم الومس أو البغاء مهنة إماء، فلا بدّ من تنظيم الزنى أو الحبّ الحرّ. فالزنى العلني مع الجواري مباح، والزنى السري مباح، إذن أين هي المانعيّة؟ تفعل الأنثى في جسدها الخاصّ/ جسد الحبّ، ما تشاء سرًّا؛ ولكنّها تخضع جسدها العام / جسد الزواج/ لرقابة المجتمع وعقابه، لأنّ الزواج تعاقد بين المرأة والرّجل والمجتمع – وهنا دور رجال الدّين. أمّا في الحياة الاجتماعيّة فتتحوّل الحيلة الجنسيّة – حيلة الحبّ بالزنى – إلى عادة جنسيّة (م.ن 179-180). إنّما على مستوى الجسد الأنثوي لا تتحمّل الثقافة الجنسيّة العربيّة الراهنة هذا المقدار من تحرير المرأة لجسدها ومن حريّة تصرّفها به كما تحبّ وتشاء. إذ الانتقال الرّمزي من أنموذج الأنثى المؤودة قبل الإسلام، إلى أنموذج الأنثى المملوكة (من قبل الرّجل ورجل الدّين ورجل الدولة) لا ينمُّ عن تحولات عميقة في مستوى وعي المجتمع لشراكة المرأة- “فمن طبائع الثّقافة الذكوريّة عدم تحمّل الوجود الأنثوي” (م.ن 182) – بل يدلُّ على لامساواة فقهيّة (إيديولوجيّة) بين “الرّجل الأعلى” و“المرأة الأدنى”، كما بين الحاكم الظّالم والمحكوم المظلوم... ولكن يبقى جسد الأنثى خالدًا بجمال جنوسته وبقوّة خصوبته وإنجابه وبتدبيره للأسرة، أساس المجتمعات والدّول. فما يُخال أنّه الأدنى في ثقافة الرّكوب، يتحوّل في ثقافة الحُبوب (جمع: حبّ) إلى قوّة مؤنسنة ومُعلقنة للتّسالم والتّلاطف حتّى بين الذّكور، بواقع التّجاسد أو التّجانس الّذي لا محيص عنه كشرط طبيعي وضروريٍّ لاستمرار الجنس البشريِّ. وعليه يمكن الكلام على قوامة أنثويّة، بالحبّ، على الذّكورة؛ قوامة خفيّة بلطافتها، شعاعيّة بل كهربائيّة بموجاتها الإشعاعيّة وبجاذبيتها الجماليّة... إذ لا معنى للذّكر بلا أنثاه، وبالعكس. أمّا ما تسميه ريتا فرج “وأد الأنثى للأنثى” أو “العنف الأنثوي معكوسًا” (م.ن، 205) فهو ظاهرة جزئيّة، شاذّة، ولا تعبِّر عن أحوال المرأة العربيّة المعاصرة، “نخلة الحريّة” في الواحات و“قطرة الدّم” في الصحارى. ويخطيء من يخال أنّها مصابة بالرّهاب العقائديِّ الجنسيِّ، ويتوهّم أنّها تتعامل مع جسدها بوهم “عوراته” – لكنّها شروى الذّكر “تحبّ وتكره معًا”. وهذا من طبائع الجنس البشريِّ والحيوانيِّ وكلّ مخلوق، وليس فقط من طباعها أو من وظائف جسدها. وبالعكس نجدها في الواقع تستثمر لذاتها على طريقتها فتعلن حبّها على الرّجل حينًا وتستره حينًا، بمقتضى كبريائها وكرامتها ومرؤتها. يبقى أنّ التّهويل على المرأة الحرّة بإناث خاضعات هو نتاج سلطة مُقامة على قوادي المال وقوادات الجنس. وترى ريتا فرج أنّ خطاب الحركة النسويّة العربيّة و / أو الإسلاميّة يرتكز على مفهوم قرآني للمساواة بين الجنسين (زواج النّفوس) كجزء من المساواة الخَلْقيّة (من نفس واحدة) بين البشر؛ فتدعو هداية توكسال إلى إلغاء الأحاديث النبويّة المعادية للمرأة من منشورات دائرة الشؤون الدينيّة التركيّة. وبذلك تبرئ محمدًا كما المسيح من “شيطنة المرأة” وتعزو ذلك إلى “إيديولوجيّة الفقهاء والعادات البطريركيّة” (م.ن، 228-229). ونحن نعزو ذلك، من جهتنا، إلى مسارات التّطور البشري، إلى الأطوار المتراكمة واللاّمتوازيّة (الحيونة، الألهنة، الشيطنة، الأنسنة – ونضيف هنا مكننة الجسد وتطبيبه أو تزينيه). أمّا وهم “المساواة المطلقة بين الرّجل والمرأة” - كما تطلقه آمنة ودود وأسماء برلاس في “المؤمنات في الإسلام” - فهو من صنع الخيال الإيديولوجي الّذي يتصوّر النسبي مطلقًا والجزئي كُلاًّ... سيكون من المفيد أكثر درس الواقع وتطوّر الجسد بكلّ تجلياته، طالما أنّ التّسويغ الإيديولوجي للجنوسة يزور أو يبرر أكثر ممّا يفسّر، ويكفي أنّه يعزو أفكار البشر إلى آلهة وخفايا، لا إلى أنفسهم.
فصل العلم عن الوهم
المساواة، كما السلطة، تؤخذ غلابًا، وفي الفراش تؤخذ بقوّة الحبّ أو الجنوسة العالمة والثاقفة، فقد أوصلنا التّطور إلى أنسنة الجسد، بقدر ما انفصل العلم عن الوهم. أمّا مقارعة اللاّهوت الذّكوري بلاهوت أنثويّ (الكلام على ربّات أو آلهات) فلن تفضي إلى غير مقارعة لفظيّة، خارج الجسد الحيِّ، جسد الحبّ، المحرِّك لفيض من المعقولات والمخيولات (ميثولوجيا التّأويل القرآني الّتي عزّزها الإسلام الفقهي تحديدًا في قصّة الخلق (م.ن، 235). فالجسد الإنساني يحتاج، عند العرب وسواهم ممن أُبتلوا بثقافة الاستبهام، إلى تشريح بيولوجي، إلى استفهام علمي/ تاريخي، لا إلى تبرير إيديولوجي ولا إلى تزوير ميثولوجي بتأويل لفظي، يقدّس أوهامه بأوهام مضافة. حتّى التّأويل الشكوكي أو الارتبابي بكلّ “أشكال التّفسير الّتي تهمّش المرأة أو اهتماماتها” الّذي اعتمدته الباحثة الكنديّة ناومي غولدنبرغ لتفكيك الرابط المتخيّل بين الذّكورة والألوهيّة“حين افتحرت مصطلح”تيالوجيا“(Thealogy) بدلاً من تيولوجيا (Theology) لا يقدّم بديلاً من التّشريح العلمي في عصرنا. ففي عصور سابقة، لا سيّما عصور الحيونة والألهنة والشيطنة، جرى تغييب الأنثى في اللاّهوت اليهوديِّ والمسيحيِّ. وأمّا اليوم فالمشكلة مختلفة: أنسنة الجسد أو مكننته؟ طبعًا إلى جانب مشاكل إيديولوجيّة متراكمة في مجتمعات ما زالت تجترّ ثقافة الأبّا (Abba) والأمّا (Ama) ، ثقافة الخلق الفردوسي الموهوم ولا ترى ما يصنعه الخلق على الأرض. هنا لا فرق بين الفقاهات الدينيّة والفقاهات المضادة لها. فالعلم يدعو إلى درس الواقع كما هو، وليس من واجبه الردّ على مستوهمين/ حائرين. العلمُ يُعلِّم ويُحرِّر، فيما الوهم يستذكر عبوديات الماضي ليصطنع منها زخارف (ديكورات) لعبوديات الحاضر، وسدّ الأفق أمام التّحرير الّذي يتيحه إعمال العقل في معاملة اللّحم والأبدان. ولا نفهم لماذا أخاف ريتا فرج من الدّعوة إلى القطيعة مع التّراث الفقهي، وجعلها تدعو صراحة”إلى اعتماد القرآن كمرجع أساسي“، وهي عالمة اجتماع، لا داعية إيديولوجيّة. (م، ن، 238 وما بعدها).
إنّ جماليات الجنوسة العربيّة، التعدّديّة، واقعيًّا، عند الجنسين، تنفي ما يتخيّله فقهاء المُحال حول سيطرة الخالق على الذّكر وسيطرة الذّكر على الأنثى. فهذا كلام أدبي، إذْ الجسد في كلّ أطواره هو وحده ولي أمر العلاقة بينهما، وبلا آخر (أنا أعلى رباني أو نبوي) مؤدلج – حتّى نسويّة محمّد مركزها جسده، لا ربّه. وعندنا أنّ فصل المخيول عن المعيوش سيشكل مدخلاً، عند العرب، لدرس الحبّ بعلم، وبمنأى عن كلِّ الأوهام المتوازية أو المضافة. فأنسنة الحبّ/ الجسد مستحيلة بدون عقلنة الجمال الإنساني وعلمنته (أي علمه كما هو، خالقًا بديعًا، صانعًا بدمه وأيضه للحياة والثقافات). أمّا الخوف العربي من إشعاع الجسد فلا راد له بحجاب أو بنقاب، وما على البشر سوى تلقي أشعّة الحبّ، كما يتلقون أشعّة الشّمس والنّجوم، بلا خوف من الموت أو الانطفاء. وأمّا محاولة فاطمة المرنيسي وسواها”أنسنة النّص التراثي دون أن تسقط عنه بعده المقدّس“فهي بنظرنا أشبه بحكاية إبريق الزيت، وطُرفة الكتابة على جليد التّطور أو مزحة استنطاق الأبكم/ الأصمّ أو استبصار العميان الّذين يقودهم أعمى بأوهامه. فالجسد ليس لفظًا يُذَكَّر ويؤنث، إنّه عالم حيّ (مئة تريليون خليّة) يصنع نفسه بنفسه، حبًّا وكراهية. الأهمّ هو أن نعرف ماذا يحبّ الجسد وماذا يكره، ومتى يُسالم ويُغالب. والأجدى النظر إلى المرأة، كما هي بيوثقافيًّا: صانعة الحياة، خالقة الرّجل من رحمها، ومؤسّسة للعائلة والدولة، ولا يضيرها كثيرًا الاعتراف بها أو إنكارها فهذا الإحراج حسمه العلم، لا سيّما البيولوجيا، وعلينا من الآن فصاعدًا درس الجسد بتكنولوجيا العلوم لا بإيديولوجيات الأوهام الغابرة. إلى هذا تخلص ريتا فرج حين تفسّر رمزيّة كشف وجه الأنثى:” من حيث الدلالة الأوليّة يشير سقوط الحدود والمساواة بين الجنسين؛ فالكشف المقرون بالفتنة سقط مع السلطة السياسيّة، وهذا يعني أنّ الأنثوي يتحوّل إلى قوّة ذكوريّة حين تحتلّ المرأة المشهد السياسي فتنزع الحجب بين عالم الحريم الثقافيِّ/ الافتراضيِّ والفضاء العام“(امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة، 256).
الحاصل أنّ أنسنة الجنوسة أفضت في عصرنا إلى أنسنة السياسة جزئيًّا بقدر ما تمكّن العلم من تطوير الجنوسة كمسألة واقعيّة راهنة، من وراء وصاوص الإيديولوجيات الجنسيّة/ السياسيّة. هنا تستدرك ريتا فرج وجهًا متحرّرًا من وجوه”الفقه الشيعي“، فتستشهد بالسيّد محمد البجنوردي:” بعد التحقيق الدقيق في الروايات والآيات وأقوال الفقهاء، وفهم طبيعة القضاء الّذي هو رفع الخصومة بين المتخاصمين أو إحقاق الحقّ في الدعاوى الحقوقيّة والماليّة وإجراء الحدود في المسائل الجزائيّة، وجدتُ أنّ هذا المعنى لا يتمّ إلاّ بالعلم والحكم بالعدل، وهذا أمر لا علاقة للجنس به (فحينئذٍ نقول بصراحة): للنّساء أن يتصدين لأمر القضاء (...) ولا فرق بين الرّجل والمرأة في أصل الاجتهاد والإفتاء“(م.ن، 258-259). ومع ذلك تستمرّ الفجوة بين الأنثوي والسياسي، فالتّجسير اللّفظي لا يقوم مقام التّجسير الواقعي. حاليًّا، يُقاس”إنصاف المرأة إسلاميًّا والتّمسك بفكرة المساواة الإنسانيّة والأخلاقيّة والدينيّة يحلان محلّ الدّعوة إلى المساواة المطلقة بين الجنسين (م.ن، ص 264). ويبقى على التّطور أن يعلمنّ ويؤنسنّ المساواة، بحيث تُقاس المساواة بميزان العلم أو العين، بعدما أفضى ميزان الوهم أو النقل إلى هذه اللاّمساواة بين البشر. وهذا ما تدعو إليه آمنة ودود، الأميركية/ الأفرقيّة (1952) المتحوّلة إلى الإسلام (1972) للخروج من قمعها المزدوج “كونها امرأة وأفريقيّة”: “نحن نبحث عن التّكامل مع الرّجل لا عن الصراع معه (...) نحن لا نريد أن نكون غربيّات حديثات وإنّما مسلمات حديثات (م.ن، ص 269) أي متعلّمات/ عالمات، حرّات لا مرتهنات لماضٍ سرابيٍّ. أمّا خرافة”عذريّة متجدّدة مقابل ذكورة فحوليّة متجدّدة“فهي من أدب الخيال الفردوسيِّ ولا علاقة لها بالحبّ الجنوسي الأرضي.
حاليًّا يدور الصراع الإيديولوجيُّ الجنسيُّ/ السياسيُّ الدينيُّ/ حول المساواة واللاّمساواة بين البشر كافّة، بين نساء يحتوين رجالاً ورجال يحتوين نساءً... والبقيّة جعدنة (salade des mots) إذ لا دين آخر للجسد سوى أيضه الحيويُّ والعقليُّ. أمّا العُوار، وَصْوَصة المرأة الوهيمة، فهو مرض إيديولوجيٌّ يحتاج إلى معالجة المصابين به، طبيًّا ونفسيًّا، وليس إلى سجالات هذيانيّة مع عُواريين لا يميزون وجه الجسد من فرجه، ولا يعرفون الفرق بين القضيب والفجل.
الحقيقة واحدة
وبعد، هو ذا كتاب علميٌّ صارم وضعته باحثة لبنانيّة آكاديميّة، دفاعًا عن حريّة العقل، لكن بلا صدم أو تصادم؛ تقول:”إنّ العودة إلى الأدبيات الفقهيّة الّتي خرج بها الفقه التقليدي، تكشف لنا عن سلطة العزل الذّكوري/ الفقهيِّ، وتشي بأنموذج المرأة المقهورة والموؤدة بفعل الخطاب الدينيِّ السلطويِّ الّذي تنبع جذوره من منظومة بطريركيّة قائمة على مركزيّة الذّكر أي المركزيّة القضيبيّة مقابل عالم أنثوي بارد وهجين/ سلبيٍّ وغير فاعل“. ( م.ن، 324) – ولكنّه بيوثقافيًّا ليس كذلك ولو أنّه كان هكذا، لما بقي من العرب والمسلمين ديار واحد. وإنّما” لم تؤسس المجتمعات العربيّة لثقافة الحبّ والشراكة، حيث يستوي الذّكر والأنثى في التّعبير العاطفيِّ والفكريِّ والاجتماعيِّ، بل لثقافة الفتنة والعورة والوأد المجتمعي والتّسلط البطريركيِّ والرّقابة الذكوريّة على أجساد النّساء“(م.ن، 325). ينمُّ كتاب ريتا فرج عن انعطافة في البحث عن الحقيقة الواحدة وعن إعلانها بحقّ وحرية الوعي النّسوي، وتقديم”رؤية بديلة للنّظام الاجتماعيِّ السائد بحيث يتمتّع كلّ من النّساء والرّجال بالاستقلال وحريّة اتّخاذ