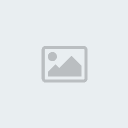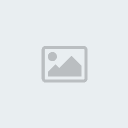
يستعصي على الفهم ما آلت إليه المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، من تخلف وجمود فكريين يهيمنان على مختلف جوانب الواقع العربي الإسلامي. وكم هو عجيب حال هذه المجتمعات في إحساسها بحقيقة ما هي عليه إثر اتصالها بالثقافة الغربية في صيغتها الحداثية، بعد ما كانت تغط في نوم عميق، غافلة لا تدرك هول المشاكل المحدقة بها من كل جانب. وبعد اجتياح الثقافة الأوروبية لها لحقها نوع من التشظي والانشطار في ما يتعلق بواقعها؛ الذي أصبح واقعاً يتنافس عليه، ويصطدم فيه ويتصارع، صنفين من المعطيات: أولا: صنف موروث من الماضي، وتثنية: صنف وافد من حضارة غيرنا، فُرِض بقوة، و ينتمي بكليته إلى الحضارة الغربية الحديثة. أمام هذه الشروخ التي نجمت عن صدمة فكرية قوية، كان حري أن تُتخد مواقف فكرية تجاه ما هو حاصل، فظهرت مشاريع فكرية لمفكرين مسلمين تروم التغيير، وتجاوز المألوف وما هو معمول به، هذا المألوف يشكل التراث-الذي يشكل النص الديني جوهره ومرجعيته ودعامته الأساسية. والحال أن تغيير الواقع، يقتضي-أول ما يقتضي-قراءة ما يشكل هذا الواقع من تراث ونص ديني، فكان هذا هو منطلق هذه المشاريع الفكرية الموسومة بالتحديثية. ولعل أبرز المشاريع الفكرية التي نمت على ضرورة التحديث، من خلال قراءتها للثراث وللنص الديني، نلفي مشروع محمد أركون.
يعتقد محمد أركون أن التراث الإسلامي-منذ انبثاقه في لحظاته التأسيسية الأولى-لم يعالج ضمن إطار التحليل والفهم النقدي ، والذي من شأنه أن يزيح اللثام عن المنشأ التاريخي للوعي الإسلامي وتشكل بينيته. والحال أن كل ما أنتج في فترة ما يسميه أركون بالعصر التدشيني قد انصب كله على النص الديني، ففي “هذه الفترة ظهرت علوم الفقه وعلوم الشريعة...الخ، ودخلت الفلسفة إلى البيئة الإسلامية، وحاول جل الفلاسفة الجمع ما بين العقل الديني والعقل الفلسفي عبر تأويل النص الديني” (1).
ويقدم الخطاب القرآني نفسه-في نظر محمد أركون- “كحداثة تغيير كل شيء قياسا إلى العقائد والعادات التي سادت قبله، حيث رُمي التراث العربي السابق في دائرة الجهل والفوضى والظلام، ليقدم في مقابله التراث الإسلامي استنادا إلى النص الديني الذي بلور ملامحه”(2). أمام هذه الوضعية الجديدة-أو لنقل أمام هذا التراث الجديد-هل ينبغي دراسة التراث استنادا إلى التحديد الأصولي الدوغمائي الذي يضفي على التراث نوعا من التعالي والتقديس؟ أم أنه يجب علينا إعادة التفكير في التراث بصفة علمية وبالتالي اعتباره صيرورة إجتماعية وتاريخية؟
والحق أن محمد أركون يعتبر “النص القرآني جزء من التراث، وليس نصا مفارقا متعاليا منفصلا عن هذا التراث، كما ذهب إلى ذلك جل المواقف الفكرية بما فيها تلك التي تتبنى المناهج المعاصرة في قراءتها لتراث” (3). وإن اعتبرنا النص الديني جزءا من التراث، فهذا يعني أن قراءة النص الديني تندرج داخل القراءة أخرى أعم هي قراءة التراث.
تاريخية النص الديني:ولئن يدرج محمد أركون النص الديني ضمن التراث الإسلامي، فإنه في موازاة ذلك يضع صفة القداسة جانبا ليبرز حقيقته التاريخية(4)، وهو يدرك أنه ما أمكنه ذلك إلا إذا قام بتفكيك المسلمات التي ينطوي عليها التفسير التقليدي للخطاب القرآني، لأن المسلمات اللاهوتية تؤدي إلى أسطرت القرآن برفع عباراته إلى التعالي المقدس، فتفقد صفتها التاريخية وعلاقاتها بالظروف التاريخية التي ظهرت فيها“(5)، إنها تُنصب النص الديني كمرجعا أعلى ونهائي لكل البشر، وتجعله يحتوي على الاجوبة والحلول النهائية للأسئلة التي يطرحونها في كل زمان ومكان، وتعتبره كلام يتعالى على التاريخ، ويحتوي على الحقيقة المطلقة. في مقابل هذه المسلمات اللاهوتية، تسعى القراءة الاركونية النقدية للنص الديني إلى تجاوز طابع التقديس عن النص القرآني، وربطه بشروطه التاريخية واللغوية والثقافية، وتهدف إلى نزع كل خطاب أيديولوجي عن كل تركيباته الفكرية والعقائدية، وتأخد بعين الاعتبار الواقع ومتغيراته، وتستلهم العلوم الإجتماعية والإنسانية، وعلم الأديان المقارن، والأنثروبولوجيا الدينية كمناهج علمية.
إن تعامل أركون مع النص القرآني-وهو النص المؤسس للثقافة العربية الإسلامية-يقوم أساسا على إعادة النظر في قداسته، والكشف عن آليات تعاليه، من خلال البحث في طبيعته اللغوية، ومشروطيته التاريخية، وكيفية تكونه، ومراحل تكونه واستقراره على الصورة التي هو عليها اليوم. فما يهم أركون ليس النص كوحي إلهي، وإنما يهمه الخطاب القرآني المنزل وفق حركة عمودية مجسدة في لغة بشرية شفوية في البداية، ثم مكتوبة بعد ذلك.
والحال أن قراءة النص الديني قراءة علمية تعني مقاربته بصفته تركيبة لغوية واجتماعية مؤطرة من طرف جماعات وعصبيات تاريخية،”فما كان قد قُبل وفُسر وعُلم وفُهم بصفته الوحي في السياقات اليهودية والمسيحية والإسلامية ينبغي أن يدرس أو يقارب منهجيا بصفته اجتماعية- لغوية مدعمة من قبل العصبيات التاريخية المشتركة“(6)؛ أي دراسة النص الديني في تجليه الأرضي البشري الذي يتيح لنا معرفة ظروف صياغاته.
لقد استخدمت النصوص الدينية-خصوصا النص القرآني-من قبل التيارات الأيديولوجية كذريعة للهيمنة على بقية المجتمع، فالتفاسير المختلفة عبر تاريخ القرآن ارتبطت بشخصيات محددة، والتي ترتبط بدورها بفئة إجتماعية تتنافس على السلطة ولها خطها الأيديولوجي، والفئة التي تنتصر تفرض خطها التأويلي على كافة المجتمع دون استثناء. ويهيمن على هاته التأويلات المبالغة الأسطورية اللاتاريخية بدل الوعي التاريخي، ذلك أن الفكرة المسيطرة على الوعي الإسلامي تقول بإمكانية تفسير القرآن تفسيرا نهائيا وصحيحا، يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان، في حين”أن القرآن عبارة عن مجموعة من الدلالات الإحتمالية المقترحة على البشر، وبالتالي فهي مؤهلة لأن تثير وتنتج خطوطا واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر تنوع الأوضاع والأحوال التاريخية التي تحصل فيها أو تتولد فيها(...)فهو نص مفتوح لا نهاية له، ولا يمكن لأي تأويل أو تفسير ان يغلقه ويدعي الحقيقة فيما أوله “(7). غير أن جل المفسرون الذين اشتغلو على النص الديني لا يعون بتاتا أن التفسير الذي أنتجوه هو في الحقيقة له ارتباط بطريقة مباشرة بثقافة وحاجيات المجتمع الذي يعيشون فيه، وله علاقة بالقوة الأيديولوجية التي تسيطر.
النص الديني: من الخطاب الشفوي إلى الخطاب المكتوبلقد سبق وألمعنا أن محمد أركون يريد تجاوز القراءة التراثية للنص الديني، لكن ما كان له أن يدرك ذلك إلا إذا تجاوز المسلمات التي تتكئ عليها التفاسير الإسلامية للنص الديني، التي تخلط بين مفاهيم عدة، فلا تفرق بين الظاهرة الإسلامية والظاهرة القرآنية، ولا تعي الاختلاف البين بين النص في المرحلة الشفوية والنص ككتابة، والحال أنه-بحسب أركون-ليست الظاهرة الإسلامية من الظاهرة القرآنية بشيء، وليس يمكننا الحديث عن المرحلة الشفوية للخطاب الديني بنفس مقاييس ومقادر حديثنا عن المرحلة الكتابية له، فالفرق بين والبون شاسع. وفي سبيل الزحزحة المنهجية والإبستمولوجية للفكر الديني والنص الديني من الأرضية اللاهوتية التقليدية إلى أفاق البحث المتحرر عن المعنى، يقترح أركون التمييز بين المرحلة الشفوية ومرحلة المدونة النصية. فيمييز أركون بين الخطاب الشفهي والنص المدون، فأما الخطاب الشفهي فهو العبارات التي تلفظ بها النبي طيلة عشرون عاما، في ظروف زمنية ومكانية، وهذه العبارات رافقت الفعالية التاريخية للنبي المتنوعة والخصبة. والحق أن محمد اركون يلفت الإنتباه إلى”المشروطية اللغوية والثقافية والإجتماعية لإنتاج هذا الخطاب من قبل متكلم ما، بلغة ما، هي هنا اللغة العربية، في بيئة ما هي الجزيرة العربي، ثم استقبله لأول مرة في التاريخ جمهور ما: هو الجمهور القرشي في مكة“(8).
ولئن كان الأمر كذلك، فإن”عملية الإنتقال من مرحلة الخطاب الشفهي إلى مرحلة الخطاب المكتوب(المدونة النصية الرسمية)، لم تتم إلا بعد حصول الكثير من عمليات الحذف والإنختاب والتلاعبات اللغوية التي تحصل دائما في مثل هذه الحالات، فليس كل خطاب شفوي يدون وإنما هناك أشياء تفقد أثناء الطريق، نقول ذلك ونحن نعلم أن بعض المخطوطات قد أتلفت كمصحف ابن مسعود مثلا، وذلك لأن عملية الجمع تمت في ظروف حامية من الصراع على السلطة والمشروعية“(9). وهذا الأمر تثبته الألسنيات الحديثة، حيث يقول أركون:”أن من أهم المكتسبات ذلك التمييز الذي تقيمه الألسنيات بين النص الشفهي والنص ذاته بعد أن يصبح مكتوبا فهناك أشياء تضيع أو تتحور أثناء الإنتقال من المرحلة الشفهية إلى المرحلة الكتابية“(10).
وأركون إذ يطرح إشكالية الإنتقال هذه، فهو يرمي إلى”تحديد المكانة المعرفية للمعنى المُنتج على المستوى اللغوي والتاريخي للخطاب الشفهي، والتمييز بينهما وبين المكانة المعرفية للخطاب المدون أو المكتوب، وهذا الشيء يعرفه علماء الألسنيات بشكل خاص عندما يتحدثون عن الظرف العام الذي قيل فيه الخطاب الشفهي لأول مرة“(11). ويقول بور ريكور بشأن الكتابة:”هي تثبيت الخطاب في حامل خارجي يختلف عن الصوت، وهذا إنجاز ثقافي هائل، إذ يختفي فيه الواقع البشري وتنوب عنه علامات مادية في نقل الرسالة وهو إنجاز يُعنى بطبيعة الخطاب أولا، ثم بالمعنى ثانيا، فلأن الخطاب وحده يوجد في لحظة زمنية حاضرة من الخطاب فقد يُفلت الكثير“(12).
يسترعي اهتمام أركون -في هذا المجال-”الصراع القائم بين العقل الشفهي والعقل الكتابي، فالعقل الكتابي هو الذي يفرض على المجتمع مقولاته وتحديداته ونظام حقائقه بواسطة ذلك التضامن الوظائفي الشغال والفعال بين أربع قوى، وينتهي بها الأمر إلى الهيمنة على كل الساحة الإجتماعية؛ أي كل المجتمع، وهذه القوى هي: الدولة والكتابة والثقافة العالمة والأرثوذوكسية الدينية“(13)، والتحالف بين هذه القوى الأربع هو الذي يحقق الإنتقال من مرحلة الكتاب بالمعنى التيولوجي إلى مرحلة المدونة الرسمية المغلقة؛ أي أن”المدونة الرسمية المغلقة تصبح عبارة عن كتاب مادي مُنتج عن طريق تقنيات الحضارة، ولكنه على الرغم من ذلك يبقى على مستوى القداسة المثبتة والمحمية من قبل سلطات ذات جوهر سياسي“(14). فالوحي أمر إلهي لا مراء في ذلك، لكن النقد الأركوني يتموضع خارج إطار المقدس ويتوجه صوب الظرفية التي تفاعل فيها الجسد الإجتماعي مع هذا الوحي، ومن تم يصبح شأنا بشريا، يجب التفكير فيه من أجل تعرية الغبر والمطمور.
تأسيسا على ما سبق، نخلص إلى أن النص الديني في مرحلة الخطاب الشفهي يختلف أيما إختلاف عما أصبح عليه في مرحلة الخطاب المكتوب، ومتى أدركنا هذا الإختلاف استطعنا اكتشاف الجوانب اللغوية والإجتماعية والسياسية والثقاقية لتلك الظاهرة الشمولية المتمثلة في الكتاب المقدس الذي جرى التسامي به بكثافة شديدة.
الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية:هذا فيما تعلق بالفرق الشاسع مابين النص الديني من حيث ما هو خطاب شفهي، وبين النص الديني من حيث ما هو خطاب مكتوب، الذي يتقلب أطوارا خلال عملية الإنتقال هذه. أما فيما يختص بالتمييز الذي يقيمه أركون بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية، فإنه مثلما يتم التمييز بين التوراة واليهودية، وبين الإنجيل والمسيحية يميز أركون بين القرآن والإسلام، أو بين الحدث القرآنيLe fait coranique والحدث الإسلاميLe fail Islamique، أو بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية. فما وجه الإختلاف بين المفهومين؟ وما دلالة هذا التمييز؟
يشير أركون-في معرض حديثه عن الظاهرة القرآنية-إلى أن أول من إستخدم هذا المصطلح هو ماك بن نبي، ولكن”ضمن منظور تبجيلي تقديسي“(15)، وذلك المنظور هو ما يريد أركون تجاوزه من أجل تحقيق ما يسميه تاريخية النص الديني. فما الذي يقصده أركون بالظاهرة القرآنية؟
يقصد أركون بالظاهرة القرآنية(16) ”القرآن كحدث يحصل لأول مرة في التاريخ، وبشكل أدق أقصد ما يلي: التجلي التاريخي لخطاب شفهي في زمان ومكان محددين تماما، فأما الزمان هو بدايات التبشير، والبيئة الإجتماعية التي ظهر فيها هي الجزيرة العربية“(17)؛ أي أن الحدث القرآني يدل على الإنبثاق التاريخي للظاهراة جديدة محصورة في زمان ومكان محددين. أما الظاهرة الإسلامية فلا”تتفرع عن الظاهرة القرآنية كما يتوهم جمهور المسلمين أو كما يعتقد التراث الإسلامي التبجيلي السائد، فهذا التراث لا يهتم إطلاقا بالنقد التاريخي؛ أي بالتأكد من صحة الأمور والوقائع تاريخيا، وإنما هو يهتم بترسيخ القدوة والموعظة والنموذج الصالح“(18).
والحق أن الحدث الإسلامي يهتم فقط بما هو مقدس في الحدث القرآني لكي يوظفه”من أجل خلع التقديس والتعالي والأنطلوجيا والأسطرة والأدلجة على كل التركيبات العقائدية والقوانين التشريعية والأخلاقية والثقافية. وكل أنظمة النشروعية التي أنشأها الفاعلون الإجتماعيون(أي البشر)، إن الظاهرة الإسلامية مثلها مثل الظاهرة المسيحية أو اليهودية، لا يمكن فصلها عن ممارسة السلطة السياسية، نقصد بذلك أن الدولة في كل أشكالها التاريخية تحاول أن تستغل البعد الرروحي المرتبط بالظاهرة القرآنية لصالحها“(19). إن أركون يريد أن ينزع صفة القداسة عن الظاهرة الإسلامية، وعن كل منتجاتها التشريعية والفقهية والسياسية...الخ. ويريد أن يقول أنها من عمل البشر على عكس الظاهرة القرآنية، فالدولة الإسلامية كلها أنظمة بشرية لا قداسة لها على الإطلاق ولكنها عرفت كيف تصادر الدين لكي تخلع المشروعية الإلهية على نفسها.
تطبيق علوم الإنسان والمجتمع في دراسة التراث:يعتقد أركون بأنه ليس بمكنتنا بلورة معرفة علمية تجاه التراث الإسلامي -الذي يشكل النص الديني أحد ركائزه-إلا إذا أقحمنا المناهج التي ظهرت في حقل علوم الإنسان والمجتمع، فاللجوء إلى هذه العلوم يساعدنا على تجاوز كل من المنهجية الإيديولوجية والمنهجية الوصفية السردية، لكي نسلط الضوء على منهجية نقدية وتفكيكية قادرة على تعرية التراث الإسلامي في جميع مستوياته، وتمكننا من إستحضار العديد من الأشياء المنسية، والتفكير في كل ما لم يفكر فيه بعد، وفتح أضابير المستحيل التفكير فيه، ومن تم معرفة الكيفية التي تشكل عبرها العقل الإسلامي في جل المراحل التي قطعها، لكن القرآن، حتما، هو المرحلة الاولى، لذلك يدعونا أركون إلى التركيز وإعطاء أهمية قصوى على هذه المرحلة باعتبارها البداية والأساس، لأن فهم الأمور لا يتم إلا إذا فهمنا ما حصل في البداية.
يتوخى أركون من تطبيقه للمنهجية النقدية دراسة الظاهرة القرآنية في شموليتها، من”خلال تطبيق التحليل الألسني، والتحليل السيميائي الدلالي، والتحليل الإجتماعي أو السوسيولوجي، والتحليل الأنثروبولوجي، والتحليل الفلسفي، وعلى هذا النحو نحرر المجال لولادة فكر تأويلي جديد للظاهرة الدينية، ولكن من دون ان نعزلها أبدا عن الظواهر الاخرى المشكلة للواقع الإجتماعي- التاريخي الكلي“(20).
يطرح التحليل السيميائي-في نظر أركون-نفسه بقوة على كل باحث يرغب في ممارسة فكر تحرري، يرمي عبره البحث والكشف عن العديد من المناطق المظلمة في أي تراث معين، وينطبق هذا الموقف بشدة على التراث الإسلامي، حيث يقول:”أصبح مؤكدا اليوم أن التحليل السيميائي يجبر الدارس على تمرين من التقشف والنقاء العقلي والفكري لابد منه. يمثل ذلك فضيلة تمينة جدا، وخصوصا أن الامر يتعلق هنا بقراءة نصوص محددة، كانت قد ولدت وشكلت طيلة أجيال عديدة الحساسية والمخيال الجماعي والفردي، عندئد نتعلم كيف نقيم مسافة منهجية تجاه النصوص أو بيننا وبين النصوص المقدسة دون إطلاق أي حكم من هذه الأحكام التيولوجية أو اللاتاريخية التي نغلق باب التواصل الفكري“(21).
إننا عبر المقاربة السيميائة”نتخد مسافة منهجية تجاه النصوص الدينية، ونتجاوز في مقابل ذلك القراءات التقليدية التي تقوم بعمليات الإنتقاء والإنتخاب وبتر النصوص من سياقها التاريخي ليتم إسقاطها بشكل تعسفي وبنفس الطريقة على الماضي، وعلى الحاضر، وعلى المستقبل عن طريق التأويلات الحرفية التي تحاول أسطرت الخطاب القرآني والتراث الإسلامي عامة، لأنها تتجاوز المادة الاولية او الاصلية باعتبارها معطى تاريخي-إجتماعي –ثقافي“(22). إن علم السيميائيات La sémiotique يمكننا من إستعادة التراث إستعادة نقدية، عندما نتخد مسافة بيننا وبين المواد المقروءة الأولية، ثم بيننا وبين كل المواد الثانية الثانوية التي أنتجها التراث في آن معا.
ولئن كان محمد أركون يلح على ضرورة الإستفادة من مجال علوم الإنسان والمجتمع، فإنه يريد أن يفكر في التراث بأطر فكربة خارج عن التراث؛ أي أنه يرغب في بلورة قراءة معاصرة للتراث، وينأى عن كل قراءة تراثية له، بيد ان هذا يبدو في نظر أركون مدركا صعبا، و”السبب هو أننا نصطدم هنا بمواقع دوغمائية تشكل الهيكل الصلب لكل فكر يكون خطابا عن الإسلام بصفته دينا ونظاما من العقائد واللاعقائد“. والحال أن أركون في جل كتاباته يطرح هذه الصعوبات ليحللها ويحدد منطق تفكيرها بغية تجاوز نمط التفكير المهيمن في الثقافة الإسلامية، الذي يشكل عائقا أمام إطلاق مشروع تحديث الفكر الإسلامي. ذلك أن شرط إنفتاح الفكر العربي الإسلامي لا يمكن ان يتم إلا بتفكيك الأطر الدوغمائية الخاص بتراثه.