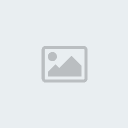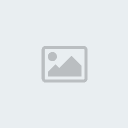
تتنقل المجموعات البشرية المسلحة، امتداداً أو اعتداء، لا فرق بين الوصفين مادام يوجد شبان مستعدين للانخراط في طرفين متحاربين، أو في طرف طاغ وطرف مدافع عن نفسه.
أصبحت هذه المجموعات مشروعاً ومتداولاً، ينشطون لتلبية إرادات ونداءات غامضة من المنطقة أو من أرجاء العالم، يطبقون هذه النداءات على سكان أبرياء، هم من ذات مناطقهم التي خرجوا منها. قد يحققون بهذا نوعاً من الضغط وبالتالي الجدوى السياسية، لكن انتهاج هذا النوع من الوسائل في تحقيق الإرادات، لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعارك، ولا يفسر إلا بضرورة استعباد للبشر من أجل تحقيق الطموحات، ما يتنافى كلياً مع معنى النجاح، مسعى كل إنسان، شرقاً وغرباً.
العقيدة التي تهيمن على تفكير شباب هذه المجموعات والامتثال لها، هو نوع من صدقهم، والإيمان بتحقيقها هو نوع من إثبات وجود وبالتالي نوع من الكرامة الفردية أو الجماعية.
إن مخاطبة هذا التفكير عند المندفعين في العقيدة، مخاطبته كلاماً أو كتابة، يكاد يكون أمراً مستحيلاً. حساسيات الاصغاء والتفاعل متناقضة مع آلية التفكير العقائدي المقاتل، كما أن مخاطبة شاب منهمك في إعداد نفسه للقتال، لا يكون بإسماعه قولاً أو بإقرائه كتاباً او مقالاً.
كما أن الانطلاق من أن خيار المجند حر، أو أنه يقوم إلى هذا بإرادته، أمر متجن وجاحد وكاره. فالشخص يقع له هذا، ولا يختار لنفسه هذا، الظروف هي التي تحدد خيار المضي إلى القتال.
قد تسمى هذه الظروف التي تؤدي إلى نتيجة كهذه نظاماً حاكماً وهناك من يمكن أن يسميها ثورة على النظام الحاكم. بالنتيجة هي ظروف تدفع إلى واقع الانكفاء أو القتال. أو كما يحدث يومياً من قتل للسكان.
وقد يكون الواقع لا خيار فيه إلا المضي إلى الحرب، من أجل النجاة أو إطالة فترة النجاة.
حدث في سوريا كل ما ارتكبته الحروب في التاريخ، وباعتقادي لم تخلف إلا الحقد والقهر واليأس، ولعل هذه الصفات هي نوع من القوة، كان يحتاج السكان إلى قوة ما أو دافع ومنبه، لكن ما مدى تأثيرها مستقبلاً على الجيل، أمر لا فسحة للتنبؤ به الآن. ويكاد يكون مناقشة هذا رفاهاً.
التفاعلات النفسية التي نعيشها يومياً، بسبب الأحداث التي لم تتوقف في سوريا، بقدر ما تكسب الإنسان خبرة بنفسه، بقدر ربما ما تفقده الرهافة. الأسئلة التي تدور في الرأس، لماذا نمارس هذا التفكير أو ذاك حين نشعر بالقلق، ما الذي يجعلنا نعتقد مثلاً أن هذا التواصل أو ذاك يمكن أن يخفف من القلق، لماذا يلوذ الانسان بشخص أو جهة مانحاً إياهم المقدرة؟ لماذا لا يكون بنفسه ملجأ؟ يفعل هذا لأن الظرف يجعله يعتقد هذا، فعل اللوذ بجهة تزيدها نعمة ومقدرة فوق مقدرتها، كما يربك تماسك جهة مقابلة، في دوامة نشطة لا مدنية ولا حضارة فيها.
يفعل هذا أكثر البشر من بلادنا ثقافة وفكراً وفلسفة، وربما هؤلاء أكثر من الشعب نفسه يكرسون هذا الواقع، وهذا يعود بالطبع إلى ظروفهم الشخصية وربما العائلية، والتي ربما تغييرها يعني قلب نمط حياة، ما أؤمن به شخصياً، قلب نمط الحياة الخاصة والضيقة، ضرورة أهم بكثير من المساهمة بالشأن العام كسياسة.
الجماعة التي تحظى بسمعة طيبة وتشجع الكثيرين على الطموح إليها، والجماعة التي تحظى بسمعة القوة والنفوذ تجعل الاخرين يرهبونها ويلجؤون إليها في الوقت نفسه. هذا الفعل يسمونه سياسة. وهذه الجماعات نشأت يوماً عبر أنشطة سياسية أيديولوجية كانت ضرراً وفائدة على أصحابها لكن وبالاً على شعوبها، كما نرى نتائجها الآن.
لم يحدث أن قرأنا تجربة صريحة تناقش هذا الواقع، لأن كل إنسان بعد أن يعبر بهذه التجربة، يفرض عليه أن يكون ضمن جماعة أو أن يقفز بينهما.
لعل وجود الجماعات المتنافسة ضرورة حياتية، لأن التسابق يخلق تحديات تقدح الذهن وتدعم الابتكار، لكن التحفيز الذي يحدث الان، يمكن أن يكون صالحاً في أي مجال في الحياة إلا مجال الثقافة والابداع الفكري.
يفهم أن الثقافة تكلف مالاً، وإن الحصول على المال لا بد أن يكون عبر مجالات السوق وتلك الصراعات، لكن متى تصبح الثقافة أكثر رقياً؟ موهبة تغيير هذا الواقع أهم من موهبة إنتاج عمل كتابي، وإن الحروب التي تعبر على بلادنا بلا توقف، تحتم هذه الوقفة.
الكتابة الممنوعة لا امتياز لها، والكتابة المشهرة لا امتياز لها، لأن تقديس الحالين ليس إلا تقديس فعل التسلط وتطويل ذراع السوق.
الثقافة تعطي الآخر ثقة، وإن لم تنفع، سوف تنفع، هذا النوع من الإصرار على شكل العلاقات، تخلق الفكرة الجديدة. لا تقف الثقافة بوجه أي تطور أو تغيير، ولا تعيق العلاقات، بجمالها وعفويتها وبقلة جمالها، لكن أمر الاقناع، لا يمكن العبور بدونه. الثقافة ليست ضد، حتى فكر العنصرية والتمييز، حين تعثر على فكرة مقنعة لهما، ووسيلة مقنعة ومكان ملائم. لكن ما يحدث هو عنف لا يتوقف وفوق هذا كأنه يطلب فكراً ينزع عنه صفته. عنف يطلب مواهب هائلة كي تكفه، أو تستوقفه. عنف لا يعرف معنى الحذر، لكنه يفرضه على كل ما يصادفه في طريقه. وهذه التحولات تطبق على فكر الانسان وشعوره وعلى صحته، في أي عمر كان وأي جنس، ما يسبب ذهولاً، ولا يحدث تراكماً يفي بأمر تغيير سيكولوجيا شعوب.