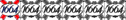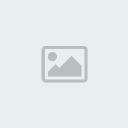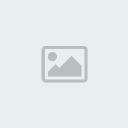
لم تحظ أفكار الحداثة
(الديمقراطية٬ العلمانية٬ الدولة المدنية٬ المواطنة٬ حرية المرأة٬الخ. .)
في الخمسينات والستينات من القرن المنصرم بأيّ اهتمام يذكر في أدبيات
المثقفين وبيانات الأحزاب السياسية (يسارية ويمينية على حد سواء)وبرامجها.
ذلك أن القضايا المصيرية، مثل الوحدة العربية وتحرير فلسطين وبناء
الاشتراكية، أرخت بثقلها على جسد المجتمع المدني وخنقت جميع الأصوات
باستثناء صوت المعركة (كصوت لا يعلو عليه أيّ صوت) التي كانت تخوضها أنظمة
«المواجهة والصمود» ضدّ أعداء الداخل والخارج، وما أكثرهم!
كان لا بدّ من هزيمة بحجم هزيمة حزيران حتى تنكشف عورات الأنظمة
الناصرية والبعثية، وترتفع أسهم الإسلام السياسي كإيديولوجية بديلة شمولية
استهدفت السلطة من جهة، وإعادة أسلمة المجتمع وتنقيته من جهة أخرى : تنقيته
من كلّ ما اعتبروه ابتعادا عن الدين القويم، وعلى رأس القائمة كلّ ما
حققته المرأة من مكاسب أدّت، حسب زعمهم، إلى الفساد الأخلاقي، وبطالة
الذكور، وبالتالي إلى الهزيمة. ولا عجب إذا أن يختار الإسلام السياسي
والأصولي الحجاب رمزا للقطيعة مع المجتمع الفاسد، وأن يعتبره فريضة، وأمرا
إلهياً، وركنا سادسا من أركان الإسلام.
لكنّ الإسلام السياسيّ كان بحاجة أيضا إلى أرضية نظرية يستند عليها.
وبما أنه لا يقبل بالديمقراطية بديلا عن الدكتاتورية، وبحكم الشعب عوضا عن
حكم الفرد، ويرفض الدولة المدنية وقوانينها الوضعية٬ بدعوى أنّ المشرِّع هو
الله لا الشعب في الدولة الإسلامية٬ كان لا بدّ إذا من استهداف العلمانية،
ورفعها إلى درجة الإيديولوجية، وتكفير مؤيديها واعتبارهم العدوّ الرئيسيّ.
وهكذا أصبحت العلمانية٬ وكلّ ما ينتمي إليها من ثمار الحداثة: كالدولة
المدنية، وسيادة الشعب، وحقوق المرأة، والحريات الفردية٬ في مركز اهتمام
المثقفين في جميع البلدان العربية والإسلامية، وحتى في دولة ولاية الفقيه،
حيث النقاش ما زال حاميا بين مؤيدي ولاية الفقيه والذين يريدون أن يقتصر
نفوذ آيات الله على قُمّ، كما اقتصر نفوذ الكنيسة البابوية على الفاتيكان.
وانتقل النقاش حتى إلى الدول الغربية تحت ضغوط الإسلام السياسي، ممثلا
بطارق رمضان والتجمعات السلفية التي استهدفت الشباب المسلم الباحث عن هوية،
وهو الشباب الذي يعاني البطالة والتهميش والإقصاء.
وأمام تحدّي الإسلام السياسي الأصولي لم تجد الأنظمة الشمولية
والدكتاتوريات الفردية «العلمانية» سوى مسايرة التيار الأصولي وتقديم
تنازلات له على حساب المرأة٬ كما حصل في الجزائر والعراق وسوريا٬ أو إضافة
نصوص دستورية تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يكون دين
رئيس الجمهورية الإسلام (كما حصل في مصر).
هذا الطرح فاجأ معظم المثقفين العلمانيين الذين كانوا منشغلين بقضايا
أخرى (أكثر أهمية بنظرهم) من مساواة المرأة بالرجل، أو استبدال القوانين
الشرعية بأخرى أكثر انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ذلك أن
معظمهم كانوا ينتمون إلى أوساط بورجوازية ميسورة حققت فيها المرأة مكاسب
عديدة وتمتعت بدرجة من الاستقلالية جعلت مطالبها بحقوق إضافية تبدو دلالا
وترفا ليس إلا. أما نساء الطبقات الشعبية اللواتي كن يرزحن تحت وطأة قوانين
الأحوال الشخصية الشرعية فلم يحظين بأي اهتمام يذكر، حتى من قبل أكثر
الحركات تقدمية ويسارية.
لو قام أحدنا بإحصاء الكتب والمقالات التي كتبت حول العلمانية والشريعة
وقضايا المرأة٬ منذ بداية السبعينات حتى يومنا هذا٬ لوجد أن حجمها تجاوز
بكثير كل ما كتب عن القومية والاشتراكية والقضية الفلسطينية خلال قرن كامل.
وقد ساهمت الفضائيات، وعلى رأسها "الجزيرة"، فيما بعد في نقل هذا الصراع
إلى مستوى المشاهد العادي عن طريق حوارات بين علمانيين وإسلاميين ليكتشف
الجمهور مستغربا وجود رجال دين ومتدينين، مثل العراقي إياد جمال الدين،
والمصري جمال البنا، ينادون صراحة بعلمانية الدولة ويرفضون تطبيق الشريعة.
ولم تكتف الأصولية بمقارعة الحجّة بالحجّة، بل لجأت إلى سلاح التكفير،
وفتاوى القتل بحقّ كتاب وفنانين، ومنع كتب وأفلام وأغانٍ مخالفة برأيهم
لتعاليم الإسلام، أو تحتوي على شيء من التجديف أو الإيحاءات الجنسية. وهنا
انقلب السحر على الساحر، وانتشرت تلك الكتب أوسع انتشار، وأعيد طبع "في
الشعر الجاهلي" لطه حسين، و"الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق، وغيرهما
من الكتب التي أُبعِدت عن رفوف المكتبات عشرات السنين.
ولكنّ شعورا بالإحباط أصاب العلمانيين الذين كان لديهم إحساس بأنهم
يعومون عكس التيار، وأن جهودهم لن تعطي ثمارها في المستقبل المنظور، وبينهم
من تراجع عن مواقف سابقة أو تهرّب من اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم،
ومنهم (حتى بين اليساريين في الغرب) من ساير الأصوليين واعتبرهم الممثلين
الحقيقيين للمعذبين في الأرَض.
ثم جاءت المفاجأة يوم قامت ثورة الشباب في تونس وفي مصر٬ وقبلها ثورة
شباب طهران سنة ٬2009 عقب إعادة انتخاب أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية، تلك
الثورة التي استعملت فيها لأول مرة وسائل الاتصالات الحديثة في تنظيم
المظاهرات وتصويرها وتوزيعها الفوري على العالم قاطبة.
لم يصدّق أنصار العلمانية عيونهم. فالجيل الجديد الذي خرج إلى الشارع،
والذي أجبر بن علي وحسني مبارك على الاستقالة، دخل الحداثة من الباب
الواسع٬ يطالب بدولة ديمقراطية، وزواج مدني، وديمقراطية عصرية (كما هي
مطبقة في الغرب) رافضا أن يضيع وقته في البحث عن طريق عربي أو إسلامي
للوصول إليها. جيل مارس الحرية بعينيه وأطراف أصابعه بفضل وسائل الاتصالات
الحديثة: قرأ خفية المقالات والأشعار الممنوعة، وشاهد الصور والرسوم
الكاريكاتورية المحظورة، وتواصل مع أناس محرومين من دخول بلادهم.
جيل من شباب وصبايا تعلّموا وحدّدوا النسل وتزوّجوا من أشخاص من أعمارهم
ومن مستواهم العلمي والثقافي. يخاطبون أولادهم بلغة الحبّ، ويلعبون معهم
ويستمعون إليهم ولا يستعملون عبارة: نحن نعرف مصلحتكم أكثر منكم!
كيف يمكن لحاكم أن يقنع هذا الجيل بأنه يعرف مصلحته أكثر منه، ويطلب منه الطاعة والخضوع لأوامره دون نقاش؟
كذلك فضحت العولمة أكاذيب الأصولية الدينية عن الحضارة الغربية والإنسان
الغربي، وخاصة عن المرأة الغربية و«معاناتها»، بزعم أنها مجرد سلعة في
مجتمع الاستهلاك، واعتبار الاختلاط بين الجنسين والعلاقات الجنسية قبل
الزواج انحلالاً أخلاقياً. وذهب مجهود عشرات السنين وعشرات مليارات
البترودولارات هدرا أمام إصرار الشباب العربي على أن يعيش مثل شباب باريس
ولندن ونيويورك وقبرص واسطنبول. هذا في الوقت نفسه الذي تحرّر فيه هذا
الجيل من عقدة النقص فيما يخص تراثه الفني والثقافي.
أدرك الشباب العربي الثائر أن الإيديولوجيات لفظت أنفاسها الأخيرة، وهو
يرفض بالتالي ذلك الطريق (بعد كل ما روّجوا له في الداخل والخارج) الذي
وضعهم أمام خيارات قاسية٬ حسب تعبير جلال صادق العظم: إما استبداد دولة
الأحكام العرفية، أو حكم القوى الإسلامية الأصولية عبر أحكام عرفية جديدة
اسمها الشريعة الإسلامية. كذلك رفض ازدواجية الشرق والغرب، ودار الإيمان
ودار الكفر.
وبينما كنا نظن أن جيلا متجهما نشأ على ثقافة العنف الثوري أو الجهادي،
إذا بثورات الشباب تتمخض عن جيل ضاحك يتظاهر سلميا وهو يغني ويرقص، يرفض
العنف، ويجد قدوته في غاندي ومانديلا.
الصدمة التي أصابت الإسلام الأصولي كانت صدمة مَن هُزم فكريا وسياسيا
بينما كان يستعد لقطف ثمار النصر. أما صدمة العلمانيين فتتمثّل في تحقيق
نصر أشبه بحلم وردي، آخذٍ بالتلاشي، صعب المنال.