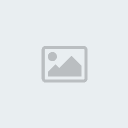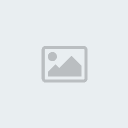
في الخامس والعشرين من أيلولنا الحزين دائما/ سبتمبر 2013 ماتت سهيلة ذات الأحد عشر عاما بداء الفشل الكلوي. ماتت سهيلة ابنة بسبب عيشها في قرية بني عقبة التي هي واحدة من ألف قرية تعد الأكثر فقراً في مصر حيث يكابد أهوال الجحيم ما يقرب من أحد عشر مليونا. وهو سبب خليق بأن يثير كتلة من القضايا السياسية والاجتماعية بل والمعرفية، لا تكاد تلتفت إليها النخب الحاكمة في خضم صراعها على المكاسب والنفوذ.
ولأن سهيلة نموذج لما جرى ويجرى على الشعوب منذ فجر التاريخ؛ فلا غرو أن يحاول الضمير الإنساني سبر غور السبب الكامن وراء هذا الموت المفزع، ذلك السبب القديم المتجدد رغم كل الدعوات الدينية بالتزام الحق والمرحمة، بل ورغم كل الثورات والانتفاضات والهبات الجماهيرية والتي غالباً – مثلها في ذلك مثل الدعوات الدينية - ما تنتهي إلى الصمت والقبول بالأمر الواقع.
من أين تكون البداية إذن؟ ؟ ربما كانت البداية هي البحث عن نظرية تغطي حركة الواقع والتاريخ من منطلق علمي غير ميتافيزيقي، شريطة ألا يغيب عن بالنا وجود فجوة – مهما تكن ضئيلة – بين الواقع وتصنيفه النظري، تلك الفجوة التي يجب علينا أن نعمل باستمرار على تقليل مساحتها كما سنرى في تضاعيف هذه الدراسة.
المهاد النظري:
كان فردريك إنجلز محقاً حين أقر بواقع امتزاج الدين بالسياسة، حتى أنه رأى في حروب أوربا الدينية في القرن السادس عشر نوعاً من أنواع الصراع الطبقي، ومن ثم لم يغب عن إدراكه أن القناع “الأيديولوجي” إنما كان يخفي تحته الوجه الملموس لحركات العصيان الشعبي آنذاك. وما كان لإنجلز أن يفطن إلى ذلك لولا امتلاكه لنظرية المادية التاريخية.
فماذا تقول هذه النظرية ؟ باختصار هي شرح للكيفية التي بها تتفاعل حركة الواقع المادي مع عقول الناس – سواء كان العقل واعياً أم غير واع – إذ تنشأ من خميرة هذا التفاعل المعارفُ والقيم والمفاهيم، وُيتفق على الأعراف والعادات والتقاليد والأخلاق التي هي بذور الديانات الأولى والعقائد والفلسفات المعبرة عن حقائق الملكية وعلاقات القوى المجتمعية الداخلة فيها، وفي خضم تلك التحولات تظهر الدولة ُ كموجود في حد ذاته ولكن دون أن ُيرى، أو مثل كائن علوي Transcendental ( = بمنأى عن المعرفة ) ومن ثم يظل الناسُ يتساءلون : من صنعه؟
صنعه الطبقة المنتصرة اجتماعيا ً، التي راحت – لذكائها - تقدم هذا الكيان السلطوي للمحكومين بوصفه كياناً محايدا ً مهمته إقرار النظام ومحو الفوضى وحماية حقوق الضعفاء ! هل هذا صحيح ؟ لا بل هو وَهم ٌ لا تلغيه بعض الاستثناءات، إنما القاعدة أن الدولة مجرد جهاز توظفه الطبقة المالكة لمصلحتها، فهي تعمد أولاً إلى استخدام قوته الخشنة : الجيش والشرطة والبيروقراطية لحماية مالكيها بالدرجة الأولى، وتلجأ ثانياً لتوظيف قواه الناعمة : القوانين، السياسة، وسائر العناصر الأيديولوجية بما فيها الأديان والفلسفات لضمان سكوت المحكومين وقبولهم بالحرمان واستسلامهم للضنك وبؤس المعيشة.
ذلك ما ُبنيت عليه الدول الحديثة منذ استقرت لكل منها السيادة على أراضيها في القرن السابع عشر، بما يجعل كل دولة تستقل بذاتها فترسم سياستها بما تراه مناسبا لها من دون تدخل خارجي في شئونها حتى وإن استبدت بمحكوميها من واقع قولها إنها السلطة الوحيدة المسموح لها بتسوية المنازعات. وبينما أطاحت هذه السيادة المطلقة بآمال ( = أوهام ) محكوميها في الخلاص من استبدادها ولو على أيد خارجية ترفع شعارات التحرير كما كان الحال زمن الفاتحين العظام ؛ فإن الباب الذي أغلق على المواطنين هو نفسه الذي حفزهم على البحث عن التحرر داخل الدولة ذاتها، ومن هنا حبلت المجتمعات الأوربية بجنين الديمقراطية والذي لم يقدر له أن يولد إلا بعد قرن وبضعة عقود مع قيام الثورة الفرنسية الكبرى.
لنقر إذن مبدئياً بأن الدولة هي جهاز مملوك للطبقة مالكة وسائل الإنتاج ومع ذلك فالدولة – شأن كل جهاز – ليست حكرا ً أبدياً على طبقة بعينها حتى ولو كانت مالكة مهيمنة، فالنضال الذي يسعى به الشعب ليشارك في إدارة شئون البلاد يمكن أن يُخضع الدولة لإرادته جزئيا ً، فتقر مبدأ الضرائب المتصاعدة مع وضع حد أدنى وحد أقصى للمرتبات والأجور، وتلتزم الحياد “الشكلاني” بين أصحاب الأديان والعقائد، وتقنن الحقوق المدنية كالإضراب والتظاهر وحق الطبقات الشعبية في تكوين المنظمات والنقابات والأحزاب دون وصاية عليها من خارجها، كما تدعم التعليم والصحة بل والترفيه...الخ وتلك هي غاية اللبرالية السياسية، فيما تدعو إليه في أدبياتها.
على أن اللبرالية السياسية لا تمثل نهاية المطاف بل ُيفترض أنها تمهد لما بعدها، أعني خضوع الدولة التام للشعب (= الديمقراطية الحقة ) الذي يطالب بالعدل الكامل في توزيع ناتج الثروة القومية ومحق كل أشكال الاستغلال الطبقي، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بانتصار الاشتراكية التي هي بناء ُيشيد على غير نموذج سابق التجهيز، وربما تشارك في تصميمه اليوم الثورةُ العالميةُ حيث ُتبذر خمائرها في مدينتيْ سياتل وبورت إلليجيري وميدانيْ التحرير وتقاسيم، مقابل أفول نجم الرأسمالية تحت وطأة أزماتها المتلاحقة والتي تعود إلى تعميم عبادة السلع بديلا عن العبادة التي دشنها الباباوات والأباطرة واللوردات في القرون الوسطى أي عصور ما قبل الرأسمالية.
هنا لابد من وقفة ُتناقش فيها ما ذهب إليه مفكرون كثر، وعلى رأسهم فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ وخاتم البشر” من أن الرأسمالية برهنت على انتصارها نهائياً بسقوط الاتحاد السوفييتي وتفكك منظومة الدول “الاشتراكية” الدائرة في فلكه، وعودة الجميع إلى محيط الرأسمالية الممتد بلا شطآن!
للرد على ذلك لابد من طرح سؤال بدئي حول ما إذا كانت الاشتراكية قد ُأقيمت فعلا في هذه البلدان أم أن الذي جرى هو شئ آخر، وإذا كان ذلك كذلك، فما هو هذا الشئ؟
رأسمالية الدولة السوفييتية:
دخلت روسيا القرن العشرين كدولة فلاحية إقطاعية، ورغم إلغاء الرق عام1861 وتصنيع بعض المناطق في بتروجراد وموسكو، ومع ذلك فإن النظام الإمبراطوري ذاته سبباً هيكلياً في إفشال تحديثها، وهكذا استمرت هبات الفلاحين البائسين تتوالى حتى نشوب الحرب العالمية الأولى حيث منيت الإمبراطورية الروسية بالهزائم المروعة على كافة الجبهات. عندئذ تجمعت عام 1917 سحب الثوار لتمطر ثورتين لا ثورة واحدة، أولاهما أثمرت في فبراير حكومة بورجوازية بقيادة كيرنسكي، لكن البلاشفة بقيادة لينين وتروتسكي أسرعوا بحشد العمال والفلاحين الفقراء والجنود الهاربين من الجبهة ليطيحوا بتلك الحكومة، معلنين قيام الدولة “الاشتراكية” في أكتوبر من نفس العام!
فماذا كانت سمات تلك الدولة؟ كان لينين عشية تلك الأحداث قد أصدر كتابه الشهير “الدولة والثورة” أوضح فيه أن دولة الاشتراكية – بجانب تأميم جميع الشركات والمؤسسات الرأسمالية وحظر نشاطها في المستقبل - إنما تقوم على عناصر ثلاثة : 1 – إلغاء الشرطة والجيش بإحلال اللجان الشعبية محلهما 2 – إلغاء البيروقراطية بتسليم إدارة المصانع والمؤسسات الاقتصادية للعاملين فيها بنسبة 100% 3- عدم حصول أي موظف في الدولة على أجر يزيد على أجر عامل متوسط.
وهذا ما عارض تنفيذه زميله “كاوتسكي” بقوله إن الظروف الموضوعية غير ناضجة لتطبيق تلك الأفكار. فما كان من لينين إلا أن هاجمه بشراسة بالغة، مصدرا ً كتاباً ضده بعنوان “الثورة الاشتراكية والمرتد كاوتسكي” ومن ثم مضى لينين في تطبيق أفكاره هو في السنوات التالية لنجاح الثورة البلشفية. ولكنه ما لبث حتى استبان النتائج الكارثية التي نجمت عن تلك السياسة أن هجر الفلاحون ( وهم بورجوازيو الطبيعة مؤمنون بالملكية الخاصة للأرض الزراعية ) العمل في المزارع الجماعية، ما أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي بشكل مخيف اقترب بالبلاد من حافة المجاعة. كما انتشرت الفوضى والمصادمات الدامية بين الجماهير وتراجع النتاج الصناعي كيفاً وكماً جراء امتعاض المدراء والمهندسين إزاء مساواتهم في الأجور بالعمال غير المهرة.
كان على لينين أن يودع أحلامه الخيالية في إقامة المجتمع غير الطبقي ( كان كاوتسكي محقاً إذن ؟! ) فما لبث حتى أصدر ما بات يسمى بسياسة النيب NIP [ اختصار New Economic Policy ] أي السياسة الاقتصادية الجديدة أعاد بموجبها الامتيازات المالية لكبار رجال الدولة وقادة الجيش والشرطة ومعهم كوادر الحزب الشيوعي بغرض الإسراع في عملية التنمية، وهو بالضبط ما أفرز طبقة أسميها : البورجوازية البيروقراطية، طبقة راحت تحصل على قدر كبير من فائض قيمة العمل الاجتماعي، وإن لم تتمتع بحق استثمار هذا الفائض في القطاع الخاص الذي كان قد تم إلغاؤه بحكم القانون.
ولأن المال Money يعد قوة رئيسية من قوى الإنتاج فقط حين يوضع على رأس عملية إنتاجية، فلقد اصطدم ذلك المال الراكد ( تحت البلاطة ) بعلاقات إنتاج تأبى أن تحوله إلى رأسمال Capital بموجب قوانين الدولة آنذاك، فكان على علاقات الإنتاج “المكبلة” تلك أن تتسع لتفسح المجال لقوة الإنتاج الكامنة Potential هذه أن تنمو. لكن عملية التحول تلك اقتضت سبعين عاماً لكي ُتنجز، وهذا سر صعود “الجورباتشية” التي أرهصت بها انتقادات خروشوف للنهج الستاليني / اللينيني في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الروسي.
فهل يجوز بعد هذا أن يزعم أحد بسقوط الاشتراكية وهي التي لم تقم أصلا ؟ إن تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية لا غزو يحثنا على وصف الدولة السوفيتية بوصف رأسمالية الدولة، حيث نضج النظام الرأسمالي ثمة بلا رأسماليين، بالأحرى بفضل رأسمالي واحد هو الدولة، ذلك الرأسمالي الذي لم يجد غضاضة – حين نضجت الظروف – أن يدعو أصحاب الأموال المكدسة لكي يتقدموا ويعلنوا عن أنفسهم كرأسماليين جدد.
أزمة الرأسمالية كنظام عالمي:
سألت سيدة برنارد شو : ما الرأسمالية ؟ فكانت الإجابة : هي مثل لحيتي ورأسي.. غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع!
هكذا وبخبطة واحدة استطاع الفيلسوف الساخر أن يشخّص العلة. فالرأسمالية ليست مجرد تكديس للأموال في خزائن الأغنياء، ذلك ما كان يفعله الإقطاعيون ومن قبلهم الأباطرة وقادة الجيوش وولاة الأقاليم والكهنة والتجار. لكن النظام الرأسمالي، الذي وُلد مع اكتشاف طاقة البخار ومع المخترعات التي حولت الحرف والورش الصغيرة إلى مصانع ضخمة، ُتمكّن من توظيف المال الراكد ليُصبَّ في صميم العملية الإنتاجية، خالقاً به القيمة المضافة، ومستخرجاً بفضله من جهد الأجراء فائض قيمة أسماها الأرباح، تزداد بقدر ما تقل الأجور عن قيمتها الحقيقية المتمثلة في جهد العمال المبذول. وهذا بالضبط هو جوهر النظام الرأسمالي: غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع.
ما أوجزه شو بسخريته الذكية، سبق وفصّله المفكرون الاقتصاديون العظام أمثال آدم سميث وريكاردو، ولكن كارل ماركس هو من كشف أن تلك الرأسمالية تفرز تناقضاتها الداخلية الكارثية فيما أسماه بنظرية “فيض الإنتاج” Theory of flow production وخلاصتها أن الرأسماليين حين يوظفون أموالهم بتحويلها إلى رأس مال، فإنهم يقسمونها قسمين، الأول رأسمال ثابت، ويتضمن الأرض والمباني والآلات والخامات، وهذا القسم تظل قيمته ثابتة بالطبع. والثاني : رأسمال متغير هو الأجور المدفوعة للعمال.. ولأن أرباح الرأسماليين لا تأتيهم من القسم الأول [ قيمته ثابتة ] بل من القسم الثاني المتغير فلابد من أن تكون هذه الأجور في مجملها أقل من قيمة السلع الكلية التي تنزل الأسواق بعد تجنيب الأرباح طبعاً. وعليه فلا يمكن للقوى الشرائية الكلية أن تعادل العرض الكلى فينجم كساد لا مندوحة عنه، وتترتب على ذلك الكساد أزمة عامة لا مخرج منها إلا بإتلاف الفائض عمداً (وهو عبث مؤكد ) أو بإعادة الأرباح إلى العمال، وهذا ما لا يقبله الرأسماليون بالطبع باعتباره سفهاً سفيهاً. فيبقى القبول بوجود سلع وبضائع ضخمة، يقابلها غالبية من الناس عاجزة عن شرائها.
وبغض النظر عن الشكل “المالي” الذي يغطرش على جوهر الأزمة في هيكليتها. فإن الكساد يجبر أصحاب المصانع على تسريح بعض العمال، مما يزيد الأزمة تفاقماً (من أين للعاطلين بنقود ليشتروا بها السلع المكدسة ؟! ) وتؤدي البطالة الى مزيد من الركود، فالبطالة فالركود إلى أن تنهار المنظومة الرأسمالية بأسرها. فما الحل ؟ الحل أن تلجأ الرأسمالية إلى دواء الحرب، فــ “بكرمها” يتم التخلص من البضائع الزائدة وكذلك من البشر الزائدين ! وهو دواء أشد مرارة من الداء.
هذا بالضبط ما حدث في القرن الماضي حين استدرجت الدولُ الغربية هتلر النازي واليابان الفاشية إلى شن حرب عالمية مروعة، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 1929 واستمرت لعشرة أعوام انتحر بسببها عشرات الآلاف، وامتهنت النساء الدعارة، وانتشرت العصابات الجماعية في كل مكان.
المسألة المصرية:
إذا كانت المتغيرات العالمية في نوعية وآليات الإنتاج الرأسمالي قد أفضت إلى تراجع البروليتاريا عن موقعها الاستراتيجي المناهض للبورجوازية ؛ فإن الأمل سيبقى معقوداً على الشعوب كما سبق وأشرت، بيد أن تحقيق نصر الشعوب الكامل ليس بالأمر القريب كما يتمنى ويشتهي كل صاحب ضمير يقظ، وإنما دونه عصر من النضال المستمر الشديد شريطة أن يتمسك المناضلون بأهداب النظرية المشار إليها آنفاً بحسبانها النظرية الوحيدة التي تنبأت بانتصار الاشتراكية، وشريطة تعديل بعض معطياتها خاصة في المسألة الطبقية. ويقع هذا التمسك بحسبان النظرية الجديرة بالتقدير إنما هي تلك التي – إضافة إلى صواب تفسيرها للواقع وتعديل التفسير كلما احتاج الأمر - تتضمن القدرةَ على التنبؤ واستشراف المستقبل.
في هذا السياق ربما كان مناسباً استخلاص جوهر نضال الشعب المصري منذ أن بدأ ثورته الوطنية الديمقراطية الكبرى عام 1919 وحتى الآن بحسبانه نضالاً طبقياً بالدرجة الأولى. فالحقيقة أن الطبقة التي كانت مؤهلة تاريخياً لقيادة هذا الشعب إنما كانت الطبقة البورجوازية التي سعت - على ضوء مصالحها - إلى استخدام الجماهير الشعبية بدلا من خدمتها، ومن ثم فلقد نجحت في التخلص من الاحتلال البريطاني ( حماية لرساميلها الوليدة ) وبالكاد نجحت في تأسيس أحزاب وحياة نيابية ذات أطر محدودة. . الأمر الذي أعجزها عن تصفية علاقات الإنتاج الإقطاعية، فكان ضروريا ً أن يتقدم الجناح العسكري لهذه الطبقة في يوليو 1952 ليستولى على السلطة السياسية مطيحا ً بالنظام الملكي رأس الإقطاع وجسد الفساد السياسي والاقتصادي.
كان طبيعياً أن يعلق الناس آمالا ً كباراً على تلك القيادة العسكرية الجديدة ذات الأصول البورجوازية الصغيرة، لا سيما بعد إصدارها لقانون الإصلاح الزراعي، وتبشيرها بنظام سياسي واجتماعي أفضل. ولكن ما كان لتلك القيادة العسكرية أن تستقر في الحكم لأشهر معدودات ما لم تجد لنفسها ظهيراً مدنيا يساندها، فكانت جماعة الأخوان المسلمين - بجماهيرها المتزايدة والمؤمنة بدور الدين في تحرير الناس - هي ذلك الظهير.
غير أن ذلك الحلف بين المؤسسة العسكرية الناشئة وبين جماعة الإسلام السياسي ما لبث غير عامين حتى تحطم على صخرة الخلاف المنطقي بين كيانين كبيرين يقوم كل منهما على أساس هيكل تنظيميَ تراتبيً : السمع والطاعة، إذ كان الأول (الجيش) يسعى لبناء رأسمالية حديثة قوامها التصنيع تكراراً لتجربة محمد على باشا، بينما كان الأخوان لا يطمعون بحكم طبيعتهم التجارية في أي تحديث بل في مجرد تقسيم الكعكة الراهنة، انطلاقاً من تشبعهم بميراث الانكفاء على الداخل منذ فقد أسلافهم ( البورجوازية التجارية العربية ) السيطرة على البحار الشرقية والبحر المتوسط في العصر الفاطمي، حيث تخلت بعدها البورجوازيات العربية عن دورها التاريخي في مناجزة الإقطاع والقضاء على سلطانه، مكتفية بالانضواء تحت لوائه، خالعة عنها توجهات المعتزلة المؤكدة للحرية الإنسانية، ومتلفعة في الوقت نفسه بالفكر الأشعري ( المصدر التاريخي للمذهب الوهابي المعاصر ) وهو فكر يبرر الجبر ويستسلم للتبعية، وهذا الفكر الأشعري هو ما ورثته جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الأخوان.
من هنا جاء نفور الأخوان من إعادة إنتاج تجربة الوالي محمد على من حيث انتهائها بهزيمته أمام الغرب الصليبي الأقوى. ولعل ذلك يفسر رفع الأخوان لشعارات العداء للغرب الصليبي بالأقوال، بينما هم على مستوى الأفعال يضمرون التبعية له، وإلا ففيم كانت شماتتهم بعد الناصر وهو يتلقي هزيمته العسكرية أمام إسرائيل عام 1967 ؟! ولم جاءت مطالبتهم اليوم الغرب الصليبي أن يتقدم ليعيدهم إلى السلطة التي ُأسقطوا عنها في الثلاثين من يونيو 2013؟!
قد يقول قائل : لكن الأخوان لهم مشروع أممي هو استعادة نظام الخلافة يستعاد به مجد المسلمين. وهو ما يفسر تعلق جانب كبير من الشعب بهم، لا سيما حين يوحون لأتباعهم أن استعانتهم بالغرب ما هي إلا عمل تكتيكي مؤقت يتم الانتقال منه إلى الهدف الاستراتيجي في الوقت المناسب.
بيد أن ذلك مردود عليه من ناحيتين. الأولى أن العالم الإسلامي لم يجن من نظام الخلافة ذاك ( عدا فترة حكم الشيخين ) سوى الحروب الأهلية والتفكك والتشرذم بل والتخلف عن ركب التطور السياسي، خاصة مع الخلافة العثمانية الأخيرة، فضلاً عن استحالة قبول المجتمع الدولي – من الناحية القانونية – بقيام كيان أساسه ضم دول مستقلة ذات سيادة بقوة السلاح أو بشعارات دينية، مذ ُأقر هذا المبدأ بمعاهدة وستفاليا عام 1648.
أما الناحية الثانية فتختص بالصدام المحتوم مع النظام العالمي الجديد، الذي هو نظام لا يمكنه أن يسمح بحال لقوى ماضوية أن تنافسه على أسواقه ومكاسبه. وإذا كان الغرب قد وقف بالمرصاد لتجربتيْ الباشا والبكباشى، رغم استعدادهما لقبول التحديث والاندماج في المنظومة الرأسمالية ( مع بعض الشروط ) فكيف الحال إزاء مشروع أخواني غايته استبدال هيمنته هو – سياسياً واقتصادياً وعقائدياً - بهيمنة الغرب الأكثر تقدماً وقوة بما لا يقاس؟!
ذلك هو السبب المسكوت عنه وراء تخلي الغرب عن الأخوان ( رغم ادعاء الغضب على من أسقطهم ) والحق أن الغرب – بقيادة أمريكا – ربما كان غاضباً فعلا من سقوط الأخوان، لسبب ليس يعلن : أنه كان يود توظيفهم لخدمة مخططاته المعروفة في إعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يحقق إستراتيجيته هو وليس بالطبع إستراتيجية الأخوان.
فهل يعني هذا أن الشعب المصري قد تم استخدامه مرتين في يناير 2011 وفي يونيو 2023 ؟ ربما يجوز قول ذلك بمعنى من المعاني، لكن شواهد الحال تؤكد أن هذا الشعب قد استبان الآن حقائق الصراع الداخلي والدولي على السواء. والمعرفة أول الطريق المفضي إلى التخلص من التبعية، وبالتالي امتلاك القرار المفضي للتحرر بما تعنيه هذه الكلمة على كافة المستويات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
إن معرفتنا بحقيقة ما فعلناه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الثلاثين من يونيو 2013 ليست بالأمر السهل البسيط، فكم من أناس درجوا على الظن بأنهم كانوا يعيشون في سعادة ( أو بؤس ) حتى يفيقوا من ظنهم هذا على واقع يثبت لهم العكس. قال أرسطو : لا يعرف المرء ما إذا كن سعيداً أم شقياً حتى ينزل إلى القبر. ولو أن العمر امتد بنيوتن مائتي عام، وقابل آينشتين لأدرك مدى خطئه في إيمانه بالزمن المطلق بعد أن يبرهن له آينشتين بالمعادلات المحكمة على أن الزمن نسبي حتى أن الساعة تبطئ حين تتغير سرعة حاملها.
لا أحد يود أن ينتظر المصريون مائتي عام لكي يعلموا أنهم حين هبوا في انتفاضتين مظفرتين، أسقطوا بهما طاغيتين ( ثم انصرفوا لبيوتهم ! ) أنهم كانوا قد قاربوا مفهوم “الثورة”، دون أن يباشروه. فالثورة بمعناها العلمي تعني التغيير الجذريChang Radical لبنية الحياة الاجتماعية، خاصة حيازة السلطة السياسية وإعادة شروط التملك وتوزيع الثروة القومية. حدث ذلك مع الثورة الفرنسية والروسية والصينية، وجزئياً مع الثورة المصرية في 23 يوليو 1952 والتي بدأت مقدماتها عام 1919 كما أشرنا قبلاً.
هكذا يتبين أن الرؤية الأصح لما حدث في يناير 2011 ويونيو 2013 ينبغي أن ترتكز على الخواتيم وليس على الأحداث في ذاتها. فإذا طبقنا هذا المبدأ على الحدثين لاكتشفنا أن يناير كان حدثاً جليلا ً، ولكن ترتب عليه استيلاء جماعة الأخوان على السلطة والعمل من خلالها على محاولة تنفيذ طموحات التنظيم الدولي لإقامة ما أسمته بالخلافة الإسلامية. والحاصل أن الخلافة الإسلامية هي بالضبط ما تسعى إلى تحقيقه دولة العثمانيين الجدد في تركيا بقيادة أردوغان، وهذا هو سر الاحتضان التركي لجماعة الأخوان سواء حين كانوا في الحكم أو بعد إبعادهم عنه، وهو أيضا ً سبب العداء التركي لجيش مصر الذي أنزل الهزائم بجيوش السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر، وكان بذلك بمثابة المسمار قبل الأخير في نعش الخلافة العثمانية.
أما يونيو فلقد كان مُدخلا للمؤسسة العسكرية ذات النهج الوطني شبه العلماني Semi- secular لإعادة مجرى النهر إلى طبيعته، لا عبر انقلاب عسكري غاشم، بل بتفويض صريح من الشعب. وليس في قاموس علم الاجتماع السياسي توصيف لمثل هذا العمل، فهو ليس انقلاباً عسكرياً مألوفا ًومتداولاً، وكذلك لم يكن ثورة بالمعنى الكلاسيكي، لكنه بالتأكيد إنما يمثل خطوة تقدمية على خلفية أهداف ثورة يوليو 52 بما تضمنته من انحياز لجموع الفقراء، ومن إصرار على رفض التبعية للغرب الرأسمالي المتوحش، جنباً إلى جنب قمعها للديمقراطية السياسية تحت شعار “الديمقراطية الاجتماعية” باعتبار “الكل في واحد” !! هذا الشعار الذي وُلدت من ُصلبه طبقة البورجوازية البيروقراطية، الطبقة التي رأينا مثيلتها في الإتحاد السوفييتي السابق، لا هي بالطبقة الرأسمالية القحة، ولا هي بالطبقة العمالية. فهي لا تأخذ أرباحاً من العمل المأجور، ولكن تنال حصة الأسد من فائض القيمة الاجتماعي بهيئة مرتبات ضخمة ومخصصات ومزايا ومكافآت. ..الخ
هكذا ماتت سهيلة:
في مصر اليوم يبلغ عدد موظفي الحكومة 3,5 مليون مجمل أجورهم السنوية 80 مليار جنيه، منهم 20000 من كبار العاملين يتقاضون وحدهم 64 ملياراً! متوسط ما يتقاضاه الواحد 266000 شهرياً ! وكل منهم مستعد لمساندة النظام السياسي الذي يحتفظ له بتميزه.
و “بفضل” هؤلاء وغيرهم من الرأسماليين الأقحاح ماتت سهيلة ابنة الأحد عشر ربيعاً بداء الفشل الكلوي، ماتت كما يموت غيرها بالألوف من سكان الألف قرية الأكثر فقراً في مصر[ 10 مليون مواطن ] حيث لا مياه شرب نظيفة ولا مستشفيات ولا مدارس، بل معاناة وبؤس من المهد إلى اللحد رغم الآمال التي عُقدت على الخامس والعشرين من يناير العظيم، والثلاثين من يونيو الأعظم.
فإذا لم يكن ما حدث في هذين اليومين انقلاباً ولا ثورة فأي اسم يمكن إطلاقه عليهما ؟ أي اسم ؟! ماذا يعني الاسم ؟ فالوردة تحت اسم تنشر عطرا، والقنفذ تحت أي اسم يدخل في جلده. .
هكذا كتب صلاح عبد الصبور في مسرحيته ذات المغزى السياسي بالغ الأهمية : مسافر ليل. وبقي أن ننظر هل سينشر الشعب عطراً ؟ أم يدخل في جلده ؟
ضميمة:
أوردت في أكثر من موضع ما يشي بموافقتي الضمنية على تصنيف الدين ضمن عناصر البناء الفوقي للمجتمعات البشرية جنباً على جنب الفلسفات والقوانين والأعراف. ..الخ
والحق أنني مع تحفظي على فكرة أن التاريخ يحركه الصراع الطبقي وحده، فإن قبولي لمجمل النظرية المادية للتاريخ لا يعكر عليه ضرورة التفرقة بين دين الدولة ودين النبوات، فهما – على تجليهما في البنية الفوقية للمجتمعات - نزعتان في الحق متعارضتان. فالنزعة الأولي توظف الدين لخدمة أغراض الدولة ( خاصة الطبقية ) السياسية والاجتماعية، بينما الثانية تهدف إلى الكشف عن منابع الوعي الإنساني كبنية أنطولوجية تحتاج فقط إلى مسوغات إبستمولوجية للتذكير بها، ومن هنا فإن “المقدس” هو ما يفتح الفضاء المعرفي لبلوغ المثل العليا، وهو أيضا ً ما يمنح الروح الطمأنينة ويشيع الحب والتسامح بين البشر بجانب نضالهم المستمر ضد الشر والقبح والاستغلال. وينبغي في هذا السياق تجاوز الثنائية الزائفة التي قد تبدو على السطح بين المقدس والدنيوي، وآية ذلك أن المقدس ينتمي بالفعل إلى الدنيا، كما أن الدنيا تتضمن المقدس ( وذلك ما يسمى بالعلمانية ) ولهذا فإن محبة الناس للأنبياء والأولياء اختيار لا غش فيه. فهؤلاء هم القادرون على توضيح الكيفية التي يجرى بها نظام الكون بما يحتويه من شرور ظاهرة، وما يحيق بالأفراد من بلايا كالمرض والموت، وما ينزل بالجماعات من نوازل كالحروب والكوارث الطبيعية، وحتى ما ينتظر الجنس البشري ذاته من مصير محتوم في نهاية المدى التاريخي مرتبط بحماقة البشر ( الذين يسعون بمخترعاتهم الجهنمية نحو الانقراض ) أو مرتبط فيزيائيا بالكوكب ذاته.
فالفناء - اختياراً أو جبراً – إنما هو مجرد عرَضٍ ملحقٍ بصورة ٍ لأصل. وهذا الأصل هو بطبيعة اختلافه عن كافة صوره لا تطاله الحوادث مثل الصور ( تستطيع أن تمزق صورة شخص دون أن يعني هذا أنك محوت الشخص ذاته ) ولأن الفناء إذا تم له تحقيق ذاته واستغرق نفسه فلا بد من أن يمحو نفسه، ومن ثم يفسح الطريق لأصل الكون أن يعيد الوجود من حيث بدأ، وهكذا فإن الموجودات الفانية تضمن – بفضل وجود الأصل الدائم - البعث والتجدد.
إذن فلا عشوائية بل نظام كوني لا يبرهن على معناه سوى خالق مدبر حكيم. وهو برحمته كفيل بضم سهيلة وسائر الشهداء إليه في نعيم هم له مستحقون.