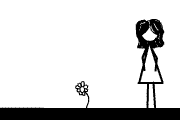“إن مشروعية أي نظام سياسي لا تتأسس فقط على احتكار النظام
لأدوات القهر والإكراه، وإنما تتأسس أيضا على الإقناع والاقتناع من طرف
المحكومين بالضرورات التي استوجبت عليهم العيش في إطار سياسي معين، وتتوقف
درجة الإقناع والاقتناع بمدى قدرة هذا النظام السياسي على تلبية حاجيات
وطموحات المحكومين”. محمد عابد
الجابري
يعيش جزء كبير من العالم العربي منذ سنة ونيف على وقع مسلسل
من الأحداث، اختلف المهتمون من محللين وخبراء ومثقفين وإعلاميين… حول
قراءتها أيما اختلاف، إن على مستوى المنطلقات والمآلات أو على مستوى تقييم
الحصيلة والنتائج.
أفرز هذا الحراك أطيافا مشككة وأخرى مقدسة وثالثة ما دون ذلك
حول ما يحصل، وبين هذا وذلك نقول أن الحراك العربي أبعد ما يكون عن بلورة
فكرة “كل ما يتمناه المرء يدركه”، لاختلاف السياقات الجيوستراتيجية والظروف
الداخلية المحاينة لمجرياته في كل بلد حيث “تجري الرياح بما لا تشتهي
السفن”.
لكن التاريخ يكشف عن حقيقة شبه يقينية هي صفوة ما قد يقال عن
هذه الثورات مفادها، أن جل الثورات التي استبدلت نظاما بنظام لم تكن
ديمقراطية على مر التاريخ. فالثورات التي تسعى لإقامة نظام جاهز لا تنتج
نظاما ديمقراطيا، بل نظاما شموليا كالذي ألغته أو أسوأ منه، ولنا في الثورة
البلشفية بروسيا والثورة الإيرانية أمثلة من التاريخ. وذلك بتفسير أساسه
أن الانطلاقة من العدم لا تكون ديمقراطية، لأن الإلغاء الكلي لما سلف يعني
أن النظام السابق كله سلبيات، وهذا غير صحيح واقعيا.
هذا ما جعل خطاب الإصلاح يتردد في أكثر من بلد بنسب ودرجات
متفاوتة، فيتم عمليا تغيير رؤوس الأنظمة، بينما تخضع باقي أجهزة الدولة
لجرعات من الإصلاح، غالبا ما يحددها عاملان، أحدهما حدة ودرجة الاحتقان
الشعبي، والآخر ذكاء ونباهة رعاة الإصلاح.
ولنا في النموذج المغربي الدليل الأمثل على صحة هذا الادعاء،
الذي عبر عنه أحد السوسيولوجيين بالقول: “في المغرب يتغير كل شيء من أجل
ألا يتغير شيء”، ورغم ما قد تحمله المقولة من تناقض ظاهري بيد أنها سليمة
عند تحليلها.
هذا الخطاب تُدووِل من قبل المؤسسة الملكية على امتداد حقبة
ما بعد الاستعمار بمناسبة وبدونها، غير أنه لم يكن محط اهتمام الجميع إلا
حينما صار أجوبة ترد بها هذه المؤسسة على أسئلة الواقع والمستقبل. وكانت
أولها بُعيْد صدور تقرير البنك الدولي منتصف العقد الأخير من القرن الماضي –
1995- الذي وصف الوضع في المغرب بالكارثي، ووضع البلد على حافة الانهيار.
انطلقت حركة الاصلاح بالسعي نحو تحقيق مطلب الانتقال
الديمقراطي، بمسلسل دشنه الملك الحسن الثاني بدستور جديد وانتخابات وترسانة
تشريعية همت كل المجالات، بيد أن الظاهر للعيان هو إبعاد – أو بالأحرى
استبعاد – المواطن المعني الأول بالأمر.
إن الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية ودخول
المعارضة التاريخية إلى دواليب الحكم والتسيير، وما تلاها من انفراج إعلامي
وحرية للتعبير كان على أساس توافقات ما بين المؤسسة الملكية والمعارضة
التاريخية التي كانت في موقع قوة (حزب الاتحاد الاشتراكي). حقيقة لم تدركها
بسبب شبح سنوات الجمر والرصاص الذي كان يطارد زعماء هذا الحزب، إلا بعد
طبخة التناوب التوافقي التي تبادل فيها الطرفان(القصر والمعارضة)
التنازلات.
كان المستفيد الأكبر من العملية هو المؤسسة الملكية بإدخالها
المعارضة التاريخية للحكم، ما يعني تحقيق المصالحة وتحسين صورة المغرب
خارجيا، هذا بالإضافة لبعثرة أوراق حزب الاتحاد الاشتراكي بخروج “تيار
الوفاء للديمقراطية”، ضدا على التنازلات وخرق القصر للالتزامات المتفق وفق
دفتر التحملات بين الطرفين.
محصلة هذه النسخة الأولى من الاصلاح بضاعة مزجاة من المفاهيم
والمصطلحات التي أضيف للقاموس اللغوي للمغاربة من قبيل العهد الجيد
والأوراش الكبرى والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة… والانتقال الديمقراطي
الذي تحول من وسيلة إلى غاية في حد ذاته. لقد اكتسب قاموس المغاربة كلمات
وفقد واقعهم المعيش حقائق حسب تعبير الكاتب الليبي الصادق النيهوم.
تولى محمد السادس سدة الحكم سيرا على خطى والده، في ذات
المسلسل على النهج والمقاس، مع بعض الإشارات الشكلية التي لا تمس الجوهر في
شيء. لكن هذا العهد الجديد سرعان ما تنكر لصفته تلك، حين قررت المؤسسة
الملكية مصادرة باقي الفاعلين، والانفراد بالفعل بعد أول انتخابات تجرى في
العهد الجديد 2002، وذلك بتبني النهج التكنوقراطي والأمني.
قاد هذا المسار البلاد إلى أفق مسدود على كافة المستويات
انبلج بجلاء في تشريعات 2007، وما كشفته من اختلالات وأزمات استشرت في
البلاد، ليطرح سؤال الإصلاح من جديد – وبحدة – أمام المؤسسة الملكية.
وكالعادة جاء الجواب – في شق منه- ضدا على السؤال بالسعي نحو إعادة تجربة
“الفديك”، من خلال تأسيس حزب الدولة بنسخة جديدة ومنقحة. ليدخل المغرب
مرحلة عصيبة كثر فيها اللغط والدجل إلى درجة تحقق شبه إجماع عن موت
السياسية.
حل الربيع العربي على هذا المشهد الآسن، ليحرك مياهه الراكدة،
ويظهر لاعبون جدد في الساحة تجاوزوا الفاعلين التقليدين على مستوى المطالب
والآليات. تبنى القصر خطابا إصلاحيا جديدا بعد أن تهاوت أنظمة عريقة في
الاستبداد غير بعيد عنه. بيد أنه سرعان ما تراجع بمجرد استدماج الحزب
الاسلامي المعارض في ماكينة النظام بعد أن فقد الكثير من بريقه، إن تجربة
اليسار الحكومي تتكرر مع الإسلام السياسي، إننا أمام تناوب توافقي جديد.
إن هذا الجرد التفصيلي لكل هذه المحطات ليس غاية في حد ذاته،
بقدر ما هو وسيلة اعتمدت لفصل المقال ما بين النظام والإصلاح من انفصال. إذ
الربيع العربي لم يثن المؤسسة الملكية من السير قدما في نهجها الحربائي
القائم على التكيف مع الأوضاع بتقديم أقل التنازلات.
ولنا في حلقات مسلسل الاستثناء المغربي البيان الأمثل، مع ما
يرافقه من تضليل سياسي وإعلامي من قبيل التأويل الديمقراطي للدستور
والتنزيل السليم للدستور والمرحلة الانتقالية الجديدة… وغيرها من الكلمات
التي لا يعلم منتهاها إلا النظام والراسخون في دواليب الحكم. هذا علاوة على
إغراق البلاد بمجالس المؤانسة التي لا صلاحيات ولا سلطات لها، والمسكونة
بهواجس الاستقطاب والمراقبة وشراء دمم أشباه المثقفين والمناضلين .
إن مستقبل مسرحية الإصلاح في المشهد المغربي لم يعد يغري أحدا
بالمشاهدة مهما اختلف الممثلون من يساريين وإسلاميين ومحافظين، مادام
سيناريو الأحداث والبطل معروف سلفا. نقول هذا لأن ما يجري من ثورات عربية
بهذه الطريقة التي تكاد تكون أشبه بانفجارات بركانية مدوية، والتي تمكنت من
استعادت صخب المجتمعات التي بدا وكأنها ماتت منذ ردح من الزمن، قد لا ينفع
معه حربائية النظام ولا أساليبه.
على مثل هذا الوضع علق المفكر محمد عابد الجابري في نهاية
زمن تسعيني – بداية التناوب _ بالقول: “يمكن مبدئيا القول أن الناس في
المغرب ما زالوا محتفظين بالأمل، وأيضا مستعدين للانتظار، فهم يقدرون
الظروف الصعبة. وهم مستعدون للانتظار أكثر إذا تبين لهم بوضوح أن أمامهم
مخرج مؤكد من النفق. ومع ذلك فالشكوك المشفوعة بالإشفاق قائمة، وربما
تتزايد ما يمكن معه توقع كل شيء”.
هذا المخرج الذي لا يزداد إلا لبوسا وضبابية في مغرب ما بعد
الحراك، الذي لم ينتبه مهندسو الاصلاح فيه إلى أن التاريخ بدأ أخيرا وكأنه
ينتقم لنفسه، ويستـــولد من صمته وعجزه جموحا في رغبات التغيير، وهو ما
يفـــسر حال ما بعد الثورات، وهذه الحيوية التي توحي أحيانا بالفوضى… يمكن
أن نقول أن المغرب أخذ ما يكفي من الحريات على صعيد التعبير والنشر والتجمع
والتعددية الحزبية. ولكن لا أحد من المغاربة يؤمن أننا فعلا حققنا
الديمقراطية… لماذا؟ لأن الديمقراطية ليست شيئا محصورا.
*باحث مغربي
منبر الحرية، 25 سبتمبر/ايلول