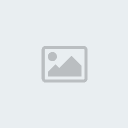 آن
آن
شينغ فرنسية من أصل صيني، عالمة بالصينيات، مهتمة بتاريخ الصين الفكري.
بدأت باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (فرنسا). ثم درّست في المعهد
الوطني للغات والحضارات الشرقية ، و في معهد فرنسا الجامعي. انتخبت في
الكوليج دو فرانس سنة 2008، وتحتل الأن كرسي الأستاذية في مبحث' تاريخ
الصين الفكري'. من أعمالها: ترجمة حوارات كونفوشيوس إلى الفرنسية (دار
لوساي 1981) و'تاريخ الفكر الصيني ' (لوساي 1997) ، كما أشرفت على مؤلفات
جماعية عديدة من بينها 'الفكر في الصين اليوم' (غاليمار 2007).
في هذا
الحوار تتحدث عن ظروف العودة إلى فكر كونفوشيوس و ما تطرحه من إشكاليات.
كما تحاول تفكيك بعض الأحكام المسبقة الغربية حول الفكر الصيني. أنتِ مهتمة بالتصدي للأحكام المسبقة المستحكمة حول الصين. ما هي في نظرك أهم تلك الابتسارات المتعلقة بالتراث الفكري الصيني؟ آن شينغ : يجب التذكير أولا أنه حينما نتحدث عن الصين، فنحن نتحدث عن واقع
ضخم و معقد للغاية. على المستوى الزمني أولا و دون أن نجاري الخطاب
الإيديولوجي الذي يتحدث عن 5 آلاف سنة من الحضارة الصينية، يمكن الحديث عن
ثلاث ألفيات على الأقل فيما يتعلق بالتراث الفكري الصيني. أما فيما يتعلق
بالمكان، فنحن أمام بلد يعادل أوروبا كلها. وهذا بغض النظر عن مدى تأثير
ثقافة وخط الصين على كل من كوريا و اليابان و فيتنام.. خلال كل الألفية
الثانية من العهد المسيحي. و مع الأسف لم نتخلص بعد من النظرة الموروثة من
عصر الأنوار والآتية تحديدا عن طريق المبشرين اليسوعيين و التي حددت
نظرتنا حول الصين. تسود خرافتان، تتحدث الأولى عن صين فلسفية وجدت لها صدى
لدى فولتير في فرنسا. والثانية عن صين الاستبداد الشرقي التي كثيرا ما
تقترن باسم مونتيسكيو. فمن جهة هناك صين ينوه
بعقلانيتها،توافقها،عالميتها، وجمالياتها.إنها أسطورة صين / الفلسفة. ومن
جهة أخرى صين عنيفة، فظة تلصق بها كل الأحكام المسبقة حول ثقافة الخضوع
الأعمى للسلطة…تلك هي التصورات المسبقة الأساسية التي ما زالت قائمة إلى
اليوم. وينتقل ذلك التصور من أقصى الكاريكاتور إلى أقصى الحذق : من النظرة
الكولونيالية حول التنكيل في الصين و ذلك الشعب غير القادر على التفكير
بنفسه، وحتى إلى أكثر الخطابات بلورة، التي تفسر كيف أن التراث الصيني لا
يعرف الحوار و الجدل و لذلك لا يمكن أن نقابله بالتراث الإغريقي- اللاتيني
المرتكز على الرأي العام والمنتديات . و هي فكرة أسقطها على العالم
المعاصر هؤلاء الذين يريدون التأكيد على انتفاء النقاش في عالم الفكر
الصيني الحالي. وهذا ليس صحيحا تماما، لأن النصوص تبين أن هناك مناظرات و
جدل في التراث الصيني. وعلى الرغم من محاولة الرقابة الواضحة التي تمارسها
السلطات الحاكمة، نجد اليوم على الأنترنيت عددا كبيرا جدا من المنتديات و
مواقع التعبير الحر، وهو ما يدل على وجود حياة فكرية غنية. و لكن للوقوف
على ذلك ينبغي أن يكون لنا حد أدنى من الاحتكاك مع الواقع الصيني على
الأقل.. وذاك ليس حال بعض الذين يخطبون حول الصين الأبدية بحماسة و لكن
دون أن يتحلون بنفس تلك الحماسة في الذهاب إلى الميدان للقاء معاصريهم
الصينيين.
هل يبدو لكِ الحديث عن 'فلسفة صينية' معقولا؟ حينما نتحدث عن التراث الفكري الصيني نميل إلى وضعه قبليا في خانة
الفلسفة. وتلك هي القبلية بالذات التي بدأت مساءلتها و أنا أتابع بكل
اهتمام كيفية اختراع هذه المقولة في الحداثة الصينية في آواخر القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وفي الحقيقة لقد عشنا عملية تركيب
مصطنعة على الشأن الصيني. لقد تم إنتاج طيلة القرن العشرين مجموعة كبيرة
جدا من "تواريخ الفلسفة الصينية" و غالبا بطريقة أشبه بالطريقة الصناعية.
فها هو مو زونغسان الذي قضى عمره المهني بتايوان، خارج الصين الشيوعية،
يحدد من جهته مشروعا ابتغى من خلاله تأسيس علم أخلاق كونفوشيوسي جديد وذلك
بالمواءمة بين الأخلاق الكانطية وأخلاق الكونفوشيوسية المحدثة. يطمح شينغ
شونغ - يونج وهو جامعي صيني- أمريكي مقيم في هاواي إلى إعادة التفكير في
الميتافيزيقا الغربية معتمدا على 'كتاب التحولات' و الذي هو مصدر من
المصادر الأساسية في الفكر الصيني. وفي المقابل نجد عمل فرنسوا جوليان
الذي يستعمل الصين ليستخرج اللامفكر فيه في الفكر الغربي. و اختصارا نجد
في الأمر تجارب من كل نوع.
"هل هناك فلسفة صينية؟" و"هل يمكن أن نتفلسف باللغة الصينية؟" من أجل
استعادة تملك تراثهم، يحاول المثقفون الصينيون المعاصرون إعادة النظر في
مثل هذه الأسئلة. المقصود اليوم هو الانطلاق من الصفر والتساؤل فيما إذا
لم يكن من المستحسن والمثمر التخلص نهائيا من هذا الافتراض الفلسفي الحصري.
ما رأيكِ في منهج المقارنة المعتمد دائما عند التطرق إلى الصين؟ يجب أن تكون المقارنة نقطة انتهاء إذ لو تم تصورها كنقطة بداية نظرية
لحُكم عليها بفبركة قضايا مصطنعة. كثير من الطلاب تجذبهم المقارنات و لا
نقصد الفرنسيين منهم فقط بل يصل الصينيون أيضا ورؤوسهم مملوءة بمنهجيات
تعلموها بسرعة، بلا عناية. وتكون النتيجة التقليل من أهمية جانبي
المقارنة. فحينما نحاول مقارنة الصين واليونان، تختزل الفلسفة اليونانية
دائما بشكل من الإشكال في أفلاطون و أرسطو. في حين يمكن أن نعود إلى وجوه
أخرى، مثلا هؤلاء الفلاسفة الذين درسهم بيار حدو، الرواقيين و
الأبيقوريين, إذ قد نجد عناصر فكرية مشتركة بينهم و بين مفكري الصين في
العصر القديم، هؤلاء الذين فكروا هم أيضا بدورهم في مسألة في كيفية عيش
الفرد لمصيره الإنساني في أفضل ما يمكن والعيش مع غيره على أحسن ما يرام.
إذا اختصرنا العصر اليوناني القديم في الإرث الأفلاطوني و الأرسطي
ووضعناه في مقابل العهد الصيني القديم منظورا إليه ككتلة واحدة، سيسهل
علينا جدا إيجاد وإظهار التناقض و التعارض، لأن بين أيدينا مواضيع قد سبق
وأن بنيناها لهذا الغرض.
شخصيا، أرى أن الأولوية هي في العودة إلى مقاربة تاريخية تقينا
من شر السقوط في تهويمات بلا أساس قد تفضي بنا إلى خطر فقدان العلاقة
بالواقع. خصوصا إذا ما عرفنا أن بعض المواقف النظرية قد تصبح خطيرة إذا ما
سقطت بين أيدي إيديولوجيين وناشطين سياسيين. فمثلا تستغل فكرة الغيرية
الصينية من طرف إيديولوجيين ينتهزون الفرصة لتمرير عبرها أن ليس للصينيين
ثقافة ديمقراطية. ومن ثمة المطالبة بكونية صينية أخرى و الحكم في نهاية
الأمر بعدم اهتمام الصينيين بحقوق الإنسان. لقد عملت الصين طيلة أكثر من
قرن على تهديم تراثها الفكري، واليوم نجد أنفسنا أمام جيل ما بعد الثورة
الثقافية الذي لا يعرف التراث وبالتالي يسهل التلاعب بعقله. ولئن كان
للصينيين الذين ولدوا في الثلاثينات بقايا علاقة مع تراث بلادهم الحي- حتى
و إن كان قد تعرض للهجوم آنفا-،فلم يعرف الجيل الموالي الذي عاش تحت نير
النظام الماوي التراث إلا من خلال عملية التهديم التي كان يتعرض لها و لم
يعرف كونفوشيوس سوى من خلال حملة النقد التي كانت موجهة ضد لين بياو. أما
الجيل الجديد المولود بين 1970 و 1980، فهو من جهته يجهل تماما ماضيه
البعيد و يتناسى ماضيه الأكثر قربا. ورغم ما يبدو من علامات العودة إلى
التراث، فإن الشباب الصيني الذي يعيش اليوم في المدن هو شباب استهلاكوي
تربى في محيط غربي بلا علاقة تربطه بالأوليين أو تاريخ الآباء. لذلك تبقى
كل التلاعبات ممكنة بعقول هذا الجيل. وأمام هذا الوضع ينبغي علينا هدم كل
ما ترسب من تصورات من أجل إعادة تأسيس شيئا، يكون قريبا من الواقع
التاريخي بعض الشيء. فالتاريخ الفكري يأخذ بعين الاعتبار مسألة إعادة
القراءة والنقاش والجدل الداخلي.
ما سر هذا الانتقال بين الصين القديمة والصين الحديثة..؟ أحاول أن أقدم إضاءة عن الحياة الفكرية لمعاصرينا الصينيين, وعلى الخصوص
هؤلاء الذين يهتمون بالتراث ويبذلون قصارى جهودهم لتملكه. منذ حوالي 150
سنة على الأقل، تنظر الصين إلى ما عاشته على أنه تجربة استلاب وإذلال أمام
الغرب. ولئن أمضت الصين قرنا كاملا في تقويض ميراثها بشكل قصدي واع، فإنها
تتخيل اليوم أنها بإمكانها الافتخار به. و هذا انقلاب حديث عهد، تم خلال
جيل واحد و يتخذ عدة أشكال و ذلك حسب مستوى العقل النقدي: من وطنية مهووسة
بالانتقام ووصولا إلى تحاليل أكثر جدية. شخصيا، أحاول أن أفهم هذه
الخطابات المتركزة أساسا حول كونفوشيوس وكتاب 'الحوارات'.
كيف تفسرين المكانة المركزية التي يتمتع بها كونفوشيوس في الفكر الصيني؟ في بداية العهد الإمبراطوري، وبالتحديد في بداية حكم سلالة هان، في القرن
الثاني قبل العهد المسيحي, رُفع كونفوشيوس إلى مرتبة الحكيم الأسمى و تم
تأليهه ضمن الشعائر الإمبراطورية. وقد غدا إيقونة في حركتين: حدثت عملية
تقديس طويلة المدى في التراث الصيني ثم تم استعادتها و تضخيمها في أوروبا
عصر الأنوار. وإن كان جاء ذلك متأخرا، فقد اكتسبت 'الحوارات' على وجه
الخصوص مكانة عظمى، وانتقلت على أنها كذلك إلى النخب الأوروبية. و قد قام
اليسوعيون بوظيفة الوسطاء هناايضا إذ كان كتاب 'الحوارات' من أول الكتب
التي نقلوها إلى اللغة اللاتينية. ولكن لا يستوفي كونفوشيوس كل ما استطاعت
الصين أن تفكر فيه. فهناك بالتأكيد أيضا التقاليد التاوية والبوذية، و لكن
ليس هذا فحسب بل نحن نجهل في الغالب، أن في بداية القرن الثامن وتحت حكم
أسرة التانغ، استقبلت الصين الزرادشتية والمانوية الخ. وهو ما يكذب بشكل
مطلق تلك الصورة المكونة عن صين منغلقة تماما قبل مجيء الغرب ممتطيا حصانه
الأبيض. يبقى أن صورة كونفوشيوس قد انصهرت مع هوية امبراطورية معينة، لا
تعني سوى السلطة المركزية مع حركة طاردة : من المركز نحو الأطراف، ومن
أعلى هرم المجتمع إلى أسفله.
ولئن ساد كونفوشيوس فذاك يعود أيضا إلى فكرة معينة عن الحضارة والثقافة
الإنسانية. فقد كان الرجل واعيا جدا بأنه وريث ثقافة سامية وأن مهمته هي
نقلها للأجيال الموالية. كان له تصورا أصيلا للغاية، فالتراث حسبه هو ما
يتغير أساسا. فلم يفهم رسالته كل هؤلاء الذين نظروا إليه على أنه شيخ
رجعي، مخرّف ومحافظ. كان ينظر إلى عملية نقل التراث على أنها علاقة
إنسانية في تغير دائم و تساؤل مستمر حول ذاتها. وحتى الذين حاولوا تحطيمه
و خاصة الأكثر تشددا منهم مثل أنصار الثورة الثقافية، فهم يعترفون اليوم
بقيمته التربوية والبيداغوجية. لقد ساد كونفوشيوس بما جسده أكثر بما قاله.
وتتجلى قيمة 'الحوارات' في حفاظها، ليس فقط على ما قدمه من دروس، و لكن قد
حافظت على صورة المعلم الذي كان. وهذا بلا شك ما سمح لرسالته أن تبقى حية
وذلك بغض النظر عن التقديس الرسمي.
غالبا ما يتم الإصرار اليوم على مسألة استعمال كونفوشيوس كأداة ووسيلة دعائية. هل من مصداقية لهذا الخطاب؟ لا يمكن رد عودة كونفوشيوس إلى مجرد ظاهرة استغلال إيديولوجية بسيطة.
فالمسألة ليست بنت أمس قريب، فمنذ القرن العشرين، حاول بعض المثقفين
الصينيين مقاومة ذلك الإغراء الحداثوي الرامي إلى رمي التراث برمته في سلة
المهملات. وإن هزمهم التاريخ واختار أغلبهم المنفى ابتداء من سنة 1949.
ولكنهم عادوا إلى واجهة الأحداث نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي عرفته بعض
البلدان الأسيوية وكذا عودة الخطاب حول القيم الكونفوشيوسية ابتداء من
ثمانيات القرن المنصرم. وقد سار على هذا الدرب جزء من الوسط الثقافي في
صين اليوم. عاد كونفوشيوس أيضا ضمن ذلك التفكير السياسي الذي مارسه مثقفون
يفكرون في طريق صينية لا هي مجرد استعادة سطحية للإرث الماوي و لا هي
امتداد لنماذج مصدرها الديمقراطيات الليبرالية الغربية. و قد ذهب أصحاب
هذا المنهج الصيني إلى البحث عن القيم و الثروة المعنوية في خزان الأفكار
التقليدية العظيم. و ذلك بغية ابتداع طريقة حكم جديدة و مناهج أخرى في
الإدارة الاجتماعية. كما نلاحظ أيضا عودة إلى التربية على الطريقة
الكونفوشوسية، تعتمد على إعادة تقييم حب الوالدين لدى الأطفال وعلى الخصوص
من خلال تحفيظهم 'الحوارات' عن ظهر قلب. و يتم هذا لحد الآن و بشكل محدد
في إطار هامشي كالمناهج الخارجة عن إطار التعليم الرسمي، و هي أساليب
تقليدية وضعها ناشطون بغية إعادة أخلقة الشبيبة و لتجاوز المشاكل
الاجتماعية التي تعيشها الصين اليوم.
وفي الأخير يمكن أن نشير إلى وجود بعض مؤرخين داخل و خارج الصين، يحاولون
أيضا فهم الظروف التي تكونت فيها صورة كونفوشيوس ونص 'الحوارات'. وأخذت
عودة الحكيم أوجه شديدة الاختلاف و هو ما يبين غليان و حراك في الحياة
الفكرية الصينية اليوم، بعيدا عن الصور النمطية المعتادة.


