[rtl] ريادة في تشريح العنصرية الغربية (1)[/rtl]
[rtl]
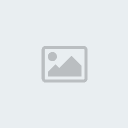
[/rtl]
[rtl]حسين سرمك حسن[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] (هل كان الابطال على الدوام موضع شبهات ، ولا يتحرّرون من اللعنات التي تلاحقهم إلا بالتضحية الشاملة ؟
هذا ما فعله الكثيرون . وكأن لا جواب مقنعا لنفي تلك التهم والافتراءات عنهم ، إلا بتدمير أنفسهم ، والإنتقال بها من عدم الحياة إلى بطولة العدم ! )
(الكائن البشري ليس غير موظف يعمل في خدمة ذكرياته على الدوام )
(إن مجموعات بشرية تحب العزلة، وتفضل معاشرة الكلاب على الإختلاط بالشعوب الأخرى ، حريّ بها هذا المجد : تعيش في غابات نباح . فالحضارة مثل المخلوق الحي ، متى ما شعر بتخمة الإستعلاء ، يكون قد أجهز على نفسه بمصير مغلق أو غامض )
(أجل يا آدم. فالعنصرية تراث من طراز معقّد. وهي ضربة قاضية لماهية الإنسان.
الشرق الذي هربت من عبودياته المختلفة، لتلتجيء للغرب الديموقراطي المفتوح، سيستعيدك ذات يوم، مادمت ترفض عبودية الغرب لك. لذلك ترى الإثنين – الغرب والشرق أقصد – يدفعان بك إلى الحفرة. فحيث ترفض استعبادية الغرب، يضغط عليك الفرنجة، لتعود إلى مواقعك الأولى عبداً لأنظمة ما تزال مُستعبدة من قبلهم. وتاليا لتكون منضبطا داخل السرب. إنها ينابيع الاستبداد القديمة. ولكن تذكر أن من يبتسم لك في هذه البلاد، إنما يشتم سلالتك في أفضل تقدير أو احتمال).
أسعد الجبوري
رواية “ديسكولاند”[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تمهيـــد :
———-
إن الموضوعة التي يعالجها الشاعر والروائي العراقي “أسعد الجبوري” في روايته الأخيرة “ديسكولاند” هي موضوعة متفرّدة لا أعتقد – وبقدر متابعتي للإنتاج السردي العراقي والعربي – أن كاتبا آخر غيره قد عالجها بهذه السعة والدقة والشمول. فقد تصدى اسعد لمعضلة هائلة، لعل أول علامات صعوبتها المضنية، هي أنها أقرب للأطروحات الفلسفية والفكرية منها إلى الأطروحات الاجتماعية والنفسية، التي تكون أكثر يسرا على الروائي عند التعاطي معها سرديا ، فالفن ليس من مسؤوليته التنظير الفكري والتأطير الفلسفي للمعضلات الوجودية، بالرغم من أنه يغوص في أعماقها، وقد يستبق المختصين في كشف إرهاصاتها والتقاط نواها الأولية ؛ واجب الفن هو أن يلتفت جماليا إلى أوجه الشقاء البشري – وهو أكثر بكثير من نعيمه وأولى منه – لـ “يصوّره” بأكثر الصور نفاذا مؤلما وقاسيا في النفس البشرية، وليهز عن هذا الطريق أسس التفكير ومقومات العقل . فدستويفسكي – مثلا – لم يطرح في روايته الجريمة والعقاب على سبيل المثال افتراضات نظرية تمهيدية حول العدالة وصراع الخير والشر، ثم يأتي بحادثة قتل بطلها راسكولينيكوف للمرابية اليهودية من أجل تحقيق “مشروعه” في تخليص سونيا – كأنموذج فردي واحد مسحوق – من مهانتها وفقرها بعد امتلاك المال ، بل طرح الحادثة الجرمية الدامية وضمنها المعطيات الفكرية المريرة والشائكة التي يؤمن بها، والتي شوّشت ذهنه وأربكت حياته هو أولا قبل المتلقي . وقد حاول أسعد الجبوري جاهدا في روايته “ديسكولاند” هذه، أن يمرّر رؤاه الفكرية حول محنة عالمية مريرة لم تأخذ حظّها الوافي من البحث العلمي والإستقصاء النفسي والتناول السردي عالميا بشكل عام، وفي الحياة الغربية، وهي المعنية بها أساسا بشكل خاص . وحين يمضي القاريء مع وقائع الرواية الكثيرة المتراكبة ذات الإيقاع اللاهث، فإنه قد يشعر بأن المعضلة بعيدة نوعا ما عن الهموم والإنشغالات اليومية الوجودية والنفسية والاجتماعية، وحتى السياسية، التي يتقلب على جمرها منذ مئات السنين. فقد يتصور هذا القاريء ذو النوايا البريئة أن محنة “العنصرية – racism ” قد انطوت صفحتها بدرجة كبيرة جدا في القرن الحادي والعشرين، الذي دخلنا بخطوات قلقة ومرعوبة عقده الثاني. وفي الغرب – وعلى مستوى المرجعيات السياسية والبحثية المؤدلجة بشكل خاص– يبدو أن العقل يعيش حالة من “الإنكار – denial” و”المقاومة – resistance”، وهما آليتان دفاعيتان نفسيتان يلجأ إليهما الإنسان لاشعوريا لتخفيف حدة الشعور بالقلق المرتبط بالإحساس بالإثم في المواقف الفكرية والسلوكية التي تثيرهما. إن العقل الغربي يعيش في ما أسماه المفكر العراقي الراحل “علي الوردي” بـ “القوقعة البشرية”، وهو مصطلح اجترحه كمرادف لمصطلح (الإطار الفكري)، الذي يحيط بعقل الفرد ووجوده، ويحدد مسارات إدراكه وأحكامه. وهذه القوقعة تكون في أوج قوتها في سنوات الطفولة المبكرة. وكلما كبر الإنسان وزادت تجاربه ضعفت فيه هذه (النظرة القوقعية) ولكنها لا تموت أبدا. ويصعب على الإنسان التخلص من قوقعته مهما حاول، فهي تكتنفه بصورة لاشعورية، وتخلق نوعا من (الغربال اللاشعوري) يغربل الأقوال التي تُقال عن شخص فلا يدعها تصل إليه على حقيقتها. ويتساوى في هذه القوقعة في النوع العامة والمثقفون ورجال الدين وقادة السياسة والزعماء والفلاسفة ولكنهم يختلفون من ناحية درجتها. فـ (الظاهر أن الفلاسفة لا يختلفون عن العامة في هذا. مزية الفلاسفة أنهم يتكلمون فلا يرد أحد عليهم مخافة أن يتهمه الناس بالغباوة أو الغفلة أو الجهل. ولهذا ملأ الفلاسفة القدماء كتبهم بالسخافات وصدق بها الناس. ولو جمعنا الفلاسفة في صعيد واحد، وقلنا لهم اتفقوا على رأي صحيح نصلح به الناس ، لتجادلوا وتخاصموا .. ولظن كل منهم أنه أتى بالرأي الصواب) (2).
ومن الواضح أن هذه القوقعة المحيطة بالعقل الغربي جمعيا وفرديا، تتصلب طبقاتها، وتتشابك أذرعها الأخطبوطية يوما بعد يوم إلى الحد الذي تشوّش فيه النظرة العلمية، بل تعمي البصيرة قبل البصر في التعامل مع المعضلات، التي تحاصر المصير البشري في المجتمع الإنساني. وقد أوصلت هذه القوقعة الغرب، حكومات ومجتمعات، إلى انتقائية مرضيّة عجيبة. تصوّر أن الغرب قد اعترض على الحكومة العراقية لأنها رسمت صورة السفاح (جورج بوش الأب)، قاتل الأطفال حسب وصف الجواهري الكبير في قصيدته المعروفة، على مدخل فندق الرشيد بحيث يدوسه من يدخل إلى الفندق، وعدّوا هذه الخطوة مضادة للديموقراطية ولحقوق الإنسان (قتل هذا المجرم 400 طفل عراقي في محرقة العامرية)، في حين أنهم يعدّون رسم صورة النبي محمد (ص) على هيئة خنزير من قبل رسام دانماركي من باب الحرية الشخصية، وشجبوا ردود فعل المسلمين الساخطة التي كانت “غذائية”، لم تتجاوز مقاطعة الجبنة الدنماركية!!
وقد حاول أسعد الجبوري، بجرأة ومهارة فنية عالية، وعزم سردي لا يلين، وعبر (356) صفحة من الوقائع المريرة المتلاحقة الصاخبة ، تمزيق البراقع عن “قوقعة” العنصرية التي باتت تخنق المجتمعات الغربية، وترسم سلوكياتها بتعسف، وبما يلحق أفدح الأضرار بالمجتمعات الأخرى، برغم أن الجميع هناك لا يقوى على الإعتراف بها.[/rtl]
[rtl]
وحيداً في صقيع الديسكولاند :
——————————
تبدأ الرواية بعرض الحال الموجع لـ “مالك” المهاجر من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصقيع الإسكندنافي، والمستقر حاليا في بلاد “الديسكولاند” عاملا في حوض بناء السفن لعشرة أيام كان من المنتظر – وكنتيجة متوقعة – أن يتكيّف مع متطلبات المجتمع الجديد مقاوما جفاف الإغتراب وموجات الموت المبكر كما يقول، إلا أنه لم يستطع تحقيق ذلك . لقد عاش نهبا لمشاعر الإغتراب عن ذاته وعن محيطه ، وعالقا في مصيدة دوامة اجترار الأفكار والذكريات السود التي تنبثق من جوف الإحساس بالعزلة الخانقة :
(… ذلك ما حدث معي طوال سنوات الإغتراب ، فقد بت أشعر بأن وجودي الشخصي ليس إلا كومة عظام معلقة على ظلام متحجر، مما دفعني لخوض المعارك تلو المعارك مع رأسي لمحو تلك الصورة ، خاصة في اللحظات التي أرفع فيها صفائح الحديد لوضعها على سطوح الرافعات الضخمة. كانت فكرة تحوّل المرء إلى مخلوق من مواد صلبة ، هو ما كان يفتتني ويرعبني في آن واحد – ص 10 ) .
في الوقت الذي رفض فيه وجوده الكلي ، روحا وعقلا، تقبّل المكان الجديد وكأنه جرثومة مميتة، فإنه لم يستطع خلع ذكريات المكان القديم. وهذا الصراع هو الطريق المستقيمة نحو الكارثة بالنسبة لأي مهاجر. وإذ استولى هذا الصراع على عقل مالك ووجوده بأكمله، فإن النتاج الطبيعي هو الغرق في خضم ذكريات وتأملات متلاطمة يكون تمظهرها الاساسي هو “الشرود” الدائم والثابت، الذي لفت إليه أنظار المشرفين على العمل برغم نشاطه وطموحه. ولهذا السبب استدعاه الآن مدير حوض بناء السفن (السيّد فرانك) إلى مكتبه. وفي محاولة لتخليصه من “مرض” الشرود هذا، طلب منه المدير أن يتحدث إليه عن طفولته، فهي مصدر تيار الذكريات والأفكار التي تتضارب في ذهنه وتمنعه من التركيز على المتغيرات المحيطة به. وفي استدعائه لطفولته يستذكر مالك الكيفية التي نُفخت فيها طقوس ولادته، لتمنحه وجودا اصطناعيا متنفجا، مخلوعا من حضن أمه الحاني، ومرميا في أحضان ذكورية خشنة وقاسية، حيث تُمنع عليه الرضاعة من ثدي أمه المنعم وتُفرض عليه الرضاعة من النوق مباشرة ليصبح أكثر جلدا على الآلام وأكثر تحملا لمشاق الحياة. وبدلا من أن توزع الحلوى على الناس فرحا بولادته، وزعت البنادق والأعتدة لتشتعل سماء المدينة بأضواء الرصاص. وعوضا عن نحر الخراف، قُطعت رقاب الأعداء من أسرى القبائل وسجنائها ممن كانوا محتجزين في قلعة جدّه (ص 15). لقد خُلع من حضن الأمومة (الأنوثة المسالمة والعادلة والمتصالحة مع ذاتها ومع الطبيعة- humanbeing among nature) الفردوسي وألقي في حضن جدّه (الذكورة المعادية والمنحازة والمتصارعة ضد ذاتها وضد الطبيعة- humanbeing against nature ) في محاولة مستميتة لنفخ ذاته بمقومات ذكورة اصطناعية افتقدت أهم ركائزها متمثلة في النمو الطبيعي الراكز في فردوس الأمومة أولا. والطفل الذي لا تدرّبه يد الأمومة (الأم هي المعلم الأول وجوديا وفلسفيا) أولا على الحب، لن يصبح قادرا على محبة نفسه، ولا على التناغم مع مشاعر الآخرين. ولهذا عاش مالك، وهو يشعر بعزلة قاتلة، وهو وسط أهله وقومه وعلى تربة وطنه، حالما – بفعل الحرمان – بالبحر كرمز مكافيء للرحم الأمومي المفقود ومنذ سنوات طفولته الأولى، عابرا إليه – لأن بيئته صحراوية جرداء – من زرقة، والزرقة لون الأمومة، عالم إرهاصاته الداخلية ، عالم مائي يذكّر بالرحم الأمومي الحاني :
(شعرت بالوحدة. أجل يا سيّد فرانك، لم أحس بتعاطف مخلوق واحد مع طفولتي. لكن، وعلى الرغم من أن جدّي لا يملك من البحار بحرا، وهو ما كان ينقصه بالفعل، إلا أنني استطعت تخيّل البحر للمرة الأولى… لا أعرف كيف قفز ذلك المشهد الأزرق الشاسع لدماغي آنذاك. فقد تخيّلت السفن بيوتا مشيّدة تمشي على سطح المياه.. قد يكون السراب الصحراوي هو الذي أوحى لي بتلك الصورة – ص 15) .
هنا تتقطع أنفاس المدير ويسقط منهارابرغم أنه لم يسمع سوى جزء بسيط من طفولة مالك المفقودة، وتنقله سيارة إسعاف إلى المشفى. ومن هنا- وعلى امتداد مسار الرواية الطويل- قد يقع القاريء في مصيدة تصوّر سطحي ومباشر مفاده أن حادثة انهيار المدير واحتباس أنفاسه هي حركة ساخرة مبالغ فيها من أجل إضفاء روح فكهة على مناخ الرواية. لكن ما سنراه يشي بخلاف ذلك. وسيثبت التحليل أن ما سنحيا في خضمّه هو ليس من نوع الكوميديا السوداء إلا بالقدر الذي توقعنا في شباكه مقاوماتنا ونزوع عقلنا التبريري (الإنسان ليس كائنا منطقيا بل تبريريا- not rational but rationalized humanbeing ). نحن نقف مع أسعد على عتبة (أقصى الواقع) والتي سنواجه بعدها (الجنون) ممنطقا ومعقلنا كما سنكشف ذلك.
يهرب مالك من مكتب المدير وهو مغيّب الوعي بفعل الخمرة، والخمرة واحدة من سبل ترميم الواقع النفسي الممزق للمهاجر غير المتكيّف. ومالك في حالة هجرة (دائمة) منذ أن اكتوى بنيران الهجرة المريرة الأولى من حضن الأمومة (الأنوثة) إلى حضن الذكورة. وضمن “مرض” السفر الدائم في الزمان أو المكان أو كليهما، والذي يترتب على صدمة الإنخلاع من الحضن الأمومي، تأتي دوامة “السفر” في “بحر” الذاكرة العارم والخطير. لا تمر لحظة على مالك دون أن “يسافر” تائها في محيط ذاكرته الهائج ، فمن تصوّر نفسه كلوح سومري أصابه الإضطراب في لحظة غامضة من الزمن، فجاء محمولا إلى حوض بناء السفن الإسكندنافي الصقيعي، إلى التفكير بتشييء ذاته إلى كمنجة أو آلة تنطق.. فتصوّر نفسه صاحب جيش جرار منهك.. وغيرها من الهواجس والصور المتلاطمة التي تعبر عن القلق من اهتزاز صورة الذات وعدم ثباتها؛ هذا القلق الذي جسّدته الصورة التي رسمها وعيه المشوش ببلاغة عبر التساؤل:
(كيف لنطفة شرقية مثلي أن تغادر رحمها الطبيعي، فتصبح قشّة في هذا التيه المخيف الموحش؟ – ص 6) .
ولم يكن بحثه عن فردوس رحمي جديد- بحريّ هذه المرة- معوضا بكفاية عن حرمانات حياته القاسية الماضية، فقد جاء صقيعيا ليمثل الطرف القصي من المتصل – continuum البيئي، صقيع مقابل صحراء؛ صقيع يجمد أوصال الروح قبل أطراف الجسد؛ صقيع حتى العمال من المواطنين الأصليين يرفضون العمل فيه في حين يُنسب العمال المهاجرون- ومالك منهم- للعمل فيه كخطوة أولى في التمييز في العالم الجديد. عالم لم يكن له فيه من خلٍّ غير المصطبة الحجرية في وحدة مروّعة لم يخدشها سوى حضور رجل ضخم جاء ليجلس إلى جواره على المصطبة. كان مالك يتوقع أن هذا الرجل سوف يخفف وحشته القاتمة، لكنه مد يده لمداعبة عضوه التناسلي!! (وسنرى أهمية هذه الإشارة الجنسية التي تبدو مُقحمة لاحقا).
هكذا تتراكم الخيبات الواحدة فوق الأخرى، وعبر عشر سنوات متلاحقات من رحلات “السفر” الدائم المضنية في المكان. ومن هذه الرحلات الفعلية- وليست المتخيلة في أكثرها- هي رحلته مع “جينفرس” التي التقاها مصادفة فقادته في رحلة إلى أقصى الصقيع حيث تعارف جسداهما، هو القادم من الصحراء وهي الراكزة في الصقيع، لتكون نتيجة هذا التعارف، الحامي جنسيا، والمتناشز معرفيا كما تدل على ذلك تفصيلات الحوار بينه وبينها، وهما يستعدان لممارسة الجنس، طفلا خديجا أسماه أبوه “المثنى” تيمنا بثنائية فصيلتين من الجينات التي اتحدت ذات يوم تحت تأثير طغيان من الشهوات المشتركة (ص 31)، كما كان مالك يرى، لكن عاصفة الحب بين الأبوين مالك وجينفرس سرعان ما همدت لتنتهي العلاقة بالإنفصال، وليحيى المثنى وحيدا، ليس بسبب اتفصال والديه عن بعضهما ثم موت أبيه، وهو في السادسة عشر من عمره حسب، بل لأنه واجه مقتا اجتماعيا متصاعدا من السكان الأصليين أوصله إلى عزلة بايولوجية ونفسية مؤلمة. كان الآخرون يسمونه “الخنزير الأسود” ويحملون أمّه وزر تلويث الدم الصافي في اختلاط غير شرعي مع فصيلة دم الشخص الطارىء الغريب (أي مالك). ولم تفلح كل محاولاته الهروبية في تخفيف هجمة العنصرية التي حاصرته من كل جانب. ومن الغريب أن حاله ينطبق على حالة أبيه التي وصفناها سابقا، حتى في التعبيرات اللغوية التي تصور آلام عزلته فقد (تحولت منازل الغرباء إلى ما يشبه أكوام قش تطفو على أسطح مياه لوّثها الطمي الإجتماعي والإنهيارات الكبرى لأحقاد بلغت ذروتها بطوفان العنصرية – ص 32).
إن وجوده، هو نفسه، وجود القشّة التي تتلاعب بها أمواج بحر التيه المتلاطمة. بل يصل التطابق حتى المماهاة – identification الكاملة في الإنفعالات النفسية حيث عاد الإبن إلى المعاناة من رحلة “السفر” المزمنة في المكان! مثلما عانى منها الأب الذي أوصى إبنه بخلاصة تجربته الإغترابية بقوله :
(لو بحثت عن العدالة الشاملة على الارض يا مثنى، فلن تجدها إلا نسخة مستهلكة لعالم أحرق صورتك حتى قبل أن تولد أو يرى ملامحك من قبل. فالأرض التي تحت قدميك الآن، يا بني، ستكون مستنقعا آسنا، تتصاعد منه رائحة العزلة. فالإندماج، وعندما يصبح قبرا مثاليا، فما عليك إلا مغادرة المناطق المشيّدة على أساس محو الآخرين. تذكّر ذلك يا ولدي، ولا يأخذك هوس الإرتباط بتيه جديد – ص 33).
وبالرغم من أن كل الشواهد المحيطة بالمثنى تؤكد صحة وصيّة أبيه، وآخرها طرده من قسم الإلكترون في كلية العلوم التي تخصص فيها، بسبب محاصرة الآخرين له من أساتذة وطلاب، كانوا يتهمونه صراحة، بأنه يريد إتقان هذا العلم، ليس لخدمة الديسكولاند التي يعيش على أرضها، ولكن لنقل هذه الخبرات إلى بلاده التي ينتمي إليها بروحه وبدمه:
(شرقكم ضدّنا دائما – ص 34)
… إلا أن المثنى كان في رحلة “سفر” متذبذبة تؤرجحه بين قناعتين متضادتين ..[/rtl]
[rtl]
وقفة : إنه واقع وليس استشرافا :
———————————–
ما وضعه اسعد الجبوري على لسان بطله مالك، وعلى لسان الراوي المستتر، من أن طوفان العنصرية سيكتسح، أو انه اكتسح فعليا، ارض الديسكولاند التي تؤمن بالديموقراطية والحرية والمساواة، ليست فذلكة سردية أو تخييلا حكائيا، ولا هو استشراف قد يضعه البعض في موضع “النبوءة”. إنه نتاج قراءة حقيقية لمتغيرات واقع “الديسكولاند” التي عايشها الكاتب فعليا، كما أن التحليل الدقيق للفلسفة المادية، التي حكمت العقل الأوربي وحركة مجتمعاته منذ عصر التنوير حتى يومنا هذا، تشير بما لا يقبل اللبس إلى أن الخاتمة الطبيعية للفلسفة الغربية هذه في مرحلتيها الحداثية وما بعد الحداثية ليست العنصرية حسب بل الإبادة (إبادة الآخر) أيضا. وصحيح أن الكاتب قد اختار زمناً مستقبليا يمتد من يوم الأربعاء من سبتمبر من عام 2021 إلى صيف عام 2056 لوقائع وأحداث “سوف تجري” على أرض الديسكولاند، لكن كل المعطيات التاريخية والفلسفية والاجتماعية القديمة والراهنة تشير إلى أن هذه الوقائع قد “جرت” منذ قرون وعقود. (وقد بيّن كاتب مدخل العنصريّة في دائرة المعارف البريطانية أنه ليس من المصادفة أن العنصريّة ازدهرت في وقت حدوث الموجة الثانية الكبيرة من التوسّع الاستعماري الأوروبي والزحف على أفريقية (حوالي 1870 م)- وهو وقت ظهور الصهيونية وبداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين.
وقد بيّن المفكر النازي ألفرد روزنبرج- في أثناء محاكمته في نورمبرج- أن العنصرية جزء أصيل من الحضارة الغربية الحديثة، وأكّد لقضاته أن هناك علاقة عضوية بين العنصرية والاستعمار. وقد أشار إلى أنه عثر على لفظة سوبرمان في كتاب عن حياة اللورد كتشنر، وهو الرجل الذي قهر العالم، كما أكد أنه صادف عبارة العنصر السيّد في مؤلفات عالم الأجناس الأميركي ماديسون جرانت والعلّامة الفرنسي جورج دي لابوج، وأضاف قائلا: (إن هذا النوع من الأنثروبولوجيا العنصرية ليس سوى اكتشاف بيولوجي جاء في ختام الأبحاث التي دامت 400 عام) أي منذ عصر النهضة في الغرب وبداية مشروع التحديث. ومعنى هذا أن العنصرية ليست مرتبطة بالإستعمار وإنما بالرؤية المعرفية العلمانية والإمبريالية وبمشروع الإنسان الغربي التحديثي. وقد كان روزنبرج محقا في أقواله، فالمركزية التي منحها الإنسان الغربي لنفسه منذ عصر نهضته باعتباره كائنا ماديا متفوقا على الآخرين، وكيف تصاعد هذا الإتجاه حتى وصل الذروة في القرن التاسع عشر حين أصبحت العنصرية أحد الأطر المرجعية الرئيسية للإنسان الغربي. وظهر علماء مثل جورج دي لابوج الذي أشار إليه روزنبرج، الذي انطلق من نظرية المجتمع ككيان عضوي، وأكد أن الجنس الإنساني لا يختلف عن الجنس الحيواني، أي أن كليهما ينتمي إلى عالم الطبيعة. ولذا دعا إلى أخلاقيات جديدة مبنية على الإنتخاب الطبيعي وعلى الصراع الدائم والبقاء للأصلح بدلا من الأخلاق المسيحية. وانطلاقا من كل هذه المفاهيم المحورية في الحضارة العلمانية، فهذه هي فلسفة داروين ونيتشه ووليام جيمس، طرح دي لابورج تصوره لتفوق الجنس الآري باعتباره الجنس الأرقى الأقدر على الصراع وذبح الآخرين. ولم يكن دي لابورج وحده ضالعا في مثل هذه الأفكار، إذ كان يشاركه فيها جو بينو وهيبوليت تين وجوستاف لوبون وإدموند درومون. وقد روج لهذه الأفكار في ألمانيا أوتو أمون وأرنست هايكل وإدموند فينيننجر (المفكر الألماني اليهودي الذي تأثر به هتلر) وهوستون تشامبرلين (الإنجليزي الأصل). أما في إنجلترا فقد كان هناك و.ف. إدواردز وتوماس أرنولد (والد الشاعر والمفكر المشهور ماثيو أرنولد) وجيمس هنت مؤسس جمعية لندن الأنثروبولوجية الذي ذهب إلى أن الطريقة الوحيدة لجعل علم الأنثروبولوجيا أكثر حيادية هو تحريره من القيم الأخلاقية الإنسانية مثل نظرية الحقوق الداعية إلى تساوي البشر. وكان من أهم المفكرين روبرت نوكس الذي أثرت أفكاره في داروين صاحب نظرية التطور الذي كان من اليسير على دعاة العنصرية أن يتبنوا منظورها اللاأخلاقي كما فعل نيتشه – ص 184 و185 و186 ) (3).[/rtl]
[rtl]
عودة : قيامة ديناصورات العنصرية :
—————————————
وهاتان القناعتان المتضادتان اللتان يتأرجح بينهما “المثنى” بألم، تستأثران بالكثير من المحفزات؛ منها ما هو داخلي تؤججه ذكريات ورسائل أمه لأبيه مالك، ومنها ما هو خارجي كالذي مثلته الإمرأة التي جلست بجواره في الباص وزرعت في ذهنه عبارات “رسولية” منصفة :
(أصبحنا أشبه بالمصابيح العمياء. فلا تعط لذلك اهتماما. التاريخ ذات يوم، سيضحك منا كثيرا. هل تعرف بأن أوروبا مليئة بفرنجة يحسون بالغربة في بلادهم أكثر من الأجانب. وبفرنجة ملحدون ودمويون وعرقيون، وبفرنجة فلاسفة لا يودون رؤية التعفن وهو يلتهم هذه الأرض التي نسكن عليها، والتي باتت شبه مستهلكة بالتمام – ص 36 ).
لكن عبارات الإمرأة الملاك هذه ما هي إلا قطرة بيضاء وسط لجّة طوفان اسود كان يتمطى لاكتساح البلاد بأكملها. فقد تصاعد نشاط الجماعات اليمينية المناهضة لوجود الأجانب في البلاد، وفي مقدمتها اليد المسلحة الضاربة، “عصابة الثيران الفولاذية”، التي قامت بقتل عشرة أطفال في إحدى رياض الأطفال كلهم من الديسكولانديين، فألبت الرأي العام ضد الأجانب، وأشعلت فتيل برميل البارود، لتبدأ قوانين الفصل العنصري، مترافقة مع حملات قتل الأجانب، الذين امتلأت المستشفيات بجرحاهم وقتلاهم، ومنهم المثنى الذي هاجمه مجهولان برش نوع من الغاز على عينيه. لقد قامت “قيامة ديناصورات العنصرية”- لاحظ أن عنوان الرواية التي سيكلف بكتابتها “السومري” لاحقا هو “قيامة الديناصور”!- كما وصفها المثنى، الذي تجمع الجرحى في غرفته الآن بصفته مدير “نادي الأجانب” الذي كان يدعو إلى التعقّل والتسامح وامتصاص العدوان وعدم إعطاء الديسكولانديين العنصريين الفرصة لمزيد من العدوان، في حين كانت أغلبية من تحلقوا حول سريره تطالب بالرد العنيف المقابل (ما ينقصنا هي المواجهة وليس الغفران – ص 42)، وتستعرض العديد من حوادث التقتيل والإغتصاب.
يتصاعد النقاش في غرفة المثنى لإيجاد حلول منها، مثلا، عودة المهاجرين إلى بلدانهم، فيرد واحد بالقول أن الكثير من المهاجرين لا يستطيعون العودة بسبب الظروف السياسية القمعية في بلدانهم الأصلية. ويكمل آخر برأي أكثر نضجا، وهو أن المهاجرين يؤدون في الواقع واجبا إنسانيا هنا بمواجهة العنصريين الديسكولانديين لأن رياح العنصرية إن انتصرت هنا، فإنها ستجتاح كل شيء، وكل مكان . يعلق المثنى على هذا الرأي قائلا:
(لا أعتقد بأن لدى الأوروبيين فائضا بشريا، ليكون ثمنا لهلوسات عصابات دموية مسعورة مازال هتلر يقودها من قبره. لقد شن النازي الأول حروبه القديمة بأسلحة تقليدية. أما هؤلاء، وإذا ما سيطروا على بلد أوروبي صغير المساحة وقليل السكان مثل ديسكولاند مثلا، فسيسيطرون على أسلحة متطورة وحديثة، يكون ثقلها التدميري شاملا، أسلحة لم تكن معروفة لدى هتلر أو السوفيت أو الإنكليز سابقا.
ولا ننسى استعداد دولة عظمى لدعم هؤلاء، بهدف زعزعة استقرار أوروبا. فهي تريد لبلد ما من بلدان أوروبا بأن يكون سكينا في الخاصرة الأوروبية. لذلك فقد تمكن هذه العصابات من لعب مثل ذلك الدور التأديبي مستقبلا – ص 44 ) .
ومن المهم التوقف على ما يبثه الكاتب على لسان شخوصه من إشارات صريحة إلى العصابات النازية وشيوع مفهومي العنصرية والنازية (مرتبطة بهتلر تأريخيا بطبيعة الحال) في الديسكولاند خصوصا، وفي العالم الغربي عموما. فقد يتصور المتلقي، أن هذه الإشارات متحاملة، أو أنها لا تمتلك مبرراتها على صعيد الحياة الواقعية التي نرقبها في العالم الغربي، والتي تعيشها المجتمعات الغربية في حركتها الراهنة التي تحكمها مفاهيم الديموقراطية والحريات الشخصية. ومن المهم إحالة ذهن القاريء إلى حقيقة مغيّبة وخطيرة تتمثل في أن ما رسخه الغرب في أذهاننا، هو أن النازية هي نتاج “ألماني” نهض به هتلر قبل وبعد تسلمه للسلطة، وأشعل حربا عالمية مدمرة لتمرير أفكاره المركزية المتمثلة في النقاء العنصري والبقاء للأصلح وعبء الإنسان الأبيض وضرورة تعقيم واجتثاث الأعراق “المنحطة” و”الملوثة” و”المتخلفة” كاليهود والزنوج والعرب والغجر .. إلخ. يجب التنبه إلى أن النازية هي نتاج طبيعي للفلسفة المادية التي حكمت العقل الغربي منذ عصر الأنوار والتي بدأت بتمجيد مركزية الإنسان، لتمر وتتصاعد بإعلان موت الإله، ولتنتهي الآن بإعلان موت الإنسان.
يذهب المثنى إلى شقة عشيقته السابقة “فيبيكا” لاستعمال الهاتف بعد أن عُطّلت جميع هواتف الأجانب تحت حالة الطواريء التي فُرضت على البلاد بعد اغتيال ملكها بتدبير من الحركات والعصابات النازية والعنصرية التي سرعان ما ألصقت التهمة بالأجانب. وبدأت الحملة الدموية “الوطنية” المسلحة لاجتثاث الأجانب من البلاد. وفي شقة فيبيكا يحاول المثنى سبر نوايا صديقته في هذا الظرف العصيب. يحاول امتحان التاريخ والجغرافيا في مساحة غرفة، وفي سرعة تشبه سرعة البرق (ص 54)، حسب التعبير الموفق للكاتب، الذي يورد هذا الحوار البليغ بينهما:
(فيبيكا: أنتم مجموعة تواريخ نختصرها بعبارة واحدة : الجثة التي لابدّ لرائحتها من الإختفاء. قد لا يليق بي أن أتلفظ بهذه النفاية .. ولكن ماذا نفعل ؟ أصبحت أفواهنا أشبه بالبراميل التي لا يتكدس فيها غير الهراء المتعفن الذي سيخنقنا ذات يوم قادم ؟
المثنى: نحن لا نخاف من هذه الإندفاعات ولا نريد حلا مؤقتا لنزع الفتيل، لأن الضرورة تقتضي من الطرفين حلا حضاريا. بعد ذلك، يمكن التوجه نحو المقبرة للمشاركة في مراسم دفن الصراع. الآن نرى العكس، فهنا من يسعى إلى النفخ في جثّة الديناصور العنصري العرقي الفاشي النازي، بهدف تحريك الدم في عروقه وإعادته للعمل على الأرض.
…………….
المثنى: مازال جنوب العالم يلملم شظايا أطراف جسده المبعثرة. ويعجز عن الدفاع عن كيانه. أنتم تحاولون وضعه خارج الخندق. تريدونه مكشوفا في العراء، علما بأنه ليس بذلك المارد الأسطوري الذي يحمل على ظهره كل ما استطاعت التكنولوجيا أن تنتجه من أسلحة وتقنيات. إنه لا يملك شيئا من ذاك القبيل. فعلام تهويل ذلك بحق السماء؟
فيبيكا: ما نخشاه نحن ليس ماردا من مردة التسليح التكنولوجي، بل من المارد الديني المضاد الذي بدأ يتشكل في الرحم الأوروبي ويتمدد في مختلف الخلايا.
نحن خرجنا على الكنيسة. تركناها متاحف وأطلالا مهجورة كما ترى. لقد قتلنا الربّ واسترحنا، بعبارة أدق: ضيّعناه منذ زمن بعيد، ولا نمتلك الرغبة بعودته من جديد. أنتم تصرّون على أن نعيده مرة أخرى إلى دياره، ونحن نرفض ونحاول المقاومة.
- هذا ليس هو الجوهر. الغرب استبدل الله بأسلحة القوة، ويحاول انتزاع الجنوب من جذوره القديمة، أي بجعلهما خاضعين لترسانة شرائعه المُنتجة من الحديد والمظالم. فالله الذي مات لديكم، صيّرتموه جنرالا مسلّحا للقرصنة والسيطرة وللإخافة. لذلك يا عزيزتي، فكل الصراع يتعلق بمن يحكم العالم. صورتنا الراهنة، صورة عبيد جديرين بالطاعة وحسب، هذا إذا كنتم تحتاجونها فعلا. فالطاعة المتناهية إلى حدود محو الكيان، تثير القرف في أنفسكم، لأنها تمنع الحاكم من التلذذ بالهلع الذي ينتاب المحكوم بالموت.
- أراكَ متأكدا من هذا .
- منذ زمن بعيد. فالإنسان الشرقي هو االتلميذ الفارغ. التلميذ الذي لا ينجو من عقوبات الأساتذة الفرنجة على تخلفه ودونيته التي يريدون منه أن يحملها إلى قبره. هذه هي أغلب مدارس الغرب وأفكارها. إنها الطعام الصحي الوحيد للعقل الشرقي، أو لبقية عقول مجمعات التخلف في العالم الثالث. أليست هذه حقيقة يا فيبيكا ؟- ص 57).[/rtl]
[rtl]
وقفة :
———
(وقد أشار المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا “فاكيلاف هافل” – الذي رحل هذا الأسبوع – إلى ما أسماه “إسكاتولوجيا اللاشخصي”، وهو اتجاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكم من خلال آليات ضخمة مثل المشروعات الضخمة والحكومات التي لا وجه لها، والتي تفلت من التحكم الإنساني، وتشكل تهديدا كبيرا لعالمنا الحديث. ويبيّن هافل أنه لا يوجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثل شل وآي. بي. إم والشركات الإشتراكية الكبرى، فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب البعد الإنساني منها. ولذلك تصبح مسألة طابع الملكية هنا، أي ما إذا كانت فردية أم جماعية، رأسمالية أم اشتراكية، إشكالية غير ذات موضوع.
وحينما سئل هافل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع أجاب قائلا:
(هذا الوضع له علاقة ما بأننا نعيش في أول حضارة ملحدة في التاريخ البشري. فلم يعد الناس يحترمون القيم الميتافيزيقية العليا، والتي تمثل شيئا أعلى مرتبة منهم، شيئا مفعما بالأسرار. وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي، إذ إنني أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز. هذه الإعتبارات الأساسية كانت تمثل دعامة للناس وأفقا لهم، ولكنها فُقدت الآن. وتكمن المفارقة، أننا بفقداننا إياها نفقد قبضتنا على المدنية، التي أصبحت تسير بلا أي تحكّم من جانبنا. فحينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى، في هذه اللحظة نفسها، بدأ العالم يفقد بعده الإنساني- ص 150 ) (4).[/rtl]
[rtl]
عودة : العنصرية تشتعل.. تساؤلات سردية :
———————————————-
بعد عملية اغتيال ملك الديسكولاند من قبل عصابات “الثيران الفولاذية” العنصرية الديسكولاندية، استولى زعيمها “جو كريس” على الحكم، فعاث في الأرض فسادا، حيث شملت إجراءاته العنفية القمعية الجميع بلا استثناء، مهاجرين ومواطنين أصليين، بالرغم من أنها كانت موجهة أصلا ضد الأجانب. وهذه سمة مركزية في الديكتاتوريات العنيفة التي لا توفّر في عنفها أحدا. وهذا ينطبق على الأنظمة والأيديولوجيات العنصرية التي تبدأ بفرز الأعراق والإثنيات “الملوّثة” وتعمل على تخليص الجسد الوطني النقي منها، لتنتهي بتمزيق هذا الجسد الوطني نفسه. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هي النازية- وأكرر أن النازية هي النتاج الطبيعي للفلسفة الغربية المادية* – التي وصلت إلى سدة الحكم في ألمانيا وضمن شعاراتها تطهير الجسد الألماني من “الشوائب” الإثنية التي علقت به كاليهود والغجر .. لكن الديسكولانديين المخلصين أفرادا وجماعات ومنهم منظمة “الأرض للجميع” التي أسسها العم “هنترسين” وذراعها المسلّح الذي تزعّمه “طوروس” وهو مهاجر أجنبي من أصدقاء المثنى عُرف عنه التهوّر والميل الشديد للمغامرة المنفلتة والعنف الجامح. وبمساعدة (لوزانا)؛ زوجة الحاكم العسكري الجنرال (جو كريس) وعشيقة طوروس، يتم اغتيال الحاكم العسكري، وتتحرك الأحزاب والمنظمات الوطنية وبعض المنظمات العنصرية المنشقة مثل منظمة “HR” النازية برئاسة “وليم فير” الذي قتل في خضم الأحداث الأخيرة.
في النهاية، استطاع طوروس إنقاذ العائلة المالكة التي خطفتها الجماعات العنصرية المسلحة، والإستيلاء على مقاليد الحكم، لتبدأ مرحلة ديكتاتورية عنصرية مظلمة في أرض الديسكولاند؛ مرحلة كانت نواها تتململ وتنمو في تربة الديسكولاند نفسها، تحت طبقة كثيفة من الممارسات الديموقراطية، التي لم تكن قادرة على منع التيارات العنصرية من أن تنمو “ديموقراطيا”، وتقوى ويشتد عضدها حتى أنها قفزت إلى سدة السلطة، واستولت على مقاديرها. ولكن- هنا أيضا، وعند هذا الموضع من الرواية- تثور معضلة فكرية وسردية. فعلى امتداد المسار المقبل من الرواية وهو طويل سيكون مثال الطغيان والعنصرية والديكتاتورية باقسى صورها الدموية البشعة هو “طوروس”، المهاجر الأجنبي سابقا، والمواطن الديسكولاندي كما يُفترض حاليا.
فما الذي يبغيه الروائي من اختيار هذا الأنموذج؟
كان من المفروض، واتساقا مع سياق وقائع الرواية، أن يخيّم على البلاد شبح عنصرية وطغيان يمثله “جو كريس” (عصابة الثيران الفولاذية)، أو “وليم فير” (عصابة HR النازية) كنتاج طبيعي للتربية العنصرية المستترة والمعلنة، التي كان المواطن الديسكولاندي يترعرع على إفرازاتها السامة منذ نعومة أظافره. ولكن الروائي اختار مهاجرا أجنبيا، وصل أرض الديسكولاند، ومنح جنسيتها، ولكنها لم تستطع معاونته- كما كان يتوقع- على التكيف مع مقومات الحياة فيها، والذوبان في بُوتقتها الإجتماعية. لقد جاء إلى أرض الديسكولاند هاربا من جحيم بلاده، متصوّرا أنه سيظفر بمحطة الفردوس النهائية، حيث قانون الأمومة المفقود الذي لا يفرق بين الأبناء الذين سينعمون بالهناءة والأمن والسعادة. ولكن “الأخوة” المهاجرين الذين نبذهم الرحم الأمومي من مواطنهم الأصلية، قد يجدون عذرا لهذا النبذ على المستويين الشعوري واللاشعوري. فعلى المستوى الشعوري الظاهر، عانى هؤلاء “الأخوة” من القمع والإضطهاد من جانب، مثلما عانوا من شظف العيش في بلدان بعضها يطفو على بحيرات من الثروات في مفارقة عجيبة- بعضها أسطوري تعرض للسلب والنهب الغربي المباشر وغير المباشر- من جانب آخر. وعندما وصلوا “الأرض الموعودة” كانوا ينظرون إليه كرحم بديل. لكن ما صدموا به هو أنموذج مواز للنبذ والتمييز ومجافاة الأهداف المعلنة والمغوية التي اجتذبتهم. لقد أسهموا بفاعلية وحماسة- بالرغم من أنهم يؤمّنون في الوقت نفسه سبل عيشهم- في ديمومة عجلة الحياة في هذا البلد الذي هاجروا إليه وحملوا جنسيته. لم يعيشوا ككائنات طفيلية على جسد “الوطن” الجديد، تمتص دمه وخيراته. إن من حق أبناء أي وطن أن يشعروا بمنافسة “أوديبية” من “الأبناء” الوافدين الدخلاء، وأن يتحسبوا من أن يستولي االأبناء الدخلاء على فردوس الرحم الأمومي ويصادروا نعمه وظلاله الحامية والحانية ويستأثروا بها. لكنهم كانوا يرفعون شعارات ديموقراطية برّاقة تصوّر وطنهم/ الرحم الأمومي المنعم الذي ينعمون بأمانه، وكأنه جنة / ملاذ آمن تجذب الأبناء المهددين في مواضع أخرى وتغويهم باللوذ بها. ولكن ما حصل هو العكس، فقد واجه الأبناء “الدخلاء” قسوة أبوية ممزوجة برفض أمومي صادم، زرع في أعماق نفوسهم الخيبة والخذلان، وجعلهم يصابون بإحباط مضاعف. فإذا كانت الهجرة من الوطن/ الرحم الأمومي الاًصلي مبرّرة من بعض الوجوه، بفعل شراسة القمع الأبوي ودمويته (الأسباب السياسية)، أو بفعل ضياع فرص العمل وغلق أبواب المستقبل في وجه الشباب خصوصا (اسباب معيشية)، أو أن نزوعا شديدا نحو آفاق ومديات أكثر سعة وتألقا في المسيرة المهنية (أسباب مهنية وعلمية)، تسوق الفرد للهجرة، فإن الرفض الذي يواجه الابناء المهاجرين من قبل “الوطن”/ الرحم الأمومي الجديد غير مبرّر، خصوصا وأنه يرفل بشعارات جذب عن العدالة والنمو والرفاه والتسامح، تقف على النقيض من محددات الواقع السابق الذي هجروه. وهذا الرفض لم يكن في الديسكولاند حالة فردية عابرة أو موقفا شخصيا طارئا. كان موقفا جمعيا تقريبا عبّر عن روحه الروائي في فقرة (غبار النص)، التي طرح فيها الكيفية التي عرض فيها تلفزيون الديسكولاند لقاء أجراه مذيع محرّض مع ثلاث عجائز:
الأولى : لقد أكلوا طعامنا وأنهكوا أعصابنا بوجوههم المظلمة..
الثانية : يريدون تحويلنا إلى أفارقة .. تصوّري أنك لا تجدين قالب كاتو ولا شموعا ولا شمبانيا ولا هدايا في عيد ميلادك التسعين.
الثالثة : هل تقبلين أن يمشي وراء جنازتك أي خنزير من تلك الخنازير الأجنبية الوسخة؟
الأولى : لقد منعت أحدهم من تنظيف طيزي ، كيلا يلوثه بيديه – ص 51) .
كما أن مديات العنف المتصاعدة، لم يكن لها أن تتأجج بهذه الصورة المسعورة قبيل وبعد الإنقلاب العسكري، لو لم تكن هناك حاضنة اجتماعية ونفسية ترعرع في كنفها ووفرت له شروط النمو:
(لم تستطع قوى البوليس الضغط على رجال العصابات وإيقاف جنونهم وتوحشهم وانتشارهم المكثف في مختلف المدن. فقد توسّعت حلقات العنف بعد أن تورط الكثير من الديسكولانديين في الصراع. فيما تخندق الأجانب العزل في بيوتهم أو هربوا نحو الريف أو لجأوا لدوائر البوليس طلبا للحماية من هوس الإنتقام المجاني الأعمى الذي راح يستشري بجنون في البلاد – ص 51 ).
صحيح أن “الحشد – crowd “، يوفّر المظلة السيكولوجية الجمعية لتحقيق التماهي العام، ولتخفيف الشعور بالذنب بحيث تتفجّر اشد الحفزات عدوانية ودموية في النفس البشرية بيسر وانسعار. في ظل الحشد يمكن أن تحصل أفعال سادية لا يمكن تصوّرها من قتل وسحل وتمثيل (أسقط الباريسيون حجارة الباستيل بأظافرهم وقتل العراقيون العائلة المالكة ومثلوا بجثثها ببشاعة) كما حصل في الديسكولاند- على سبيل المثال – من حرق بشع لجثث الأجانب الذين احتجزتهم عصابة الثيران الفولاذية في الطاحونة. ولكن التأثير النفسي هذا، للحشد، يتاسس عادة على ركائز أولية مترسخة في البنية النفسية البشرية من جانب، وعلى “استعداد” للمجتمع المعني من جانب آخر. هذا “الإستعداد” الذي أثارت غيلانه المجموعات العنصرية. وبالرغم من ذلك لم تستطع هذه الموجة العارمة أن تكتسح كل منابع الإنسانية في النفوس، متمثلة بصورة رئيسية في جماعة الأرض للجميع وبقية القوى التي لم تستطع الإطاحة بقادة الإنقلاب العسكري العنصريين، إلا باللجوء إلى استخدام القوة (إرفع البندقية لنزع البندقية وتحقيق السلام كما قال “ماو”) التي برع في إدارتها “طوروس” المهاجر، الذي استولى على الحكم، وأصبح ملكا، بعد أن تزوج من “شيريهان” – المصرية (أجنبية شرقية ايضا!!) – أرملة الملك السابق “روبن شيفر” الذي تم اغتياله.
ومن جديد، ما الذي يبغيه الروائي من تصميم حبكة وفق هذه الصورة، التي يصبح فيها الأنموذج العملي الأول للعنصرية والطغيان في الغرب، مهاجرا شرقيا، يستولي على الحكم بصورة تقفز على الحيثيات الموضوعية والظروف المنطقية التي تحيط بمجتمع الديسكولاند البحر شمالي كجزء من المجتمع الغربي ؟.
وقبل أن نمضي في تساؤلاتنا يجب أن نضع في أذهاننا أن الواقع السردي يختلف عن الواقع الموضوعي، وقد يفارقه بدرجة كبيرة جدا في بعض الأحيان. هل يريد الروائي تصميم حالة فنّية توضح للديسكولانديين، بشكل صارخ، الكيفية التي ستدمّر فيها العنصرية حياتهم، فيما لو تسيّد على السلطة تيار عنصري في بلادهم ؟ ولكن – ومن جديد- لماذا مهاجر شرقي ؟ هل لأن الشرقيين مهيئين أصلا، وبحكم التجربة التاريخية، للنزعات العنصرية والسلوك الطغياني الدموي؟
قد يكون واحدا من الحلول التي يجترحها النقد، هو أن نبقى مع الروائي في إطار الحقيقة السردية؛ في إطار الواقع الفني المغاير وأحيانا المناقض للواقع الموضوعي “المادي” المباشر. ولكن التأني القرائي، والصبر التحليلي سوف يكشف الرؤيا الفريدة التي صممها الروائي لحكايته الشائكة.
طوروس الطاغية “منقذاً” :
—————————–
بعد استيلاء طوروس على الحكم، تشهد البلاد أحلك مرحلة في حياتها، من قهر واضطهاد وهدر لكرامة الإنسان. فخلال ساعات عصفت المخاوف بالديسكولانديين ، وبلغت ذروتها القصوى حين شعر الرجال، الذين شاركوا في الحرب ضد العنصرية، بأن الثأر يهرول نحوهم هرولة، كي يقتص منهم، ويسحقهم باعتبارهم مذنبين قطعوا شوطا لا بأس فيه بتعذيب وقتل وإهانة الغرباء (ص 83). وهنا بدأت أوسع هجرة في تاريخ الديسكولاند إلى الخارج عبر البحر بصورة رئيسية.
ومن هذه اللحظة السردية، وقدما، نستطيع ملاحقة المستلزمات والاشتراطات الفكرية والإجرائية (سياسيا واجتماعيا ونفسيا)، لإشادة معمار الديكتاتورية المتقن والكريه، وللكيفية التي يُصنع فيها الديكتاتور الطاغية. وهذا امتياز مُضاف لأسعد.
فأولا على الطاغية أن يصور نفسه كمنقذ منتظر/ مخلّص. ولاحظ أن كل التغييرات الكبرى- والسلبي منها بشكل خاص، نصحو عليه بعد حين عادة بسبب التغييب النفسي للبصيرة البشرية الذي تحدثه اسطورة المنقذ- تقوم على تصوير الطاغية كمخلّص، بدءا من الإسكندر، ومرورا بنابليون وهتلر، وليس انتهاء ببوش الإبن. الطاغية، هو المخلص الوحيد والأوحد، وأي محاولة لمنافسته في ذلك، ستشوه صورته الإنقاذية هذه، لأن التشارك معه في أي صفة يعني أنه “بشري” عادي. أما استئثاره بها، فهو يقربه من صورة الإله، إن لم يجعله إلها فعلا . لذلك كانت أول خطوة قمعية ملحة، قام بها طوروس، هي إعدام رئيسي تحرير الصحيفتين، اللتين نشرتا منشيتات تصوّر “لوزانا”، بطلة وطنية، استطاعت بخبرتها الماكرة ودوافعها الوطنية، أن تسحق رأس الأفعى العنصرية؛ زوجها “جو كريس”.
أما الشرط الثاني، فهو نزع، وحتى سحق القداسات القديمة، وتأسيس قداسات “مدنّسة”، سيعتاد عليها الجمهور الواسع لتصبح “مقدسات” خالصة جديدة. وفي مقدمة ذلك الإستئثار بـ “الأم” أو رموزها ومكافئاتها. من هذا القبيل قيام طوروس بالزواج من الملكة شيريهان أرملة الملك السابق (الأم السابقة). الآن أصبح طوروس أبا رمزيا حتى لو كان مكروها. وبالمناسبة فإن شحنات كره الأب هي الوجه المستتر للعملة الأوديبية في الموقف من الأب.
ثم أن عهد المنقذ يجب أن يتعمد بأضحية ذات مضامين وإيحاءات أسطورية – يتساوى في ذلك، ويا لغرابة النفس البشرية، دور المنقذ في وجهيه الإيجابي والسلبي !- .. يتعمد بدم .. ولا أخطر من مهابة الدم والقلق الذي يثيره في نفوس الأبناء. وإذا كانت ثورة الأبناء المباركة الأولى ضد الأب – وحسب أطروحة معلم فيينا- قد تعمدت بدم الأخير الأمر، الذي خلق شعورا مستديما بالذنب في نفوسهم حتى يومنا هذا، فإن تصدّي الإبن لدور الأب الطاغية، الذي سيثير حسد الأبناء/ الأخوة الآخرين، لابدّ أن يتعمد بدم بعض الأخوة/ الأبناء، لردع أكثرية الأبناءالباقية. وهذا من الإجراءات الدموية الأولى التي قام بها طوروس، حيث جعل وسائل الإعلام، تعلن أن الملكة قد أعادت العمل بعقوبة الإعدام، وأن أول حكم سيُنفّذ، هو إعدام الشابين الأجنبيين اللذين قاما بقتل سبعة من المواطنين الديسكولانديين الأصليين ابتهاجا بالعرس الملكي. إن من المهم جدا أن يُثبت الأب الطاغية، أن عدوانه وشراسته، لن توفر أحدا؛ لا مواطنا أصليا ممن أذلّوه كمهاجر، ولا مواطنا أجنبيا من أخوته المهاجرين. هكذا سيكون الجميع تحت مطرقة الرعب، كمشروع متوقع للتصفية والموت. لابدّ أن يكون المخلّص في وجهيه قرينا للموت لا للحياة. فكونه قرينا للحياة سيشوش صورته وتجعلها ذات مضمون أمومي (أنثوي خصبي)، في حين أن اقتران حضوره بالموت سيحدّد صورته كتمظهر أبوي (ذكوري خاصي).
ولعل من أخطر الإجراءات التي يقوم بها الطاغية، هي أن يعرض “عقاب” الأخوة / الأبناء السابقين على الابناء الآخرين .. على عموم الشعب كما يُسمى . (لم تنم عين واحدة في البلد. كان المواطنون يتطلعون إلى الساعة التي يشهدون فيها قامات أولئك الجناة من الأجانب، وهي تخر أرضا كالشمع الملتهب. لم تر الناس عملية إعدام واحدة في البلاد على مدار سنوات تاريخهم، لذا جاءت العائلات بأطفالها لرؤية ذلك الفيلم الخرافي الأكثر متعة من أفلام كارتون توم وجيري أو أفلام الأكشن. تدفقت الحشود البشرية وكأنها تريد رؤية يوم القيامة – ص 87 ).
حصل هذا مثلا في المدرج الروماني القديم .. وفي عهد

