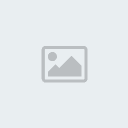 إن
إن
الفن سواء أكان طقسياً أم لم يكن، ينطوي على عقلانية النفي. إنه في مواقفه
القصوى، الرفض الأكبر، الاحتجاج على ما هو كائن. والأساليب التي يجعل بها
الانسان يظهر ويغني ويتكلم، والتي يجعل بها الأشياء ترنّ، هي أنماط من
الرفض، من المقاطعة، من إعادة الخلق لوجودها الواقعي.
ماركوز
"الحداثة مشروع لم ينجز بعد" هكذا كان عنوان محاضرة قدمها هابرماس في
عام 1985. وهذا أمر صحيح تماماً، وذلك خصوصاً إذا ما نظرنا إلى الحداثة على
أنها مشروع أبديّ، أي لا يكاد ينغلق، حتى يجد لنفسه الثغرة التاريخية
المناسبة للانبثاق من جديد. فإذا كان كلّ تحديد نفيا عند لسبينوزا، فإنه من
الصحيح أيضاً القول بأن كل تقدم في مشروع الحداثة هو نفيٌ لها، في الآن
ذاته، إذاً هو فعل خلق وإعادة خلق، إنتاج وإعادة إنتاج مستمرّين.
ينطلق ماكس فيبر، من سؤال سيتمحور حوله كل اهتمامه المعرفي اللاحق: لم لم
يتجه التطور العلمي والفني والسياسي، والاقتصادي.. على دروب التعقيل الخاص
بالغرب خارج إطار البلدان الأوربية؟؟ وكانت الإجابة الأولية تشير إلى البحث
في الصلة القائمة بين الحداثة وما كان يدعوه العقلانية الغربية، وهو شيء
كان حتى ذلك الوقت أمراً مفروغاً منه.
ولكن ما الحداثة؟ وما الحديث؟ في الحقيقة لا يمكن فهم الحداثة في ذاتها،
كما لا يمكن فهمها بمعزل عن الزمان والمكان اللذان نشأت فيهما. لذا كان
للحداثة مقدماتها التاريخية، والتي لا بد من القبض عليها كي يتسنى لنا فهم
مشروع الحداثة ذاته.
يحيل مفهوم الحداثة عند هيغل، إلى "الأزمنة الجديدة" أو " الأزمنة الحديثة"modern times
وهو يعتمد على تقسيم ثلاثي للتاريخ، (تاريخ قديم، وتاريخ وسيط، وتاريخ
حديث) . أما العصر الحديث، فيشير إلى المرحلة التي أفضت فيها مضامين النهضة
الأوربية إلى حدوث قطيعة مع ما قبلها وذلك بدأً من القرنين الخامس والسادس
عشر على وجه التقريب.
تضفي هذه القطيعة مضموناً جديداً على مفهوم العصر الحديث، حيث أصبح هذا
الأخير يشير إلى "عصر يحيا بالنظر إلى ما هو آت، وينفتح للجديد القادم.
هابرماس". وتبدو الحداثة إذا ما دققنا في مقدماتها التاريخية أنها نتاج
سلسلة –تثير الدهشة- من الثورات العلمية والمعرفية التي أنجزها الغرب في
المرحلة التي دعيت بعصر النهضة.
ومن هنا كان العصر الحديث هو بالضبط العصر الذي وضع حداً أو إذا شئتم
قطعاً تاريخياً مع ما قبله، كما وضعت ثورة كوبرنيك الفلكية حداً لما قبلها؛
فالكون الذي كان الله مركزه، والعالم الذي كانت الأرض محوره، سينقلب على
قاعدة اكتشافات كوبرنيك، لتصبح الشمس مركز الكون والإنسان مركز العالم؛ وهو
الشيء الذي سيفسح المجال فيما بعد للتعريف الحاسم الذي سيلحقه، مارتن
لوثر، بالإنسان، ليصبح هذا الأخير، معرفاً بالعمل.
منذ هذه اللحظة لن يعود الإنسان كائناً مهملاً وملحقاً من ملحقات قوى
غريبة عنه، تنظر إليه من اللامكان، بل سيصبح الإنسان الصانع والمحاسَب عما
تصنعه يداه. أما الطبيعة المحيطة به، فبعد أن كانت مقراً للقوى الشريرة وكل
القباحات التي كان ممكنا للنصوص الدينية أن تصورها بها، ستتحول إلى مكان
للاكتشاف، اكتشاف الجماليات، كما ستصورها الفنون فيما بعد.
فالفن الذي كان يصور الطبيعة على أنها عالم الجسد الفاني، ومكان ممارسة
هذا الجسد، لكل متعه المحرمة، سيلتقطها الجيل الأول لعصر النهضة، ليعيد
تشكيلها من جديد، هنا ستصبح الطبيعة هي كل الجماليات التي تحيط بنا، من
حركة جانح الطير وحتى أبسط الأشياء أو أعقدها، إنها ببساطة عالمنا الذي نحب
ونحيا به؛ أما الأشخاص المعبر عنهم من خلال الفن السابق على عصر الحداثة
والذي غالباُ ما كان يصورهم على أنهم أشخاص مقدّسون، تفصلهم دائماً مسافة
عن الأرض، هؤلاء الأشخاص ذاتهم سيعيد الفن تشكيلهم ليضع أقدامهم على أرض
صلبة، هي في المحصلة أرض الواقع الاجتماعي للإنسان.
لعب الفن في هذا السياق دوراً حاسماً في القطيعة التي حدثت بين الحداثة
وما قبلها، حيث سيتبلور النقد الجمالي على يد الرواد الأوائل، والذين
سيباشرون العمل على القطيعة مع نموذج الفن القديم. في هذا المعنى سنلاحظ أن
فكرة الحداثة ارتبطت ارتباطاً كبيراً بتطور الفن الأوربي. الفن هنا سيلعب
دوراً نقدياً هداماً، أي سيشكل نفياً لواقع معطى محاولاً في هذا السياق
بناء واقع جديد يستلهم نسيجه من تجربة معاد بناؤها عبر موشور المخيلة.
ارتبط تطور الفن بتطور العلوم بشكل عام، ولم يكن دوره في هذا السياق
حيادياً أو معزولاً بتأثيره، على جملة التطورات التي راحت ترج واقع
التجربة.
لقد أفضى تطور العلوم، إلى قلب العلاقة، بين الانسان والطبيعة، فبعد أن
كان الانسان خاضعاً بالكامل لقوانين الطبيعة، سيُجري تطور العلم، تعديلاً،
على هذه المعادلة، لينقل الانسان وفق هذا التعديل، إلى موقع المسيطر.
ستتأسس هذه السيطرة، عبر ما عرف بسيادة العقل؛ بينما قوانين العقل هنا
ستتجلى باعتبارها التعبير الأسمى للكمال الإنساني. وستصبح العقلانية،
السلاح الأساسي والفعال في القطيعة مع المراحل التي سبقتها. إن التمفصل
التاريخي بين تطور العلم والعقلانية المرافقة له، سيشكل القاعدة الموضوعية
–أي الضرورية- لانطلاق مشروع الحداثة.
في هذا المعنى سنلاحظ أن عصر الحداثة هو بالضبط عصر تثوير العقل الإنساني
وإعادة وضعه في مركز الفاعلية التاريخية. إنه العقل بالضد من الخرافة.
تشير العقلانية إلى كونها لحظة من لحظات تكوّن النهضة الأوربية، وهي
محصلة تثير الدهشة لشغف العقل الأوربي في بحثه عن المعرفة، في الأسئلة التي
أثارها، والفضول الذي قاد هذا الفتح وأسس فيما بعد لما بات يعرف بعصر
النهضة الأوربي.
أكثر من ثمانمائة عام، ولم تنتج أوربا كتاباً واحداً، بجرة قلم جريئة ،
حرم القديس أوغسطين جميع العلوم. ضُرب حصار على العقل لن يشبهه شيء في
التاريخ الإنساني، بيد أن هذا العقل كان لا بد له من أن يجد حصانه الطروادي
كي يتسلل عبره إلى التاريخ.
إن القطيعة الجاري الحديث عنها ستطال التاريخ أيضاً؛ لن يعود التاريخ هنا،
تاريخاً متخيلاً، يدور حول الآلهة والملوك، بل سيصبح تاريخ الانسان ذاته،
ينتجه في سياق إنتاجه حياته المادية ذاتها. وهنا أيضاً سنلاحظ، التعديل
الجذري الذي طرأ على علاقة الانسان بالتاريخ، حيث ستتجلى هذه العلاقة عبر
ما سيعرف فيما بعد بفلسفة التاريخ، أو علم التاريخ، الذي سيؤسسه هيغل،
ويعيد إنتاجه ماركس فيما بعد.
أسست الحداثة لمشروع طموح، يجعل من الانسان مركزاً للعالم، ويجعل من
التاريخ تاريخاً مرتبطاً، بالفاعلية التاريخية للبشر، قد يكون شعار الثورة
الفرنسية عام 1789 من أكثر الشعارات المعبرة عن هذا التوجه: (حرية عدالة
مساواة) المسألة كانت تدور هنا حول أشكال الانعتاق، التي كان من المفترض أن
يتيحه تطور العلم الحديث، مهيئاً لمرحلة جديدة يتخلص عبرها الانسان من
الاستلاب المرافق لكل تجربته السابقة.
بيد أن الحداثة الجاري وصفها أعلاه، لن تفضي إلى هذا الانعتاق، بل ستؤسس
لمرحلة جديدة من الاستلاب الذي سيدعوه الفكر الاقتصادي بالاستلاب
الاقتصادوي، وهو الاستلاب المرافق لآليات عمل نمط الإنتاج الرأسمالي؛ سنكون
هنا إزاء حداثة رأسمالية بامتياز،كما يصفها سمير أمين، حيث (الاستلاب نقيض
الحرية، والحداثة تتحدد بإعلان أن الكائن الإنساني فردياً وجماعياً، هو
صانع تاريخه ومسؤول عنه، وتضع بالتالي في مقدمة المسرح، المتخيل المجتمعي،
وهو التعبير الأرفع، عن الحرية الإنسانية، إلا أن الحداثة القائمة بالفعل
حتى اللحظة، ليست سوى حداثة رأسمالية.) .
الآن نعيش في عالم مشتت، تبدو فيه اللوحة الإجمالية لترابط العالم على
العكس تماماً مما تظهره وسائل الإعلام الجماهيري، فنحن نحيا تناقضاً، بين
عالمٍ أصبح بالفعل عالمياً، على قاعدة مجمل التطورات التقنية والتكنولوجية،
وهي حقيقة لا يمكن إنكارها، بيد أنها نظرة في غاية التقنية، وعالمٍ هو
الآخر واقعي، بيد أنه يعكس تفاوتاً عجيباً على مستوى أسباب الحياة، تفاوتاً
بات من السائد الحديث فيه عن مهمشين من دون أن يشعرنا ذلك بالغرابة أو
السوء. يضع هذا "الانخلاع"، الحداثة موضع التساؤل؛ فهل ما تزال الحداثة
مشروعاً للتقدم يسعى إلى وحدة الكائن الإنساني، أم باتت هي الأخرى، مختزلة
إلى جانب تقني يقلص مفهوم التقدم إلى مجرد معدلات للإنتاج، ويقلص الفرد إلى
مجرد رقم؟
لقد لعب الفرد العقلاني دور الفاعل الحاسم في التاريخ حسب الفلسفة
الليبرالية، بينما سيستبدل هذا الفرد- الإله، بمفهوم الطبقة لدى الفكر
الاشتراكي، هذا في الوقت الذي ستسفر فيه التجربة الواقعية عن التهام الفرد
من قبل السوق الاقتصادية، وامتصاص الطبقة من قبل حزبها الثوري، وهو الشيء
الذي أخلى ساحة التاريخ من فاعليها، فهل نحن إزاء تحديد هوية جديدة للفاعل
الاجتماعي، يتناسب مع تعريف جديد لمشروع الحداثة المعنيين بالعمل عليه هنا؟
لقد انطوى مشروع الحداثة منذ البدء على فعل الهدم وإعادة البناء، يتيح في
الآن ذاته، خيارات اجتماعية، تضع الفاعلية الاجتماعية، على المحك؛ كما
تحرر الممارسة الاجتماعية نفسها، للفاعلين، من قيودها. وكانت كل هذه
المضامين، تؤسس لوعي بمفهوم التقدم، هذا أن التقدم ذاته قديم قدم التجربة
الإنسانية بيد أن وعي التقدم يشكل سمة حديثة تلتصق في عمق مشروع الحداثة.
فهل ما تزال الحداثة، تحتمل مثل هذه الديناميكية، وهل في التاريخ من إمكان،
يعيد وضع أسس جديدة لمفهوم التقدم، يضع في مقدمة أولوياته الكائن
الإنساني، بمعزل عن صفاته الملحقة؟؟.


