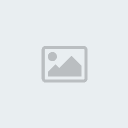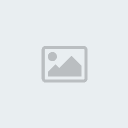
أنا عورة !! عمى في عينيك ..
¤ مُتظاهرة
الثورات الاجتماعية تقوم لأجل الدفاع عن العدالة والحرية والمساواة، إلا الثورات الدينية لاتقوم إلا لتغطية جسد المرأة، وكأنه مرتبط بأسباب الأزمات الاقتصادية والسياسية.. فهناك من يدافع عن حق الإنسان، وهناك من يرى أن جسد أنثى عاري أكثر استفزازا من مشاهد الحرب والبؤس والفقر. وأن جغرافيته المكشوفة همّ سوسيولوجي أهم من سوء التدبير السياسي.
والعجيب في الأمر، أنه حسب محرك البحث غوغل فإن المناطق الدينية هي الأكثر استهلاكا للمواد الإباحية، ودون أن نشير إلى أن العرب ضمن من حطموا أرقاما قياسية بالبحث عن كلمة جنس Porno Sex ، فإنه حتى بالنسبة للمناطق الحداثية والعلمانية وهنا إشارة للولايات المتحدة فإن الإحصاء كشف أن المناطق التي تسكنها أغلبيات دينية (مسيحية خاصة) تفوقت على باقي المناطق (التي لايلعب الدين فيها دورا كبيرا) باستهلاك الأفلام الإباحية ومشاهدتها (وتم ذكر الأمر بحلقة من برنامج لريشارد دوكنز عن “الجنس والموت ومعنى الحياة”، وأضاف السيكولوجي “داريل راي” بنفس الحلقة أنه وجد باستطلاع قام به سنة 2011 أن ممارسة العادة السرية بين المتدينين والغير متدينين لم تختلف بالنسب، الفرق الوحيد هو بتفوق المتدينين بنسب مشاهدة المواد الإباحية، وكلما زاد السن زادت نسبة الاستهلاك).
هنا يظهر التناقض، فمن يهتمون بالقضاء على المغريات الجنسية، هم الأكثر تنقيبا عنها، والأكثر استهلاكا لها. وبأحد البرامج التلفزية الغربية سخر المذيع من إحدى الدول المتشددة دينيا التي انكشف أنها تخطت البحث عن الجنس بين البشر، لتنتقل لتحطيم أرقام بمشاهدة الأفلام الجنسية الخاصة بالحيوانات. حتى أن المذيع صاح من منبر الاستوديو مخاطبا تلك الحكومة الدينية بقوله : “دعوهم يمارسون الجنس، حتى يتوقفوا عن مشاهدة ممارسات الحيوانات” فانفجر البلاطو بالضحك. ومن الظاهر أن مشاهدة الحيوانات من منظور ديني لا تعتبر ذنبا مقارنة بمشاهدة البشر. فمثّل هذا حلاًّ هنا يرضي كُلاّ من الغريزة والمجتمع.. ربما!.
إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإنسان بها التغلب على غرائزه، هي بإشباعها، فعندما يكبتها الإنسان، فهو الخاسر طبعا.. وغالبا ما يدفع ضرائب مضاعفة عن هذا التصرف، تكون على حساب صحته النفسية والوجدانية، والجسدية حتى. فعندما يعجز الإنسان عن إشباع رغباته واقعيا نتيجة ضغوط أو معيقات اقتصادية واجتماعية وثقافية فإنه يلجئ “للصورة” كتعويض. وكما يقول أحد علماء الاجتماع الفرنسيين بأن “الواقع أصبح هو الصورة”، أكانت صورة بشاشة حاسوب أو تلفاز أو حتى آيفون.. فواقعنا صار يُصنع عبر الصور.
ولننتقل لدور الجسد الأنثوي في مثل هذه المجتمعات، دون التركيز عن المتشددة منها التي لا دور للأنثى (المختفية جسدا) فيها سوى الإنجاب وغسل الصحون :
ففي مجتمع الكبت.. لا تُقدّر قيمة الأنثى بحجم عقلها، مايهم هو حجم مؤخرتها!
تحدس الأنثى هذا الأمر فتعمل على تضخيمها بدل تضخيم عقلها. ومن منظور أنثروبولوجي يُفسَّر الأمر بأن اتساع منطقة الحوض لدى الأنثى البشرية يجذب الذكر الذي يرى في اتساع حوضها علامة على خصوبتها وبأنها النموذج القادر على انجاب نسل صحي، كاستمرار للنسل البشري متطور ومتكيف مع الحياة.
فالغرائز هي التعبير الطبيعي عن العالم الحيواني، وطبيعي أن يجذب اتساع الحوض العقل الذكوري الحيواني. مثلما تجتذب الروائح واحمرار المنطقة التناسلية، ذكور بعض أنواع الحيوانات نحو إناثها.
ومنه فإن تقدير قيمة الأنثى فقط من حجم مؤخرتها، يعتبر نظرة حيوانية لها.
هذه النظرة الحيوانية قد يرتبط بها مستقبل الأنثى، ففي ظل مجتمع يعاني من مشاكل مع العقل ما يعني أن القيادة للغرائز، لن يصبح لمواهب واختصاصات الأنثى أي دور أمام جمال شكلها أو روعة مؤخرتها، فهذه الأخيرة هي من تكون سبب قبولها بالوظيفة بدل شهادة التحصيل الدراسي أو دبلوم الاحتراف المهني، وهذا هو جوهر مشاكل المجتمعات الغبية : الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب بالوقت الغير مناسب. يتم التضحية بمهندسة متألقة مقابل مهندسة ليست بمستوى لكنها تمتلك قوام رشيق أو مؤخرة كيم كارداشيان، “وكأنها ستضع التصاميم بردفيها وليس بعقلها”!.
دون أن نحكي عن الوظائف العادية والخاصة بالاستقبال أو السكرتارية، فالغلبة طبعا للردفين وليس للخبرة.
هناك خطاب فكاهي يدور بين الشباب، مفاده أن الجميلات غالبا كسولات والبشعات جد مجتهدات، وإن سألت أحدهم لماذا؟ سيجيبك دون تفكير بأن البشعات يربطن علاقة غرامية مع الحروف والأرقام طالما أن لا أحد يهتم بهن، لدى فإنهن يشغلن أنفسهن بالدراسة طالما أنها الشيء الوحيد المتوفر لهن. عكس الجميلات واللاتي يطاردهن الجميع، فلا يجدن وقتا للدراسة أو متابعة الدروس نظرا لتجوالهن طوال اليوم مع الشباب، وبالمساء يجتمعن مع صديقاتهن الأخريات ليحكين لهن عن معجبيهن. والخطاب صحيح نسبيا خاصة بسنوات الاعدادية والثانوية، لكن هذا لاينفي ـ ماهو موجود واقعيا ـ بإيجادك لطبيبة “صاروخ أرضءأرض”، وتجد بَشِعة قاطعة طريق أو مروجة مخدرات.
رغم ذلك فمن المتعارف أنه بظل هذه المجتمعات، أن صاحبة المظهر لا يجد الفشل طريقا ليطرق على بابها، فحتى لو لم تتفوق بدراستها أو وظيفتها، فإنها قد توقِع بشخص ثري يقدم ثروته لخدمتها، أو تتزوج بمليادير عجوز، أو حتى قد تجمع ثروة بامتهانها للدعارة الراقية التي تشترط جمال الشكل. مايعني أن شكلها له أكبر الأدوار بصناعة مستقبلها، فمهما يكن فإن جيناتها ـ التي ليس لها دخل فيها ـ تصبح ورقتها الرابحة في المجتمع الذي ينخره الكبت. وسلام على العقل!.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حتى أن طلاقها أو لو حدث وترملت، فإن هذا يتحول لنعمة ! فكثير من يسعدهم أن يرتبطوا بالقوام الرشيق والمؤخرة المحترفة التي لها تجارب سابقة بالجنس. فتصبح هذه النوعية من النساء ـ التي ربما تعاني ولم تتخلص بعد من ضغوط ومشاكل مابعد الحادثة ـ محط انظار واهتمام ليس فقط أقرانها بل من أصغر الفئات العمرية إلى أكبرها، فحتى المراهقين والشباب يرونها ككنز من المتعة لأنهم لن يعانوا معها من مشاكل البكارة أو التردد الجنسي، فعقول البطيخ تظن أن كل من دخلت عالم الزواج صارت مدمنة جنس، امرأة مكبوتة ما إن يغيب زوجها حتى تتعطش لأي قضيب!.
فالخضّار والبقال وبائع الملابس وسائق باص المدرسة والمدير والأستاذ والجار وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، جميعهم يعاملونها معاملة خاصة ويصبح أبنائها أحب الأطفال عندهم. هذا إن لم يستغلوا أطفالها للوصول إليها ـ “فإن أحبك أبناؤها ستحبك طبعا” ! ـ ولنا من المواقف المعاينة، الكثير لوصف هذا الأمر ولايكفي المقال لذكرها. ترى الواحد يكره الأطفال ثم فجأة يتحول مع طفل أو أطفال معيّنين إلى أصغر الكائنات على وجه الكرة الأرضية، يمسخ نفسه لطفل ليكسب حب أحد الصغار كطريقة للتعرف على أمه، أو كوسيلة لإثارة اهتمامها خاصة إذا كانت تمتلك ثروة، قد يتحوّل لبهلوان ساعتها!.
لكن ماذا لو لم تنجح الحيلة أو أن الأم صدّت؟ مباشرة “إنها عاهرة وأبناؤها مزعجين” ! “لقد كنت اعطف عليها وعلى ابنائها لأنها مسكينة/مطلقة/أرملة لكن تبين أن نواياها سيئة”! “ناكرة الجميل لا تستحق، وعيناها ماكرتان.. أعوذ بالله من نساء هذا الزمان، لا يخجلن”! “لا اهتم سوى بالأطفال وما يؤلمني هو عندما يكبرون ويعرفون حقيقة أمهم”. يصبح كل رجل ساعتها “يوسف الصديق”!.
ببعض المجتمعات التي يشملها الحديث، تُعتبر المرأة فيها كائناً من الدرجة الثانية! ـ لماذا؟ .. لأن التعرف عليها عندهم يتم عن طريق الأجهزة التناسلية و ليس عن طريق العقل. وتكفي إطلالة سريعة على عالم الفتوى، حتى ترى أنه خصص جزءً كبيرا منه لمنطقة الحوض لدى الأنثى.
“ليس صحيحاً.. أن جسد المرأة لا يؤسس شيئاً.. ولا ينتج شيئاً.. ولا يبدع شيئاً..
فالوردة هي أنثى.. والسنبلة هي أنثى.. والفراشة والأغنية والنحلة والقصيدة هي أنثى.
أما الرجل فهو الذي اخترع الحروب و الأسلحة
واخترع مهنة الخيانة.. وزواج المتعة.. وحزام العفة..
و هو الذي اخترع ورقة الطلاق..
ليس هناك جسد أنثوي لا يتكلم بطلاقة..
بل هناك رجل.. يجهل أصول الكلام”(1).
قد يذهب البعض حد القول أن هذا ينطبق على المجتمعات المتفتحة أو الغربية وليس على المجتمعات المحافظة أو العربية، وقد سبق وبيّنا بمواضيع أخرى أن المجتمعات الغربية لم تتفوق لحد الآن على المجتمع العربي الذي كانت تتجول فيه الجاريات عاريات (وكان هذا مفروضا عليهم لتمييزهم) وإن حدث ودخلت لبيت أحدهم قد تجد سبايا صغيرات لا يرتدين شيئا ! (فقد كان الشرط هو تعرية النهدين فقط).
أما بالنسبة لضخامة المؤخرة فهذا لم يعد أمرا متطلبا لأن مقاييس الجمال الحديثة ترتبط بالنحافة والرشاقة، لكن الإعلام الإباحي يستعمل المعدات الأنثوية الضخمة لاستقطاب المستهلكين، فالمحروم أو المكبوت يبحث عن الزيادة فيما حُرم منه، فطفل صغير حرم من الشوكولا تجده يرغب باقتناء علبة كبيرة، والمثال يفسر لنا اهتمام البعض بالأثداء والأرداف الضخمة، فالكبت كطاقة حبيسة تضخم الحرمان .. وهذا ما تبني عليه صناعة الإباحية نجاحها، وهي الصناعة التي تعرف أضخم الإنتاجات وأضخم المداخيل وأضخم الأرداف وأضخم الأثداء ! .
مردود ذلك يؤثر بعقل الأنثى، التي تجدها تبحث عن أعشاب وأدوية لتضخيم المؤخرة (طالما أن ذلك هو مايثير الإعجاب) .. وحتى لا ينكر البعض ممن يعانوا من آلية الإنكار (كحيلة ذهنية للدفاع عن المعتقدات ضد المُعطى الواقعي)، فيكفي أن يبحثوا عن الموضوع بمحركات البحث، حتى يجدوا العديد من التحقيقات الصحفية والبرامج التلفزيونية (العربية والمغاربية للتأكيد) التي تتطرق لهذا الموضوع، وتحذر النساء من مخاطر تناول تلك المواد التي تساعد على تضخيم أردافهن. حتى أن بعض المجلات تخصص صفحة التمارين الرياضية لحركات تساعد على إبراز الأرداف ! .
ثقافات لا يهمها الجسد العاري إلا عندما يكون به ثديان وردفين كبيرين.
هوامش :
1 : نزار قباني - قصيدة المرأة وجسدها الموسوعي.