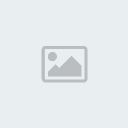 "الورد يدلّ عليها
"الورد يدلّ عليها
والفجر الصّاعد في درجات الشمس
يدلّ عليها
والحزن الساكن في قسمات الناس
يدلّ عليها"… "أدونيس" ارتبط اسم "علي أحمد سعيد اسبر" في الثقافة العربية المعاصرة بمشروع
متكامل جمع بين الإبداع الشعري والنقدي والفكري. ولم يستثن صاحب المشروع
نفسه من هذه المغامرة فاختار اسما بديلا لاسمه الحقيقي وهو "أدونيس"،
الرّمز الأسطوري للخطيئة والحب والانبعاث من الموت. ويتميّز "أدونيس" بكونه
من أكثر الشعراء العرب المعاصرين إن لم نقل الوحيد من بين الرّواد من شدّد
بوضوح على ربط التحديث الشعري والفكري بتجاوز نقدي للبنية السلفية للتفكير
الدّيني في الثقافة العربية الإسلامية، ما جعله في أعلى قائمة الملعونين
والمكفّرين والمحرومين من الجنّة في مختلف القائمات السوداء التي نشرها
الأصوليون منذ ثمانينات القرن الماضي. مع قصائده ومجاميعه الأولى وتحمّسه
لقصيدة النثر التي يعدّ رائدا لها توصّل في أطروحته الجامعية لنيل شهادة
الدكتوراه والتي نشرت تحت عنوان "الثابت والمتحوّل بحث في جدلية الإبداع
والإتباع في الثقافة العربية" إلى أن المنحى "الثبوتي" في الشعر راجع إلى
ارتباط الذهنية التي سادت وحكمت الماضي بالدّين في وجهه التاريخي، والذي
قدّم باعتباره خاتمة المعرفة ونهاية الكمال، الأمس والآن والغد لا يكشف
عمّا يتجاوز الوحي، بل إنّه على العكس يشهد له، الآن لحظة تذكير وكذلك الغد
وليس المستقبل بعد اكتشاف بل بعد حفظ واستعادة.(1) الدّين لم يعد أصلا
لمعرفة الغيب فحسب، بل هو كذلك أصل لمعرفة العالم . (2) .
ومن خلال قراءاته المختلفة لمدوّنة الأدب العربي يشرح كيف تسرّبت الخلفية
الدينية للنقد و للشعر أيضا. فطلب اليقينية في الشعر ورفض الاحتمالية
تأكيدا على أن النظرة النقدية كما اكتملت في القرن الثالث حول "أبي تمّام"
هي نفس النظرة الفقهية للنصّ الديني، التي شكّلت ذوقا تقليديا "يميل إلى
تجريد اللّغة وقتل الإيحاء والتوكيد على أن المفردة وحدة لغوية ثابتة
المعنى ويضيف في هذا السياق " ولعلّ هذا مرتبط بالنظرة النفعية للشعر، لأنّ
الشعر في التقليد العربي إنما هو للتهذيب والإمتاع ومن هنا الإلحاح على
المألوف ومطابقة الكلام لمقتضى الحال.(3)
في ضوء هذه الرؤية النقدية يؤسس "أدونيس" مشروعه التحديثي على اعتباره
امتدادا شرعيا لرموز وحركات التحديث، كفكر المعتزلة "العقلاني" ورموز
الثورة في تاريخنا مثل "ابن الرّوندي" و"ابن المقفع" و"الرازي" و"جابر ابن
حيان" وحركات الرّفض والتمرّد من قبيل ثورة الزنج والقرامطة فضلا عن رموز
الحداثة الشعرية "أبو نواس"، و"أبو تمام" و"جميل بثينة" وغيرهم دون أن ينسى
التجارب الصوفية التي غيّرت جوهر العلاقة الرّوحية، الإيمانية وصولا إلى
"جبران خليل جبران" الذي يعتبره بحقّ رائد الحداثة الشعرية والأدبية
المعاصرة. في نفس الإطار يضع أدونيس منطلقات فلسفية للحداثة الشعرية، استو
لدها من قراءة الشعر الجاهلي ومن عناصرها كما هي مبثوثة في كتبه :
أوّلا - "إن الإنسان هو مقياس الأشياء وليس اللّه، لأن بناء عالم جديد
يقتضي قتل مبدأ العالم القديم حتّى تتحقّق للإنسان الحرية الحقيقة التي
تجعل من و جوده سابقا لماهيته، ويتحوّل مستقبله إلى مشروع يتحقّق، شيئا
فشيئا،(4). وقد حقّق الصوفية هذا الانجاز داخل الفضاء الدّيني عندما حوّلوا
اللّه من نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان إلى حركة في النفس، في
أغوارها. فزال الحاجز بينه و بين الإنسان، وبهذا المعنى قتلوه وأعطوا
الإنسان طاقاته. (5) ثانيا "الطبيعة ليست موضوع تعاطف كوني وتغنّ رومنطيقي،
وليست ملجأ أو تعويضا إنما هي واقع" (6). ينطلق "أدونيس" في هذه الرؤى من
تصوّر حداثي، تمكّن خلال مسار تاريخي طويل من الانتقال بالفن من
تصوير الطبيعة على أنّها مجرّد شاهد على خالقها لتصير ببساطة العالم الوحيد
المتاح لحياة البشر، وليعيد الناس إلى هويتهم البشرية التي أضاعوها في
تهويمات الأديان والأساطير.
ثالثا -الدين جواب والإيديولوجيا جواب أما الشعر فلا يقدّم جوابا إنه سؤال
استبصار، أو هو كشف متسائل. هكذا يتعارض الشعر مع كلّ نظام معرفي
ثبوتي.(7) وكمثال على تمثّل "أدونيس" لهذا الفكر يقول في دراسة عن الشاعر
"أحمد شوقي" الذي يعتبره شاعرا يكرّس السلفية في التعبير حسب رأيه" ما
يلي: "التأمل في المادّة أو الشيء هو نوع من التأمل في قدرة الخالق أي في
بيانه ووصف الأشياء شعريا، إنما هو في العمق وصف لهذه القدرة، لا المادة في
ذاتها ولذاتها. النصّ الشعري هنا كلام على كلام الخالق وخيال الشاعر إزاء
المادة التي يتحدّث عنها- خيال لغوي- ينبثق من حركية اللّغة- وليس خيالا
مادّيا، ينبثق من المادة فليس شيئية المادة هي التي تملي لغتها الملائمة بل
اللّغة هي التي تضيف على المادّة الكلمات التي تلائمها" (8) رابعا -هدم
النظام الثقافي السائد ووعد بثقافة جديدة تخرج عن قيم الأمر والنهي وتتيح
حياة فيها تآلف بين إيقاع الجسد والواقع في موسيقى الحرية"
(9) خامسا-"الرؤيا الدينية الإسلامية كأي رؤيا دينية نقيض الشعر من حيث
الهدف أيضا كما هي نقيض من حيث اللّغة والنوع الكلامي وكذلك على مستويين:
الأول هو أن الشعر تغير، رؤى وأشكالا، ممّا يجعله في تعارض مع النشور أو
الغيب، فهذا ممّا وراء التاريخ أمّا الشعر فيعيش في ديمومة التاريخ مع
اللاّ منتهي واللاّ محدود حتى في تغيره". الثاني هو أن صورة العالم الأرضي
في الرؤيا الدينية زائلة أي فانية ولذلك لا يجوز خلق الآلهة الأرضية أو
الوقوع في وهم الجنة الأرضية هو وهو يخلقه بامتياز الشعر (10).
يتقصّد أدونيس في نثره كما في شعره مناقضة كلّية وجذرية لمكوّنات وأسس
النزعة السلفية في الثقافة العربية السائدة. فهو يقوم شعريا ببناء قيم
جديدة، ورؤى في مستوى علاقة الإنسان بالكون والأشياء يقول "سلاما للفساد
الخالق الأليف كأنّه الهواء المؤسس كأنّه البدء (11). وهو شاعر يؤسس مذهبه
فيما بعد الخير والشرّ واللّه، والشيطان، متمثّلا في ذلك ثورة كبار شعراء
الحداثة الغربية يقول "دربي أنا أبعد من دروب الإله والشيطان، إنّني لغة
لإله يجيء" (12) والمبدأ الذي يقوم عليه هو الإنسان وليس اللّه، ووجود هذا
الإنسان سابق لماهيته، لأنها صنعه هو يحقّقها عبر تجربته مع الحياة. يقول
في نبرة تذكّر بلغة الفيلسوف الألماني نيتشه :
"اليوم أحرقت سراب السبت سراب الجمعة
اليوم طرحت قناع البيت
وبدّلت إله العجز الأعمى واله الأيام السبعة
بإله ميت
باسم تلك الشموس التي تتقدّم أبدأ هذه الجنازة". (13).
استنادا لهذه الرؤية لا يمثّل الوجود والأشياء في رؤية "أدونيس" دليلا على
قوة غيبية، هي سبب وجودها، وحركتها، كما تؤكد ذلك الرؤية الدينية، بل إن
الوجود المادي، يتحرّك من خلال عناصره المادية المكوّنة له فلا يدل المادي
إلا على المادّي، يقول متمثلا مجازيا هذا المعنى :
"الورد يدلّ عليها
والفجر الصّاعد في درجات الشمس يدلّ عليها
والحزن الساكن في قسمات الناس يدلّ عليها" (14).
ضمن هذا التصوّر تشكّل الحياة مغامرة مع الكون والحياة ورحلة اكتشاف وبحث.
فالرّحيل هو مبدؤها ومنتهاها، الاستقرار وقوف وموت، أمّا السؤال والقلق
الدائم فهما محرّكان للإنسان والحافزان للحركة والفعل والإبداع والضياع
والتيه هما اللّذان يمنحانها معنى ولذة وثراء لأنّهما يكشّفانها على طرق
ومسالك غير مطروقة، يقول:
"آخذك ….ثنية ثنية- وافتح مسالكي
أتمدّد فيك لا أصل
أتدوّر لا أصل
أتسلّل أنتسج لا أصل
آخذك أرضا لا أعرفها
تلالا وأودية تغطّيها نباتات البحث.
اللّهب الذي يقودني أتمرّد عليه، اللّهب الذي أقوده يتمرّد علي"(15) .
ويقول "ليست الأرض هي التائهة بل ضبابة سمّوها السماء
أمحو وجهي- أكتشف وجهي
أمحو وأنتظر من يمحوني" (16).
ومع أنّ هذه الرؤى الفكرية والشعرية دّالة بوضوح على تمشّي "أدونيس"
الفكري في مناقضة الرؤية الدّينية إلاّ أنّ ذلك لم يمنع عددا من
المفكّرين من الكشف عمّا اعتبروه رؤية دينية في تفكير "أدونيس" كانت نتيجة
للمنهج البنيوي الذي تحكّم بقراءته للثقافة العربية. وهي قراءة ترى أن
العقل العربي تشكّل واكتمل في زمن معين، عصر التدوين، وظلّ يعيد إنتاج
نفسه تاريخيا. هذا التصوّر يلغي التاريخ ولا يتبيّن الاختلاف بين بنية
العقل العربي كما تشكّلت في الماضي والتي كانت نتيجة بني إنتاجية مختلفة عن
بني الإنتاج الحديثة التي تتميّز منذ منتصف القرن 16 عشر بتاريخ بداية
الاستعمار والارتباط بالامبريالية. وتقديرنا أنّ هذا الطرح الذي يتحمّس له
معظم الماركسيين، يكشف عن جانب مهمّ في تفكير قطاع كبير من المفكّرين
العلمانيين العرب الذين بالغوا في إبراز خطر المنظومة الفكرية السلفية
مقابل التقليل من الخطر الذي تشكّله أنظمة سياسية شمولية فاسدة مافتئت
تستعمل قيم التنوير والحداثة ومحاربة التيارات السلفية لإصباغ شرعية على
وجودها السياسي. وقد يفسّر هذا التفكير أو الاختيار برغبة هؤلاء المفكّرين
تجنّب ظلم السلط الحاكمة وجورها، كما يعود إلى حالة ما يطلق عليه ب
"الإسلاموفوبيا" التي خلقتها بامتياز الحركات الدّينية بما أنشأته من مظاهر
سلوكية متزمّتة وأعمال عنف إرهابية.


