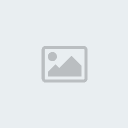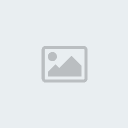
ليس التفكير مجرد نتاج آلي لفعل
فيزيائي ينعكس من العالم إلى الحواس، كما أنه ليس ردّ فعل بيولوجيا بحتا
يتعامل مع انطباعات حسية آتية من العالم الخارجي. إنه إعادة صياغة وفهم
تأويلي للعالم. هذا التأويل يحمل بطبيعته فهما مستقلا عن حقيقة العالم
كموجود معطى. إنه فهم تحكمه الطبيعة النفسية التي تجعل الناس تنظر لنفس
الموضوع نظرات مختلفة، حسب تغير الزمان والمكان.
وكل شخص علمي هو، عند التدقيق، مُختص فيما لا يُتوقع، وكل اكتشاف مهم هو
بالتعريف شيء غير متوقع، ولو كان يمكن توقعه لما كان اكتشافاً بل نتيجة،
أليس غرض العلم هو إيجاد الظروف التي تتيح تحقيق أحداث أو مشاهدات غير
متوقعة؟ إن طبيعة الأفعال العلمية الكبيرة تأتي من أولئك الذين يجازفون
بأنفسهم خارج المسار التقليدي ولا يخشون ظهور ما هو غير منتظر، فكل شيء
يتقدم بقفزات غير متوقعة لا يمكن التنبؤ بها. ومن واجبنا لا في المجال
العلمي فقط، بل في المجتمع نفسه، أن نشجع تنظيماً حقيقياً لاستيعاب ما هو
غير متوقع والتجاوب معه. وتجاوبنا مع ما هو غير متوقع يتيح لنا إعادة فهم
الذات وتفاعلها مع الموضوع. وفي المقابل فإن معرفة الذات - من حيث هي عملية
تكرارية تفاعلية - تهبنا استبصارات للعلم، والعلم يلقي الضوء على المسائل
الشخصية. وكلما اكتشفنا أكثر عن الطبيعة اكتشفنا أكثر عن أنفسنا، وإذ نكون
على وعي بالرابطة بين النفس والتجربة، نستطيع أن نطرح على أنفسنا أسئلة
مختلفة حين يبدو العمل غير هادئ. وحين تخيبنا التجربة أو مشروع البحث أو
حين تتواصل ظهور المشاكل، يمكن أن نقطع خطوة إلى الوراء ونتدبر ما إذا كان
ثمة شيء ما ذاتي، ربما تشير التجربة إلى الحاجة لتعديل منظورنا في المجال
الشخصي، وبالمثل تماماً في البحث العلمي نستطيع أن نتساءل إذا صنعت هذه
التجربة بصورة مجازية ماذا سيحدث هنا، وما هي الديناميات الكامنة في الخلف،
فنحن نستطيع أن نفحص تفاعلنا مع الطبيعة لنتعلم المزيد عن أنفسنا.
البحث العلمي ودوره في النفس:لقد أكد هانسون أن النظريات العلمية التي يأتي بها العلماء تجدد لنا
تصور ما شوهد، نظراً لأن العلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة يشاهدون نفس
الشيء لكن نمط المشاهدة المشار إليه لا يعالج تصور المشاهدة معالجة كاملة،
حيث يوجد معنى آخر بمقتضاه لا يرى ملاحظان اثنان الشيء نفسه، ولا يبدءان
أيضاً من نفس المعطيات، مع أنهما من الناحية البصرية على وعي تام بنفس
الشيء الملاحظ، وهو موضوع المشاهدة. وهناك في الواقع معنيان لكلمة يشاهد؛
المعنى الأول هو ما عرف منذ بداية العصر الحديث بالموضوعية التي تعني تركيز
الانتباه على كل جوانب الظاهرة، وتمييز أوجه الاتفاق والاختلاف فيها،
وتمييز عناصرها بدقة، والعناية بتدوين التفاصيل المشاهدة وحسب دون تدخل
الذات في عملية الملاحظة ذاتها والمشاهدة. بهذا المعنى يمكن أن نطلق عليها
اسم المحايدة، حيث يرى العلماء ضمن هذا المعنى نفس الشيء. أما المعنى
الثاني فبموجبه لا يشاهد العلماء نفس الشيء؛ إنهم يشاهدون الظواهر الخارجية
من خلال الذات. إننا نجد العلماء – بلغة علم النفس – يقررون تأويلاتهم
الخاصة الداخلية على الأشياء. فكأن المعنى الموضوعي هو ما يمكن أن نطلق
عليه مصطلح التفسير، والمعنى الذاتي مصطلح التأويل. وهو ما يعنينا هنا
بالذات في هذه الدراسة.
إن تفاعل الذات الموضوع لا يمرّ دائماً دون إشكالات تصيب الباحث نفسه،
كما تؤثر على ديناميكية البحث العلمي. فمن الوجهة التحليلية نقول أن
الانفعال هو الصفة الرئيسية التي تربط أنواع العصاب النفسي للشخصيات التي
أدت أعمالاً خلاقة، وينشأ العصاب عن صراع قائم بين الرغبة ومحاولات
تحقيقها. وكلما ازدادت الرغبة اتقاداً زاد احتمال أن يؤدي إحباطها إلى
العصاب. وقد ييسر هذا بدوره تحقيق الرغبة، أو يؤدي دور الحاضر للتطهير
العقلي الذي ينتج عنه عمل خلاق عظيم. ويبدو أن هذا هو أساس العلاقة بين
العصاب النفسي والإبداع الذي نسميه تحليلياً بالتصعيد. وبالمقابل، فإن
الفوران المتواصل للأفكار يؤدي غرضين حاسمين؛ فهو يغذي الخيال للشخص
العلمي، كما تُطرح أسئلة جديدة يحاول عقله الإدراكي المنظم صياغتها بطريقة
تنفيذية، وكل فكرة يتم اختبارها و التأكد من صحتها، هي خطوة صغيرة إلى
الأمام في حصيلة الفهم. والجهل بطبيعته يدفع – إذا ما رافقته الرغبة
بالمعرفة – إلى اكتشافات جديدة. تلك الاكتشافات توجد بدورها جهالات جديدة،
فالإنسان في العصور القديمة لم يكن قد طور بعد علوم ما قبل التاريخ أو
الفلك أو الفيزياء والإلكترون، كان يفسر بأسطورة بسيطة ما يبدو لنا اليوم
معضلات جسيمة وعويصة. وفي البحث العلمي قد تتولد الفرضيات عن الجهل
والضلالات التي تخلقها اكتشافات أكثر مما تتولد عن النمو المدرسي للمعرفة
المتحصلة. ذلك أن عدم الرضا بما هو موجود، سمة مميزة للوجود الإنساني، وهذا
السخط هو الذي أدى بالإنسان إلى التكيف مع العالم من الناحية البيولوجية،
إذ جعله يستخدم خياله بصورة ما، ولا أحد يقنع بمجرد إشباع حاجاته الطبيعية.
بل إن أولئك الذين نسميهم بالبدائيين ونعرف أنهم ربما يكونون قد عاشوا
ألوف السنين متكيفين مع نمط واحد من الوجود، هؤلاء البدائيون لديهم أفكار
عن نوع من الجنة السماوية التي سيعيشون فيها متحررين من الشقاء والمعاناة.
والإخفاق في التمييز بين الإلهام والجنون قد أسهم في أن تكون فكرة
العبقرية الشائعة بين العامة على الدوام صورة من صور الجنون. وهي الفكرة
التي بلغت أوجها في القرن التاسع عشر من خلال أعمال عالم الاجتماع سيزار
لومبروزو الأستاذ في الطب الشرعي في جامعة تورين، إذ أنه وصف العبقرية
بأنها ذهان متدهور لمجموعة أشباه الصرعى، وقد تتبع آثار هذه الفكرة في
العصور القديمة في أعمال أرسطو وأفلاطون وديمقريطس. وفي العصر الحديث
ربط عالم النفس كريتشمر بين العبقرية واضطرابات الشخصية قائلاً : إن
العبقري من وجهة النظر البيولوجية البحتة يعدّ حالة شديدة الخصوصية في
الجنس البشري، ومثل هذا يبدي ميلاً قوياً للانحلال والمرض العقلي، وبصفة
خاصة فإن تلك الحالات الصعبة التي تقع على حدود المرض العقلي هي بلا جدال
أكثر ظهوراً بين أصحاب العبقرية. ومثل هؤلاء الناس هم أكثر تعرضاً لأنواع
الذهان والعصاب والأمراض النفسية، ويعتبر هذا التحلل الداخلي للبنية
العقلية بالنسبة لبعض أنماط العباقرة بداية لا مفر منها. ويضيف – إن العامل
السيكوباتي هو جزء جوهري وضروري وربما الحافز الأساسي لكل أشكال العبقرية.
والواقع أن مثل تلك النظرة لم يبق لها أثر بعد ذلك إلا عند عامة الناس، إذ
لم تعد تلك النظريات تجد أي تأييد من علماء الطب والنفس.
لكن هذا لا ينفي في المقابل، أن لتطور الفكر العلمي محاذيره من الناحية
السيكولوجية. فتطور البحث والاكتشاف لا يلبث أن يوقعنا في تناقض بين عظمة
اكتشافاتنا وتفاهة وجودنا، الأمر الذي يجعل الرأي العام العلمي قبل الشعبي،
يعارض غالباً بل ويعادي الاكتشافات الثورية للعلم. فمنذ كوبرنيكوس
وغاليليو ومن جاء بعدهم نرى أنه كلما ازدادت معلوماتنا العلمية توسعاً أخذت
هذه المعلومات تزيد أكثر وأكثر من الحد من أهميتنا ومعنى وجودنا في
العالم. فكلما ازددنا قوة وقدرة على التأثير في الطبيعة ازداد علمنا بمدى
تفاهتنا ونقص فهمنا للوجود ولغاية العلم الحساسة.
ما يمكن قوله استنتاجاً هنا أن البحث العلمي، في أي درجة من درجات دأبه،
مشروع انفعالي، وتأسيس المعرفة الطبيعية يتوقف قبل كل شيء آخر على النفاذ
إلى ما يمكن تخيله ولكنه غير معروف. وقد كتب عالم القرن الثامن عشر الكونت
رمفورد عن نفسه : إن الحماسة التي تلهب عقلي لا يمكن التحكم بها لدرجة أن
أي شيء يهمني يستغرق انتباهي كله، وأتابعه بدرجة من الحمية التي لا تعرف
التعب حتى لتقارب الجنون. وكم هي عقيمة تلك المناقشات العامة حول قيمة
العلم إن لم تنفذ إلى تفصيل قيمة الأفكار العلمية، وإن لم تر أن كل فكرة
علمية تحقق بصورة ملموسة قيمة نفسية من مستوى عالٍ، والبنية العقلية – حسب
باشلار – ليست بنى ثابتة بل متطورة بفعل أثر المعارف العلمية عليها.
فالمعارف العلمية الحديثة والمكتشفة لا تؤثر في تطور المعرفة العلمية وحسب،
بل تؤثر أيضاً على بنية الفكر الذي ينتج هذه المعرفة.
ومن الناحية التاريخية يعتبر العلم قوة هامة في تطور الوعي، وبدلاً من
السير في طريق الخوارق أو التسليم بأقوال السلطات الدينية، يفحص العلم
مباشرة ويختبر الافتراضات، وعن طريق النظر إلى العالم وردّ الطبيعة إلى
الأجزاء المكوّنة لها كدّس العلم المعارف الشاسعة والقوة. إذ لا يوجد بحث
علمي لا يرافقه اعتقاد وأمل بتحقيق أمان ما، واستبصار الاطراد والأنماط
النظامية، قد حمل في طياته مغزى الأمان، حيث أمكن الركون إلى الطبيعة،
الليل يعقب النهار، الربيع يتلو الشتاء، ولا يعني الكسوف الشمسي نهاية
العالم، ولا ظهور مذنب كارثة ما، والتنبؤ الدقيق هو برهان على نجاح
النظرية، إذ نظم العلم الفوضى الضاربة في العالم مانحاً الإنسان الأمل في
تأمين بقائه عن طريق السيطرة على بيئته. و يبدو أن العقل البشري مركب
بطريقة معينة بحيث يؤدي اكتشاف النظام في التعقيد الموجود في العالم
الخارجي إلى انعكاسه ونقله وتجربته، كما لو كان اكتشاف نظام وتوازن جديدين
في العالم الداخلي للنفس، وهذا ما يجعل علاقة العلم والفن علاقة انعكاس
ايجابي بين الواقع وما يجب أن يكون. ويبدو أن العباقرة كثيراً ما يقعون تحت
تأثير صراعات تدور داخل ذواتهم، وتؤدي بهم غالباً إلى الإحساس بالتعاسة
وعدم الرضا والقلق، ولكنها في الوقت نفسه تمنحهم القدرة على التخيل
والتساؤل واللهفة على اكتشاف وتجربة مباهج الوحدة والتركيب. لقد كتب غاوس
الذي حاول لمدة عامين أن يبرهن على نظرية رياضية دون أن ينجح في ذلك
"أخيراً نجحت منذ يومين، لم يكن ذلك بسبب جهودي المضنية، ولكن بفضل ومضة
مفاجئة، حدث حل اللغز، وأنا نفسي لا أستطيع أن أتكلم عن كنه ذلك الخيط
الهادي الذي يربط بين ما أعرفه من قبل وما جعل نجاحي ممكناً".
إن متطلبات خلق درجة من الأمن والأمان عن طريق التنبؤ والتحكم بالطبيعة
قد دفعت العلماء إلى خلق نظام مستخدمين في هذا وظيفة التفكير، وهي الوسيلة
الأفضل لاكتشاف نظام ما في شواش الطبيعة، وفي وضع كهذا يمكن تنفيذ الكثير
من وظائف التفكير والإحساس عن طريق الآلات، إذ يستطيع الحاسب الآلي معالجة
المعطيات أسرع كثيراً من ذهن البشر، تستطيع الأجهزة قياس الأطوال الموجية
في شعاع الضوء والصوت، عبر مجالات أوسع مما يمكن للعيون والآذان البشرية
التقاطه، غير أننا في المقابل نحتاج إلى الحدس ليطرح المعطيات معاً، فتشكل
نماذج وتقدر المعنى استقرائياً، ونحتاج إلى الشعور لتحديد الجدارة
والاستحقاق وإرساء قيم أخلاقية نظرية وعملية.
من ذلك المنطلق يمكن التحدث عن ثلاث مراحل للمعرفة العلمية انعكست بشكل
مباشر تأثراً وتأثيراً بنظرة الإنسان للعالم : المرحلة الأولى هي مرحلة
المعرفة الحسية والخبرة الذاتية، هذه المرحلة لا تزال قائمة بيننا حينما
يعجز الإنسان عن تفسير مواقف أو مواجهتها، وتنطبق تلك المرحلة على ما يمكن
أن نسميه طفولة العلم، حينما كان الإنسان يحاول أن يجد حلاً دون أن يستطيع
التحرك بطريقة منظمة، وبهذا نقول أن المحاولة والخطأ يعتبران أول مراحل
التطور في العلم. والمرحلة الثانية : هي الاعتماد على مصادر الثقة
والتقاليد السائدة، كالاعتماد على الحكماء القدامى في تفسير وتعليل بعض
الظواهر، كاعتماد العلم الغربي على تعاليم أفلاطون وأرسطو، وهو أمر لا يزال
سائداً حتى الآن أيضاً، حيث نعتمد على تجارب أسلافنا في التعميم، وحيث
الاعتماد على الخبرات أكثر من الاعتماد على التقصي و التحقيق. والمرحلة
الثالثة : هي التأمل والحوار، وهي مرحلة التدليل العقلي والمنطقي عن طريق
إتباع طرائق الاستنتاج والاستدلال. وهذه الطريقة قد تخدع الباحث أحياناً
حيث يشغل عقله بالحوار الماهر، أكثر من انشغاله في البحث عن الحقيقة ذاتها،
وقد يصل به ذلك إلى الجدل العلمي لا التطور الجدلي للعلم. والمرحلة
الرابعة : هي مرحلة المعرفة العلمية والتحقيق العلمي، أي وضع الفروض وإجراء
التجارب ثم استخلاص النتائج، وهي مرحلة أكثر دقة حيث يتحول الوصف إلى كمّ،
الذي قد يوقع أحياناً في فخ الجمود التجريبي الجامد البعيد تماماً عن
الروح الشجاعة والخيالية التي تطبع النظريات المبدعة. والأمر الهام في تلك
المرحلة هو التأكيد على أهمية المنهج التجريبي في العلم.
والنهج التجريبي هو احد مساعي الفكر الإنساني وغايته إعادة تكوين الواقع
في الدماغ، فإذا لم يفكر الإنسان لا يمكنه أن يدرك الواقع، وإذا لم يستمر
الإنسان الذي أدرك في التفكير، فإن الواقع المُدرك سيبقى عقيماً، فالفكر
إذاً حاضر في كل مراحل المسعى العلمي. وفي البحث العلمي يجب الانفتاح، يجب
أن نعرف أن جمال العلم ليس فقط في أن تصيب كل تصوراتنا، بل في أن تخطئ
أيضاً، الخطأ يولد انفعالاً جمالياً، من خلاله يمكننا أن نتطلع إلى عوالم
وأفكار جديدة لم نكن نتوقعها، ولم تكن في قاموس معارفنا وتصوراتنا أبداً.
إن الملاحظة تساعدنا في اتخاذ موقف معارض لفرض مقبول، وهذه الملاحظة تحتاج
إلى إصرار أطول وصراع أشق، أكثر من المعطيات الملاحظة التي تتفق مع
التوقعات، وتوقعاتنا تؤلف ما نشاهده لكنها لا تستبعد تماماً الرؤية غير
المتوقعة.
والبحث في نشأة العلم الحديث يحتم على المرء تقصي الأسباب والظروف التي
جعلت الناس يستبدلون نظرتهم التقليدية إلى الإنسان والكون بنظرة مخالفة
أخرى، فقد ظل الناس لفترة طويلة حبيسي تصور تقليدي اتخذ طابعا نفسيا
مطمئنا، فهم يظنون أن في أحداث الكون رتابة بفضل ما أودعه الله في الطبيعة
من ثبات، ولكن نظرة جديدة وجدت طريقها بعد ذلك إلى أذهان الناس وتصوراتهم،
إذ شاعت بينهم فكرة اللامركزية في الكون الواسع الذي لا تحده حدود، فصارت
نظرة الناس إلى العالم ديناميكية لا استاتيكية. تماماً مثل نظرتنا نحن
اليوم إلى طبيعة الأحداث في عالم يتطور على مر الزمن. فالقيم الجديدة التي
حملتها معها الثورة العلمية المعاصرة هي قيم ذات معاني نفسية إلى جانب
كونها قيماً معرفية، وإذا وضعنا مشكلة الجدة العلمية على الصعيد النفسي
الخالص، لن يفوتنا أن نرى أن هذا السير الثوري للعلم المعاصر لا بد وأن
يؤثر على بنية الفكر، فالفكر بنية قابلة للتغيير منذ اللحظة التي يكون
للمعرفة فيها تاريخ. وبذلك نجد أن بنيتنا العقلية تنتج المعارف ولكنها تخضع
بدورها لتأثير تطور هذه المعارف، فتعرف هي ذاتها تطوراً. فالعقل لا ينتج
العلم وحسب، ولكنها يتعلم منه أيضاً.
الخيال ودوره في البحث العلمي:الخيال والأصالة عنصران لا غنى عنهما للفكر المبدع، والحقيقة كما يقول
"موداوار" لا تكمن مستقرة في الطبيعة بانتظار الإعلان عن نفسها، بحيث لا
يمكننا أن نعرف مقدماً ما هي الملاحظات الملائمة، وما هي غير الملائمة. فكل
اكتشاف وكل توسع في الفهم، يبدأ كتصور خيالي قبلي لما قد تكون عليه
الحقيقة، وينشأ هذا الفرض الخيالي نتيجة عملية يسهل أو يصعب فهمها، كأي عمل
خلاق من أعمال العقل، فهو موجة عقلية، أو تخمين ملهم، أو نتيجة للمحة
نافذة متوهجة من لمحات البصيرة، وهو يصدر على أية حال من داخل النفس، يضاف
إلى ذلك المثابرة. حيث تميل ومضة الحدس الإبداعي، إلى أن تبزغ في أوقات
الاسترخاء، أثناء الاستحمام أو الحلم أو حين السير في نزهة على الأقدام أو
حين يرنو البصر إلى النجوم عبر النافذة، إنها تفلت من سيطرة مقولات العقل
الصارمة التي تنحو نحو الإنجاز، كما تتخلص من آثار الصدمة والقلق والإجهاد
يثبط هذه العملية، إن العقل الحدسي المستكشف المتخفف المسترخي، يختنق في
أجواء التوتر والقلق التي تخلقها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالعلم
التقني، حيث تسود أجواء العلم التنافسية، القائمة على كم الإنجاز، لا كيف
الإبداع. ولا توجد نظرة عقلية خالصة للعالم لا يلعب فيها الخيال دوراً، بل
إن الاكتشافات العلمية تعتمد – إلى درجة كبيرة – على الخيال، ولو لم يكن
لدى أينشتاين القدرة على تخيل الصورة التي يبدو فيها العالم للمراقب
المسافر بسرعة تقارب سرعة الضوء لما صاغ النظرية النسبية. لقد حلم
الفيزيائي بور بالنظام الشمسي كنموذج للذرات، بما أدى إلى نموذج بور لبنية
الذرة، وفي بواكير القرن العشرين، نال مراهق غير متعلم من أسرة فقيرة في
الهند، كتاباً مدرسياً قديماً في الرياضيات حيث يقول رامانوجان :أنه بعد
قراءة هذا الكتاب سرعان ما ظهرت الربة ناما جيري، في أحلامه بالصيغ و
المعادلات، و من هذه الأحلام شيد بنياناً مهيباً من المعارف الرياضية مكنه
من الحصول على منحة دراسية في كامبردج. و بعد دورة مكثفة من العمل و
التركيز، تمثل لمندلييف في أحد الأحلام الجدول الدوري للعناصر الكيميائية،
حيث يقول " رأيت في الحلم جدولاً تحتل فيه كل العناصر مواقعها بالشكل
المطلوب، و فور أن استيقظت سجلت هذا على الورقة، و بعد هذا لم يظهر إلا
تصويب واحد ضروري في أحد الأماكن. دون أن ننسى أن اكتشافات أينشتاين
العظيمة الأولى كانت حدسية الطابع، حيث لم يكن قد أصبح أكاديمياً بعد.
فالعلماء الكبار، أمثال أينشتاين و فاينمان، و بوم، لا يقومون بتقسيم
تصوراتهم إلى مقولات شخصية، و أخرى علمية، لا يستبعدون عن مضامين مشاغلهم
ما هو فلسفي، و ما هو سؤال ميتافيزيقي، بل على العكس من ذلك، يترك
عملهم تأثيراته في رؤيتهم الشخصية للعالم، يدركون الثقل الكبير لارتقائهم
السيكولوجي و حياتهم الجوانية، على عملهم. و من المعروف أن الفيزيائي
المعروف باولي كان يلتقي مرات كثيرة مع العالم النفسي الشهير يونغ، من اجل
تبادل خصيب للأفكار حول العلاقات بين الفيزياء النظرية، و علم النفس.
والنهج العلمي هو فن التنقيب عن الأحلام التي هي مواصفات قيمة للواقع من
بين مليارات الأحلام التي ينشئها الدماغ البشري، و التوفيق بين الفكرة و
الملاحظة، لا يمكن الحصول عليه إلا إذا كانت هناك فكرة مسبقة، أي إذا كان
الدماغ ناشطاً حول موضوعات مدروسة. و الفكر البشري يميل ميلاً طبيعياً
إلى الحلم عندما يجهل، و قد وجدنا رجالاً يرسمون حركة الكواكب قبل أن
يلاحظوها، و يؤكدون وجود الفلوجستون قبل دراسة الاحتراق، و يقيمون نظرية
الأسعار بتعليل عدد من مجموعات الإحصائيات، في الوقت الذي يتطلب ذلك
الألوف منها.
و البحث العلمي يوجد لوجود مشكلة، أو وجود وضع إشكالي، و إنه يوجد في
البداية وضع غير محدد، تكون فيه الأفكار غامضة، و الأمور مشكوك فيها، و
المفكر حائراً، و المشكلة لا يمكن حلها إلا بعد أن يستشعر المفكر هذه
الحيرة، و يطرح التساؤلات، و يضع من خلالها الفرضيات. لذلك قد يكون
للخيال الدور الأول في الإبداع العلمي، كما في الإبداع الفني ( الدور
الهام للخيال نجد في أعمال أينشتاين، هايزنبرغ، واطسون، كريك، و الكثير
غيرهم ) و لكن لا يوجد في العلم سوى جواب واحد، يجب أن يكون صحيحاً. و
السؤال هو العنصر الجوهري في تطور المعرفة، و هو نتاج الفكر الطبيعي و
التلقائي، إذ لا تستطيع القوانين جميعها، و لا المراقبات، و لا حتى
أنصار الواقعية التطبيقية، أن يبتروه، فالأسئلة التي لا أجوبة لها، و
الاضطرابات التي تنشئها، جزء من الوضع البشري، بل لا ريب أنها خاصة مميزة
للحياة تتغلب فيها الحاجة إلى المعرفة على الإعلام.
عقبات البحث العلمي من المنظور النفسي:السؤال الآن : لماذا كانت الثورة العلمية ذات أبعاد ليست فقط موضوعية،
بل ذاتية و فلسفية ؟ السبب في ذلك هو عملت على إعادة تفكيرنا و تصورنا
للعالم و كيفية فهمه )، و لكن ما حدث بعد ذلك هو أن العلم اعتمد على
الملاحظة و القياس و التفكير المنطقي، و رفض الشعور و الحدس ( و هما
جانبان معرفيان أيضاً )، و المهمة الآن، هي أن نستحضرهما في علاقة مع
الوعي الإنساني، و ليس يعني ذلك هجران العلم و التكنولوجيا، بل بالأحرى
الدخول في علاقة جديدة مع عناصر جرى كبتها سابقاً. و هنا بالذات يمكننا
التحدث عن العقبات – ذات الطابع النفسي – التي قد تعيق الحركة العلمية و
البحث العلمي ، فعندما نبحث عن الشروط النفسية لتقدم العلم، سرعان ما
نتوصل إلى اقتناع أنه ينبغي طي مسألة المعرفة العلمية بعبارات العقبات، و
المطلوب ليس اعتبار عقبات خارجية، مثل تركيب الظواهر و زوالها، و لا
إدانة ضعف الحواس و العقل البشري، ففي صميم المعرفة بالذات تظهر التباطؤات
و الاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية.
و في البداية نقول : أن كل معرفة موضوعية مباشرة، لا بد أن تكون كيفية (
دون أن تكون مغلوطة بالضرورة ) و نعني بها، شحن الموضوع بانطباعات ذاتية
حتماً، فالمعرفة المباشرة ذاتية في أساسها، و هي إذ تتخذ الواقع خبراً
لها، إنما تقدم يقينيات مسبقة تعوق المعرفة الموضوعية أكثر مما تخدمها، و
كذلك فإننا قد ننخدع فيما لو فكرنا أن معرفة كمية تنجو مبدئياً من مخاطر
المعرفة الكيفية، فالكم ليس موضوعياً بشكل آلي، إن مفاهيم موضوعية جداً
في الظاهر، مصورة بشكل واضح جداً، ملتزمة بكل جلاء في هندسة دقيقة،
كالفيزياء الديكارتية، تفتقر افتقاراً غريباً إلى مذهب القياس، و لدى
قراءة المبادئ، يمكن القول أن الكم هو امتداد للكيف. و نفسانياً، لا
توجد حقيقة دون خطأ مصحح. لذلك يرى بوبر أنه في العلم الموضوعي يوجد
استقلال تام عن الشعور الفردي، فعملية اختيار النظريات العلمية، لا تتضمن
أو تعتمد على الاعتقادات الذاتية لأي فرد، فما دام الاختيار سيقوم به فرد
ما، فإنه يمكن تكراره مرات و مرات بواسطة أي فرد آخر في أي زمان و مكان،
وكما يتطلب ضرورة موضوعية النظرية، كذلك فإنه لا بد و أن تكون قضايا
الملاحظة الشخصية – التي تختبر النظرية – موضوعية أيضاً، أي لا ترد إلى
محتوى الشعور لأي فرد.
هذا الجدل بين الذاتي و الموضوعي قد يلعب دوراً لا يمكن إنكاره، في
نشأة العقبات العلمية التي تقف في طريق التقدم العلمي و الاكتشاف، فأي
باحث علمي يجب أن يدرك أن هناك نفور طبيعي – غريزي النزعة – لديه، من تغير
النماذج الأولى، و هو نفور، أو ميل إلى الشك، يعد جزءً لا يتجزأ من
العملية العلمية، و قد لفت هيلجان النظر إلى حقيقة مؤداها، أن نزعة الشك
يمكن، بل و كثيراً ما يحدث، أن تنتهي إلى رفض تسلطي، و دفن للحقائق و
الأفكار المزعجة -دعنا نقول المقلقة -.
لذلك فإن تشبعنا الدائم، بما يسمى بالأفكار المسبقة، تعتبر من أهم
العوائق النفسية الطابع، القائمة أمام الباحث العلمي، و ما أكثر ما
تعوزنا الشجاعة الكافية، إذ نميل إلى إقامة كافة أنواع العراقيل، و
الانحرافات المنطقية، مثل الطعن في كفاءة الباحث، أو حتى في صدق معلن
للنتائج، و شتى أشكال الدفاع الخاص لحماية الواقع القائم. رافضين
الإقرار، أن الفكر ينتخب الحقائق من العالم المحسوس، و الدماغ البشري إن
لم يكن عاجزا ً، فهو على الأقل قليل القدرة، أو قادر بصعوبة على إدراك
حقائق العالم الخارجي عندما لا تكون هذه الحقائق منسجمة مع مضمونه المسبق،
و يمكننا أن نتمثل طبيعة الضلالات التي تنجم عن الملاحظة المبتذلة للطبيعة
و تنوعها إذا ما أصغينا إلى الناس، و هم يتكلمون عن تأثير القمر في
الزمن، و تأثير الكواكب في حياة الناس، أو الأرقام بالحظ. من هنا نجد أن
للاعتقاد المسبق أثر بعيد، في إنكار الحقائق التي قد تظهرها مستجدات
جديدة حسية، ناتجة عن الملاحظة المباشرة، أو حتى عن طريق أداة تكنولوجية
جديدة، و نحن نعرف كيف خاب ظن غاليليو بالناس بعد أن فشل بإقناع قامة
الفكر الفلسفي و الديني في عصره بوجهة نظره من خلال اختراعه التلسكوب،
فبعض الرجال الذين شاع صيتهم بين الناس، رفضوا أن ينظروا من خلال
التلسكوب، بينما أقدم البعض الآخر على النظر من خلال هذه الأداة
التكنولوجية العجيبة، و لكنهم ادعوا أنهم لا يرون شيئاً جديداً، من شأنه
أن يغير نظرتهم إلى الأمور، و ادعى آخرون بأنهم رفضوا النظر من خلال
التلسكوب، لأن كل ذلك لن يؤدي بهم إلى نتائج جديدة ذات قيمة فلسفية كبيرة،
و قد ذهب بعض الرافضين للنظرية الجديدة، إلى أنه من غير المعقول ألا يكون
عند القدماء أداة كهذه !، و بموجب هذا الرأي الدوغمائي و المستقر في
الفكر، فإن غاليليو لم يكتشف سراً جديداً، بل لا جديد في العلم على مر
الزمان، طالما كان الجديد و القديم كلاهما قائمين في كتب أرسطو.
هذا التصور المستقر، في ذلك العصر و كل عصر، لا يمكن أن يطور فكر
علمي، حيث لا بد من النزوع نحو الانفتاح الذي يفضي بالعلماء إلى الاكتشاف،
و من دون أفكار متصورة قبلاً، يجد العلماء غربة في الطبيعة ما كانوا
ليستطيعوا توقعها في أكثر شطحات خيالهم طموحاً، حقائق جديدة مطوية، أمام
أولئك الذي يبصرون بعيونهم، و لسوء الحظ، كثيراً ما تنسحب بعض الملاحظات و
الأفكار الغريبة إلى هوامش العلم على مدى عقود أو قرون، لأنها لا تتفق مع
المعتقدات السائدة، على سبيل المثال : الفلكيون في الغرب عجزوا بمعنى
الكلمة عن رؤية التغيير في السماء، لأنهم اعتقدوا أن السماء غير قابلة
للتغيير، و لم يسجل واحداً منهم ظهور نجوم جديدة حتى فتح كوبرنيكوس عقول
الناس، على إمكانية التغير في السماوات، لم يكن مجرد اختراع غاليليو
للمقراب هو الذي أتاح للفلكيين رؤية المزيد، و في تاريخ أسبق كثيراًَ سجل
الصينيون، الذين لا تمنع معتقداتهم الكوزمولوجية التغيير في السماء،
تغيرات في السموات، من قبيل كلف الشمس، و ظهور نجوم جديدة. لذلك نقول :
أن العقبة الأولى أمام العقل العلمي، هي عقبة الاختبار الأول، الاختبار
الموضوع قبل النقد، و فوق النقد، و الذي يعتبر بالضرورة عنصراً من عناصر
الفكر العلمي، و بما أن النقد لم يفعل فعله صراحة، فلا يمكن للاختبار
الأول، في أي حال من الأحوال، أن يكون سنداً موثوقاً.
لذلك نفرق بين المعرفة العامة، و المعرفة العلمية، إذ أن الأولى تجعل
المسافة قصيرة بين الواقع و الفكر – تعمم من التجربة، أو الخبرة الأولى –
أما المعرفة العلمية فإنها تفصل بينهما بالرجوع المستمر إلى التركيب
العقلي، أي بالمحاولة المستمرة لإضفاء العقلانية على التجربة. و على
الرغم من أننا نعرف أنه من أهم شروط البحث العلمي النزاهة، بمعنى إقصاء
الذات و تجرد الباحث عن الأهواء و الميول و الرغبات، و إبعاد المصالح
الشخصية، و هذا يتضمن الموضوعية، أي الحرص على معرفة الوقائع كما هي، لا
كما يتمناها الباحث. فإن الإنسان ينطلق بصفة طبيعية، حين يريد ملاحظة
الظواهر الأكثر إثارة للاهتمام و الدهشة، بكل غرائزه و أهوائه، و بكل
ذاته. ليستنتج على أساسها. لذلك لا ينبغي أن نندهش لأن تكون المعرفة
الأولى خطأ أولاً، و المثال البسيط عن التجربة الأولى كعائق نجده حين ننظر
لأول وهلة إلى جسم متحرك في الماء و قد توقف عن الحركة، يخطر ببالنا أن
الجسم هو الذي يقاول الماء، و هذا خطأ تقابله حقيقة تأتي نتيجة لعقلنة
التجربة الأولى، و هدم المعرفة الناتجة عنها، حيث الماء هو الذي يقاول
الجسم، فالمعرفة العلمية تأتي من هدم المعرفة التي تكون نتيجة تجربة أولى،
لا استمراراً لها.
و لعل من أحد أسباب هذا العائق، هو هاجس التخصص، حيث نجد في العلم
العادي، كما في الحياة العادية، ننهمك في حل المشكلات و الإضافة إلى
حصيلتنا المعرفية، و إذ ينقح العلماء نظرياتهم و مفاهيمهم، فإنهم يشذبون
معداتهم و يطورون مفرداتهم التخصصية و مهاراتهم، و تبعاً لهذا، يغرق
العلماء في الإطار النظري للعمل و يقاومون التغيير، إن التخصص المتزايد،
يؤدي إلى تقييد رؤية العلماء، و يزيد التزمت أكثر و أكثر، إلا أن شذوذاً
ما يظهر فجأة، مثلما لفت جانب مكبوت من الشخصية الانتباه فجأة، و عن هذا
الشذوذ تنشأ أزمة في مضمار البحث، و تؤدي إلى تقويض النظريات القديمة، و
الإبداعية تكمن في جوف الظلام الذي منه تشرق إمكانية بلا حدود.
و يمكننا التحدث مع ضيق المجال عن عائق نفسي آخر، هو التعميم، إذ هناك
على ما يبدو، جانباً ثابتاً في التكوين النفسي لكل الناس، و في كل
الأزمان، يتمثل في النظرة إلى أسباب الأشياء، على أنها أعمق، و أهم
فكرياً و أدبياً و علياً، من الأشياء التي نتجت عن هذه الأسباب، و في كل
مرة توضع فيها فرضية ما، إما عن طريق الاستنتاج من نظرية مقبولة إلى
بديهية، أو عن طريق التعميم الاستقرائي، و تختبر بمقارنتها بالواقع،
يتأكد اعتقادنا في فلسفة بارمنيدس القائلة : أن ظواهر الكون هي في الحقيقة
مظاهر سريعة الزوال لحقائق كونية ثابتة. و لا نعرف إن كان هذا الثبات يمثل
حقيقة ما هو كائن، أم ما نريده أن يكون. و عندما نتحدث عن التعميم هنا
لا نقصد صيغته المنطقية، بل صورته المعبرة عن النزعة المكبوتة للارتياح و
الاطمئنان بأي ثمن، فالتعميم قد يكون استجابة لمتعة عقلية، فيكون متسرعاً
و سهلاً و يعوق بلوغ حقيقة الظواهر، و التعميم السهل الذي ينطلق من تجارب
أولى، يعوق فهم الوقائع في غناها من حيث أنه لا يأخذ بعين الاعتبار كل
التعقد الماثل في الظواهر التي يريد تفسيرها، و على سبيل المثال كان
العلماء في القرون السابقة يميلون إلى تفسير أكبر عدد ممكن من الظواهر،
بالعودة إلى القوانين الخاصة بالتيار الكهربائي، فالقوانين الخاصة بهذا
الميدان، تعمم التفسير لظواهر تخضع لميادين أخرى، كالمرض و الصحة و السحر
و الكيمياء و الحياة، و ذلك بفعل السعي إلى التوحيد غير المبرر، و إعطاء
قوانين أكثر عمومية، لا بفعل الواقع الموضوعي لهذه الظواهر. و الواقع
أنه لم يؤثر شيء على عجلات تقدم المعرفة العلمية، أكثر من عقيدة التعميم
الباطلة التي سادت منذ أرسطو حتى بيكون، و التي لا تزال بنظر كثير من
العقول، عقيدة أساسية في المعرفة، حيث ثمة متعة فكرية خطيرة من التعميم
السريع و البسيط.
إن العلم، في واقع الأمر، هو تركيبة فكرية، و ليس مجموعة من العبارات
المنفصلة ينطق بها رجل يحاول أن يثبت دعواه، من خلال طرح تصورات يظن أنها
تؤيد وجهة نظر ما، و بزوغ فجر العلم الجديد، و تطور مسيرته، كان ممكناً
في عصر النهضة، و بالذات مع الثورة العلمية من القرن السابع عشر، بفضل
تأكيد الإنسان على حقه في تشكيل عالم الفكر و المادة بفعل قواه الذاتية
الكامنة فيه. إنه تصور جديد أعاد الثقة بالإنسان كقدرة، على فهم العالم
بجهوده الذاتية. و من تعريفات العلم أنه مجموعة من المعارف الإنسانية التي
من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية الإنسان، أو تساعده في صراعه في
تنازع البقاء ( هناك قول مأثور مفاده أن المعرفة قوة )
البحث العلمي و دافع الإنجاز:كل بحث علمي أصيل لا بد أن يرافقه دافع عميق للانجاز، و نحن نجد أنه في
الأعم الأغلب، يلقى الهواة في العلم استخفافاً بوصفهم عديمي المهارة و
الكفاءة، و لكن بعض الناس قد يفضلون استئجار هاوٍ لأداء وظيفة، لأن
الهواة يمارسون العمل بدافع من الحب، و لن يلفقوا فيه. و قد تبين أن ما
يزيد على نصف الحائزين على جائزة نوبل في العلم، قد تعلموا على أيدي من
سبق لهم الحصول على هذه الجائزة، حيث توحي تلك الحقائق أن وجود من يُقتدى
بهم من المبدعين قد يكون أمراً جوهرياً بالنسبة لتطور العبقرية العلمية و
إنجاز البحث العلمي، و هذا التأثير عبر الأجيال، قد لا يتطلب دائماً
الاتصال الشخصي المباشر بين الأساتذة و المعجبين الصغار، فالنشأة أو
التربية في الأزمنة الحيوية، من الناحية العقلية، و التقنية، قد تُفضي
بذاتها إلى التطور على المنهج الإبداعي، فالإعجاب قوة دافعة شديدة في
التطور الشخصي.
لذلك فإنه بالإضافة لمستوى الذكاء العالي الذي يجب أن يتسم به صاحب
الانجاز العلمي، لا بد من توافر عدة مميزات من أهمها الحاجة إلى الإنجاز،
و قد وجد أن حوالي 90 % من المشاهير ظهرت لديهم منذ البداية حاجة قوية
لتحقيق التفوق. و إذا ما تفحصنا الدراسات التي أجريت على الشخص المبتكر
نجد أن صورة هذا الشخص، تمثل الانطواء و التوجه الذاتي، و الاندفاعية،
الاستقلال الذاتي، الحاجة القوية للسيادة، ، و السيطرة و الاستقلال، و
من الملاحظ وجود مطابقات عديدة بين هذه الصورة، و الصورة المرسومة للشخصية
النرجسية. هذا الدافع العميق في الباحث للإنجاز قد توقعه في عائق آخر هو
الفصل بين البحث العلمي، و نتاجه من الناحية الأخلاقية، ففي أنماط البحث
العلمي، يجب أن نميز حالتين، داخليتين، قد يعملان في نفس الباحث، الأول
يقوم على أساس ميول معرفية بحتة، أساسها العلم من اجل العلم، دون أي
تقييم أخلاقي قيمي لنتائج أي بحث، حيث يكون الباحث هنا بارد على نحو ما، و
هناك بالمقابل الجانب الشعوري القيمي، الذي ينطلق من مبدأ الضمير
الأخلاقي " أو الأنا الأعلى إن شئت " القائم على الاستبصار المعرفي، و
التنبؤ في مستقبل المكتشفات العلمية، لا سيما الأكثر خطورة، في مجال
التسليح أو البيولوجيا. و تعطينا وظيفة التفكير المقدمة القائلة أن كل بحث
علمي يستحق بحد ذاته الاضطلاع به، و من ناحية أخرى تتساءل وظيفة الشعور عن
أولوية المشروع العلمي و عواقب المعرفة، مثل التساؤل عن مستقبل ثورة
الجينوم البشري، و نتائجه على الإنسان. و في ميدان الفيزياء، نتذكر أن
الفيزيائيين في مشروع مانهاتن، كانوا غارقين في حل مشكلة الانشطار النووي،
لدرجة أن أغلبهم أصبحوا فاقدين استبصار المأساة البشرية الآتية من جراء
قنبلتهم، و النمط الشعوري يستطيع ربما، أن يهدي العلماء إلى رفض إجراء
بحث يشعرون أنه خطأ، أو أنه يسيء المجتمع استغلاله، و نحن حتى الآن
نتساءل، عن سبب فشل مشروع القنبلة الذرية النازي، الذي لم تكن تنقصه
الكفاءة و لا الإمكانية، هل هناك خطأ رقمي، أم رغبة لا شعورية لدى
هايزنبرغ بفشل هكذا مشروع ؟
و مع ذلك لا يوجد عائق مهما كان، يمكن أن يقف في طريق المتعة التي
يحققها اكتشاف سر جديد في الطبيعة، يحاكي الرغبة بمعرفة جوهر الإنساني
النفسي كذات مفكرة، إذ يقول بيرس " في الحقيقة، كل إبداع فكري و علمي
يكون بداية أكثر شاعرية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ذلك أنه في إطار التكافؤ
بين الأشكال المحسوسة و الروحية، تزول في الأصل نفس الوظيفة في حالتي
العمل الخاصتين بالعالم والشاعر، إلا أن ما ننوي تكريمه هنا، هو الفكرة
المجردة، فكرة العالم أو الشاعر كذلك "
وقد اكتشف السيميائي قديماً، أن ثمة علاقة تبادلية بين ظرفه النفسي
الجواني، و العالم الخارجي، و قد وصف يونغ هذا : أنه ظاهرة الإسقاط، حيث
نسقط مكنونات لاوعينا على المواقف و الأشياء الخارجية، العالم بهذه
الطريقة شاشة عرض، يمكن أن نرى العملية الجوانية لكينوناتنا معروضة عليها،
إننا نشاهد تحولاتنا تحدث في هذا المختبر السيميائي، و اكتشف يونغ أن
العمليات النفسية لمرضاه تتفق مع المبادئ الأساسية، و البينات، و الرموز،
التي كتب عنها السيميائيون القدامى. و يمكننا بشيء من الرومانسية أن
نشبه الاكتشاف بالوقوع في الحب، و الوصول إلى قمة جبل بعد تسلق شاق، إنه
نشوة ليس مبعثها المسكرات، و إنما الكشف عن جانب من جوانب الطبيعة لم يسبق
لأحد قط أن رآه، و الذي يتبين في أكثر الأحيان أنه أكثر رهافة و إثارة و
روعة مما يمكن لإنسان أن يتخيله، هذا الشعور لا يخالج العالم الحقيقي من
اكتشافاته وحدها، بل من اكتشافات زملائه أيضاً.
نتيجة:لقد تعلمنا مراراً أن السعادة و تحقيق الذات، يكمنان في العلاقات
الشخصية المتبادلة وحسب، ولكن التناسل والحياة الأسرية ليستا هما الغايتين
الوحيدتين للإنسان، ولو لم يكن الإنسان كائناً مهتماً اهتماماً شديداً
بإضفاء معنى ونظام على الكون، لما قُدّر لأعظم منجزاته العقلية أن تظهر
للوجود. إن الإنسان لم يخلق للحب وحده. و نحن ندين بدين هائل لأولئك
العباقرة الذين طغت حاجاتهم إلى إيجاد معنى لعالم بدا لهم غير متسق، على
حاجاتهم إلى تكوين علاقات إنسانية. و الواقع أن الغالبية العظمى من البشر
مشغولون إلى حد ما، بأن يكون لحياتهم معنى و نظام، كما أنهم مشغولون
بالعلاقات الشخصية مع غيرهم من الناس، و لكن أسمى ما تم الوصول إليه من
مستويات الفكر التجريدي، إنما تحقق على يد رجال كان لديهم الوقت و الفرصة
للانفراد بأنفسهم لفترات طويلة، كما كان اهتمامهم بالعلاقات الشخصية أقل
بكثير من اهتمام معظمنا بها، لقد كان معظم الباحثين الكبار منعزلين إلى حد
ما. هل يعني ذلك أن نبتعد عن الناس كي ننجز، ليس هذا بالضبط هو المراد،
ما نقوله هو أن ننجز، يعني أن نجعل العالم بكليته مندمجاً بخيالنا،
فنتحد بالموضوع المدروس، و إن نسينا قليلاً جزئيات حياتنا الاجتماعية.