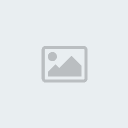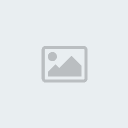
“إن كتابة رواية هي مثل لصق قوالب الطوب أما كتابة قصة فتشبه صب الخرسانة.”. مقولة ينسبها ماركيز لنفسه بحذر شديد خوفاً من أن يكون قد سبقه إليها أحد، ويشير فيها إلى جنسين أدبيين مختلفين. وفي تشبيه آخر يقول: “القصة هي سهم في قلب الهدف أما الرواية فهي كصيد الأرانب.”. تشبيه ماركيز للرواية بشكل عام يمكن أن ينطبق على الرواية التي بين أيدينا والتي يمكن أن أصوغ لها تشبيها خاصاً أستعيره من فن النحت والفن التشكيلي.
كل روائي بمثابة نحات أو فنان تشكيلي. ومثل نحات خبير، يُعمل أشرف الخمايسي إزميله في صخرة السرد فتلين له، لتتبدى شيئاً فشيئاً ملامح الشخصيات والأحداث في تماثيل مرمرية بديعة. أو كلوحة تتقافز عليها فرشاة فنان عظيم، كفراشة تتنقل بين الأزهار، لتظهر في الأخير تحفة فنية مدهشة. بصبر نحات يرى أعجوبة في كتلة من الصخر، وبثقة فنان يرى تحفة على قماش أبيض، بالنحت والرسم، بالإزميل والفرشاة، يصوغ لنا الخمايسي، روايته الثانية، وربما تحفته الأولى: “منافي الرب” (1). وببراعة النحات والفنان يشكل لنا ثلاث شخصيات، أحدها أيقونية هي شخصية “حجيزي” بالإضافة إلى “سعدون” و “غنيمة”، تتناوب سرد أحداث هي مزيج بين الواقع والخيال، يتداخل فيها الحلم والأسطورة والتاريخ.
إذا كان “الشاعر يولد ولا يصنع” كما يقول المثل، وإذا كان الشاعر نبي، فالسارد إله علاَّم بالمحجوب وبكل ما يخفى عن الشخصية التي تمارس التعجيب نفسه بتعبير فلوبير. فكرة أن الروائي إله أو خالق، تصدق أكثر ما تكون على الخمايسي، وعلى خلقه الثاني، “منافي الرب”، على وجه التحديد. وهي فكرة تنسجم مع دعوة الرواية إلى الإنسان الإله، الجدير بخلافة الله في الأرض، أو “الإنسان الأعلى” بتعبير نيتشه، تلك الفكرة المبثوثة في ثنايا الرواية، في كثير من العبارات:
“الله جعلك خليفته في هذا العالم، فلتكن الله في الأرض” (ص 325). “ما خلقت الإنسان ليكون عبداً دنيئاً، يأخذ من غير عطاء، وإنما خلقته خليفة لي، رباُ على هذه الأرض، كما أنا أعطي هو يعطي أيضاً، وكلما أعطى بالرضا، صار ربا أقوى.” (ص 310). الله “لا يحب للإنسان أن يكون مجرد عبد، وإنما خليفة رباني، لا يأخذ فقط مثل عبد، وإنما يعطي كإله. أن يعطي من أعظم ما يملكه، من حياته، يعطي أوقاتا للألم والعذاب، ويتجمل بالصبر، صبر يليق بخليفة رباني” (ص 343). “المجد للإنسان الذي يعرف قيمة نفسه، رب هذه الأرض، والعزة لله، الذي خلقه ليكون خليفة، وأول ما علمه، علمه سر أسماء مفاتيح الربوبية. أنا الذي قلت للإنسان أعظم كلمة: اقرأ، وأيقظ العقل، لتعرف كم أنت عظيم” (ص 366).
القدرة على مزج الواقع بالخيال واليقظة بالحلم هي مهمة الفنان وفيها تتجلى أصالته. وبهذا المزج تختفي الملامح فلا تعود قادراً على التفريق بينهما. في “منافي الرب” يستهل أشرف الخمايسي روايته بـ“حجيزي” وهو غير قادر على التفريق بين الليل والنهار بين الحلم واليقظة. الذريعة، في بداية الحلم، هي الضباب، لكن لهذا التداخل وظيفة فنية هي القول بتداخل الزمن أو لا أهميته، بالرغم من أن ملامح الزمن تتبين مع الاستمرار في رحلة القراءة، والذي يتراوح بين زمنين ماضٍ وحاضر. ماضٍ خاص، يستعيد فيه الثلاثة حيواتهم، وماضٍ عام يخصنا جميعاً تُستعاد فيه ومضات من تاريخنا في اشتباكه بتاريخ الآخر: الإنجليزي والعثماني والمملوكي والفارسي. استعادة أو استدعاء الرواية للتاريخ ليس زينة لغوية أو تطريزاً سردياً، وإنما لعلاقته الشاكلة والمشكلة للحاضر الذي لا يمكن حسم مساره دون الرجوع للوراء.
هذه البداية الضبابية التي تصيب “حجيزي”، يشاركه فيها القارئ، عندما تتداخل الأحلام فلا يعود يفرق بين حلم “حجيزي” ويقظته فيحتار معه، أهو في حلمه الأخير أم أنه يلج حلماً آخر، أم أنه قد انتهى منها جميعاً وهو الآن في عالم اليقظة! تكمن مهارة السرد في أخذ القارئ إلى تلك المنطقة الضبابية بين الصحو والحلم، الرمادية بين الأبيض والأسود، البرزحية بين الحلم والواقع. ومع أن الزمن يتضح لاحقاً بالقول أن هذا الزمن الضبابي ما هو إلا الفجر، الخط الفاصل بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، يظل التداخل قائماً على مستوى الحدث، بين اليقين والشك، في تخييل روائي يختلط فيه الأحياء مع الأموات وتتداخل فيه الأصوات، والتاريخ بالدين، والماضي بالحاضر.
يمكن تقسيم زمن الحكاية إلى ماضٍ وحاضر، لكن زمن السرد لا يلتزم بهذا الترتيب. ويمكن النظر إلى زمن “حجيزي” على أنه هو الزمن الحاضر بأحداثه الومضية المتنوعة، في حين يتكئ هذا الزمن على استرجاع ذكريات وامضة من الزمن الماضي: ذكريات أو حكايات “غنيمة” عن العثمانيين والمماليك والإنجليز الذين تعاقبوا على حكم مصر. عن رحلته في الصحراء والحوادث العجيبة التي يلاقيها، جيش الفرس الذي ينبلج من بين الرمال و “جالة” الجميلة الفارسية، ظهورها واختفاءها المفاجئ وقت العاصفة الرملية، ورؤيته لله وحواره معه، إلى غيرها من الحكايات التي لا يصدقها صديقه “حجيزي” كلما سردها. الشك في مصداقية حكايات “غنيمة” ينتاب القارئ أيضاً في خاتمة الرواية عندما يكتشف أن المسجد الذي بناه العثمانيين لم يكن مسجداً كما قال “غنيمة” وإنما سجناً لتعذيب المماليك. مع حكايات “غنيمة” نكتشف قيمة أهم من حقيقة القصة وهي قدرة الخيال على تجميل مرارة الواقع وتحسين شروط العيش فيه.
ومن خلال أحاديث “غنيمة” عن عمله في قطار الإنجليز، عندما كان شاباً، يمكن أن نجد مقارنة، مضمرة، بين عالمين: عالم القطار، وعالم الصحراء، عالم الإنجليز المحفوف بالازدواجية التي تتبدى من خلال حكاية العصفور الذي دخل القطار، فيعامله الخواجة برفق ورحمة ويطعمه القمح ويبني له منزلاً، ثم يخصص لنسله من العصافير عربة قطار بحراسها، في حين أن هذا الخواجة يحتل أرضا غير أرضه ولا يتعامل مع أهلها كما يتعامل مع هذه العصافير! لتقول لنا الحكاية أن حياة العصافير عند الإنجليز أهم بكثير من حياة المصريين.
في أول مائة صفحة يغيب عنصر التشويق القائم على تطور الأحداث، لذلك، ليس الحدث هو ما سيشد القارئ في هذه الصفحات، وإنما متعة السرد لحياة البسطاء ومشاهد الصحراء، في واحة يسميها السارد “الوعرة” ليرصد به وعورة الحياة في وطن يتحول فيه ناسه إلى منافٍ للرب. والرب هنا ربان: رب ظاهر، هو رب الكون ورب باطن أو مضمر، هو النفس أو الإنسان الحزين الذي لم يصبح بعد جديراً بخلافة الأرض!
بالرغم من أن الرواية الحديثة قد تجاوزت بمراحل شكلها أو بنيتها الكلاسيكية، إلا أن كثيراً من النقاد، وهم يقدمون الرواية الحديثة، يحرصون على تلخيص جانبها الحكائي. لكن مع هذه الرواية يصعب عرض هذا الجانب ولو بعد محاولات إعادة ترتيب أحداثها، لأنها، ببساطة، رواية لا يتأسس فيها السرد على الحدث كعنصر بناء متراكم بل على نحو وامض ومشتت. مشاهد على هيئة ومضات تخفت في موضع، حتى لتظن أنها قد اكتملت، لتضيء أكثر في موضع آخر بين موت وبعث متكرر، ما أن تعتقد بأن ومض الحدث قد خبى نهائياً حتى يُبعث من جديد أكثر لمعاناً ليصعد بك جبل السرد خطوة خطوة ليصل بك إلى قمة لن تود مغادرتها.
“حجيزي” شخصية روائية مبتكرة، أبدعها الخمايسي، يمكن ضمها إلى قائمة الشخصيات الروائية العالمية. يمثل “حجيزي” في الرواية دور الاستثناء في مقابل القاعدة من الناس. استثناء الشك في مقابل اليقين، والتهكم والسخرية في مقابل الرصانة والوقور الكاذب. له قلب وعقل طفل ممتلئ بالدهشة والتساؤل البريء في مقابل عقول أخرى مليئة بالإجابات الجاهزة الجامدة.
“حجيزي” لا يخاف من فكرة الموت بقدر ما يخاف من فكرة دفن الميت. لذلك يستغرب كيف يمكن لعزيز أن يدفن عزيزه. ويسأل أسئلة عن أشياء، لكثرة ما ألفناها، نسينا أن نسألها، أو ظننا أننا نعرف إجاباتها. أسئلة بسيطة لكن إجابتها ليست كذلك. يسأل “حجيزي” مثلاً: لماذا يدفن الناس موتاهم؟! وما معنى النشور في دعاء الاستيقاظ من النوم؟! ولماذا ندعوا به ونحن لم نكن موتى بل نيام؟!
تبدأ الرواية برؤية يتلقى فيها “حجيزي” خبر موته. في الحلم يأكل “حجيزي” ثلاث تمرات يفسرها الراهب بثلاثة أيام هي كل ما تبقى له من عمر. ليصبح الموت، وطقس الدفن بالتحديد، هاجسه الوحيد. ليست الرؤية في المنام فقط هي وراء انشغال “حجيزي” بفكرة الموت والخوف من الدفن، فعمله مع والده “شديد” في تحنيط الموتى، جعله دائم الانشغال به، لدرجة أنه لم يفكر في الزواج إلا وهو في سن الخمسين. وبالرغم من أنه عاش خمسون عاما أخرى إلا أنه لم ينم على سرير زوجته “سريرة” سوى ثلاث مرات فقط!
في هاجس الموت دلالة على ثقافة الموت التي تحيط بالأحياء من كل مكان حتى تحولت الدنيا إلى منافٍ ومقابر كبيرة للأحياء الموتى. وفي الرواية نقد للدين والخرافات المصاحبة له وإدانة، غير مباشرة، للديانتين المسيحية والإسلام اللتان تبشران بثقافة الموت وتهملان ثقافة الحياة. وبقدر ما الموت مخيف بقدر ما يتحول إلى حكاية مسلية مرادفة لحياة الصحراء المملة. “سيرة الموت والقبور تشغف قلوبهم، كأنها حكاية مسلية، فالحياة في واحة”الوعرة“، مثلما في أي واحة من واحات الصحراء، رتيبة، وينخر فيها الملل” (2).
يؤمن “حجيزي” أن الموت حق، لكنه “لا يريد أن يُدفن، وفي نفس الوقت، لا يريد أن يُترك على وجه الأرض فتأكله الكلاب، أو تنهشه الوحدة. لا يهرب”حجيزي“من الدفن، سوى لأنه الوحدة الصِرف، وهو يحب الونس، ولن يقبله الأحياء بينهم، لو أنه تعفن، لو استطاع التخلص من التعفن، لن ينفر منه الأحياء، وسيتركون جسده بينهم، وإذا كان الخلاص من الموت مستحيلاً، فالخلاص من الدفن ممكناً، لو أنه أحسن تنفيذ الخطة.” (3).
وفي سبيل الهروب من الدفن وطلب الخلود يفكر في التحنيط. يقول:
“الأولى أن نحنط أجساد أحبابنا، لا أجساد الحيوانات والطيور، أحبابنا هم من يجب أن نضعهم معنا في بيوتنا بعد موتهم، لا أن ندفنهم ونرميهم للبلى.” (4).
لكن لا يوجد أحد يمكن أن يحنطه، فقد تعلم “حجيزي” تحنيط الموتى على يدي والده “شديد”، لكن ولده “بكير” لم يتعلمه منه لأن “قلبه مثل قلب فأر” (ص139). في اقتراح تحنيط الميت، كما كان يفعل قدماء المصريين الفراعنة، بدلاً عن دفنه، كما يفعل المسلمون، دعوة، لا للعودة إلى القديم، وإنما لاستحضار حضارة الأجداد الخالدة في زمننا الحاضر.
يفكر “حجيزي” بحل آخر - رائحة العفن هي ما يجعل الناس يدفنون موتاهم، والرائحة العفنة مصدرها الطعام والشراب، لذلك يفكر:
“لن يأكل شيئاً أبداً، فقط سيسف مطحون القرض، ولن يشرب ماء إلا بالقدر الذي يسمح بابتلاع هذا المطحون العلقم، فالماء مصلحة لأجساد الأحياء، لكن إذا مات الجسد، صار الماء مفسدة له، وعندما يصل إلى شجرة البرتقال، لابد من اكل ولو ثمرة واحدة، يريد إذا مات أن يعبق جلده برائحة البرتقال، الأحياء سيحبونه أكثر وهو يفوح بعطر البرتقال.” (5).
يعتقد “حجيزي” بأن حياة المرء لا تنتهي بالموت وإنما بالدفن. الدفن هو الموت الحقيقي بالنسبة له، والخلود ممكن بدون دفن لو أن الجثث لا تتعفن. لذلك، هو يرى أن هناك أدوارا أخرى يمكن للميت أن يقوم بها، من خلالها سيظل عائشاً. يقول حجيزي: “الأموات يموتون فعلاً لما ندفنهم، لكن لو بقوا بيننا سيعيشون، ستكون لهم أدوار أخرى في حياتنا. في بيوتنا غرف لنومنا، وعرف ينام فيها اطفالنا، وغرف لخزين غلال حقولنا، وغرف لتخزين بلح نخيلنا، وحظائر لبهائمنا، لن تضيق بيوتنا إذا جعلنا فيها غرفا لأمواتنا، ولن يزعجنا الميتون طالما هم فواحات عطور” (6).
لكن صديقه “سعدون” يوقظه من أحلامه على حقيقة مُرة قائلاً:
“والله يا”حجيزي“لو سقيت الميت عطراً، فلن يخرج من دبره إلا فساء عفناً، هذا طبع الميتين.” (7).
لا يقتنع “حجيزي” بقول صديقه، وتبقى فكرة الهروب من الدفن مسيطرة عليه. “لابد من الهروب من الدفن، وإذا كنت لم أستطع العيش بينهم حياً، لأحيا بينهم ميتاً” (8).
ومن أجل الهروب من الدفن فكر في اعتناق المسيحية لأن الراهب “يوأَنس” أخبره أن “كل مسيحي يموت، وكل مسيحي يقوم من موته” (9). يرحل معه إلى الصحراء، لكن موت “برسوم” الراهب ودفنه، ثم موت بقية الرهبان، جعله يتأكد أن مصير الميت عندهم هو نفس المصير عند جميع الناس. وهناك في الصحراء يظهر له المسيح ويحاول إقناعه بضرورة الدفن. وقبل موته يقول له المعزي أو ملاك الموت:
“إذا صرت فواحة عطور، ستفتح طريقا واسعا لمهانة الإنسان، وما أراد الله للإنسان أن يكون مهانا حتى بعد موته... عندما تتحول الأجساد الميتة إلى فواحات عطور، ولا يكون حولها من الأحياء إلا أحفاد، سيتبادلون الجثث الفواحة فيما بينهم، سيتعاملون معها كما يتعاملون مع أي فواحة عطور جامدة، وعندما تمتلئ البيوت بهذه الفواحات، سيحطمونها بأيديهم ليتخلصوا منها وهم يشربون الشاي، لا مكان للموتى بين الأحياء وإن صاروا فواحات عطور” (10).
ويسترسل في إقناعه قائلاً: “القبر منبع الذكرى، والدفن حياة، يبقى الإنسان حيا في ذاكرة الأحياء بكامل هيئته وصورته طالما هو مدفون في قبر.” (11). يقتنع “حجيزي” في النهاية بأهمية الدفن فيصيح بابنه “بكير” وهو في رحلة الموت في الصحراء: “احفر قبراً، احفر قبراً، احفر قبراً” (12).
تقدم الرواية إجابة استشرافية لسؤال غير مطروح هو: ماذا سيحدث لو لم يُدفن الموتى ؟! مثلما تطرح رواية “انقطاعات الموت” لجوزيه ساراماجو فكرة توقف الناس عن الموت لأسباب غير معروفة. تتعرض رواية ساراماجو لمسألة تداعيات التوقف عن الموت وهي تداعيات كلها سلبية في مقابل الخلود. لكن ثمن الخلود غالٍ حين يتساوى ثمن جثة ميتة بدون دفن مع جثة تسير على قدمين أو ممددة على السرير!
في “منافي الرب”، “حجيزي” نموذج للإنسان الباحث عن الخلود. وهو وإن كان هنا خلود فردي إلا أن له دلالة إلى الرغبة في الخلود عند الأمم. وفي ضياع حياة “حجيزي” دون أن يحياها ويستمتع بها، دون أن يترك له فيها أثراً يخلده، دلالة على حياة الأمة الذي شغلها الموت عن الحياة والإبداع. تعيد الرواية تعريف الخلود وتربطه بالإنسان الجماعة، فمن خلال الجماعة يمكن للإنسان الفرد أن يُخلد بما أبدعه. هنا لا يموت الإنسان ولا يدفن لأن ذكراه، خلقه وإبداعه، هو ما يخلده. الذكرى الغائمة، في حكايات “غنيمة”، عن الإنجليز والعثمانيين والمماليك والفرس ،وأثرهم القليل المتبقي المدفون في رمال الصحراء، هي دلالة على هذا النوع من خلود الأمم. حتى البحر لم يمت وما زال أثره باقياً من في صحراء العلمين، ومن خلال الرائحة التي يتنسمها “حجيزي” وما تبقى من قواقع قليلة تشير إلى أن البحر كان يوماً هنا ومازال.
“الإنسان لا يموت، لأن الموت اختفاء، والإنسان ظاهر في الأرض يشيد خلوده، لا يموت الإنسان ولا يُدفن”، لأن “الواحد ليس إنسانا، الجماعة هي الإنسان، يموت الواحد، لكن الجماعة لا تموت”. الجماعة لا تموت شريطة أن تحيا حياة إنسانية، لأن “الحياة ليست أن تعيش. أولاد الأفاعي يملؤون الأرض، يعيشون ولا يحيون، الحياة لا ينالها إلا من يعيش كإنسان” (13). وإن لم يحقق الإنسان هذا الشرط سيعيش كل حياته في المنافي.
للمنافي في الرواية دلالتان: مكانية، هي الصحراء، بكل ما تعنيه من عزلة وقسوة ومعاناة، ودلالة نفسية معنوية، لتعني الحزن، بكل ما يعنيه من فراق وبؤس. وفي كلا المنفيين ينعدم شرط الحياة الطبيعية. مثل هذه الحياة عاشها الرهبان، وهم يعتقدون أن هدف الدين هو التبشير بالموت والتخويف من حياة القبر. أما السبب الذي جعلهم يفرون إلى هذين المنفيين فهو علاقتهم الغير طبيعية بالمرأة. الراهب “يوأَنس” مثال لشاب فر من الحياة ونعيمها بقتله “سيرين”، التي حاولت إغواءه، متخيلاً أن ما فعله يمثل إرادة المسيح ومطالب الدين، ولما عجز عن أن يحيا حياة طبيعية ضيع بقية حياته في منافي الصحراء ومنافي الحزن. ثم كانت نهايته على يدي المسيح منكراً عليه وبقية الرهبان حياتهم التي اختاروها معتقدين أنها مشيئته.
جرب “حجيزي” المنفيين. عمله في “تحنيط الجثث قتل حبه للجسد” (14)، لذلك عاش وهو يفكر في الموت والهروب من القبر، أكثر من انشغاله بالحياة ونعيمها. ولم تتوج حياته الطويلة، التي قضى نصفها بصحبة زوجته “سريرة”، سوى بثلاث لقاءات جنسية. رآها في أول ليلة بعد الزواج جثة على السرير بانتظار التحنيط، ولم يتم اللقاء الأول إلا بعد مضي عشر سنوات بعد الزواج. لذلك لم يتذوق طعم السعادة.
في الأخير يتوصل “حجيزي” إلى سر السعادة، “السعادة امرأة تحبك وتحبها، كلمة تشبه ما قاله الراهب”يوأَنس“: لو وجد أحدنا امرأة تحبه ما ألقى بنفسه في منافي الرب”. ولكي يعيش المرء إنساناً سعيداً، ينصح “حجيزي” ولده “بكير”: “حافظ على امرأة تحبك، حتى لا تلقي بنفسك في منافي الرب”. وعندما يسأله “بكير” وما منافي الرب؟!“، يجيبه:”الحزن يا بكير“. تخبرنا الرواية أن شرط السعادة مرتبط بعلاقة سوية طبيعية مع المرأة، واهبة الحياة. مثل هذه السعادة يحققها”سعدون“وزوجته”زليخة“، فبالرغم من أنهما لم ينجبا ولداً إلا أن علاقتهما سادها الحب والعشق، لذلك، يموت”ممدداً على سريره ضاحكاً، وعيناه تنظران إلى فوق، وفيهما لهفة“(15).
دخلت الرواية ضمن القائمة الطويلة لنيل جائزة الرواية العربية”البوكر“لهذا العام 2014.”كان أشرف الخمايسي، قد أعلن علي حسابه الفيسبوكي، بعد انتهائه من كتابة “منافي الرَّب”، أنه كتب الرواية الأروع في تاريخ الأدب العربي، وأن هذه الرواية يجب أن تحتل مكانتها في الأدب العالمي، وإنها الرواية التي، إذا دخلت أية مسابقة، فيجب أن تظفر بالمركز الأول!“(16).
بعد أن أنهيت قراءة الرواية، وقراءة”فرانكشتاين في بغداد“الفائزة بالجائزة، لم أشك للحظة على أن منافي الخمايسي كانت تستحق الانضمام إلى القائمة القصيرة والفوز بالجائزة لولا أن لجنة التحكيم اعتمدت معايير أخرى لفرز الروايات! ربما أرادت تشجيع الوجوه الجديدة من الروائيين، فمعظم الأسماء التي انتقلت إلى القائمة القصيرة هي من الوجوه غير البارزة، ومن قائل بأن اللجنة لم تغتر بالأسماء الكبيرة وركزت على المضامين لذلك فضلت لفت الانتباه للرواية الواقعية. لأن واقعنا الراهن أولى بالالتفات إليه من صنعة الرواية، أو لعل السبب جغرافي، بالرغم من أن لجنة التحكيم أكدت، على لسان الناقد، ورئيس لجنة التحكيم، سعد البازعي، على نزاهة الاختيار.
أن لا تفوز”منافي الرب“بالجائزة أمر يمكن قبوله، لكن أن لا تدخل الرواية إلى القائمة القصيرة، هو أمر يدعو للاستغراب. لكن ما يقلل من وقع الدهشة، ويدخلنا في حيرة أخرى ربما أشد، هو أن أسماء أخرى كبيرة لم تفز بالجائزة ولم تدخل حتى ضمن القائمة القصيرة، مثل إبراهيم عبد المجيد (مصر)، واسيني الأعرج (الجزائر)، أمير تاج السر (السودان)، عبد الخالق الركابي (العراق)، أنطوان الدويهي (لبنان)، إبراهيم نصر الله (فلسطين) وأسماء أخرى أكثر شهرة وتكريساً للرواية. وهو ما يجعلنا نرجح وجود معيار جديد للحكم على الأدب الروائي، فربما أرادت اللجنة إنقاذ نفسها من حرج تفضيل اسم من الأسماء السابقة على الآخر فاستبعدتهم كلهم!
هنا لا يسعنا إلا أن نتساءل كما فعل فاروق يوسف، في مقال له على الحياة:”هل يمكن أن لا يصمد واحد على الأقل من أولئك الروائيين حتى يصل إلى الخط الأخير من السباق في القائمة القصيرة؟ أيُعقل أن أولئك الروائيين الذين قرأنا لهم أعمالاً روائية مهمة قد تراجع مستواهم الابداعي في أعمالهم الأخيرة التي قدمتهم دور النشر من خلالها إلى الجائزة؟".
الهوامش:1- صدر للكاتب: ثلاث مجموعات قصصية وروايتان. الجبريلية، مجموعة قصصية، الهيئة العامة لقصور الثقافة 1995. الصنم، رواية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1999. الفرس ليس حراً، مجموعة قصصية، الحضارة للنشر، 2011. السكاتة، مجموعة قصصية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2013. منافي الرب، رواية، الحضارة للنشر، 2013. ورواية انحراف حاد، الدار المصرية اللبنانية 2014. وله تحت الطبع: أهواك، مجموعة قصصية، أخبار اليوم – كتاب اليوم.
2- الرواية، ص 150
3- الرواية، ص 139
4- الرواية، ص 130
5- الرواية، ص 140
6- الرواية، ص 143
7- الرواية، ص 141
8- الرواية، ص 162
9- الرواية، ص 164
10- الرواية، ص 365
11- الرواية، ص 366
12- الرواية، ص 368
13- الرواية، ص 325 ، 326، 328
14- الرواية، ص182
15- الرواية، ص 346، 360، 361
16- مصطفى عبدالله، أخبار الآداب، مقال: الخمايسي صاحب الثقة المستفزة.